طبائع المؤسسة (حياة في الإدارة)1 - 2الباب: مقالات الكتاب
 | أ.د. إبراهيم بن محمد الشتوي أستاذ الأدب والنقد |

لولا أني لا أحب أن أغضب جمهور ومحبي الراحل غازي القصيبي - رحمه الله- لقلت إن هذه المادة المكتوبة بين دفتي كتاب اسمه «حياة في الإدارة» رواية تخييلية، يقوم فيها الخيال بدور كبير كأي رواية واقعية، إلا أنني سأتفادى هذا الغضب بألا أقول هذه الرؤية، وأعتبرها سيرة ذاتية تقول الحقيقة ولا غير.
بيد أن هذه الرؤية والشعور حيال النص المكتوب يعزِّز رؤية «بارت» في كتابه «هسهسة اللغة»، و«أمبرتو إيكو» في كتابه «الزمان والسرد»، حينما يقفان على التداخل بين التاريخي والتخييلي، ويعدان كل واحد منهما قريبًا من الآخر.
وهذه السيرة الإدارية التي تفضل الدكتور غازي القصيبي بتقديمها للقارئ، تكشف عددًا من جوانب دهاليز المؤسسة الإدارية على كل مستوياتها على الرغم من عنايتها بالأساس بتسليط الضوء على تجربة الكاتب، ورؤيته الإدارية بالدرجة الأولى.
ومع أنها تسلط الضوء على حقبة تاريخية سابقة، فإن السؤال عن سبب كتابة هذه السيرة بعد أن ذهبت تلك الأيام بحلوها ومرها، وبعد أن استطاع غازي/المؤلف أن يعيد اسمه إلى الأضواء مرة أخرى بعد أن ظنه «منافسوه» قد ذهب إلى غير رجعة، وهو ما يعد الرد الفعلي على تلك المواقف، ورد الاعتبار الحقيقي بعد الاعتبار الرسمي، مما يغني عن كتابة هذه السيرة وما جاء فيها من بيانات دفاع واضحة، أقول: إن السؤال لا يزال مطروحًا.
لكننا إذا استبعدنا مسألة الدفاع عن نفسه، وتجميلها بسرد موقفه الشخصي من كل حالة لاكتها ألسنة الإعلام، وقلبتها على كل وجه قد لا يكون منها وجهة نظره الخاصة، وهذه إحدى وظائف السيرة الذاتية -على كل- التي لا يستطيع أحد أن يبرئ السيرة الذاتية منها، وقد سارت بها الركبان، إذا استبعدنا ذلك بوصفه يريد أن يقدم الدروس والعظات، والتجربة لمن جاء بعده، كما امتلأت بها السيرة.
مع هذا، فإننا لا يمكن أن ننكر الجانب التجميلي والدفاعي الذي أشرت إليه من قبل بوصفه أحد وظائف السيرة الذاتية، ولأن السيرة الذاتية «حياة في الإدارة» قد تناولت في صفحات عدة موضوعات كانت تشغل المتحدثين عن الجانب الشخصي للراحل، وهذا يتجلّى مثلاً في حديثه عن «الشعبية» التي نالها منذ بدأ عمله في الجامعة.
والذي أريد أن أقف عنده أولاً - وما أظن الكاتب غافلاً عنه- هو أن الشعبية مسألة نسبية، فقد يظن الإنسان أن له شعبية، في حين أن شعبيته لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، الذين يمرون به غدوًا ورواحًا، وهو في الحقيقة لا يملك شيئًا من ذلك، وهو ما عبر عنه أحد النقاد الفرنسيين في وصف حركة الرواية الجديدة في فرنسا حين قال: «زوبعة في فنجان»، ولا يعني هذا أنني - والعياذ بالله- أطعن في «شعبية» أستاذنا الكبير، ولكني أقول: إنها مسألة نسبية، ولا يمكن للإنسان دفعها أو ثباتها بناء على شعوره الشخصي، فلله عباد يوهمون الإنسان بشعبيته، وإن كان في الحقيقة لا أحد يأبه به، والكاتب على كل ليس منهم.
أقول إن محاولة دفع الكاتب تهمة «الشعبية» وكأنها «الشعوبية» أمر يلفت الانتباه، وكأنه يراها سبة، من جهة، وهي ليست كذلك، بيد أنه يقدم جوابًا على سؤال عن سبب كتابة السيرة. على أنه من المهم القول: إنه لولا الشعبية التي يحظى بها منذ البدء لما تولى عمادة الكلية، وقد يكون دفاع الكاتب يتركز على كونه لم يسع إلى هذه «الشعبية»، وأنها لا تهمه.
قد تكون -الشعبية- كغيرها، تأتي حين يعمل الإنسان ما يستحقها، غير أن قول الكاتب في بعض المواقف: «فلتذهب الشعبية إلى الجحيم» يبين وعيه بها، وبمتطلباتها، وأنها كانت حاضرة في ذهنه، وذهن من حوله بوصفها موضوعًا للنقاش، هل يدفعني هذا إلى القول بأن في هذا الموقف ما يناقض ما قاله عن عدم سعيه إلى ذلك؟ لن أجيب على هذا السؤال لأنه -في الحقيقة- لا يهمني، خاصة وأن «الشعبية» لم تحكم الكاتب بناء على المقولة المشهورة: «الجمهور عاوز كذا»، وإنما كان متفقًا معها في الوقت الذي تكون متفقة مع منطلقاته، وهذا يعني أنها -الشعبية- بناء على أن تعريفها الحقيقي ليس الحب، ولكن تحقيق المعايير التي يتطلبها الشعب (عامة الناس)، وجعل مصالحهم الأساس الذي يبني عليه مواقفه الإدارية، والقرارات التي يتخذها.
ولعله يمكن القول: إنه بناءً على المقولة السابقة - الجمهور عاوز كذا- يتبيّن أن العلاقة معه ليست بتلك السهولة، فالجمهور الذي تنبني على العلاقة به «الشعبية» لديه توقعات، ينبغي أن يحققها من يتعرض للجمهور. هذه التوقعات انبنت من خلال مرحلة طويلة من الخبرات الاجتماعية، والمعرفية، بعضها قد يكون مغلوطاً بوصف هذا الشخص ابن بيئته، ويتأثر بها.
إذا كانت الشعبية هي كسب رضا الشعب من خلال تحقيق المعايير التي يتطلبها فإن هذه المعايير قد نشأت من تجارب، وخبرات سابقة، وتكونت من البيئة التي نشأ فيها «الشعب»، وهذا يعني أنها ليست بالضرورة موضوعية، وهو ما يدل على أن الشعبية ليست بالضرورة محمودة، أو أن تحصيلها لا يعني بالضرورة أن صاحبها على صواب؛ الأمر الذي يوصلنا إلى قضية العلاقة بالجمهور «الشعبية»، فالجمهور الذي يحيط بالقائد له متطلباته، وتوقعاته، وشروطه التي يفرضها على من يحبه، ويمنحه ثقته، فإذا لم يحققها الشخص (لنقل: النجم) فإن الجمهور قد يكون له موقف آخر، فإذا كان هذا الجمهور قد اعتاد على المحاباة، والاعتماد على معايير تتمثل بالقرابة، والجهة، والعناية بالمصالح الشخصية الفئوية الضيقة، فإن شعبيته ستكون قائمة على من يحقق هذه المعطيات، ويتوافق معها. ولأن هذه العلاقة قد تكون مغرية لبعض الناس، لا يريد أن يخسرها، فإنه يستجيب لما يضمنها له، ويتراجع عما يراه صوابًا، أو ما يؤمن به حفاظًا عليها. وهذا ما يعني أن «الشعبية» سلاح ذو حدين.
وقد كان الراحل واعيًا بهذه العلاقة الخطيرة، والحالة التي ينجذب فيها «النجم» للهالة التي توفرها «الشعبية»، فيستسلم لها، ويتحول من مركز التوجيه، واتخاذ القرار، لأن يكون صدى لهذه المجموعة، أو تلك، يستجيب لما يملونه عليه، ويحقق رغباتهم منه. وحين تكون هذه الجماهير «الشعبية» متكونة من العامة، وأنصاف المتعلمين، فإن الهرم القيادي ينقلب على رأسه، ويصبح غير قادر على اختيار الوجهة الصحيحة.

هذا الوعي لدى الراحل لا يتوافر لدى كثير ممن هم محط الأنظار؛ لذا نجد آراءهم تتقلب، ومواقفهم تختلف، لا بحسب ما يرونه، أو بحسب ما تبدو لهم الحقائق، وإنما بحسب ما يضمن لهم «الشعبية»، ويكفل بقاءهم في دائرة الأضواء، وهنا يتحول هو نفسه من قائد إلى عضو في مجموعة، ومن صانع للوعي إلى واحد من الغوغاء، يحظى بمنزلة أكبر من غيره.
ولأن الراحل أدرك هذا، ولم يستسلم «للشعبية»، أو يسقط في هالتها، فهي لم تكن عيبًا، ولا سببًا للطعن في أهليته، أو معنى يفسر من خلاله مواقفه، بدليل أنه لا يبالي بها حين يراها لا تتوافق مع المصلحة العامة التي اتخذها هدفًا له فيما يأخذ أو يذر. المصلحة العامة التي لا تأخذ بحسبانها الفئة الضيقة التي ينحدر منها، أو التي تضمن مصالحه، سواء كانت جهوية، أو طائفية، أو قبلية، أو فئوية.
وهنا نأتي إلى الفرق بين «الشعبية» و«الشعوبية» التي في أساسها تستمد قوتها من الشعوب التي تجد نفسها خارج النسيج الاجتماعي الرسمي؛ ما يشعرها بالغبن، وضياع الحقوق؛ وهو ما يجعلها بدوره تتعصب لمصالحها، دون النظر إلى ما يسوغ هذا التعصب، أو يبرر الحصول على المصلحة بوصفها حقًّا لها. وهنا تجد نفسها في مواجهة مع المؤسسة الاجتماعية؛ فتتحول إلى فئة لا تراعي القوانين، ولا تؤمن بها، كما لا تعتبرها (القوانين) ممثلة لها، ومن هنا فهي تسعى إلى أن تتجاوزها ما دامت بمعزل عن المحاسبة. وهنا تتحول «الشعوبية» إلى داء، وخلل ينخر في منظومة القيم الاجتماعية، ويهدد كيانها، وتصبح معضلة تحتاج إلى حل، وليست صورة من صور الوقوف ضد الظلم، أو التهميش، والإقصاء.
على أننا حين نتأمل هذه الرؤية «للشعبية» لا نجدها تختلف عن رؤية غازي القصيبي العامة في تصريف الأشياء، فالدكتور لا يولي اهتمامًا كبيرًا «للعدد»، و«الكثرة»، و«الحشد»، و«الجماهير»؛ إذ إن هذه القضايا أو المفردات لم ترد في حديثه كثيرًا، ولا تشكل «وصفة سحرية» ينبغي أن يتمكن منها لتكون طريقًا لتحقيق الأهداف، أو أنها وسيلة تحديد الصواب من الخطأ.
بل إننا نجد أنه يمكن أن يحسب من أنصار «النخبة» والمؤمنين بها على «الجماهير»، و«الخاصة» على «العامة». هذه النخبة تبدأ بالتكون - على رأيه - من الجامعة التي ينبغي أن تكون خاصة للمتميزين، وأصحاب المعدلات العالية، فتكون مكانًا تمنع الجماهير من دخوله، ويأخذ فيه الداخلون العناية الكاملة من التعليم، والتدريب، حتى إذا تخرجوا وجدوا أماكنهم في المؤسسة الإدارية جاهزة؛ ليساهموا في التنمية الشاملة للمملكة.
وهنا تتحول القيادة والعاملون في الدولة - كما يرى - ذات مواصفات عقلية معينة، تم اختيارها من الجامعة، وإمكانيات علمية ومهارية تم تعليمها وصقلها في الجامعة أيضًا، ولن يكون لمن لم يدخل في تلك المؤسسة «العصيبة» الجامعة طريقًا إلى الدخول في المواقع المهمة في المؤسسة الإدارية.
هنا تصبح الفئة التي دخلت الجامعة منذ البدء نخبة مختارة من أصحاب المعدلات العالية، وتمر بمراحل صقل، وغربلة، على مدار سنوات الجامعة، فيتخرج منها صفوة الصفوة، هي النخبة الحقيقية العاملة في الدولة، وهي المعتمد عليها في تولي زمام الأمور القيادية بدرجاتها المختلفة، وعندها لا يصبح «للشعبية»، و«الجماهير» دور كبير في الإدارة، لأن النخبة تعلم مصلحتها، وتعلم الطريقة المثلى لتحقيق هذه المصلحة، وبناء على هذا فإن دور الجماهير، و«الشعبية» مقتصر على دعم النخبة، وتأييدها، والوقوف معها، وتسويق مشاريعها، والقضاء على العوائق التي تقابلها، وهو دور المساعد.
وهذه الرؤية رؤية تنموية جميلة جدًّا، لكنها رؤية حالمة، رومانسية تتفق مع طبيعة غازي الشاعر، تشبه مدينة أفلاطون الفاضلة، حيث لا مكان إلا للكُمَّل، لكنها ليست واقعية، ولا يمكن أن تتحقق، وهذا لعدة أسباب.
إن هذه المدينة الفاضلة التي يريد أن يجعلها أستاذنا الكبير المصنع الأول للنخبة (الجامعة)، ليست عصية على أيدي الفاسدين، فإذا كانت التجربة التي مر بها في الجامعة قد أعطته انطباعًا جميلاً عنها، فإن هناك حالات أخرى يقوم فيها المسؤولون بالجامعة بالاعتماد على عناصر تكونت بطريقة مريبة، فتجد فيهم من تورط بسرقة علمية، أو من تورط بالغش، والكذب، أو من خالف لوائح الجامعة وأعرافها في دراسته، وتكونه، فيجعلهم طريقًا لتقويم، وتسيير العناصر الأخرى التي تنطبق عليها المعايير «النخبوية» لأستاذنا الكبير، وهنا تصبح العناصر المفارقة للنخبوية، هي المقياس الذي من خلاله تدار النخبة، وعندها تصبح مؤسسة إعداد النخبة -في الحقيقة- مؤسسة لإفسادهم، وصياغتهم صياغة لا تتفق مع الصياغة الصحيحة.
ثم إن الجامعة لا تتكون من الأساتذة، والطلاب الذين سيكونون نتاج هذه المعايير النخبوية، وإنما أيضًا فيها قدر كبير من الموظفين ذوي المراتب المختلفة، وهم -حتمًا- خارج هذا الإطار، وقد يملكون من التأثير في بناء القرار في الجامعة ما لا يملكه الأساتذة في بعض الأحيان، والمشكلة في هؤلاء الموظفين أنهم من سياق اجتماعي، إداري، مختلف عن سياق الطلاب والأساتذة، إنهم من منظومة قيمية -أحيانًا- بعيدة عن الاعتبارات الأكاديمية التي ينشغل بها الأساتذة والطلاب.
إضافة إلى هذا فإن الاعتماد على المعدلات التي خصصت بطريقة معينة لقياس قدرات محددة لدى الطلاب، واعتبارها هي الموضحة الحقيقية لمستوى الطلاب وقدراتهم، هو اعتماد غير صحيح، فقد ثبت بالتجربة أن التميز في الناس، الذي يعتمد عليه ببناء النخبة، ليس مقصورًا على هذه المعدلات، وأن كثيرًا من أصحاب المواهب البارزة ليسوا من أصحاب المعدلات العالية، فهي تعطي مؤشرًا على قدرة الطالب على التحصيل، والمعرفة، ولكنها لا تقطع بعدم صلاحية الباقين.
وعلى هذا، فإن منع من يرغب الالتحاق بالجامعة من أن يحقق رغبته، هو نوع من حرمان المجتمع من عدد كبير من الإمكانيات المحتملة، كما أنه منع أيضًا له من حق متاح، وهو «التعلم»، ما دامت الإمكانيات المادية في القبول ممكنة.
ثم إن ربط التعليم بالتوظيف، بالرغم من أهميته في القضاء على البطالة، وفي تهيئة البنية التحتية للتنمية كما يرى الراحل، هو تركيز على الجانب النفعي التطبيقي للعلم، وعلى هذا ينبغي أن نغلق كثيرًا من أقسام العلوم الإنسانية التي لا تتصل بهذا الجانب التطبيقي.
كما أن حصر النخبة بمن تخرج من الجامعة أمر يخالف كثيرًا من الحالات، حيث نجد أصحاب المواهب، والمتميزين، ممن لم يكن لهم حظ الدراسة في الجامعة، ومع ذلك يكونون شعراء، ونقادًا، وكتابًا، وقياديين ناجحين، ساهموا في خدمة الثقافة، والمجتمع.
وهذا يدفعني للحديث عن مفهوم «النخبة»، فالكاتب لم يتحدث على وجه الحقيقة عنها، لكن حديثه عن طريقة تجهيز الكوادر يكشف أنه يحددها فيمن تخرج في الجامعة، وتمكن من أن يتولى موقعًا كبيرًا في المؤسسة الرسمية، ولا شك أن هؤلاء جزء من النخبة، ولكننا لا نستطيع -كما مر من قبل- أن نحصرها بهؤلاء، فالنخبة هم الذين يتوافرون على مستوى من التعليم الجيد سواء كان عن طريق المؤسسات التعليمية النظامية، أو الاجتهاد الشخصي، مع قدر جيد من الوعي بالقضايا والظروف المحيطة بهم، وهذا يفتح المجال للمشاركة أو الاستفادة من جميع المكونات الوطنية على اختلاف مكوناتها العلمية والفكرية، والمهارية.
تغريد
اقرأ لهذا الكاتب أيضا
- التحيز في الأدب 1-2
- التحيز في الأدب 2-2
- الهوية والقومية
- طبائع المؤسسة (حياة في الإدارة)1 - 2
- طبائع المؤسسة (حياة في الإدارة) 2 - 2
- من «وحي الحرمان»
- الموقف من الآخر في السرد العربي
- جماليات القبيح
- بلاغة المهمشين
- أدبيات البرجوازيين
- ثقافة المديح
- كتابة تاريخ الأدب
- سرديات شوقي ضيف
- نـــقــــاد الــعــجـم
- شعرية شعر الحكمة
- قول في الكلام
- اللغة والمجتمع
- الأدب والصنعة
- الأدب المترجم
- أغلاط المتنبي
- جناية الأدب المصري على الأدب العربي الحديث
- الشوفينية المصرية
- الجنسانية المصرية (1)




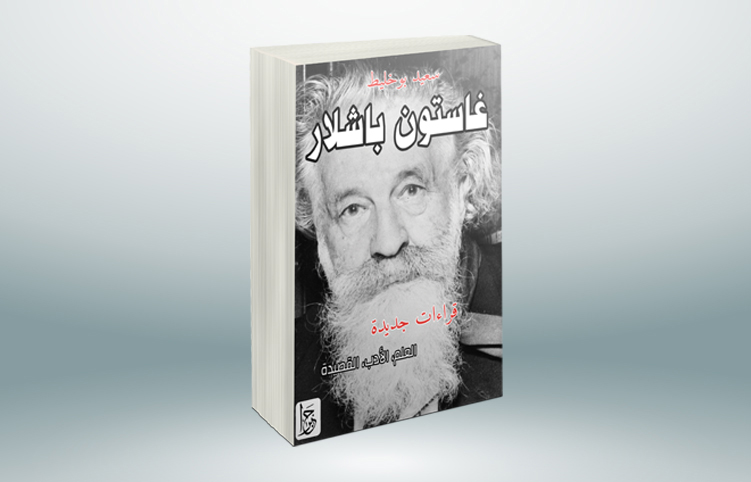

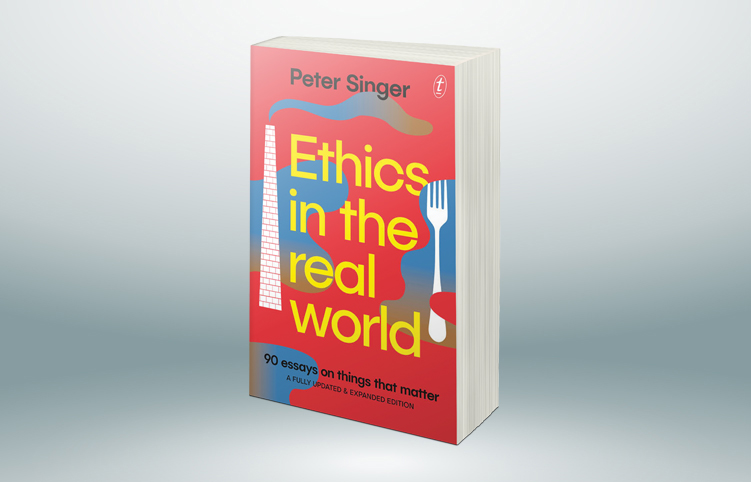










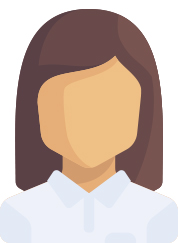
اكتب تعليقك