بلاغة المهمشينالباب: مقالات الكتاب
 | أ.د. إبراهيم بن محمد الشتوي أستاذ الأدب والنقد |

أخذ ميشيل فوكو في دراسته للنصوص غير الأدبية أو «المتكلفة» - إن صح التعبير- مظهر تأثيرها على جماهير المتلقين، فاستنبط منها نظريته في السلطة، فكانت قيمة هذه النصوص لديه في تأثيرها على الوعي خاصة في سيرورتها وانتشارها.
وهذه النصوص تقابل بالنصوص الأدبية الرسمية من داخل الأجناس الأدبية المعروفة: (الشعر، الرواية، القصة، الخطبة، الرسالة، المقالة). وهي أجناس أدبية تلقى عناية فائقة من قبل الجماعة المخاطبين بها (المجتمع) من أعلى مستوى فيها (الخلفاء، الوجهاء، العلماء)، ولذا فهي فنون رسمية، وتستمد قوتها الأدبية من موقف المؤسسة الرسمية الاجتماعية منها بناءً على أهمية الناس الذين يعنون بها.
وقد كان القدماء يهتمون بالقص كما يهتمون بالشعر والكتابة والخطابة، «فالقصاص»، وهم جماعة من المتحدثين يتولون القص على الناس في المساجد، ويتولون هذا العمل من قبل الخليفة أو من يقوم مقامه، ما يجعلها وظيفة رسمية، ويجعل هذا الجنس معتمدًا صحيحًا.
وقد قام العلماء بعد ذلك بالعناية بهذه الأخبار والنصوص المسرودة عن أناس ذي حظوة في الخلافة، وعند أهل السلطان، فظهرت في كتب أبي عثمان الجاحظ، والمبرد، وابن قتيبة وسواهم. بل إن ياقوتًا الحموي في معجم الأدباء عقد فصلاً سماه «علم الأخبار»، وافتتحه بمقدمة أورد فيها طرفًا من أقوال تسند إلى معاوية بن أبي سفيان في فضل هذا العلم، وبيان قيمته.
وقد اندرجت هذه الأقاويل فيما توارثه العلماء، والنقاد فيما بعد في حديثهم عن «البيان» و«البلاغة» و«الفصاحة»، واعتبرت من الأمثلة التي ينطلق منها الناقد أو يقيس عليها المتكلم ما يريد أن يقول، ولذا فقد أصبحت جزءًا من تكوين البلاغة العربية والنقد، ومكونات الوعي الجمالي العربي، تتماهى مع الذوق الرسمي السلطاني وتعبر عنه.
إلا أن هذه القصص والأخبار ليست جميعًا مما يندرج في هذه الكتب العلمية، مما يوصف بدواوين البلاغة، ولا كل هذه الأخبار مما يسند إلى الجماعة الأولى في المجتمع، وإنما هناك أخبار أخرى وقصص لا تُدون بتلك الدواوين، ولا تسند إلى تلك الفئة، وتوصف أحيانًا في بعض الدوائر العلمية «بالأدب الشعبي» أو «السرد والقصص الشعبي»، ويختلف الباحثون في تعريفها؛ فمن قائل إنها مكتوبة بلهجة عامية، ليست هي اللهجة الرسمية، ومن قائل هي ما لا يعرف مؤلفه الأول دارت بين الناس يضيف كل قوم منهم ما يضيفه، ويحذف ما يحذف إلى أن اكتملت صورته الظاهرة، فهو من إنشاء الشعب.
وأيًا ما يكن تعريفه، فإن الجانب المميز لهذا اللون من الأدب أنه يتحرك في فضاء بعيد عن الأدب الرسمي، حيث بسطاء الناس وعوامهم، يتردد بينهم، ويتضمن همومهم، ويعبر بلغتهم، وينضح عن أفكارهم، ويمثل خيالاتهم. إنه أدب العامة في الأسواق، والنساء في المنازل، والصبيان في الملاعب والفلاحين حين يعودون من الحقول، يجتمعون للسمر والسهر، فيملؤون به مجالسهم، ويؤانسون به أصحابهم، ثم يرددونها في ذاكرتهم تتوارثها أجيالهم وسيتخلصون منها حكمتهم التي يعيشون فيها.
وهذا يعني أن هذه النصوص على اختلاف أجناسها أصبحت واقعًا نصيًا ملموسًا، لها فضاؤها الاجتماعي الذي تتحرك فيه، وتنتمي إليه، وليست صورة معدلة عن نصوص أخرى أكثر ازدهارًا وكمالاً، أو صورة مشوهة عنها، تفتقد قيمتها بناء على بعدها من تلك النصوص، وتعبر عن درجة ثانية من الثقافة، وأنها - النصوص - قد استطاعت أن تفرض نفسها على المتلقين بالتأثير فيهم، وجذب عنايتهم، والتغلغل في كياناتهم وحيواتهم، مثل سائر الآداب، وهذا هو الشرط الثاني لكل قول يوصف بالأدب ويعنى به.
وبناء على اختلاف الفضاء الذي يتحرك فيه هذا الأدب، واختلاف مواضعاته، وأسلوب معيشة هذا الفضاء، اختلف تكوينه، واختلفت الأدوات التي تؤدي ما به من تأثير، كما اختلفت أيضاً موضوعاته والقضايا التي يعالجها والقيم التي ينشرها عن الآداب الأخرى المدونة عند القدماء والتي يمكن أن توصف بلغة النقد الحديث أنها آداب «كلاسيكية». والكلاسيكية هنا مأخوذة من معنى كلمة « Class» وهي الطبقة، بمعنى أنها تعبر عن طبقة معينة ذات اهتمامات محددة وذوق معين، ولأن البلاغة العربية قد استمدت من تلك النصوص، وجعلتها أمثلتها والنماذج العليا لها، فإنها في الحقيقة تنتمي إليها وتعبر عنها، أي عن النصوص الكلاسيكية، ولا تعبر عن النصوص الأخرى الشعبية، ما يعني في الوقت نفسه أنها (النصوص الشعبية) تتضمن بلاغيات أخرى مغايرة للبلاغيات الكلاسيكية تعبر عن ذوق الفئة التي تبنت تلك النصوص لأول مرة، وتأثرت بها ومنحتها حيزاً للوجود، وهي فئة المهمشين من الناس، ولذا فهي تعبِّر عن بلاغة المهمشين.
حين نعد القص الشعبي «خطابًا» مؤثّرًا، ونقوم بدراسته من هذه الزاوية، فإن هذا الاعتبار يصبح جواز مرور إلى سائر أنواع الدراسة والتأمل، ويمنحه الفرصة للدخول إلى عالم النصوص الأدبية المعتبرة. وهذا يعني أن سائر عناصره ومكوناته تصبح مجالاً للدرس والتأمل والنظر لأنها هي التي كونت هذا الخطاب، ولأنها أيضاً تحمل بذور التأثير في المتلقي وهذا ما يجعلها عناصر بلاغية في المقام الأول.
تقوم البلاغة - في الغالب- وأقصد البلاغة العربية على الشكل في المقام الأول، بمعنى أنها تبحث عن مكونات شكلية. وبناءً على دلالة هذا الشكل يتحدد المعنى البلاغي الذي هو - في الغالب- جزئي يتصل بهذا العنصر الشكلي نفسه. وهذا مطرد في مباحث علم البيان والبديع والمعاني.
وحين نقول خطاب المهمشين، فنحن لا نبحث في الضرورة عن شكل، وإنما قد نبحث عن مضمون أو معنى، وهذا يعني أننا نتجاوز المفهوم الضيق للبلاغة العربية للبلاغة لنجعله دالاً على السمات العامة للقول حين يصبح مجالاً للدراسة والتأمل، ذلك أن الموضوع الذي يطرحه «القول» أحد العناصر المهمة الجاذبة له، ثم إننا في رحلتنا إلى تأمله وقد أصبح أداة للتأثير والإمتاع، وملء الوقت، لا بد أن نقف على مكوناته بوصفها جزءاً من عناصره المساهمة في تكوينه وبيان أثره.
أول سمة ظاهرة مضمونية، وهي شكلية في الوقت نفسه، من سمات القص الشعبي إسناد الأفعال إلى قوى غيبية، تتمثل بالجن على وجه الأغلب. وهي سمة تحدث عنها كثير ممن تحدث عن القص الشعبي، حتى عدها بعضهم السمة الفارقة له عن القص الحديث، وعن الأسطورة باعتبار أن الأسطورة - خاصة اليونانية- تقص نبأ صراع آلهتهم، في حين ترتبط أحداث السير الشعبية بالجن والشياطين. أما القص الحديث فيتناول سير البشر من غير آلهة أو جن، واللجوء إلى السحر والكهانة، والحيلة في تحقيق المراد.
فالجن حاضرون بصورة كبيرة، والصلة بين الإنس والجن قائمة، تكون عن طريق المصاهرة كأن ينكح الجن إنسية أو الإنسي جنية، أو عن طريق الصداقة بأن يكون أحد الجان صديقًا للإنسان، أو عن طريق التعاون فيعمل كل واحد منهما عملاً للآخر، إضافة إلى تصور الجن بصورة الإنسان والطير وتحوله بين الأشكال المختلفة. وهذه الصلة بين الجن والإنسان تجعل العوالم متداخلة، فالشجر والحيوان يتكلمان، والإنسان يطير، وتنتج فضاءً شعبيًا متميزًا مختلفًا-ربما- عن العالم الواقعي المحسوس.
فالإنسان - بصورة أخرى- في القص الشعبي متجاوز عالمه الظاهر، وممتد تأثيره إلى العالم الغيبي (وهو عالم الجن طبعًا)، وهو ما يعطيه قوة على الطبيعة وميزة عن الأجناس الأخرى. وهذه القوة التي تمنحها الجن للإنسان هي قوة مساندة لأننا لا نلبث أن نرى الإنسان يتفوق على الجن والعفاريت في كل مواجهة بينهما، ويكون هذا التفوق بالمواجهة حينًا وبالحيلة أخرى.
ونحن نقول (ربما) لأننا لا نستطيع أن ندرك الحالة التي يرى الإنسان الشعبي (البسيط) في القص الشعبي الكون عليها، ولا نستطيع أن ندرك الطريقة التي يتعامل مع الكون من خلالها، فنحن لا نستطيع أن نحدد إذا ما كانت الحالة التي جاء عليها الفضاء في الحكاية تعبر عن الرؤية الحقيقية أم أنها تفسير الإنسان البسيط للكون من حوله، أم أنها بمثابة تعبير مجازي رمزي عنه.
لكن الأمر المهم هو أن هذا الإنسان البسيط (المهمش) قد أنتج عالمًا جديدًا موازيًا للعالم الواقعي الذي يعيشه، تختلف فيه العلاقات عما يراه، كما يختلف فيه موقعه، فعوضًا عن أن يكون مهمشًا لا يؤبه به، يتبع مواقع الكلأ لأغنامه، أو يتابع سقيا زرعه، أو أن تكون امرأة تعنى بشأن رحاها وتنورها، أصبح مركزًا تدور حوله الأحداث، يصول ويجول ويأخذ ويدع، ويصل ويقطع، تمتد قدرته إلى ما وراء الطبيعة، يتحدث إليها ويسمعها، فيحدث الشجر والحجر والطير والدواب، ويركب الرياح والبحار، ويحرك الجن كما يشاء.
هذه الحالة التي يأتي عليها المكان ومن فيه، تمثِّل نوعًا من التعويض عن الواقع الذي يعيشه، وحاله فيه، ونوعاً من التسلية لما يعانيه من كبد العيش ومشقته، ومن عجزه حياله، يجد فيه الإنصاف إن لم يكن منصفًا في واقعه، ويجد فيه الانتصار إن كان مظلومًا، يشحنه بمواعظه، وبتحذيره من مغبة مصير الظالمين الذين يتجاوزون الأعراف والتقاليد، ولا يراعون الحقوق.
وهو في الوقت نفسه كشف عن العالم الغيبي أو ما وراء الطبيعة، الذي لا يرى عادة، والمتمثل بالجن والشياطين هنا وتمظهراتهم المختلفة، والجانب الخفي للمكان، أو ما يسمى بقاع المجتمع، حيث خدع المحتالين، واللصوص، وحيل النساء وكيدهن، وأفاعيل السحرة والمبطلين، وأكاذيب الفقراء والمتسوِّلين. تقدمها هذه الحكايات حيناً في صور اعتداء وبغي، وتجاوز من هذه الفئة، أو بصورة انتصار وبحث عن إحقاق الحق، وانتصاف المظلومين، فتدون تاريخهم، وتحكي تفاصيل حيواتهم.
وفي هذه النصوص الشعبية نجد التراكيب المستعملة كما الألفاظ لا تتحرج أن تكون خارج النظام اللغوي الرسمي المتعارف عليه، فهي لا تلتزم بالتركيب الفصيح، كما لا تلتزم أيضًا بالبنى الصرفية العربية المعروفة، فتخرج أحيانًا إلى ما تسمى بالعامية، وربما اعتمدت بعض التراكيب التي تكون في أصلها غير عربية، أو ربما جاءت ناقصة، بل لا يبعد أن تطغى عليها الألفاظ السوقية النابية، ينطق بها صراحة، وتسمى الأشياء بأسمائها دون كناية أو مجاز.
كما أنها قد تمثل الفئات المختلفة في المجتمع من خلال حضور لغتهم، فقد تأتي لغة الأجنبي المكسرة حاضرة في القص الشعبي على لسان الراوي، أو لغة الطفل الذي لم يستقم لسانه حين يتحدث أو يناغي، كما أنه -الراوي- يسعى إلى أن يتمثل الفروقات الصوتية في كلامه بين فئات المتكلمين، ونطقه لها، فيرقق صوته حين يكون المتحدث امرأة، أو يخشنه حين يكون رجلاً وقد يلوي لسانه ويغمغم في الكلام إذا كان يدعي أن المتحدث ذئبًا، أو أسدًا، كما يسعى إلى أن يتوسل من وسائل الكتابة ما يساعده على تسجيل ذلك وكتابته.
وأما من حيث بنائها، فإنها لا تلتزم نظامًا محددًا في تركيب عناصرها، أو في تأطير شخصياتها، وتصويرهم، كما لا تلتزم إطارًا محددًا في تقديم أحداثها، وتسلسل أزمانها، أو في ضمير القص فيها، وكأنها قطعة سردية بغير نظام، فهي تقصر وتوجز المدد الطويلة بكلمة أو كلمتين، والطفل يتحول شابًا أو هرمًا في غضون صفحة من القص أو صفحتين، وتطيل في ذكر تفاصيل دقيقة حيناً لا يحتملها المقام، والأحداث في تتابعها لا تبحث عن الترابط السببي، والشخصيات تخرج عن الإرغامات التي تفترضها كل شخصية أو موقع اجتماعي لتقدم نفسها بصورة مختلفة، وفي الوقت الذي تستعمل المنطق والحجة في بناء خطابها السردي، لا تبالي أن تكسر هذه الحجج وتخرج عليها في السياق نفسه، ساعية لبناء منطقها الخاص.
والأمر العجيب أن القارئ يجد الحكاية الواحدة تتكرر في المجالس بتغيير شخصياتها، أو أزمنتها، ومكانها دون أن يجد أن هذا التبديل والتحوير أو عدم الالتزام بصورة واحدة مما يحرج لأجله الراوي، أو يجد السامع فيه ما يقلل من قيمة الحكاية المسموعة، بل ربما يكون أمرًا مقصودًا يعمد إليه الراوي لتقريب الحكاية من السامعين، وجذب انتباههم إليها بجعلها تتحدث عن حيواتهم الشخصية، وتعبر عنهم حقيقة التعبير، وكأنها تروي أخبارهم، وتدون أفعالهم، وهذا ما يزيد التصاقها بالمتلقين، ويكسبها بعدًا واقعيًا، يوازن ما فيها من جنوح الخيال وبعد عن المعقول. وهذا الخروج عن الصياغة الأدبية الرسمية المعتبرة أو -بصورة أخرى- الالتزام بالصورة التي وردت عليها الحكاية في بيئتها الأصلية وظهرت في خيال راويها، دون كثير تنظيم وزبرقة، وتحوير، يعكس الصورة الاجتماعية التي تمثلها، وتقدمها، وحال الجماعة التي تنتجها، وتستهلكها. وهو ما يعني واحداً من أمرين: إما أن هذه الفئة قصدت إلى ذلك قصدًا لتجعل هذا الوجود الفني واللغوي نوعًا من الوجود الاجتماعي الذي تتدثر به مقابل ما تقابله من تهميش، فهو نوع من النضال والمواجهة للسلطة المركزية اللغوية والاجتماعية، أو أنها لا تستطيع ذلك المستوى ولكنها لا تحفل به، وتعلن رفضها للسلطة النقدية والأدبية التي تقصيها بإخراجها من فردوس الأدب والثقافة، لتمارس أدبها بما لديها من إمكانات متخذة هذا المنتج النصي وسيلتها اللغوية في تدوين ثقافتها وفكرها، وتهدم المنطق الاجتماعي والفكري لتبني منطقاً جديداً تصنعه هي، وتؤلف بين عناصره كما يشاء، وكما ترى الوجود أمامها حيث لا يقوم على منطق صحيح في نظرها، وهما في الحالين صورة من صور التمرد على المؤسسة الأدبية، ومن جهة أخرى بيان الصلة الوطيدة بين الأدب والطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها، بجعل هذه النصوص اللغوية معادلاً موضوعيًا -إن صح التعبير- أو صورة متكاملة عن البنية الاجتماعية التي تنتمي إليها، ويمكن أن تكون كيانًا قائمًا مستقلاً عن البنية الاجتماعية تمثل المواقع فيها، والعلاقات بينها تكوينًا موازيًا لمثيلاتها في البنية الاجتماعية.
والأمر المهم أننا حين نعاود النظر إلى هذه النصوص وما تحمله من سمات لغوية ومضمونية، تتصل بالبيئة الضيقة التي أنتجتها، وبالفئة الاجتماعية التي تدور في أحضانها، لدرجة أن هذه البيئة والفئة تحور الحكاية أحيانًا وتبدلها لتوافق ذوقها، دون شعور بالحرج أو التردد، نتبين أن هذه العملية تجعل هذه الحكايات تعبر عما يسمى بالنقد بـ«المحلية»، بمعنى أنها تلتصق بالبيئي والخاص، وتبتعد عن الأجنبي، أو أنها تغوص بالبيئة المحلية محاولة استعمال أبرز مكوناتها، وتقديمها من خلال ما ذكرناه سلفاً من ظواهر لغوية أو بنيوية للحكاية. وعن طريق هذه المحلية تتمكن من أن تثبت تميزها وفرادتها بوصفها نصوصًا, وأدبًا خاصًا مختلفًا عن سواه، يستحق البقاء والدراسة.
تغريد
اقرأ لهذا الكاتب أيضا
- التحيز في الأدب 1-2
- التحيز في الأدب 2-2
- الهوية والقومية
- طبائع المؤسسة (حياة في الإدارة)1 - 2
- طبائع المؤسسة (حياة في الإدارة) 2 - 2
- من «وحي الحرمان»
- الموقف من الآخر في السرد العربي
- جماليات القبيح
- بلاغة المهمشين
- أدبيات البرجوازيين
- ثقافة المديح
- كتابة تاريخ الأدب
- سرديات شوقي ضيف
- نـــقــــاد الــعــجـم
- شعرية شعر الحكمة
- قول في الكلام
- اللغة والمجتمع
- الأدب والصنعة
- الأدب المترجم
- أغلاط المتنبي
- جناية الأدب المصري على الأدب العربي الحديث
- الشوفينية المصرية
- الجنسانية المصرية (1)




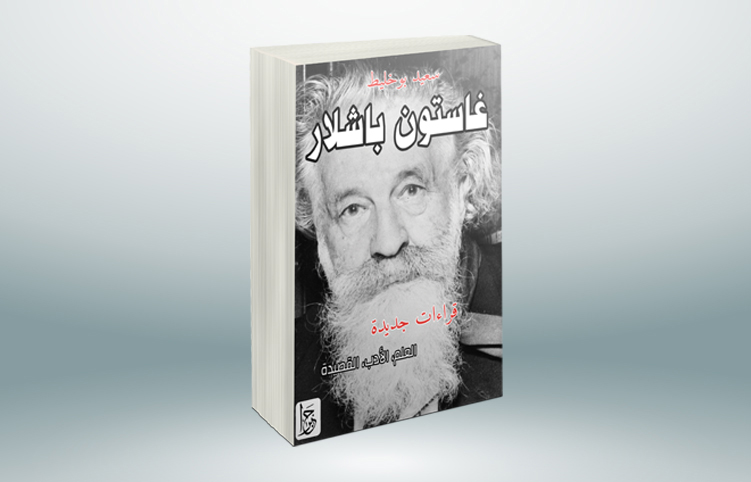

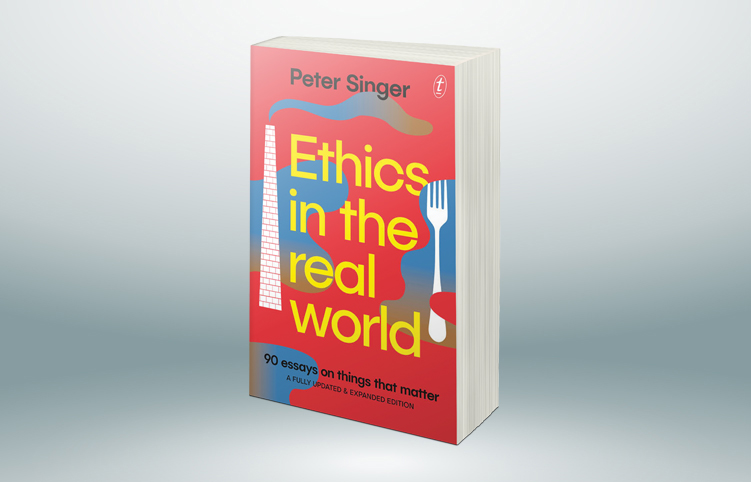










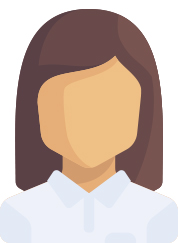
اكتب تعليقك