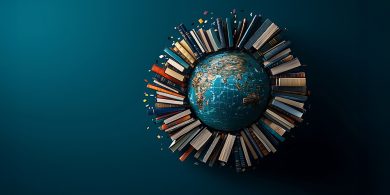في عصر يعدُّ نفسه سليل الحداثة، ووريث التنوير، وحصيل أفكار التقدم والتحديث الجذري في أفق بناء مدنية إنسانية مكينة بتحقيق العيش المشترك بين الأنفس البشرية، وذلك في ظل التراكم النوعي في الأدوات والآليات التي تجعل مبتغى التقارب والتواصل والتعايش أقرب من أي وقت مضى في وصل المنفصل وتقريب البعيد والتفاهم مع المغاير. لكن المعاين، عكس هذا المنشود “الفاضل”، هو أن سعار الهوية ما فتئ قيمته الوجودية في ارتفاع مفرط؛ إلى الحد الذي بتنا فيه على وضع يقتضي تحيين عهد “الملل والنحل”، وبات الفضاء الكوني أفقًا للصراع الهوياتي إن بأسماء ايديولوجية ودينية أو من خلال يافطات اقتصادية وسياسية ومنسوب تاريخي عميق جدًا. لهذا المآل، بات على أفق الفكر مهمة جليلة وعسيرة، تتمثل على وجه التحديد في الكشف عن بعض “جينيالوجيات” تشكل العقل المتهوّي، وذلك في أفق إبراز فضيلة الإنسان الكوني على العالم والإنسان نفسه.
حينما يؤول فعل التفكير إلى مجرد قياس الحاضر على الماضي، ويكون أشد الحرص على أن يكون ضرب حضوره في الراهن يحذو وفق ما تقرّر سلفًا حذو الحرف بالحرف، ويختزل طبيعة النظر العقلي في الارتكاز على سلطتي النظر والعمل اللتين تحصّلتا في الذاكرة العميقة، قصد اقتناص الأجوبة القاطعة التي تُحقّق نوعًا من الرضا لأنفسنا الموشومة، وذلك بشأن ما يُطرح من هموم فكرية ويستجد من قضايا عملية ضمن الوجود اليومي، فإن هذا الأمر وهو على هذا الحال، يجعلنا نخلص إلى حكم لا يعتريه أدنى ذرة من الشك بكوننا ذوات متذكّرة بامتياز ولسنا ذوات مفكّرة بالدرجة الأولى. لكن ما معنى أن نكون ذوات متذكّرة دونما أن نبلغ طور الذات المُفكِّرة؟ بعبارة موجزة، يمكن القول أن الأمر قُضي في أمهّات المسائل وحُسم القول والنظر في جليل الأمور ودقيقها، فليس لنا سوى إذن أن نُفعّل مخزون الذاكرة، ونحفّز المفكّرة على أن تقتات من المحفوظ وتسترجع ما لا يتقادم ولا تطاله عوامل الزمان ونوائبه. عندما يكفّ الفكر على أن يفكر، حينما ينحصر دور العقل على نحو سلبي في احتراف التكرار وإدمان الاستذكار، حينئذ ندخل طور نسيان أنفسنا، نكون كمن يساهم، عن دراية وجهالة، عن نفي وعيه من الحاضر، فليس له سوى أن يولى قبلة مشروعيته نحو الماضي، حيث سُويّ كل ما من شأنه أن يجعل الحاضر في حاجة إلى نفسه. ليس هنالك سوى بعد واحد للزمان، أو بالأحرى فإن البعدين الآخرين للزمان هما توابع للبعد الواحد المتعالي الذي هو الماضي. فيمسي كل تقدم إلى الأمام وتطلع نحو المستقل، هو تقدم نحو الماضي؛ كأننا نوجد لنخطو نحو الماضي، فليس القادم سوى الموت والمجهول والعدم، وحده الماضي يكتنز الحياة والأمل والإجابة الحاسمة عن كل حاجيات الحاضر والمستقبل. أن يكون للذاكرة سلطان مطلق على أنفسنا، فلن تعوزنا الحاجة إلى أن ندفع بقوة التفكير إلى الواجهة، ويكون مصدر التفكير هو أنفسنا التي تتموضع في الحاضر، لكي نمارس فعل التفكير في الموجود والتاريخ ومسائل العالم دون فواصل زمانية وحدود فكرية. فقد اقتدرنا على أن نؤثث فضاء الذاكرة بشكل هائل، وأن نُقرّ لها بسلطة ضاربة، ليتوارى فعل التفكير وقدرته وراء الذاكرة، ويمسي الرهان عليه أمرًا نافلاً. لتصبح بذلك الذاكرة العميقة شبيهة بالخزان السحري الذي يمد العقل المتهوي بكل حاجياته، إنها بمثابة “الصيدلية” التي يمكن أن يبتاع منها الترياق المناسب لكل الأوجاع التي تؤرق الوجود اليومي في الحاضر؛ فلكل نظر مرتكز في الأصول، ولكل مشكل مطروح وإشكال وارد، جواب مجهز سلفًا أو جاهز بشكل قبلي، يكفي أن ننشّط الذاكرة، وندع المُفكّرة تتحدث بلسان الهوية العميقة والخالصة، فيقع استنساخ الحاضر على منوال الماضي بشكل آلي. عندما يتم توطيد الحبل المتين مع الذاكرة العميقة، نكون أقرب وفاء إلى الجذور، وأشد حرصًا على مضاهاة ما تحقق في الأصول؛ وطوبي لمن وصل إلى تحقيق أقصى درجات المطابقة والمماثلة. لكن إلى أي حد حق أن نتحدث عن إمكانية إقامة السُويّة الزمانية، وإلى أي مدى أمكن للهوية أن تتخطى التعين الزماني لها، فتصبح الذات بوصفها نفسها بغض النظر عن التعين الزماني الذي كان لها أو الذي أصبحت عليها؟
ليس نقد هذا النسخ الذي يحرص عليه العقل المتهوي من خلال المطابقة المطلقة بين الحاضر والماضي، إنما يشي بدعوة إلى القطيعة مع أحد ضروب التعين الزماني الذي هو الماضي، أو من قبيل النقد الذي يُشرط منطق تفكيرنا من خلال مسح الذاكرة أو إلغائها على نحو ضرب التفكير الذي انتدبه ديكارت. فعيادة الماضي لا تطرح في حد ذاتها أي إشكال، إن هذا الأمر لازمة من لوازم التفكير، بل إن الاشكال يقع عندما يُهجر فعل التفكير لصالح الذاكرة، فيصبح الماضي بمثابة القُدّاس الذي تنهل منه على نحو نُسكي الذاكرة الحاضرة، وهي تتفاعل مع مسائل الراهن على منوال الأجوبة الجاهزة على نحو مطلق سلفًا. وليس يفضي بنا هذا الضرب من المسلك سوى نحو تأسيس جذري لقيام فارق أنطولوجي رهيب بين العقل الحر والعقل المتهّوي، كيف ذلك؟ فالحديث عن العقل الحر، يقتضي أن يكون رهان التفكير هو المطلب الحيوي الذي ما ننفك نقبل عليه، دون أن ينسحب فعل التفكير الذي لكل ذات نحو النسيان أو يمارس بالنيابة أو يستعاض على نحو كلي بالذاكرة. فلن تقوم قائمة لكل عقل حر ما لم يسهم من تلقاء ذاته في التفاعل مع ما ينعطي في حاضره وينبثق في وجوده؛ فيكون بذلك أحرص على إقامة الجدل الحي، الذي تنبّه له هيغل، بين الفكر والواقع، فيصبح كل فكر عين الواقع والواقع عين الفكر. كما أن تحرر الذات من كل إشراط زماني بعينه، يتيح فسحة حيوية للتفكير من خلال ممارسة الاعتبار في كل أبعاد الزمان ومجرى التاريخ، مع الحرص على أن يكون نقطة المرتكز هو الفعل الذي يصرّفه العقل الحر في الحاضر. أما وشأننا جار على التمسك بتوجيه بوصلة نظرنا حصرًا على مدار الهوية، وذلك من خلال التعويل المفرط على إيتاء الذاكرة سلطة مطلقة، والعمل على ترويض العقل ليمتنهن صناعة الهوية بامتياز، حق أن يكون ضرب التفكير العقلي الذي أرخنا له وشيدناه في الحاضر، هو العقل المتهوي بإطلاق.
وليس من متنفس رحيم للعقل المتهوي، سوى أن يحتكم إلى الذاكرة العميقة التي تريح العقل من الاشتغال من تلقاء ذاته في مغامرة لا تؤمن عواقبها ولا تعرف نتائجها. وإن كان التحرر منذر بالخطر، فإنه يكفي أن نستعيض التحرر بنوع من الراحة النفسية التي تؤمنها الذاكرة، فما على العقل المتهوي سوى أن يتوسل بشكل حرفي بآليات التماثل والمشاكلة والمطابقة، إن هو أراد أن يحترز من حصول أي مغايرة أو تعاظم الفجوة بين حاضر الذات وماضيها. لئن كان هنالك اختلاف ممكن يمكن أن يسلم به العقل المتهوي، فهو الاختلاف مع الآخر من حيث هو يقابل الذات ويتغاير معها جذريًا من زاوية الثقافة والتاريخ. لم يكن هاجس الانخراط في مجرى التفكير الكلي الذي يجعل مسائل الإنسان والوجود والعالم نصب تفكيره المنشود، هو من صميم الهاجس الذي أطبق على العقل المتهوي، بل إن هذا الأمر بالنسبة له خطوة غير محمودة العواقب، وتوطئة نحو انسلاخ الذات عن جلدها الهووي، وقفزة قاتلة نحو الاستلاب الذي ليس منه عودة نحو الهوية الخالصة. ولئن كان هنالك أي اعتبار للأفق الكوني من وجهة تقدير العقل المتهوي، فيجب أن يكون هذا العطاء الكوني استنساخًا للتجربة التي أنتجها العقل في حدود تجربته الخاصة، وليس على نحو التجربة الكلية التي تتأسس على التفاعل وتغليب القواسم المشتركة.
إن الارتقاء ممكن لأي ذات، وذلك متى كانت على وعي تام بالمنزلة الحقيقية التي تكون عليها، وليس الاكتفاء بالمنزلة المتخلية والرضا بالعيش على الأوهام، وبالموازاة مع الوعي بالوضع المنسي الذي تعيشه الذات، يقتضي أن يكون هنالك عزم مطلق على تجاوز وضع السكون الذي يعتريها. ولعل أولى الخطوات نحو تحقيق العبور، تتمثل في “العودة إلى الذات”؛ وليس المقصود بالعودة هو الانكفاء عليها وتسييجها من أي وافد غريب عنها، يقع خارج السردية الهلامية التي كونتها لنفسها، وإنما المقصود بـ”العودة إلى الذات” هو العمل على إزالة طبقات من الصدأ الذي ترسبت في عقلونا، والعمل بشكل حثيث على حصر السلطة المطلقة التي تتنزّله الذاكرة الآلية في أنفسنا؛ وبعبارة موجزة: إقامة علاقة حيوية بين عقولنا والراهن الذي نتمظهر في طياته، أي الشروع بالتفكير بأنفسنا في كل ما انتهى إلينا وتعين أمامنا من مجريات الحياة وشؤون البشرية في العالم، وذلك من دون أي سياج دوغمائي أو فرز متهوي.