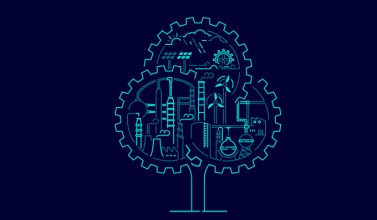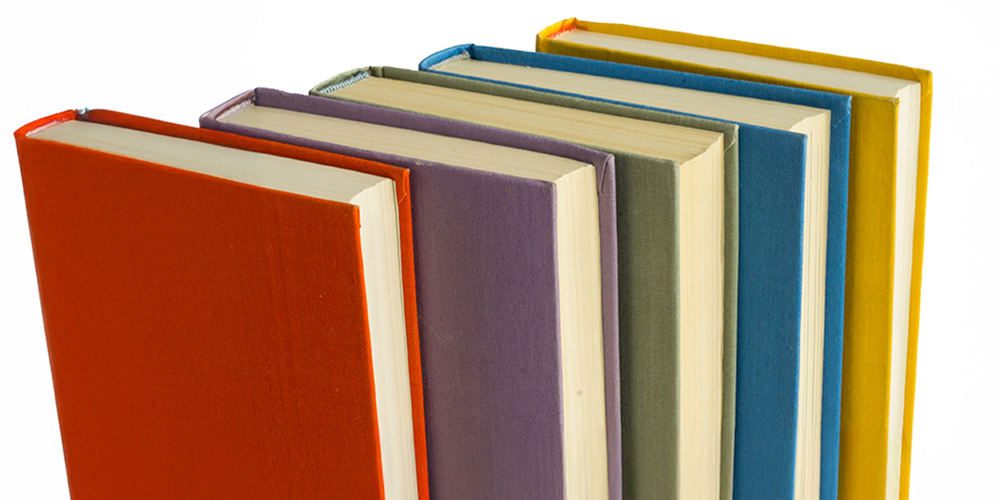
إذا كانت البحوث الخاصة بتاريخ الفرق الدينية والمذاهب الفقهية والفرق الكلامية والطوائف بصفة عامة قطعت مرحلة مهمة فيما يتعلق بالجهة الشرقية من العالم الإسلامي، فإن الدراسة في تاريخ تلك الفرق والطوائف والمذاهب في الجهة الغربية مازالت في أولى خطواتها، هذا مع ما واجهته هذه البحوث من مشاق مختلفة، تتجلى على وجه الخصوص في قلة المصادر اللازمة.
وقد اهتم فقهاء المالكية بتدوين وتسجيل أحداث ووقائع تخص أعلام ورموز مذهبهم، وفي هذا السياق ذكروا أشكال الخصومة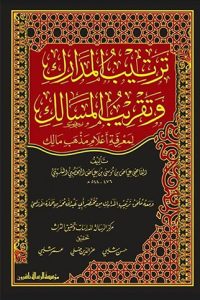 بين المالكية وغيرهم من المخالفين لهم. وتعتبر “طبقات المالكية” لمحمد بن محمد مخلوف المصدر الأول لأي دراسة تنشد إبراز تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي. ويعد كتاب “ترتيب المدارك” للإمام القاضي عياض السبتي أول تأليف في هذا الباب يعتمد عليه في التأريخ للمالكية عمومًا، وللمالكية في الغرب الإسلامي خصوصًا. وهو يعتبر، بلا ريب، مصدرًا مهمًا استوعب بكل ما له صلة بهذا الباب.
بين المالكية وغيرهم من المخالفين لهم. وتعتبر “طبقات المالكية” لمحمد بن محمد مخلوف المصدر الأول لأي دراسة تنشد إبراز تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي. ويعد كتاب “ترتيب المدارك” للإمام القاضي عياض السبتي أول تأليف في هذا الباب يعتمد عليه في التأريخ للمالكية عمومًا، وللمالكية في الغرب الإسلامي خصوصًا. وهو يعتبر، بلا ريب، مصدرًا مهمًا استوعب بكل ما له صلة بهذا الباب.
وتمثل ذيول وصلات “ترتيب المدارك” مصدرًا قيما ينطوي على معلومات دفينة يمكن الاعتماد عليها كذلك في البحث عن تاريخ الفرق الإسلامية في الغرب الإسلامي. نذكر منها: “الديباج المذهب” لابن فرحون، و”نيل الابتهاج” وكفاية المحتاج لأبي العباس أحمد بابا التنبوكتي، و”أزهار البستان” لابن عجيبة، و”الفكر السامي” للحجوي.
إن “طبقات المالكية” المذكور سابقًا لم تكتف بالتعريف بأعلام المذهب المالكي فحسب، بل تتميز عن غيرها بكونها تختزن كثيرًا من المواد التاريخية التي لا يهتم بها غالبًا المؤرخون الرسميون وأمثالهم ومن حذا حذوهم.
وقد كان للمستشرقين قصب السبق في استثمار هذه المصادر ونظائرها في التأريخ للفرق والطوائف الإسلامية بشمال إفريقيا والأندلس، ولقد خصّ ألفرِد بِل كتابا ضخمًا للفرق الإسلامية في شمال إفريقيا(1)، ثم أفرد روبر برنشفيك بحثًا خاصًا كشف فيه الأثر الكبير للمالكية في تاريخ الغرب الإسلامي(2).
وأما الدكتور عباس الجراري فقد تطرق للحديث عن تاريخ المذهب الكلامي وأثره الإيجابي على المغرب في أكثر من موضع في كتاباته ومحاضراته، ثم أفرد له بحثا خاصا تحت عنوان: “وحدة المغرب المذهبية”. وللدكتور محمود إسماعيل جهد يثنى عليه في هذا الباب، تكلل بدراسة قيمة متمثلة في كتابه القيم عن تاريخ الخوارج في المغرب(3).
ومن الثابت أن الأبحاث الآنفة الذكر رغم اختلاف مناهلها ومناهجها ومواقفها ومراميها، ومع الاعتراف بالجهد الكبير الذي بذل فيها، فإنها لم تُحِطْ بجميع جوانب موضوعنا بالصورة المنشودة.
لقد اصطدم المذهب المالكي وهو في طريقه إلى بسط آرائه وأفكاره في الغرب الإسلامي بواقع ثقافي واجتماعي مخالف لما وجده في مواضع أخرى من العالم الإسلامي، وتصدت طريقه الدفاعي فرق وطوائف مخالفة كثيرة، من أبرزها: الخوارج الصفرية، والمعتزلة، والفاطمية، والغزالية، والتومرتية، والبرغواطية، هذا عدا حركة المتنبئين(4).
وإذا كانت هذه الفرق والطوائف متباينة ومختلفة في أصولها ومبادئها وآرائها بصورة عامة، فإنها كانت كلها تتوق إلى تكوين دول باسمها، وإن اقتضى الأمر إلى استعمال العنف وأساليب الشدة والغلظة(5).
من المؤكد أن المذهب المالكي عرف طريقه إلى الغرب الإسلامي(6) على عهد صاحبه الإمام مالك رحمه الله(7)، وذلك من خلال المتلقين عنه في دار الهجرة ممن نزحوا إليه من إفريقية والأندلس، أمثال: أسد الفرات وسحنون ويحيى الليثي، ولعل هذا الأخير هو أشهرهم من حيث السند في الموطأ(8).
ولم يكتف تلاميذ مالك بأخذهم عنه فحسب، بل رجعوا إلى بلادهم ومعهم المدونات التي دونها، ومتأثرين أيضًا بسلوكه وأخلاقه. وقد توسّع القاضي عياض في الحديث عن عادات الإمام مالك وأنماط سلوكه(9).
ومهما يكن، فإن المذهب المالكي استغرقت مسألة انتشاره واستقراه وانتصاره على غيره عقودًا بل قرونًا، صارع فيها المالكية خصومهم من أصحاب الطوائف والفرق المخالفة بشتى أنواع الوسائل الدفاعية.
1 – الخوارج:
يبدو أن المذهب الخارجي وطئت قدماه أراضي المغرب مع وصول القادمين الفاتحين إليه، ولعل أهم الأسباب التي جعلت أهل المغرب ينفتحون على هذا المذهب وينزعون إليه ترجع إلى تمادي بعض هؤلاء القادة الفاتحين ومبالغتهم الشنيعة في ولائهم لأمرائهم في دمشق وغيرها، فأحكموا القبضة على رقاب أهل المغرب، وجعلوا عائدات كل خيراتهم تؤول إلى خزائن كبراء حكامهم وولاتهم(10)، مستعينين ببعض دعاة الخوارج الذين جاءوا من العراق وعلى رأسهم ميسرة الصُّفري لزرع بذور مبادئ الخوارج بين صفوف البربر، مما سرّع وتيرة انتشاره…
فما إن انتهى الفتح، حتى اشتغل المغرب بثورة خارجية، وتمّ الإعلان عن ميلاد أول دولة خارجية في مدينة طنجة سنة 121هـ(11)، ثم أعقبتها إمارتان خارجيتان أخريان في كل من تاهرت وسجلماسة(12). ثم توسع المذهب الخارجي الصّفري في سائر أرجاء المغرب الأقصى وبعض نواحي إفريقيا والمغرب والأدنى، لتشمل دعوته العرب والبربر والأفارقة على السواء(13).
بعد ذلك ظهرت دولة الأغالبة في إفريقيا، وانتشر مذهب مالك بفضل جهود تلامذته الآخذين عنه العلم وأخلاقيات المذهب مما قلّص نطاق انتشار المذهب الخارجي. وبالمقابل أخذت المالكية طريقها إلى التوسع والانتشار، وبسط نفوذهم.
وما يلاحظ من خلال هذا السياق التاريخي، أن تلك المواجهة العنيفة التي دارت رحاها بين المالكية والخوارج وقد كلفت خسائر مادية وبشرية، لم تخلف إلا إشارات مبثوثة هنا وهناك في بعض الكتب والمصادر التاريخية، والتي لا تشفي غليل كل باحث يتوق إلى جمع ملفات موضوعية في هذا الباب.
2 – المعتزلة:
يمكن اعتبار المعتزلة من أقدم الفرق دخولاً إلى المغرب ومن أكثرها تأثيرًا فيه، بيد أن المعلومات المتوفرة عن هذه الفرقة وفكرها نادرة جدًّا لا تفي بالمقصود. ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن علماء المغرب من أهل السنة لم يكونوا يرون المبتدعة من العلماء، ولذلك أسقطوهم من طبقاتهم ومن اعتبارهم..
وفي هذا السياق يؤكد ابن عبد البر على أن أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أجمعوا على أن أهلَ الكلام أهلُ بدع وأهواء وزيغ(14).
ولم تأت مقاومة علماء السنة المغاربة الذين هم على مذهب مالك لبدعة الاعتزال من فراغ، بل كانت هناك أسباب كثيرة جعلتهم يقاومون هذا الفكر الاعتزالي والتصدي له بشتى الوسائل والطرق، نجملها في الآتي:
– إن أهل المغرب كانوا يقاومون كل فكر منحرف عن نهج السنة مهما كان انحرافه، دون تفريق بين هذا وذاك.
– محاولة فرض آرائهم هذه على الناس عامة والعلماء خاصة، واستعمال القوة على حملهم عليها وامتثالها.
– المحنة الشديدة والقاسية التي تعرض لها علماء السنة المغاربة على يد المعتزلة من قبل بني الأغلب(15).
وقد اتخذت هذه المقاومة أنماطًا مختلفة وأشكالاً متعددة من أجل القضاء على الاعتزال والمعتزلة وعلى كل بدعة، نجملها اختصارًا في الآتي:
المقاومة عن طريق التأليف- المناظرة- ضرب من عرف عليه الاعتزال- إعدام مؤلفات من عرف عليه الاعتزال- اعتزال أهل البدع(16).
3 – الفاطميون:
اتسم وجود الفاطميين في المغرب منذ أن أقاموا دولتهم في سنة 297ه بنزاع شديد، ومواجهة عنيفة مع حركة المعارضة للفاطميين شملت طوائف مذهبية كثيرة، غير أن الخلاف بين المالكية والفاطميين خصوصًا، هو خلاف بعيد الغور، حتى أن المالكية اتحدوا مع الخوارج لمواجهة زحف الفاطميين الذين تمادوا في الطعن في المعتقدات التي قام عليها إيمان الناس(17).
ويمكن تقسيم الصراع بين المالكية والشيعة الفاطمية في بلاد المغرب إلى مرحلتين أساسيتين:
– بدأت المرحلة الأولى بمواجهة فكرية صارمة.
– اتسمت المرحلة الثانية بإشهار المالكية السلاح في وجه الفاطميين حين تحقق بعض علماء السنة وبخاصة المالكية منهم من خطر الوجود الفاطمي على عقيدة أهل المغرب بعامة وعلى مذهب مالك بخاصة، إذ كان يشكل القوة الرئيسة لأهل السنة بالمغرب، وكان أول موقف جماعي لهم حين آزروا الأغالبة في قتال أبى عبدالله الشيعي، وألّبوا الرأي العام ضد الفواطم وأجمعوا على أن قتالهم واجب وجهادهم فرض عين، وهذا حين استفتاهم زيادة الله الثالث في أمرهم. ويبدو أن العناصر المالكية شكلت موقفًا معارضًا كاد أن يحدق بدولة الفاطميين ودعوتهم الإسماعيلية(18).
وجدير بالذكر، أن أهل المغرب والأندلس وعامة الغرب الإسلامي رغم شدة حبهم لآل البيت عامة، وهو حب ضمّنوه شعرهم ونثرهم(19)، فإنهم لم يبالغوا في حبهم هذا إلى درجة التشيع، ولم يأخذوا بآراء الشيعة ولم يؤمنوا بمقولاتهم.
لقد أكره الفاطميون من الشيعة العبيديين الخروج من المغرب متجهين صوب القاهرة بمصر. وكان هذا الخروج المخزي انتصارًا للمالكية ودعمًا لهم.
4 – البرغواطيون:
قامت دولة برغواطة على دعامة قبيلة بربرية تدعى زناتة، وهي بربرية صنهاجية أيضًا. والقاسم المشترك بين الفاطميين والبرغواطيين يكمن في القول إجماعًا ببعض المبادئ الخاصة بالفكر الشيعي، وكان البرغواطيون ينتظرون الإمام السابع منهم.
وبخصوص نحلتهم، يوجز ابن الخطيب حديثه عنها في قوله: (وزعم، أي صالح بن طريف المؤسس، أنه المشار إليه في القرآن، وشرع لهم الديانة التي قرر ضلالها في سنة خمس وعشرين ومائة، وهي: أمور غريبة ومضحكة: يأمر بصوم رجب فيها، وأكل رمضان، وخمس صلوات بالليل.. وأباح تزوج النساء مما فوق الأربع.. وشرع قتل السارق.. ووضع لهم سورًا بلغت ثمانين سورة…)(20).
لذا رأى المالكية أنه بات من الواجب حربهم، والتصدي لهم، وإيقاف ردتهم. فدخل الأدارسة في حربهم، إلى أن تمكن المالكية من السيطرة عليها في عصر المرابطين.
لقد كان من نتائج المواجهة العنيفة التي خاض غمارها المالكية ضد العبيديين والصفرية والبرغواطية خلال القرن الرابع، أن قام فقهاء المالكية بتكوين دولتهم تحارب باسمهم، ويعتمدون عليها، وتؤازرهم، وقد لقوا في سواعد الملثمين المرابطين مبتغاهم وما يحقق هدفهم.
5 – الغزالية:
ويقصد بها في الكتابات الصوفية المغربية جماعة الصوفية التي كانت تتعصب لآراء وأفكار الغزالي، وتنتصر لها من خلال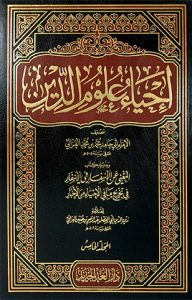 كتاباتها وعلى رأسها “إحياء علوم الدين”(21).
كتاباتها وعلى رأسها “إحياء علوم الدين”(21).
والمعروف أن الشيخ أبا حامد الغزالي قد تتلمذ على يده كثير من المغاربة نذكر منهم إمام ومؤسس دولة الموحدين في المغرب محمد بن تومرت، والشيخ أبو بكر العربي وغيرهم… كما كانت هناك علاقة طيبة مع يوسف بن تاشفين وبين الغزالي، إذ تذكر كتب التاريخ أنه قد جرت مكاتبات بينهما.
وإذا كان الصراع بين المالكية والغزالية انتهى بما يمكن أن يسمى بالمصالحة، فإن المالكية ظلت ترصد الحركات الصوفية وتتبع خطواتها، كما واصلت طوال التاريخ التصدي لكل حركة صوفية تخرج عن نطاق المقررات السنية في القول والعمل كآراء أصحاب الشطحات الصوفية أمثال الحلاج وابن سبعين وابن عربي الحاتمي. ولعل أهم مظاهر هذه المواجهة تتجلى في تلك المحاكمة التي أجراها الفقهاء للصوفي الشهير أبي العباس أحمد بن عجيبة الدرقاوي(22).
6 – التومرتية:
تنسب إلى محمد ابن تومرت مؤسس المذهب، وينبني هذا المذهب على أمرين: أحدهما عقدي، ويتمثل في اتكاء ابن تومرت على آراء المعتزلة عملاً بمبدأ التأويل، وقد تسمّى المذهب التومرتي بالمذهب الموحدي، ومنه أخذ اسم دولة الموحدين. وقد نهضت دعوة المهدي على تكفير المرابطين باعتدادهم من المجسمة لكونهم أخذوا القول بالصفات على ظاهرها(23)، ويعتبر هذا تهمة ملفقة قذف بها المعتزلة مخالفيهم من أهل السنة، وقد أورد القاضي عياض في مؤلفه أن أهل السنة كانوا يدعون بالمجسمة قبل أن يظهر الأشعري، وأن هذا الادعاء مجرد افتراء لا أساس له من الصحة(24). وأما الأمر الثاني من هذا المذهب فهو سياسي يقوم على آراء وأفكار مستوحاة من الفكر الشيعي. وقد ادعى لنفسه العصمة، وقد استطاع أن ينشر مذهبه الذي عرضه في كتابه المعروف بعنوان: “أعزّ ما يطلب”، كما ردد شعراء الدولة الموحدية ادعاءات المهدي في أشعارهم من أبرزهم في ذلك أبو العباس أحمد الجراوي، شاعر الخلافة الموحدية(25).
ويذكر عبدالواحد المراكشي أن الموحدين تصدوا للمدونات المالكية وحاربوها(26)، ويذكر غيره أن الاهتمام بهذه المدونات توقفت كليا على عهد الموحدين..
وفي زمن يعقوب المنصور انقطع علم الفروع وخافه الفقهاء، وأمر الفقهاء بإحراق كتب المذهب… وكان قصده في الجملة محو مذهب مالك، وتوعد من اشتغل بالفقه المالكي بأقسى العقوبة… (27)
لقد واجهت المالكية التومرتية بكل ما أوتيت من أسباب القوة المادية والفكرية، وكان القاضي عياض الخصم العنيد واللذوذ لدعوة ابن تومرت، إذ قاومه بالعلم والسيف(28).
7 – مذاهب سنية محالفة:
عرف الغرب الإسلامي تواجد مذاهب سنية غير المذهب المالكي، وقد أشار القاضي عياض في “ترتيب المدارك” إلى أحد الشيوخ الذين كانوا على مذهب أبي حنيفة(29). أما المذهب الأوزاعي فقد استقر في الأندلس، واستمر وجوده ردحًا من الزمن حتى أبعده المالكية دون مشقة. وثالث المذاهب السنية المخافة للمذهب المالكي هو مذهب ابن حزم القرطبي الظاهري الشهير (ت: 456 هـ).
وقد لقي ابن حزم مواجهة عنيفة بسبب آرائه وأفكاره من خصمين، أحدهما المالكية، والثاني الصوفية(30). وعانى كثيرًا من الفتنة الأندلسية والفتنة البربرية كما يسميهم بعضهم. وللأندلسيين من المالكية ردود على ابن حزم ساق ذكر بعضها الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله فيما كتبه(31)،
تلك هي أهم الطوائف والفرق التي تصدت لها المالكية في الغرب الإسلامي خلال القرنين الثالث والسادس الهجريين، وهي فرق وطوائف، كما تبين سابقًا، مختلفة في مبادئها وأصولها ومراميها، ولعل القاسم المشترك بينها هو ميولها السياسي ورغبتها الجامحة لبناء دولة تحمل اسمها.
وعليه، فإن دراسة موقف المالكية من هذه الطوائف يتطلب، حسب تصورنا، الوقوف عند جانبين: الجانب الفكري، والجانب التاريخي.
أولاً- الجانب الفكري:
ويتجلى في الأصول الفكرية التي كانت موضوعًا للمواجهة بين المالكية وبين مخاليفها فيما بين الفترة السابقة الذكر. إن المدونات التي يمكن الاستناد إليها والإفادة منها في بحث هذا الشق شحيحة جدًا، ولعل الكثير منها تعرض للضياع والتلف، ومردّ ذلك يرجع إلى ذلك العراك الذي كان قائمًا بين تلك الفرق، وتباين نصيب تلك الفرق من المدونات التي ظفر سهمها من الضياع.
وبالتالي، فإن النصوص التي تهتم بالخوارج في الغرب الإسلامي قليلة جدًا، علما بأن الخوارج الذين أقاموا الدنيا في مغرب القرنين الثاني والثالث كانوا ينتسبون إلى الصفرية، وهؤلاء لم يعد لهم وجود في المغرب.
وكل ما نعلمه ووصل إلينا من أخبار عن الأصول والمبادئ التي استند إليها البرغواطيون، إنما احتوت عليها كتب التاريخ والجغرافية(32).
ولم تترك الغزالية تراثًا يتعلق بخلافها مع المالكية، وإن كانت قد ترددت بعض الإشارات إلى أوجه الخلاف بين أهل الفقهاء والمتصوفة في غير تأليف من تآليفهم.
وبالنسبة للمذهب التومرتي، فإن أهم ما انتهى إلينا من تراثه تختزله رسائل محمد بن تومرت التي يجمعها كتابه المنشور باسم “أعز ما يطلب”، ثم كتاب “نظم الجمان” لابن القطان، فقد ورد فيه كلام يبين أوجه الخلاف بين المالكية وبين التومرتية.
وأما بخصوص المذهب الظاهري الحزمي، فإن تآليف صاحب المذهب هي ثرة بحيث تفيد الباحث في هذا الموضوع، هذا مع العلم أن الظاهرية ظهرت آثارها في كثير من تآليف الأندلسيين في علوم اللغو وعلوم الشريعة.
ومن الصعب تحديد ما خلفته المالكية في باب توضيح مبادئ المذهب وأصوله والدفاع عنه، وفي مواجهة أعدائه، وتجدر الإشارة هنا إلى أن المالكية مذهب فقهي، وتوجه فكري(33).
وفي هذا السياق، يمكن اعتبار كل المدونات المالكية مصدرا هاما من مصادر المذهب، إضافة إلى ذلك فإننا نجد أمامنا تآليف القاضي عياض، وتآليف شيخه ابن عربي تمثل أهم المصادر المالكية التي تمدنا بإفادات قيمة في إبراز التوجه الفكري.
إن الخلاف بين المالكية وبين خصومها من الفرق لم يكن قائمًا على أساس مذهبي، ما عدا ما كان بينها وبين الظاهرية. فالبرغواطية رغم أنها كانت أثرى تلك الفرق، ومع ذلك، لم يصنفها أحد ضمن الفرق الإسلامية. والشيعة الفاطمية لم تكن في تصور المالكية من الفرق الإسلامية، والخوارج الصفرية اعتبرتها المالكية فرقة ضالة ومضلة.
وقد ترددت بشدة آثار وانعكاسات مواجهة المالكية لبعض الفرق التي سبق ذكرها، وأهمها الخوارج والتومرتية والظاهرية في نوازل “المعيار” للونشريسي، وهو تأليف ضخم يعكس التراث المالكي، كما لا يخفى، في الغرب الإسلامي(34).
ثانيًا- الجانب التاريخي:
من الثابت أن المصادر الموثوق بها في دراسة هذا الجانب من جانبي تلك المواجهة بين المالكية والفرق والطوائف أوفر، وهذا يدل على قيمة البعد التاريخي أو السياسي لتلك المواجهات، لأن كل فرقة أو طائفة كان لها ميول سياسي، ورغبة شديدة لإقامة دولة.
لقد كانت البرغواطية أشد وأخطر طائفة واجهت المالكية في المغرب، وقد تم القضاء عليها بعد حرب طويلة راح ضحيتها زعيم المالكية في المغرب الشيخ عبدالله بن ياسين. ولم يلبث هذا الانتصار إلا قليلاً حتى ظهر ابن تومرت ومذهبه التومرتي،
فكان في ذلك ابتلاء جديد للمالكية، ومحنة كبيرة ذهبت بأكبر رواد مالكية المغرب في القرن السادس القاضي أبي الـفضل عياض السبتي(35).
وتمكن التومرتيون من إقامة دولتهم ولعلها أكبر دولة على عهدهم، واستغرق حكمهم قرنًا كاملاً من الزمن.
إن التمكين النهائي للمالكية على كل الطوائف والفرق في الغرب الإسلامي إنما تحقق على عهد بني مرين وبإعانتهم، أي في القرن السابع، القرن الذي بسط فيه المرينيون حكمهم على بلدان المغرب، وليشمل، أيضًا، قسمًا مهمًا من الأندلس.
ولقد جابهت المالكية على وجه الخصوص خلال القرنين التاسع والعاشر فرقًا وطوائف كانت تنتمي إلى التصوف، وظهر في تلك المجابهة أعلام من المالكية من أهمهم أبو العباس أحمد زروق، وأبو عبدالله الخروبي الطرابلسي، وعبدالكريم الفكون،
ومن الطوائف المخالفة اشتهر ابن محلي المراكشي الشهير بتصانيفه الغريبة.
ولعله اتضح من خلال تلك المواجهة العنيفة بين المالكية وغيرها من الفرق والطوائف المخالفة لها، أن لكل جانب من جانبي تلك المواجهة أهمية قصوى في معرفة مبادئ وأصول تلك المواجهات وآثارها وأبعادها. بيد أن التفصيل والتوسع في ذلك قد يقحمنا في متاهات وفضاءات معقدة تنأى بنا عن مجال ودائرة دراستنا واهتمامنا، وحسبنا في هذا المقام، أن حاولنا تسليط بعض الأضواء الكاشفة على تلك المواجهات، والإشارة إلى بعض أطرافها، وتحديد طبيعة كل منها، وكيف تفاعلت فيما بينها وبين غيرها، مع التركيز على أن فهم تاريخ الغرب الإسلامي بكل عناصره وأطيافه السياسية والمذهبية يستلزم دراسة مستفيضة ومعمقة لكل المكونات الفاعلة فيه، سواء كانت مذاهب فقهية أو فرق كلامية، أو طوائف صوفية التي ساهمت بشكل كبير في صناعة وتشكيل ذلك التاريخ.
وفيما يتعلق بالأسباب والعوامل التي جعلت المالكية تنتصر على سائر الفرق التي واجهتها في الغرب الإسلامي، ومدى أثر ذلك على المنطقة كلها، فإننا نجد بعض المصادر تعزو انتشار المذهب المالكي بالغرب الإسلامي إلى عامل سياسي يتمثل في دور السلطان، فهذا ابن حزم الأندلسي يقول في هذا الشأن: (مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرئاسة والسلطان، مذهب أبي حنيفة، فإنه لما ولي القضاء أبو يوسف كانت القضاة من قبله من أقصى المشرق إلى أقصى عمل إفريقية، فكان لا يولي إلا أصحابه والمنتسبين لمذهبه، ومذهب مالك عندنا بالأندلس، فإن يحيى بن يحيى كان مكينًا عند السلطان مقبول القول في القضاة، وكان لا يلي قاض في أقطار بلاد الأندلس إلا بمشورته واختياره، ولا يشير إلا بأصحابه ومن كان على مذهبه..)(36)
وقد دعّم كثير من الباحثين هذا الرأي(37).
وفي تقدير بعض الباحثين والدارسين أن انتشار المذهب المالكي وانتصاره على المذاهب والفرق الأخرى في الغرب الإسلامي، مردّه إلى مجموعة من العوامل والأسباب لا يتسع المقام إلى ذكرها في هذا الصدد(38)…
ومما لا ريب فيه، أن المبادئ التي أسست عليها المذهب المالكي هي القوة والترابط والطاقة على الاستجابة لحاجات المجتمع وتطوره وتنوعه، بحيث يصعب مواجهته، ولا يقدر من يطلب ذلك إلا الخضوع له، والتسليم بأصوله(39).
وفيما يخص تحديد آثار المالكية ومذهبهم في الغرب الإسلام، فيمكن القول، إن للمالكية الفضل العميم في صنع أحداث التاريخ السياسي والثقافي لهذه الجهة من العالم الإسلامي وفي تشكيله وتكوينه(40).
كانت تلك أهم المعطيات المرتبطة بالصراع المذهبي في الغرب الإسلامي والمتمثلة خاصة وحصرًا، كنموذج، في جهود المالكية
في مواجهة مخاليفها، وما لقيته من محن قاسية ومقاومة شرسة من قبل بعض المذاهب والفرق المخالفة لها. ويظل باب البحث والدراسة مفتوحًا على مصراعيه للإفادة وإثراء الموضوع بإضافات جديدة تنير سبيل الباحثين والدارسين المشتغلين على التراث العربي في جهة الغرب من العالم العربي والإسلامي.
الهوامش:
1 – “الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح حتى اليوم”- ألفرد بل – ترجمة عبدالرحمن بدوي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط3/1987.
2 – مجلة الأندلس- المجلد 15- 1950 – ص: 377- 435.
3 – “الخوارج في المغرب الإسلامي حتى منتصف القرن الرابع الهجري” لمحمود إسماعيل، دار الثقافة، المغرب، ط2/1985.
4 – اشتهر منهم أحدهم يدعى باسم (أبو محمد حاميم بن منّ الله الملقب بالمفتري ت: 315ه). ينظر “المسالك والممالك” لأبي عبيد البكري، تحقيق أندريان فان ليوفن وأندري فيري، الدار العربية للكتاب 1992- 2/ 776، 777.
5 – في هذا الموضوع تنظر المصادر الآتية: “البيان المُغْرِب في أخبار الأندلس المَغرب” لأبي العباس أحمد بن عذارى (ت: 712ه)، تحقيق: ج، س، كولان وليفي بروفنصال، بيروت، 1983- 1/56 وما بعدها. و”المعجب في تلخيص أخبار المغرب” لعبدالواحد المراكشي، ضبط وتقديم محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي، مطبعة الاستقامة، القاهرة، ط1/1949- ص: 161، 184. وكتاب “العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر…” الشهير بتاريخ ابن خلدون، لعبدالرحمن بن خلدون (ت: 808ه)، ضبط وفهرسة خليل شحادة وسهيل زكار، دار الفكر 2000- ج6/241، 276، 288، 305. و”الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى” لأبي العباس خالد الناصري، تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، المغرب 1997-ج1/170.
6 – يعني مصطلح (الغرب الإسلامي): شمال المغرب والأندلس والجزر المتوسطة مثل صقلية التي كانت تحت الحكم الإسلامي.
7 – “ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك”، للقاضي عياض السبتي (ت: 544ه)، تحقيق محمد بن تاويت الطنجي، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، ط2/ 1983- 1/120، 154، 181.
8 – “فهرسة” ابن خير الإشبيلي (ت: 575ه)، تحقيق محمود بشار عواد وبشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، تونس، ط1/2009- ص: 112 وما بعدها.
9 – تنظر ترجمة مالك في الجزء الثاني من “ترتيب المدارك” للقاضي عياض.
10 – “البيان المغرب” لابن عذارى، تحقيق: ج، س، كولان وليفي بروفنصال، بيروت، 1983- 1/51 وما بعدها. و”تاريخ إفريقية والمغرب” لأبي إسحاق إبراهيم بن القاسم، المعروف بالرقيق القيرواني، (ت: 420ه)، تقديم وتحقيق محمد زينهم محمد عزب، دار الفرجاني للنشر والتوزيع، ط1/1994- ص: 64 وما بعدها. وينظر كتاب “مجتمع المغرب الأقصى حتى منتصف القرن الرابع الهجري…” لهاشم العلوي القاسمي، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية 1995- 1/188 وما بعدها. و”الخوارج في المغرب الإسلامي حتى منتصف القرن الرابع الهجري” لمحمود إسماعيل، دار الثقافة، المغرب، ط2/1985- ص: 30 وما بعدها. و”تاريخ الدولة العربية منذ ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية” يوليوس فلهوزن، محمد عبدالهادي أبو ريدة، المركز القومي للترجمة القاهرة، ط2/2009- ص: 331 وما بعدها.
11 – “الخوارج في المغرب الإسلامي” ص: 49 وما بعدها. “مجتمع مغرب الأقصى” 2/135. “البيان المغرب” 1/52.
12 – “الخوارج في المغرب الإسلامي” ص: 50 وما بعدها. تاريخ ابن خلدون، 4/241، 242. و”فجــر العربيــة بـالمغرب الأقصى أو المراكز، الأولى للثقافة العربية بـه” محمد بن تاويــت، مجلة دعوة الحق، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، العدد 8، السنة 11 / 1968- ص.94.
13 – تاريخ ابن خلدون 4/241، 242.
14 – “جامع بيان العلم وفضله” لأبي عمر يوسف بن عبدالبر (ت: 463ه)، تحقيق أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، ط5/1422- 2/95.
15 – ينظر في الموضوع: “معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان” لأبي زيد عبدالرحمن بن محمد الأنصاري (ت: 696ه)، تصحيح وتعليق إبراهيم شبوح، مكتبة الخانجي بمصر، ط2/ 1968- 1/ 24 وما بعدها. و”كتاب المحن” لأبي العرب محمد بن أحمد بن تميم التميمي المغربي الإفريقي (ت: 333ه)- تحقيق يحيى وهيب الجبوري- دار الغرب الإسلامي، ط1/1983- ص: 459.
16 – ينظر في الموضوع: “جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل السنة” ص: 210 وما بعدها. “المذهب المالكي بالغرب الإسلامي” لنجم الدين الهنتاتي، منشورات (تبر الزمان)- 2004، تونس- ص: 97 وما بعدها.
17 – “البيان المغرب” 1/159. “الخوارج في المغرب الإسلامي..” ص: 220.”تاريخ الفاطميين في شمالي إفريقية ومصر وبلاد الشام” لمحمد سهيل طقوش، دار النفائس، لبنان، ط2/ 2007- ص: 81.
18 – “البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب”، تحقيق: ج، س، كولان وليفي بروفنصال، بيروت، 1983-1/149. “”المؤنس في أخبار إفريقية وتونس” لمحمد بن أبي القاسم الرعيني القيرواني المعروف بابن أبى دينار (ت: 1110ه)، تحقيق: محمد شمام، المكتبة العتيقة، تونس،1967 – ص: 50.
19 – ينظر “درر السمط في خبر السبط” لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر الشهير بابن الأبار الأندلسي (ت: 658ه)، تحقيق عبدالسلام الهراس وسعيد أحمد أعراب، مستل من مجلة “الموسم” عدد 13/1992.
20 – نفس المصدر: 2/369، 370. يريد قوله تعالى في سورة التحريم، الآية 4: (وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير). ينظر أخبارهم في كتاب “مجتمع المغرب الأقصى”، لهاشم العلوي القاسمي- طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية 1995- 2/166 وما بعدها.
21 – “نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان” لأبي الحسن علي بن محمد بن عبدالملك بن يحيى المعروف بابن القطان الفاسي (ت: 628ه)، دراسة وتحقيق محمود علي مكي، دار الغرب الإسلامي، ط1/1990 – ص: 70، 71. “التشوف إلى رجال التصوف” ص: 96، 145.
22 – “الإرشاد والتبيان في رد ما أنكره الرؤساء من أهل تطوان” لأبي عبدالله محمد بن محمد بن عبد الله المكودي التازي متصوف من شيوخ المغرب (ت:1800)، تقديم وتحقيق عبد المجيد البوكاري، منشورات جمعية تطاون أسمير، تطوان، 2008- ص 51/57.
23 – ينظر في هذا الشأن كتاب ترتيب المدارك للقاضي عياض 5/24 إلى 30.
24 – نفس المصدر السابق 5/24 إلى 30.
25 – هو أبو العباس أحمد بن عبدالسلام الجراوي (ت: 608هـ(، من أعماله الأدبية: “صفوة الأدب ونخبة كلام العرب” ويعرف بـ”الحماسة المغربية” على نسق الحماسة لأبي تمام. وله ديوان شعري. تنظر أخباره في “النبوغ المغربي في الأدب العربي” لعبدالله كنون، ص: 169، و”الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصى” لمحمد بن تاويت الطنجي، ص: 116.
26 – “المعجب في تلخيص أخبار المغرب” لعبدالواحد المراكشي، ص: 279 وما بعدها.
27 – “العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين” لمحمد المنوني، مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، ط2/ 1977- ص: 53.
28 – ينظر المقدمة التي كتبها المرحوم ابن تاويت الطنجي لتحقيق الجزء الأول من “ترتيب المدارك”.
29 – “ترتيب المدارك” للقاضي، 5/24 – 30.
30 – ينظر كتاب “سنن المهتدين في مقامات الدين” لمحمد بن يوسف الغرناطي المشهور بالمواق (ت: 897ه)، تحقيق محمد بن سيدي محمد حمّين، عثمان، مطبعة بني يزناسن سلا- المغرب، ط1/ 2002- هامش ص: 70.
31 – “الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية” لعبد العزيز بن عبد الله، مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، 1975- 1/75.
32 – من أهم المصادر في معرفة البرغواطيين: “المسالك والممالك”ل أبي عبيد عبدالله بن عبدالعزيز بن محمد بن أيوب بن عمرو البكري (ت: 487هـ)، و”أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام” لابن الخطيب.
33 – ينظر بعض أهم المصادر التي يمكن الرجوع إليها في إبراز التوجه الفكري للمذهب المالكي: تآليف القاضي عياض وخاصة كتابه “الشفا….” وتآليف شيخه ابن العربي وخاصة كتابه “العواصم من القواصم”.
34 – ينظر كتاب “المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب “لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي (ت: 914هـ)، خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجي، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، 1981.
35 – مات الشيخ عبدالله بن ياسين في حرب برغواطة سنة 451هـ، وضريحه معروف إلى الآن في المكان الذي استشهد فيه. أما القاضي عياض فقد مات غريبًا مغربًا ومنفيًا في مراكش، نفاه إليها خليفة ابن تومرت عبدالمؤمن بن علي الكومي في مراكش. مات في ظروف غامضة سنة 544ه، وضريحه بها مشهور كذلك.
36 – ينظر كتاب “تاريخ قضاة الأندلس” لأبي الحسن علي بن عبدالله بن الحسن النهاني الأندلسي المالقي، كانت وفاته في القرن الثامن الهجري، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط5/1983- ص: 22 وما بعدها- “وفيات الأعيان” لأبي العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر ببيروت، 1978- ج6/144.”المغرب في حلى المغرب” لأبي الحسن نور الدين علي بن موسى العنسي المعروف بابن سعيد المغربي، تحقيق شوقي ضيف، دار المعارف بمصر، ط2/1964، ج1/164.
37 -“محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي” لعمر الجيدي، منشورات عكاظ، المغرب، 1987- ص: 35، هامش 22.
– “المستدرك على الصحيحين” لأبي عبداالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري، دار المعرفة، بيروت، كتاب العلم، ج1/90، وقال: صحيح على شرط الشيخين،.
-“السنن الكبرى” لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، دار المعرفة، بيروت، 1992م- ج1/386.
38 – ينظر:
– “المقدمة” لعبدالرحمن بن خلدون، تحقيق علي عبدالواحد وافي، دار نهضة مصر للنشر، ط7/ 2014 – 3/ 954.
– “الصراع المذهبي” عبدالعزيز المجدوب، تقديم: علي الشابي، الدار التونسية للنشر، د.ط، تونس 1975م- ص: 65.
39 – ينظر القسم الأول من ترتيب المدارك للقاضي عياض.
40 – ينظر كتاب “وحدة المغرب المذهبية” للدكتور عباس الجراري، دار الثقافة، المغرب 1976 – ص: 25.
عدد التحميلات: 16