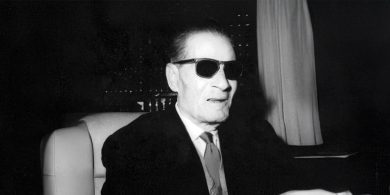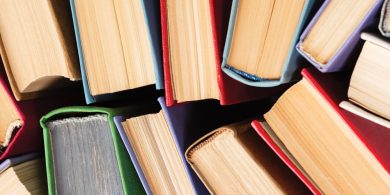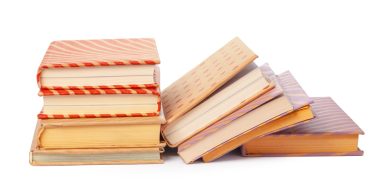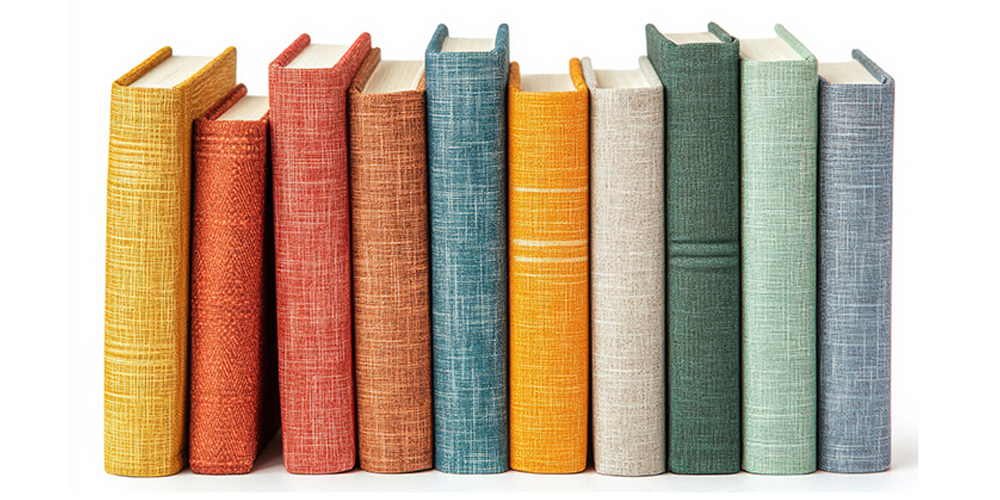
تقديم:
تصدّت الحركة الوطنية الإصلاحية في الجزائر، خلال النصف الأول من القرن العشرين، بشتى الوسائل للغزو الفكري والعسكري، ولمحاولات طمس الهوية الوطنية للشعب الجزائري، وقد ساندها الأدباء من كل الفئات في هذا التصدي، فكان أن نتج لنا أدب نهضوي إصلاحي في مضامينه، تقليدي إحيائي في أساليبه، متعدد في أشكاله من شعر، ومقالة، وخطبة، ورحلة، وقصة، ومقامة، هذا اللون الأخير وإن لم يعرف إقبالاً كبيرًا من الأدباء الجزائريين، لكن نصوصًا قليلة استطاعت أن تحيا وتؤدي وظيفتها في حضن الصحف والجرائد، ومن أبرزها: “المغرب”، و”النجاح”، و”البصائر”، وبذلك نستطيع أن نقرأ في القرن العشرين مقامة عمر بن بريهمات المنشورة في جريدة المغرب، بعنوان “مقامة أدبية”1، و”المقامة الرثائية، مناجاة مبتورة، لدواعي الضرورة” لمحمد البشير الإبراهيمي ألفها في رثاء الشيخ ابن باديس عام 1946 بمنفاه في آفلو الجزائرية، نشرت فيما بعد في جريدة البصائر التابعة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين2، ومقامات “زفرات القلوب” لمحمد الصالح خبشاش –موضوع هذا المقال- المنشورة عام 1927 في جريدة النجاح ضمن أربع عشرة حلقة3.
- الكاتب في سطور:
محمد الصالح بن البشير خبشاش، شاعر وصحفي، من مواليد 1904 بوادي يعقوب ولاية قسنطينة الجزائرية، درس في كتاب قريته، وحفظ القرآن فيه، ثم انتقل إلى مدينة قسنطينة لمتابعة تعليمه، فسنحت له الفرصة بالتعرّف على الشيخ عبدالحميد بن باديس، والتتلمذ على يديه مدة ثماني سنوات، مما فجّر مواهبه، وسهّل له الإبداع في الشعر، والمقالة، والرحلة، والمقامة، فأسهم بكتاباته، وقصائده في الحركة الإصلاحية التي كانت في أوج نشاطها في تلك الفترة، واشتغل في التعريب بجريدة النجاح مدة اثني عشرة سنة، كما تولى منصب كاتب بالرابطة الأدبية عام 1928، ونشر عدة مقالات تاريخية، واقتصادية، وإصلاحية، توعوية، تدعو إلى التسلح بالعلوم المعاصرة، وتنادي بتعليم المرأة كذلك، وقد نشط بتلك المقالات على الخصوص في جريدة الحق، وجريدة الشهاب، والنجاح،
اشتهر بقصائده المتميزة ذات الموضوعات الاجتماعية، والسياسية، والدينية، على منوال شعر حافظ إبراهيم، كما عرف بقصائده الرومانسية، التي تذكرنا بشعر مواطنه رمضان حمود، والشاعر المصري عبدالرحمن شكري، فكان خبشاش في قصائده يتغنى بجمال الطبيعة، وفي أخرى يعبّر عن حزنه ويأسه، ومتاعب حياته، ويشكو الفقر والإهمال والمرض؛ فقد عانى من مرض صدري لازمه سنتين، إلى أن توفي في مارس 1939، ودفن بمقبرة قسنطينة4.
- في رحاب مقامات زفرات القلوب:
حاول محمد الصالح خبشاش في خطابه الأدبي المعنون بـ”زفرات القلوب” أن يقدّم لقرائه ومواطنيه نصوصًا تمزج بين المقال القصصي، والمقامة، وقد أكّد خبشاش جنس خطابه من أنه يندرج تحت فن المقال، في قوله: “..ألحَّ عليَّ أن نتحّد معًا، ونكتب مقالات رنّانة، يكون لها في نفوس أولي المراتب العالية، والمناصب السامية مكانة، يبلغ صداها إلى المشارق والمغارب، ونأتي فيها بالعجائب والغرائب.”5 كما سمى ما كتبه بالعريضة، فهي شكوى من الزمن، ومن مواطنيه، وتفصيلاً في آفات ومعضلات شاهدها في مجتمعه، لكن الممعن في ما كتبه خبشاش يلمس التقاطع الواضح والكبير مع فن المقامة العربي، الذي هو فن عريق، وقديم ظهر في شكله الفني التام في القرن الرابع الهجري، لببرهن على إتقان العرب لفن القص منذ القديم، واقترن باسمين بارزين هما: بديع الزمان الهمذاني (ق4هـ/ 10م)، ومحمد الحريري (ق5هـ/ 11م)، لكنه تطور مع ابن محرز الوهراني (6هـ/ 12م)، واستطاع التعايش مع فنون النثر الحديث بفضل إسهامات كل من ناصيف اليازجي، والأمير عبدالقادر الجزائري، وأحمد فارس الشدياق، ومحمد المويلحي، وحافظ إبراهيم، هذا الأخير تأثر به خبشاش كثيرًا في هذه المقامات.
لقد جمع خبشاش بين شخصيتين خياليتين مستلهَمتين من فن المقامة العربي، موحدًا في ذلك بين شخصية الحارث بن همام6، الراوي لأفعال شخصية خالد السروجي، الأديب المتسول والمخادع في مقامات الحريري، وشخصية سطيح7 (أحد الكهنة العرب القدامى)، وهي الشخصية التي شكلت محور السرد في مقامات الشاعر المصري الحديث محمد حافظ إبراهيم، في كتابه المؤلف وفق أسلوب المقامات: “ليالي سطيح”8 وهو ما يوحي برغبة خبشاش في الموازنة بين التقليد والحداثة، إلا أن مقامات خبشاش لا تنبني أحداثها على الكدية والاحتيال الذي تتصف به الشخصية الفاعلة كما عهدناه في المقامات السابقة، بل هي عرض لمظاهر سلبية لاحظها كل من الحارث ين همام وسطيح في المجتمع الجزائري، وفي بعض فئاته المثقفة منها، والعامية، لكن الكاتب احتفظ ببعض خصائص الشخصية المقامية، منها السفر والتجوال بحثًا عن الحقيقة، ولقاء الشخصيات دائما بشخصيات أخرى مطلعة على الغيب، أو لها مقدرة على تفسير الأحلام.
كما أن مقامات خبشاش لا تفصل بين الراوي الصوت السردي المتوهم في الخطاب، والشخصية الفاعلة في قصة المقامة، بل جعل الشخصيتين يتناوبان على الفعلين: إما الرواية أو القيام بالحدث، فنقرأ مقامة بتوقيع الحارث بن همام -الذي يمثل شخصية خبشاش- ثم مقامة بتوقيع سطيح، وهكذا إلى أن تنتهي المقامات الإحدى عشرة، وكذلك نلحظ التباين بين أسلوب المقامة القديمة المعتنية بالسجع، وضروب البلاغة لهدف تلقينها للناشئة والمهتمين بالصناعة النثرية، وأسلوب خبشاش، الذي جمع بين أسلوب المقامة المسجوع من غير تكلف، وأسلوب النثر المرسل في المقال القصصي الحديث، تأثرًا بأعلام الفكر والإصلاح في المشرق والجزائر، الذين ركزوا على وضوح المضامين الإصلاحية، وعلى ما يترتب عنها من تغيير في القلوب والعقول، دون تكلف في الأساليب، أو مبالغة في الصنعة اللفظية.
- وقفة على عناوين مقامات خبشاش:
عالج محمد الصالح خبشاش قضايا اجتماعية ودينية وثقافية تربوية، كل ذلك ضمن نظرة انتقادية ساخرة ولاذعة، جاءت من وراء زفرات قلب الكاتب، وقلوب جميع مصلحي الجزائر، ومعنى زفر في اللغة تنفس تنفسًا حارًا فيه آهة وحرارة، ولعل خبشاش تأثر في ذلك بأدباء المشرق الرومانسيين أمثال مصطفى صادق المنفلوطي في قصصه “العبرات”، وجبران خليل جبران الذي قال في قصته ابتسامة ودمعة (1914): “ثُمَّ سَمِعْتُ صَوْتًا رَقيقًا تُقاطِعُهُ زَفَراتُ أَنْفاسٍ مُلْتَهِبَةٍ”9، وقد آثر الكاتب ذكر لفظ الزفرة في المقامة الأخيرة، حيث قال عن الشاعر الذي ضيعته أمته، ولم تدرك قيمته، وهي شخصية لا محالة تحيل إلى خبشاش ذاته، قال: “… أما الأول فيمثل شاعرًا غريبًا نظر إلى فساد أخلاق الأمة وإهمالها لنبغائها (فزفر) بالبيت الأول..”10.
ووفق أسلوب العنونة في المجموعات القصصية عنون خبشاش كل مقامة بعنوان جزئي يندرج ضمن العنوان الرئيس زفرات القلوب، ويتصل بمضمون المقامة الخاص، فجاءت العناوين كما يلي: إلى من أكتب؟ عجائب الأقدار، على حين المرور، سجون الأبناء، من قمة منارة، في عالم الرؤيا، جاء الربيع، ما أجملك يا غار، حضرت الصلاة، الهلال والناس، ماذا دهاك؟ السرك والتمثيل والتحية للمدير، في المرسح، موعظة واعتبار، وبذلك نوّع الكاتب في عناوينه: فمنها ما ركّز على الحدث، ومنها ما أشار إلى المكان، أو الزمان، أو الشخصية موضوع السرد، وننوه إلى ظاهرة المزج بين الواقع والخيال، وبين اليقظة والحلم، مما يجعل نصوصه تجمع بين المقامة والمنامة11، وقد يرجع ذلك لطابع الشخصية الموظفة في المقامات وهي شخصية سطيح، التي كانت تمارس الكهانة والتنبؤ بالغيب، وتفسير الأحلام.
- محمد الصالح خبشاش ودعوة الوسطية في الفعل والرأي:
يبدو الكاتب خبشاش من خلال مقاماته ذا موقف وسطي يجمع بين القديم والحديث؛ حيث سخر من نظام التعليم القديم في الجزائر، وهو ما كان يطبق في المدارس القرآنية والكتاتيب، عن طريق الاعتماد على أسلوب التلقين والتحفيظ الآلي والخالي من التفكير والفهم، لكنه بموازاة ذلك لم يفوّت كذلك فرصة التعريض بالفئة الشبانية التي تعلمت في المدارس الفرنسية، وتأثرت أيما تأثر بالحضارة الغربية، فضيّع الشباب الجزائري هويتهم، وشخصيتهم الوطنية، قال سطيح في مقامة “في عالم الرؤيا”: “أما الشبيبة التي رضعت أثداء الكليات الكبرى والليسيات (الثانويات) فلا رجاء بقي لنا فيهم لكونهم أصبحوا أمة غيرنا مخالفين لنا في العوائد، وكثير من المقاصد، وهم يرون العربي (الجزائري) دائما بعين النقص والازدراء! ولا همّ لهم إلا وقفة بباب الوادي (حي بالعاصمة)، أو جلسة بكافي (مقهى).. أو مشية مع مسيو (رولان)..؟”12 وبديلاً عن الفئتين تمنى وجود فئة شبانية مثقفة، نهضوية تستقي نماذجها من السلف الصالح، ومن التجارب الناجحة في الفكر والإصلاح التي طبقت في بلدان إسلامية كبيرة كمصر وسورية، والعراق، والهند، وإندونيسيا، بذلك يتفق خبشاش مع شيخي الإصلاح في الجزائر: عبدالحميد بن باديس، ومحمد البشير الإبراهيمي في الاقتداء بالدعوة النهضوية الحديثة في المشرق، التي راداها كل من جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده، ومحمد رشيد رضا؛ فقد كان للشيخين فرصة في التعرف على الإصلاح بالمشرق من خلال رحلة ابن باديس أولاً إلى العربية السعودية وعيشه مدة بها، ثم تجوال الإبراهيمي في بلدان المشرق الكثيرة: مصر وسورية، والعراق، وبلدان إسلامية في آسيا كماليزيا، وباكستان، وإندونيسيا، فكانت نتيجة هذه اللقاءات دعوات إصلاحية تسعى للنهوض بالإنسان المسلم، واستعادة أمجاد المسلمين، وتعليم المرأة، والتحذير من تضييع الدين والأخلاق، والتسلح بالعلوم الحديثة، اقتداء بالغربيين الذين ارتقوا وتطورت بلدانهم بعد ترقية المجال العلمي. 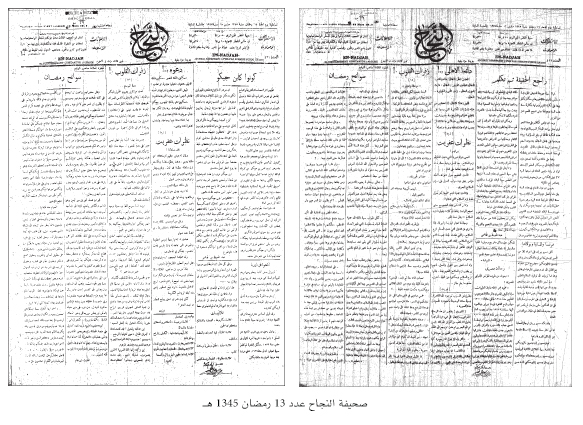
واتخذ خبشاش الموقف ذاته عندما تناول نشاط إلقاء خطبة الجمعة حيث وجد الأئمة يجترون المواضيع ذاتها في كل زمن، فهم يقتصرون على حث الناس على الصلاة والصوم وإيتاء الزكاة والحج، ولا يتوغلون في مشاكل الناس، وفي حياتهم اليومية، كما ليس لهم سبيل إلى التفكير في موضوعات لخطب جمعية حديثة، كذلك أفصح خبشاش عن موقفه من النزاع القائم كل عام حول هلال رمضان، وهلال العيد، فالمسلمون دائمًا على خلاف في المسألة، بين اعتماد الحسابات الفلكية، والعلم، مثلما كان العمل به آنذاك في تونس، أو الرجوع إلى رجال الدين وآرائهم الفقهية، وإلى الرؤية البصرية البشرية، وقد نجم عن هذا الخلاف دعوة فئة من الناس بالجزائر إلى اتخاذ شهر سبتمبر من كل عام شهرًا لصيام رمضان، لما لهذا الشهر من فضائل كثيرة كاعتدال الجو، ووفرة المنتجات الفلاحية، وقد استخف خبشاش بالأمر، ولم يقدّم الحل الأمثل، بل ترك المسألة مفتوحة لا تزال محل نقاش، وتعارض، وأورد بلساني شخصين معارضين لإجراء تونس قائلاً: “فقال الثالث مستهزئًا إن تونس دائمًا تقدّم الفرح بليلة! .. قال الرابع والعجب كل العجب فيمن يقلّد تونس من أبناء الجزائر المقيمين عقر دارهم ولا أدري ما الحامل لهم على ذلك؟ فهل التونسي خلق من الذهب، والجزائري من القزدير! أم أن التونسي مجبول على العدالة والجزائري على النقص والبلاهة.”13
وإن كان خبشاش قد استنكر اقتصار تعليم الناشئة على حفظ القرآن فحسب، وبقاء الأطفال والشبان لساعات في الكتاتيب وكأنهم مأسورين فيها، لكنه لم يدعُ إلى ترك الدين، بل عرّض ببعض الفئات التي لا تؤمن بالله، أو التي تعبد الأصنام، أو التي تعبد الدرهم والدينار، فلا إفراط ولا تفريط في الدين.
- زفرات القلوب فسحة للتعبير عن الذات، وفرصة لنصح الآخر:
بدا خبشاش في كامل مقاماته رجلاً ناقدًا، ثائرًا على مجتمعه، داعيًا إلى الإصلاح، مبديًا إعجابه بالحركات الإصلاحية الحديثة التي كانت في المشرق، وتمنيه في أن يتبدل حال الجزائر، لكن العديد من اللمسات التعبيرية لدى خبشاش تذكرنا في المقابل بأسلوب جماعة الديوان الرومانسية، التي ثارت على التقليد، وعارضت جماعة الإحياء وجماعة الإصلاح الداعمة للاتجاه الإحيائي في الأدب،
ومن يقرأ المقامات بإمعان يستدعي لا محالة بعض الشخصيات الرومانسية، كالمنفلوطي في عبراته ونظراته، وجبران خليل جبران في لفظ الزفرات، كما سبقت الإشارة إليه، وإيليا أبي ماضي، وعبدالرحمن شكري، أما التأثر بإيليا أبي ماضي فيظهر في تأملاته الكثيرة في الخلق، والسماء والنجوم، وفي يأسه، وضيقه من عامة الناس، ويقتبس منه بيته الشعري في مقامته “سجون الأبناء” إذ قال خبشاش:
أمور يحار لها الناظر
وتدمي فؤاد اللبيب الحصيف”14
وهو اقتياس من قول إيليا أبو ماضي من قصيدة: “جلست وقد هجع الغافلون”:
أمـور يحــار بها الناقد
وتدمي فؤاد اللبيب الحصيف”15
وفضلاً عن تأثر خبشاش بحافظ إبراهيم في توظيف شخصية سطيح في مقاماته، اقتبس أيضًا من شعره؛ حيث أنشد خبشاش في أول مقامة له وهي “إلى من أكتب”:
ربِّ هبْ لي قلمًا منْ رحْمَةٍ
أو بَيَانًا مِنْ هُدَى فِي الكَاتِبِينَ”16
وقد أخذه عن حافظ إبراهيم في قصيدته “القصيدة العمرية” في مدح الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:
“حسبُ القوافي وحسبيَ حين ألقيهَا
أنّي إلى ساحة الفاروقِ أهديهَا
لَاهُمَّ هَبْ لي بيانًا أستعين به
على قضاءِ حقوقٍ نامَ قاضِيهَا”17
وكذلك اقتبس خبشاش لفظ الحوادث المقترن بهموم الإبداع والتأليف؛ إذ قال حافظ إبراهيم واصفًا نفسه بلسان سطيح: “..أديب بائس وشاعر يائس دهمته الكوارث ودهمته الحوادث.. لقد أخرجتَ للناس كتابًا، ففتحوا عليك من الحروب أبوابًا، وخلا غابُك من الأسْد فتذاءب عليك الحسد”18، في حين نظر خبشاش في مقامته الافتتاحية “إلى من أكتب” نظرة إيجابية إلى ما سيبوح به ويزفر، على الرغم من أسئلته المتشائمة -وفق أسلوب إيليا أبي ماضي- حول هوية متلقي خطابه، وحول مضمون مقاماته، وأثرها في الواقع، قال بلسان الحارث بن همام: “تعلّمتُ بالفكر خوض الحوادث، وعمّا قليل أخوضها بالعمل، أحب العراك عراك الحياة، ونفسي تشتاق إليه بكل قواها، ولكن إلى من أكتب؟ أأكتب لتلك النفوس التي تزدحم أقدامهم وراء الأصفر الرنان! فيصرفوه في الملاهي وصحبة الأخدان!! أم إلى عزائم تتصادم طمعًا في مقام خطير وشرف موهوم!.. أي ميدان أخوضه؟ حسبي من هذا أن أسير وإلى أين أسير؟”19
ويبدو إعجاب خبشاش الواضح وتأثره الشديد بحافظ إبراهيم، الذي هاجم المحتفلين من أهل السلطة والمسؤولية بيوم شم النسيم، لما كان يقع فيه من اختلاط ووقوع في المحرمات، وقضاء اليوم في الرقص والغناء مع الجواري20، ومثله خاض خبشاش في مقامته “أقبل الربيع” الموضوع ذاته، فبعد أن تغنى بفصل الربيع وعدّد مباهجه، مفتتحًا مقامته بقوله:
“جاء الربيع فنلت فيه رخاء
وأراك من بعد الشتاء صفاء
زار الحـمى ببهائه وجمالـه
متوشحا ثوب الكمال رداء”21
اغتنم خبشاش الفرصة لتوجيه نقده اللاذع لما كان يحدث في بداية الفصل، وفي (يوم الربيع) من منكرات شاهدها الحارث بن همام مع صديقه سطيح، إذ شاهدًا عددًا كبيرًا من الرجال يخرجون باكرًا للتنزه، ثم الجلوس بخيمة (قيطون) للهو والقمار وشرب الخمر إلى ما بعد الظهيرة، وهو ما أغضب الشيخين، قال الحارث بن همام: “.. انصرف الجميع، وتفرق القوم، فبقينا نحوقل ونستغفر الخالق الغفار، علّهُ يزيح عنا الآلام والأحزان ويرشد “قومنا” إلى أقوم سبيل”22،
في الأخير يمكن اعتبار مقامات محمد الصالح خبشاش حلقة من حلقات الخطاب النهضوي الإصلاحي في الجزائر، الذي تشكل ابتداءً من النصف الثاني من القرن التاسع عشر بإسهامات الأمير عبدالقادر الجزائري الأدبية شعرًا ونثرًا، وصولاً إلى إبداعات نخبة الجزائر من العلماء، والأدباء، ورجال الفكر والدين في العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين، التي تعددت في أنواعها: من شعر ومسرح، وقصة ومقالة ورواية، وعلى الرغم من وقوع الجزائر تحت سيطرة الاحتلال الفرنسي إلا أن مقامات محمد الصالح خبشاش تعكس بوضوح اطلاع أدبائنا في تلك الفترة على مستجدات الحركة الأدبية الحديثة في المشرق، وتأثرهم بالاتجاهين الرائجين آنذاك وهما الاتجاه التقليدي الإحيائي، والاتجاه التجديدي الرومانسي.
الهوامش:
1 – جريدة المغرب أسسها بالجزائر الفرنسي بيير فونتانا، المعروف فيما بعد بمطبعة بيير فونتانة نسبة لمؤسسها، نشطت المجلة عامي 1903- 1904، نشر عمر بن بريهمات مقامته بعنوان في حلقتين، ع. 11، و12، 15/19 ماي السنة الأولى 1903.
2 – نشرت مقامة الإبراهيمي في جريدة البصائر، الجزائر، ع. 76، 1949، ونشرت في كتاب: محمد البشير الإبراهيمي، عيون البصائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، د.ت، ص- ص. 656- 659.
3 – محمد الصالح خبشاش، زفرات القلوب، جريدة النجاح، قسنطينة، الجزائر، ع. 406، 11 فبراير 1927- ع. 422، 20 مارس 1927.
4 – ينظر حول ترجمة الكاتب خبشاش كتاب: سليمان الصيد، نفح الأزهار عما في مدينة قسنطينة من الأخبار، المطبعة الجزائرية، الجزائر، 1994، ص- ص. 220- 227.
5 – محمد الصالح خبشاش، زفرات القلوب، ع. 409، 16 شعبان 1345هـ/ 18 فيفري 1927م.
6 – قصد الحريري بهذا الاسم نفسهُ، ونظر في ذلك إلى قول النبي محمد صلى لله عليه وسلم: “كلكم حارث وكلكم همام” فالحارث: الكاسب، والهمام كثير الاهتمام بأموره، وما من شخص إلا وهو حارث وهمام.
7 – سطيح هو ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن مازن غسان والملقب بـ “سطيح” وهو من الكهنة الذين كانوا يخبرون الناس في الجاهلية بمستقبلهم، مما يدعى بعلم الغيب، وعرف بتفسير الأحلام كذلك، وهو مما نهي عنه الإسلام، كان سطيح في بلاد الشام.
8 – نشر عمله عام 1906.
9 – جبران خليل جبران، دمعة وابتسامة، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، 2011، ص. 30.
10 – محمد الصالح خبشاش، زفرات القلوب، ع.422، 16 رمضان 1345هـ، 20 مارس 1927م.
11 – أدب المنامات: هي لون قصصي تجري أحداثه في زمن الحلم والرؤيا، تحررًا من السلطة، وخوفًا من العقاب، وهو انعكاس للواقع وصفا ونقدًا، وسخرية، ابتدع هذا الفن ابن محرز الوهراني في ق. 6ه.
12 – محمد الصالح خبشاش، زفرات القلوب، ع. 413، 25 شعبان 1345هـ- 27 فبراير 1927م.
13 – المصدر نفسه، ع. 418، 7 رمضان 1345هـ – 11 مارس 1927م.
14 – المصدر نفسه، ع. 411، 21 شعبان 1345هـ- 23 فبراير 1927م.
15 – ينظر: إيليا أبو ماضي، ديوان، مطبعة مرآة الغرب اليومية، جامعة ويسكونسن، 1919، مج. 2، ص. 116.
16 – محمد الصالح خبشاش، زفرات القلوب، ع. 406، 8 شعبان 1345هـ- 11 فبراير 1927م.
17 – حافظ بك إبراهيم، عمرية حاظ في تاريخ سيدنا عمر وسيرته ومناقبه وأخلاقه، تقديم: محمد بك الخضري، مطبعة الصباح، 1918، ص. 12.
18 – محمد حافظ إبراهيم، ليالي سطيح، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، 2010، ص. 7.
19 – محمد صالح خبشاش، زفرات القلوب، ع. 406، 8شعبان 1345هـ- 11 فبراير 1927م.
20 – محمد حافظ إبراهيم، ليالي سطيح، ص. 8.
21 – محمد الصالح خبشاش، زفرات القلوب، ع. 415، 30 شعبان 1345هـ- 4 مارس 1927.
22 – المصدر نفسه، ع. 415، 30 شعبان 1345هـ- 4 مارس 1927م.
عدد التحميلات: 1