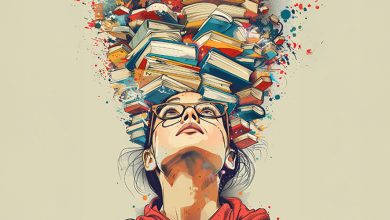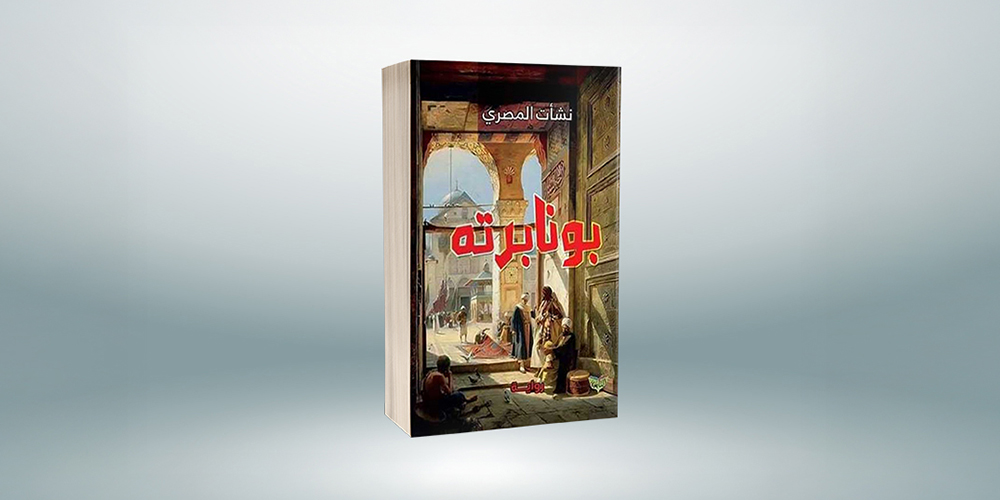
استحضار الماضي بصُور مُعاصرة ومُغايرة
تنتمي رواية (بونابرته) للكاتب نشأت المصري إلى ما يعرف بالأدب الرفيع (أدب بناء)؛ لِما تُوفر فيها من مقومات الفن الأدبي وغاياته، فالرواية الجيدة كما نعلم لها جناحين: الإفادة والإمتاع، أما الرواية التي توسم بالأدب الرفيع، فهي التي تحمل في طياتها نوعًا من الرسائل الإنسانية والقومية، وتهدف إلى طبع أفراد الأمة بطابع من الوجدان السامي ونبيل العواطف وتتجه بهم إلى مستوي رفيع من الإنسانية وتسمو فيه بالخير، وتسمو نفوسهم إلى عالي المقاصد، ويترفعون عما يصم أو يشين. وما قيمة أمرئ أجدبت نفسه من العواطف، وأصاب وجدانه التصدع، ولم يكن له من الحس الصافي نصيب؟1
ويسير الكاتب في عمله هذا على نهج التطهير الذاتي، واستدراك النقص، ودفع المبادئ الإنسانية إلى الأمام حتى تكمل بعد أن أصبحت زائفة لتوقفها في الطريق، أو تغافل أفراد المجتمع الحديث عنها، ولأنه يُدرك دوره التنويري في المجتمع، فهو يضع القارئ في مواجهة مع حاضره، بتقديم صورة مماثلة من الماضي، وبناء الواقع الجديد عن طريق الأمثولة؛ رجاء تغيير ممكن له2.
ونجد الكاتب متمثلاً دور بلزاك3 حين قال: “إن المجتمع الفرنسي سيكون هو المؤرخ، أما أنا فلست إلا مجرد سكرتير له”، وهو هنا يتصور رسالته على أنها شهادة على عصره، وتوثيق له، وبهذا يفي بما قاله “تين” من إن أعماله تتضمن أعظم قدرًا من الوثائق التي توفرت لنا عن الطبيعة البشرية، ويصدق عليه ما أراده لنفسه من أن يكون “دكتورًا في الطب الاجتماعي”4.
وتحيلنا رواية “بونابرته” إلى الموضوع الأكثر تشابكًا وتقاربًا بين المؤرخين والروائيين، ألا وهو الفارق بين “الرواية التاريخية” و”رواية التاريخ”، حيث يتشابه المصطلحان إلى حد كبير، ويصعب على غير المتخصص التمييز بينهما؛ فكلتاهما تحاول الإجابة عن تساؤلات اجتماعية، أو اقتصادية، أو ثقافية، أو سياسية جرت في الماضي، خاصة وأن القصة كلما اقتربت من قاعدة الحقائق أصبحت أقرب إلى التاريخ، بينما التاريخ كلما اقترب من الأسلوب القصصي ابتعد عن هدفه ومنهجه، وبدون الاستطراد في التفاصيل، فلا بد أن نوضح أن “الرواية التاريخية” من عمل الروائي أو الأديب، وتبدو فيها الذاتية والخيال واضحين للعيان، بينما “رواية التاريخ” من عمل المؤرخ، وتبدو فيها، أو ينبغي أن تبدو فيها، الموضوعية والواقعية، وهما من عناصر التكوين الرئيسة في العرض التاريخي5.
فقد تناول المؤلف الحملة الفرنسية على مصر، كحدث تاريخي، بمنطق الراوي الأديب لا بمنهج المؤرخ اللبيب، واستخدم المؤلف الرمز المباشر في الإسقاط، وكانت فكرة الوطنية المصرية هي محوره الصريح لعملية الإسقاط تلك.
ففي مُفتتح الرواية، الصفحات 5،6،7،8،9 يضع الكاتب يده على عوامل قيام الامبراطوريات العظمي قديمًا وحديثًا بافتراضية حديث بين البطل الراوي العليم (نابليون) والبحر، ليضعنا مباشرة ودونما مقدمات طويلة أمام ملامح السياسة وقتئذ فمن يسيطر على البحر يكون له مستعمرات أكثر ومكاسب اقتصادية كبرى، وإيمان البحر بسيادة الأقوى، وإيمانه أيضًا بأن سيادة المصريين لن تبدأ إلا بخروجهم مما هم فيه من تخلف وتراجع، لكن كيف عرف البحر؟ أو الفرنسيون الوضع القائم في مصر؟ هنا يصمت الأديب، ويجيء مؤرخ، فيجيب بأن تزايد شغف الفرنسيين تجاه الشرق منذ القرنين السادس عشر والسابع عشر، وحرص الرحالة الفرنسيون على تعريف بلدهم بإمبراطوريات الشرق العظيمة في ذلك الوقت، خاصة الامبراطورية العثمانية، والفارسية، والصينية، والهندية، وجاء الاهتمام بمصر خلال هذه الفترة باعتبارها جزءًا من الإمبراطورية العثمانية.. ولا شك أن تقارير القناصل الفرنسيين وكتاب الرحالة قد اسهمت بدور كبير في تأكيد فكرة غزو مصر ولكن ينبغي ألا ننكر أن ضعف أحوال مصر الداخلية كان من أهم العوامل التي ساعدت على إتمام هذه الفكرة فقد شهد القرن الثامن عشر ضعف السلطة المركزية، وانتشار المنازعات بين المماليك بعضهم وبعض وبين الأوجاقات (وحدة عسكرية تركية) مما أدي إلى انتشار المذابح في الشوارع. مما شجع البدو على الإغارة على القوافل التجارية، كذلك ساعدت الأحوال الاقتصادية السيئة على تأكيد فكرة الاستيلاء على مصر خاصة بعد تدهور الصناعة والزراعة والتجارة وأهمال الجسور والترع وتقلص مساحة الأراضي الزراعية بسبب انخفاض مياه الفيضان6.
كما غلب على الكاتب بغضه للعثمانيين ونقده للسياسات العثمانية، باعتبار أنها كانت سبب التخلف الذي يعانيه البلاد، إضافة إلى أنهما سببا البلاء في خضوع بلاده لقبضة الأجانب.. وهنا يتفق الروائي مع المؤرخ في تأثير احتلال الأتراك العثمانيين للقاهرة 1517 ويكفي الإشارة هنا إلى عدد المصريين كان نحو اثني عشر مليونًا عام 1517م وقد انحسر هذا العدد إلى نحو مليونين ونصف في تعداد الحملة الفرنسية مطلع القرن التاسع عشر7، وعلى القارئ أن يبحث أو يتخيل سبب هذا الانحسار؟
كما نجد نابليون يفتخر بأنه هو الذي أنشأ لمصر الديوان والديوان العام (ص 87) والتحق بهما كبار رجال الدولة والشيوخ بدءًا بشيخ الأزهر (على شاكلة مجلس النواب) وهي أول تجربة في المنطقة كلها. يقف المؤرخ محتجًا على هذا الادعاء فكانت من مهام الباشا (حاكم البلاد نيابة عن السلطان) وتعتبر من أهم الوظائف في الامبراطورية العثمانية.، وكانت من مهام الباشا كما أوضح جرانجيه” عقد الديوان ثلاث مرات أسبوعيًا أيام الثلاثاء والخميس والأحد بحضور البكوات والأغوات ورؤساء الفرق العسكرية. وقد اتيح للقنصل الفرنسي ميليه حضور إحدى جلسات الديوان وذلك بشأن شكوى قدمها التجار الفرنسيون الذين صودرت بضائعهم في جمرك الإسكندرية فكتب معربًا عن سروره: اتيح لي مشاهدة انعقاد الديوان وهو أمر لا يتيسر للقناصل إلا نادرًا!8.
ولا يقف اختلاف واتفاق الكاتب الروائي والمؤرخ في طرح الحدث فقط بل وتوظيفه أيضًا، ففي صفحة 98،99 يتحدث نابليون عن فلسفته في الحياة بأنها مجرد لعبة، ولنا الحق أن نتجاوز أصولها. ففي أغسطس 1794-الكلام على لسان نابليون-أي منذ خمسة أعوام، قابلت لويز جوتييه في بلدة كيرو، وهي في شهر العسل مع زوجها تورو الضابط المهم، كانت مولعة بقصار القامة، جمعها معي عشق خاطف وجاد له آثار مدوية، كنت حينذاك شابًا في مقتبل العمر، شعرت بالفخر لتجاوبها الشبق معي، قررت أن أثبت لها قدراتي، وهذا حقي، وأن تم على حساب أرواح الآخرين، كنا معًا في سياحة بضواحي جبال “تند” ،وومضت في عقلي فكرة غريبة، وهي أن أشغل لها خصيصًا حربًا صغيرة لتشاهدها من باب التسلية، ودون تباطؤ أصدرت أوامري لإحدى الوحدات المقاتلة بأن تهجم العدو الأوروبي بكافة الأسلحة، فهبت حرب صغيرة، وأنا وهي نصفق معًا، وكالعادة كسبت المعركة المفتعلة، وفقدنا عددًا من جنودنا، المهم أن لويز كانت سعيدة ومبتسمة، وأنا كذلك، وإن كنت لمت نفسي بعد ذلك، واكتملت الصورة بانتحار زوجها تورو. لكنني لا أرى الفارق كبيرًا بين ما فعلته وما فعله الفرعون الشهير أمنحتب الذي صنع لزوجته بحيرة كبيرة بطول كيلومترين على الأقل في الصحراء، خلال أسبوعين فقط، ومات خلالها مئات العمال دون مقابل، لكنه وزوجته استمتعا بمنظرها وهذا يكفي، أعدك يا بولين إذا عدت إلى مصر أن أصنع لك بحيرة مماثلة نضحك على ضفافها، ولا تشغلي بالك بعدد الضحايا، فهم ميتون في كل الأحوال، وعبيد لنا. وإذا كان أمنحتب وهو مصري مثلهم لم يرحمهم، فهل يتوجب على الأجنبي بونابرته أن يعاملهم كبشر، ويرعى حقوقهم؟
والقياس هنا خاطئ بين نزق قائد عسكري، نابليون، وملك مصري، وهو أمنحتب الثالث (الأسرة الثامنة
عشرة)، الذي كان ينظر إليه في الفكر المصري القديم على أنه الإله الحي، وابن إله الشمس رع، وقد كان أمنحوتب الثالث أعظم من عرفتهم مصر في مجال التشييد والبناء، وفي البر الغربي بالأقصر، شيد لنفسه قصرًا في منطقة ملقاطه وبه البحيرة المذكورة لزوجته الملكة “تي”9، وأن كان المؤلف رأى أن نتيجة الفعلين واحدة!! فهذا منتهي الغبن- من قبل المؤلف- للحضارة المصرية القديمة.
وإذا كان الهدف المرجو والمُحقق من قبل المؤلف يرنو إلى كشف النقاط السلبية التي استمرت في جينون الإنسان المصري، وكان من أثرها الامتثال على مدى عشرات السنين للاحتلال الإنجليزي، وما أسفر عنه من تشوهات نفسية، استفاد منها الاستعمار وأعوانه من قبل ومن بعد لقهر مصر والمصريين، وتجريدهم من ينابيع القوة أو تحويلها لصالح الطغاة على مر العصور. فيرى الشيخ الإمام محمد عبده (مفتي الديار المصرية) في منهجه الإصلاحي للأمة أن هذا يرجع إلى عقيدة الإذعان للقدر ويعدها من أسباب الانحطاط عند الشرقيين عمومًا وعند المسلمين خصوصًا؛ لأنها نزلت بالأمم المعتقدة بها إلي الكسل وانتظار ما يأتيهم من الغيب، وبسطت أيدي الأغنياء في الإسراف اتكالاً لما يسوقه عالم الغيب، ولكن ذلك سوء فهم أهل هذه العقيدة10.
كما وضع توفيق الحكيم يده علي سر التأخر في تقدم الأمم، وإنه لا إهمال الفكر، ولا مشكلة الاقتصاد، ولكن في بقاء الخُلق تابعًا للتقاليد القديمة، التي جري بها العرف، ولم يجي أحد كـ”ديكارت” يلقي الشك على صلاحيتها، لم يجيء أحد يحدث ثورة في مبادئ الخُلق، كما حدثت الثورة في العلم.. الثورة التي هزت عروشًا كان العلماء يظنونها ثابتة الأركان. الثورة التي وثبت بالعلم إلى مرتبته الحالية، ولكن مع الأسف جعلته يكسو بدرع من الفولاذ، ويسلح من الفولاذ ويسلح رجلاً ما زالت غرائزي غرائز أهل الكهوف والمغاور11.
الهوامش:
1 – عبدالحميد حسن، الأصول الفنية للأدب، دار المعارف، القاهرة 2013، ص 62.
2 – جان بول سارتر، ما الأدب، ترجمة محمد غنيمي هلال، مكتبة الأسرة، القاهرة 2005، ص 244.
3 – اشتهر بأعماله التي كشفت فساد وجه فرنسا الملكية الاقطاعية في عصره.
4 – صلاح فضل، منهج الواقعية في الإبداع الأدبي، دار المعارف، القاهرة 1995، ص ص 14-110.
5 – نقولا حداد، الزغاليل المجهولة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة 2019، ص ص 20-24.
6 – إلهام محمد علي ذهني، مصر في كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين في القرن الثامن عشر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1992، ص ص 49-70.
7 – عباس أبو غزاله/مذكرات ناليون، الحملة على مصر، المجلس القومي للترجمة، القاهرة 2016، ص ص 23-24.
8 – إلهام محمد علي، المرجع السابق، ص 45.
9 – نيقول جريمال، تاريخ مصر القديمة، ترجمة ماهر جويجاتي، مراجعة زكية طبو زاده، دار الفكر للدراسات، القاهرة 1991، ص ص 283-284.
10 – عماد أبو غازي من أوراق الإمام محمد عبده المجهولة، مشروع استقلال مصر 1883، دار الشروق، القاهرة 2024، ص 55
11 – جابر عاصفور مقالات سهير القلماوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 2019، ص 413
عدد التحميلات: 5