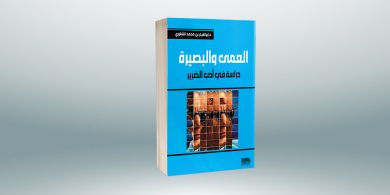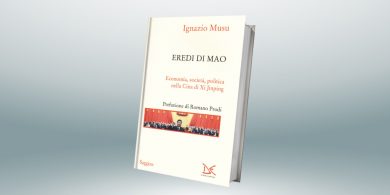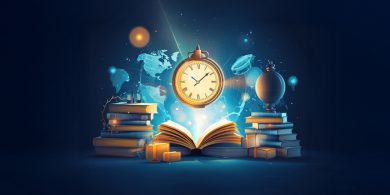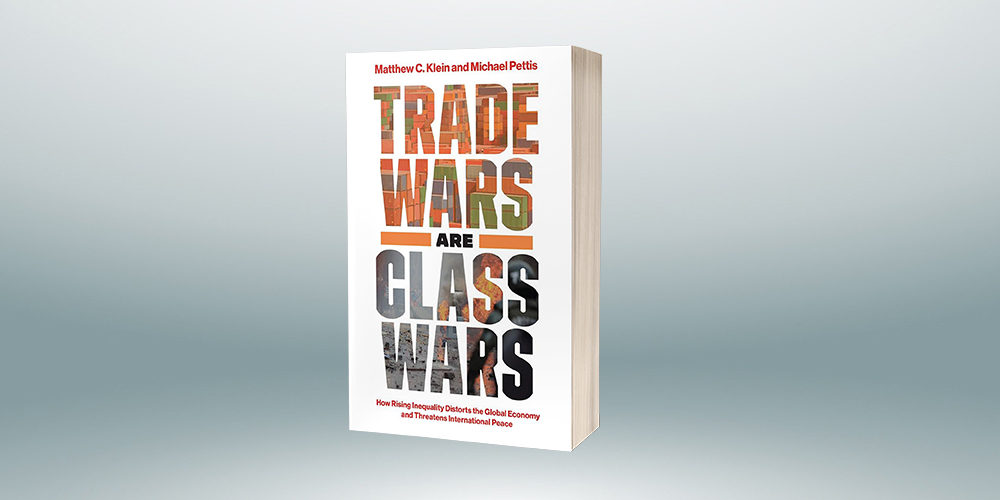
في كتابهما (الحروب التجارية حروب طبقية) 288 صفحة، يعيد المؤلفان ماثيو كلاين ومايكل بيتيس تعريف مفهوم الحروب التجارية، والتي عادة ما يُنظر إليها على أنها نزاعات تجارية بين بلدان تتعارض مصالحها.
وعلى العكس من هذا المفهوم الشائع للحروب التجارية، يؤكد كلاين وبيتيس من خلال كتابهما أنها تنشأ في الأساس نتيجة للاختيارات السياسية المحلية التي تخدم الأثرياء على حساب العمال والمتقاعدين.
ويتتبع المؤلفان أصول الحروب التجارية، ويرجعانها إلى القرارات التي اتخذها السياسيون وكبار رجال الأعمال في الصين وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، على مدى الثلاثين عامًا الماضية.
وفي حين ازدهر الأثرياء في جميع أنحاء العالم، لم يعد بإمكان العمال على الجانب الآخر تحمل تكلفة شراء ما يقومون بإنتاجه، كما فقد الكثير منهم وظيفته، أو اضطروا إلى استدانة مبالغ ضخمة.
حروب طبقية
يركز المؤلفان في الفصول الثلاثة الأولى للكتاب على أن الحروب التجارية هي حروب طبقية بالأساس، ويناقشان تاريخ التجارة العالمية، هذا بالإضافة إلى دور التحرر المالي في توليد تدفقات رأس مال غير مستدامة، والعلاقة بين المدخرات والاستثمارات والاختلالات الخارجية.
كما يستعرض الكتاب تحليلاً لتاريخ الصين وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية على مدى العقود الثلاثة الماضية، فعلى سبيل المثال أرجع المؤلفان النجاح الاقتصادي للصين إلى نسخة متطرفة لما أسمياه نموذج التنمية القائم على «المدخرات ذات العائد المرتفع»، بالإضافة إلى استغلال الفرص التجارية.
يشير المؤلفان كذلك إلى أنه كان هناك انخفاض حاد في نصيب الأسر الصينية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، منذ أوائل التسعينيات وخاصة بعد عام 2000، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل من بينها ارتفاع مدخرات الأسر، وانخفاض معدلات الفائدة، والضرائب التنازلية، ووفقًا للكتاب فإن الصين بإمكانها حل مشكلة انخفاض نصيب الأسر الصينية من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا للمعايير الدولية، من خلال نقل الثروات من أيدي النخبة إلى الناس العاديين.
من ناحية أخرى يستعرض المؤلفان مرحلة ما بعد إعادة توحيد ألمانيا في التسعينيات، وتحرير سوق العمل خلال العقد الأول من القرن العشرين، ويشير الكتاب إلى أن هذه المرحلة شهدت ارتفاع أرباح الشركات، وضعف استثمار الشركات المحلية، في المقابل انخفض الإنفاق المحلي بشكل كبير، مما أدى إلى وجود فائض ضخم في الحساب الجاري.
تم تعويض هذا الفائض في ألمانيا والعديد من الدول الأوروبية الأصغر مثل هولندا حتى عام 2008، من خلال طفرات الائتمان غير المستدامة والإنفاق في دول مثل اليونان وأيرلندا وإسبانيا، إلا أن الأزمة المالية العالمية أوقفت اتباع مثل هذه الطرق، ومنذ ذلك الحين أصبحت منطقة اليورو كلها لديها فائض في الحساب الجاري، الأمر الذي يزعزع استقرار الاقتصاد العالمي.
يؤكد المؤلفان أنه حينما تكون هناك مدخرات فائضة لدى بعض الدول، تكون الدول الأخرى في وضع معاكس تمامًا، كما يشيران إلى أن تدفقات رأس المال أدت إلى حدوث عجز كبير في البلدان الناشئة، إلا أن أكبر دولة حاليًا تعاني من العجز هي الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعاني واشنطن من عجز في الحساب الجاري، بسبب الطلب الخارجي على الأصول الأمريكية الآمنة.
وجاء تعويض الطلب المحلي الزائد من مصدرين هما الفقاعات المالية والعجز الفيدرالي، وظهرت الفقاعة الأولى وهي فقاعة سوق الأسهم في التسعينيات، بينما ظهرت الفقاعة الثانية وهي الفقاعة العقارية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
لا يستعرض المؤلفان في كتابهما المشكلات فقط، بل يقترحان حلولاً أيضًا، مؤكدين أن الحل الأساسي لحل هذه المشكلات، يتمثل في توزيع الدخل على الأشخاص الذين سينفقونه، بدون أن يضطروا إلى الاستدانة. ويقترح المؤلفان أن تنشأ منطقة اليورو سلطة مالية مركزية لديها القدرة على إعادة توزيع الموارد، إما بالنسبة لألمانيا فيقترحان أن تنفق الحكومة أموالاً أكبر على الاستثمارات والرفاهية.
بالنسبة للصين سيتطلب الأمر إصلاح أنظمة حقوق الملكية، وتحسين حقوق المهاجرين إلى المناطق الحضرية، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي، والنظام الضريبي، وفي النهاية يؤكد المؤلفان أنه إذا لم تدرك الدول هذه التحديات، وتستجيب لها، فإن العالم سيغرق في اختلالات وحروب تجارية.
قيل عن الكتاب:
“ينسج المؤلفان نسيجًا معقدًا من السياسات النقدية والمالية والاجتماعية عبر التاريخ ويقدمون آراء ما الذي سار بشكل صحيح وما الخطأ. . . يستحق القراءة للاطلاع على رؤاهم حول تاريخ التجارة والتمويل. “- جورج ميلوان، وول ستريت جورنال
«هذا كتاب مهم للغاية.»- مارتن وولف، الفاينانشيال تايمز
عدد التحميلات: 2