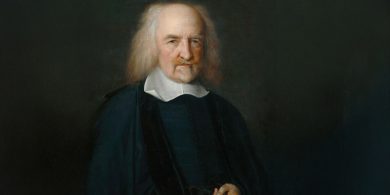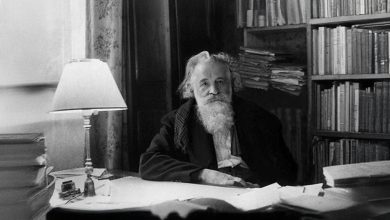بيير بورديو: ماهية النيوليبرالية؟(1)
ترجمة: د. سعيد بوخليط
ماهي النيوليبرالية؟ برنامج تحطيم بنيات جماعية بوسعها أن تشكل عائقًا أمام منطق كلي للسوق.
هل يعتبر حقًا العالَم الاقتصادي، مثلما يدعي الخطاب المهيمن، نظامًا صافيًا وخاليًا من العيوب، يعرض بشراسة منطق نتائجه المتوقعة، ثم يسرع كي يردع مختلف أنواع التقصير بالجزاءات التي يعاقب بها، سواء آليًّا، أو- أكثر استثناءً- بواسطة أذرعه المسلحة، أقصد صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عبر السياسات التي يفرضونها: التقليص من كلفة اليد العاملة، تخفيض النفقات العمومية وكذا مرونة العمل؟ رغم أن النيوليبرالية، ليست حقيقة سوى تفعيل لطوباوية، فقد تحولت إلى برنامج سياسي، لكنها طوباوية سيتأتى لها بمساعدة النظرية الاقتصادية التي تستند عليها، أن يتم التفكير فيها باعتبارها وصفا علميا للواقع؟
هذه النظرية الوصية محض تخيل رياضي (من الرياضيات)، تقوم، منذ البدء، على تجريد مدهش: ترتكز باسم مفهوم ضيق بل صارم للعقلانية المماثلة للعقلانية الفردية، على أن تضع بين قوسين الشروط الاقتصادية والاجتماعية للتدابير العقلانية وكذا البنيات الاقتصادية والاجتماعية التي هي شرط ممارستها.
يكفي فقط، حتى نعطي قياسًا للإهمال، التفكير في نظام التعليم، لأنه لم يؤخذ أبدًا بعين الاعتبار مثلما هو، خلال وقت من الأوقات، حيث يلعب دورًا محوريًا في إنتاج ثروات وخدمات، ثم يخلق منتجين أيضًا .مثل هذا الخطأ الأصلي، الذي تضمنته أسطورة أوغست ولرس(2) عن ”النظرية الخالصة”، أنتج مختلف نواقص وكذا انتهاكات النظام الاقتصادي، ثم الإصرار المميت الذي يتمسك وفقه بالمعارضة الاعتباطية التي أوجدها،ضمن تموقعها الوحيد، بين منطق محض اقتصادي، يقوم على المنافسة وينطوي على الفعالية، ثم المنطق الاجتماعي، الخاضع لقاعدة الإنصاف.
مع ذلك، ”فهذه النظرية” غير الاجتماعية واللاتاريخية أصلاً، تمتلك اليوم أكثر من أي وقت مضى، الوسائل كي تصبح حقيقية، وقابلة تجريبيًا للاختبار. بالفعل، يختلف الخطاب النيوليبرالي عن باقي الخطابات الأخرى. على طريقة خطاب الأمراض النفسية والعقلية داخل الملجأ، حسب إيرفينغ غوفمان(3)، إنه ”خطاب قوي”، لكنه ليس قويًا جدًا وفي غاية الصعوبة حين مواجهته سوى لتوفره على مختلف إمكانيات عالم علاقات القوى التي يساهم في تكريسها مثلما هي، لا سيما بتوجيهه الاختيارات الاقتصادية وجهة من يسيطرون على العلاقات الاقتصادية ومضيفا قوته الخاصة، تحديدا الرمزية ،إلى علاقات القوة تلك. باسم هذا المخطط العلمي للمعرفة، وقد صار برنامجًا سياسيًا للممارسة، يتحقق عمل سياسي ضخم (رافض، مادام يعتبر مظهريًا، محض سلب) يتوخى خلق شروط تحقق “النظرية” وتفعيلها: برنامج ينهض على التحطيم المنهجي للجماعات.
تصبح الحركة ممكنة، بفضل سياسة التحرير المالي، نحو الطوباوية النيوليبرالية من أجل سوق خالص ومثالي، يتم عبر الفعل المحوِّل، المدمِّر لمختلف المعايير السياسية، وينبغي حقا قول ذلك (أقربها عهدًا، التوقيع على الاتفاق المتعدد الأطراف حول الاستثمار، الداعي إلى حماية، المقاولات الأجنبية واستثماراتها، ضد الدول الوطنية)، لأنها تتطلع نحو إعادة النظر في كل البنيات الجماعية القادرة على أن تقف سدًّا أمام منطق السوق الخالص:الأمة، بحيث يستمر هامش المناورة لديها في التراجع؛ جماعات العمل،إلى جانب مثلاً، شخصنة الأجور والوظائف على ضوء الخبرات الفردية وما يترتب عن ذلك من تفتيت لصفوف العمال؛ هيئات الدفاع عن حقوق العمال، النقابات، التعاونيات؛ بل الأسرة نفسها، والتي تفتقد جانبًا من مراقبتها للاستهلاك، جراء تشكيلها الأسواق حسب أصناف العمر.
يستمد البرنامج النيوليبرالي، قوته الاجتماعية من القوة السياسية/الاقتصادية لمن يمثل مصالحهم – مساهمين، مضاربين ماليين، صناعيين، سياسيين محافظين أو اشتراكيين ديمقراطيين ارتكنوا إلى استقالات اطمأنت لشعار اتركه يعمل، موظفين ماليين رفيعي المقام، أكثر ضراوة بالأحرى بخصوص فرض سياسة تبجِّل إفلاسهم الذاتي، وبخلاف أطر المقاولات، لا يجازفون بتاتا كي يدفعوا ثمن النتائج حين الاقتضاء – أقول في المجمل ينزع برنامجها صوب الدفع لتحقيق القطيعة بين الاقتصاد والحقائق المجتمعية، وتؤسس بذلك، ضمن سياق الواقع، نظامًا اقتصاديًا يتماثل مع الوصف النظري، أي نوعًا من الآلة المنطقية، والتي تبدو مثل سلسلة إكراهات تقود الفاعلين الاقتصاديين.
تضمن عولمة الأسواق المالية، ارتباطًا بتطور تقنيات الإعلام، تحركًا غير مسبوق للرساميل وتمنح المستثمرين، المنشغلين بمردودية استثماراتهم على المدى القصير، إمكانية المقارنة دائمًا بين نتاج أكبر المقاولات وتُعاقب بالتالي إخفاقاتها. المقاولات نفسها، الواقعة تحت رحمة تهديد دائم مثل هذا، يلزمها التوافق بكيفية سريعة أكثر فأكثر مع مقتضيات الأسواق؛ تحت طائلة، مثلما يقال، “خسارة ثقة الأسواق”، وفي نفس الآن، دعم المساهمين والذين جراء خوفهم من الحصول على مردودية قصيرة المدى، فإنهم قادرون أكثر فأكثر بخصوص فرض إرادتهم على المسيرين، ويلزمونهم بمعايير، عبر الإدارات المالية، وكذا توجيه سياستهم المتعلقة بالتشغيل، الوظيفة والأجرة.
هكذا يترسخ النفوذ المطلق لعملية التطويع، مع التوظيف المقيد بعقود محددة زمانيًا أو العمل المؤقت وكذا ”الخطط الاجتماعية” المتكررة، ثم التنافس داخل المقاولة نفسها، بين فروع مستقلة، وفِرق مضطرة إلى تعدد المهارات، وأخيرًا بين الأفراد، عبر شَخْصنة علاقة الراتب : تثبيت أهداف فردية؛ إجراء مقابلات فردية لاستخلاص التقييمات؛ تقييم دائم؛ زيادات في الرواتب تتسم بطابع شخصي أو منح مكافآت على ضوء الكفاءة والاستحقاق الفرديين؛ نجاحات فردية؛ استراتجيات لـ ”المساءلة” تنزع نحو ضمان التشغيل الذاتي لبعض الأطر، يعتبرون مجرد أجراء ضمن تبعية هرمية قوية، سيتحملون في نفس الوقت مسؤولية الإشراف على المبيعات، المنتوجات، وكذا الفروع، والمخازن، إلخ، على طريقة ”مستقلين”؛ واقتضاء “الضبط الذاتي” الممتد إلى” إشراك” الأجراء، حسب تقنيات ”الإدارة التشاركية”، مهام عديدة تبتعد فعليًا كثيرًا عن وظائف الأطر. جملة تقنيات للإخضاع العقلاني، بقدر ما تفرض الاستثمار أساسا في العمل، وليس فقط ما يتعلق بمراكز المسؤولية، ثم العمل وفق الطارئ، فإنها تتبارى بخصوص إضعاف أو إلغاء معالم الروابط المجتمعية.
التأسيس العملي لمنظومة داروينية (نسبة إلى داروين) حيث صراع الجميع ضد الجميع، على جميع مستويات الهرمية، وقد اكتشف دوافع الانتماء إلى المهمة وكذا المقاولة في إطار اللاأمان، والمعاناة والإرهاق، لا يمكنه بالتأكيد النجاح أيضًا تمامًا إذا لم يعثر على تواطؤ تدابير هشة بلورها سياق الوجود غير المطمئن، ضمن مختلف أسلاك الهرمية، بل وحتى عند المستويات الأكثر تساميًا، خاصة بين صفوف الأطر، ثم جيش احتياطي من اليد العاملة، أضحى منقادًا نتيجة وضعية الهشاشة وكذا تهديد البطالة المستمر.
يتموضع الأساس النهائي لكل هذا النظام الاقتصادي تحت يافطة الحرية، التي تعكس في الواقع، البنية العنيفة للبطالة، واللااستقرار والتهديد بالطرد من العمل الذي يضمره: شرط التشغيل “المتناغم” مع النموذج الميكرو- اقتصادي الفرداني، بمثابة ظاهرة جماهيرية، ثم وجود جيش احتياطي من العاطلين.
أيضًا يضغط هذا العنف البنيوي على ما نسميه عقد العمل (وقد عقلنته ”نظرية العقود” بذكاء وألغت عنه سمة الواقعية). لم يتكلم قط خطاب المقاولة كثيرًا عن الثقة، التعاون، الوفاء ثم ثقافة هذه المقاولة سوى أثناء حقبة تمكننا من انخراط جل اللحظات بالعمل على إخفاء أيّ من الضمانات الزمانية (ثلاثة أرباع حالات التوظيف محددة زمانيًا، ويتسع باستمرار حيز الوظائف المؤقتة، ثم ينزع مبدأ تسريح الفرد تمامًا نحو عدم الامتثال لأي قيد). هكذا نلاحظ سعي الطوباوية النيوليبرالية إلى التبلور على أرض الواقع مثل آلة جهنمية، بحيث تفرض قيمها على المهيمنين أنفسهم. كما الشأن مع الماركسية إبان ظرفية أخرى، والتي تتلاقى معها حسب تلك العلاقة، عند نقاط مشتركة عديدة، تثير هذه الطوباوية اعتقادًا مدهشًا، مفاده الإيمان بالتبادل الحر، ليس فقط عند الذين يعيشون ذلك ماديًا، كما الوضع بالنسبة لرجال المال، مدراء المقاولات الكبرى، إلخ. بل أيضًا عند الذين يلهمهم بمسوغاتهم الوجودية، مثل كبار الموظفين والسياسيين، المؤمنين بقداسة سلطة الأسواق باسم الفعالية الاقتصادية، مما يقتضي ضرورة إزالة الحواجز الإدارية والسياسية التي بوسعها إزعاج الماسكين بالرساميل في إطار بحث محض شخصي على أقصى درجات الربح الفردي، المستند إلى نظام عقلاني، يريد بنوكًا مركزية مستقلة، وينصح بإذعان الدول الوطنية لضرورات الحرية الاقتصادية من أجل أساتذة الاقتصاد، مع إلغاء مختلف القوانين على تلك الأسواق، بدءًا بسوق العمل، منع العجز والتضخم، الخوصصة العامة للخدمات العمومية، وتقليص النفقات العمومية والمجتمعية.
دون اقتسام بالضرورة للفوائد الاقتصادية والاجتماعية لمعتقدين حقيقيين، يمتلك الاقتصاديون ما يكفي من فوائد نوعية في حقل العلم الاقتصادي كي يقدموا مساهمة قطعية، مهما كانت أحوالهم الذهنية بخصوص التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للطوباوية التي يلبسونها برهانًا رياضيًا، لإنتاج وإعادة إنتاج مرة ثانية الإيمان بالطوباوية النيوليبرالية. وقد انفصلوا بكل وجودهم، عن العالم الاقتصادي والمجتمعي كما هو، لاسيما، نتيجة تكوينهم الفكري، التجريدي خالصًا في أغلب الأحيان، تنظيريًا ومقتصرًا على مضامين الكتب، واكتفوا خاصة بدائرة خلط أشياء المنطق مع منطق الأشياء.
واثقون في نماذج لم يعثروا قط عمليًا على فرصة إخضاعها لاختبار التحقق التجريبي، والتزموا فقط بالتأمل فوقيًا مكتسبات علوم التاريخ الأخرى، بحيث لا يكتشفون بين طياتها صفاء وكذا الشفافية البلورية لمفاتيحها الرياضية، ثم عجزهم في أغلب الأحيان عن استيعاب ضرورتها الحقيقية وكذا تعقيدها العميق، ثم يساهمون ويشاركون في تحول اقتصادي واجتماعي مدهش، بحيث وإن أثارت بعض نتائجه فزعهم (يمكنهم تسديد الاشتراك إلى الحزب الاشتراكي وتقديم نصائح حذرة لممثليهم داخل أجهزة السلطة)، فلا يمكنها أن تزعجهم مادامت، المجازفة ببعض الإخفاقات، مستندين خاصة إلى ما ينعتونه أحيانًا بـ”فقاعات تأملية”، يتطلعون خلف ذلك التحول صوب إعطاء حقيقية للطوباوية المنطقية للغاية (مثل بعض أشكال الجنون) التي كرسوا لها حياتهم.
مع ذلك فالعالَم هنا، مع التأثيرات الملاحظة فوريًا جراء اشتغال الطوباوية النيوليبرالية الكبرى: ليس فقط البؤس المتزايد أكثر فأكثر بين أوساط طرف من المجتمعات حتى الأكثر تقدمًا اقتصاديًا، ثم النمو غير العادي للفوارق بين الأرباح، والاختفاء التدريجي لعوالم مستقلة ضمن الإنتاج الثقافي، السينما، النشر، إلخ، من خلال فرض متطفل لقيم تجارية، لكن أساسًا وخاصة تحطيم مختلف السلط الجماعية القادرة على التصدي لمفعول الآلة الجهنمية، في مقدمتها الدولة، المُؤْتَمنة على مختلف القيم العامة المرتبطة بفكرة الجمهور، ثم تعميمها في كل مكان، داخل أعلى دوائر الاقتصاد والدولة، والمقاولات، لهذا النوع من الداروينية الأخلاقية، والتي مع شعيرة عبادة المنتصِر، المُصاغة برياضيات دقيقة ثم القفز المطاطي، فقد صار تشكلها بمثابة معايير لمختلف ممارسات حرب الجميع ضد الجميع وكذا الاستخفاف.
هل يحق لنا الترقب من الكتلة الهائلة للمعاناة التي أفرزها نظام كهذا اقتصاديًا- سياسيًا أن تكون في يوم من الأيام مصدرًا لحركة قادرة على وضع حد للسباق نحو الهاوية؟ بالفعل، نجدنا حيال تناقض عجيب: بينما العوائق التي نصادفها في سبيل تحقيق النظام الجديد- المتعلق بفرد وحيد، لكنه حر- تتناول اليوم انطلاقًا من انتسابها إلى جمود منظومات قديمة، وبأن كل تدخل مباشر وواع، لاسيما حينما يصدر عن الدولة، كيفما جاءت الزاوية، لم يعد يحظى بالمصداقية، بالتالي يلزمها أن تنمحي لصالح آلية خالصة وغير معروفة، أي السوق (حيث ننسى أنه كذلك فضاء لممارسة المنافع)، أقول يمثل هذا في الحقيقة استمرار أو بقاء مؤسسات وفاعلين ينحدرون من النظام القديم في طريقهم إلى التفكك، ومجمل عمل شتى أصناف العمال المجتمعيين، وكذا جل أشكال التضامن الاجتماعي، العائلية أو غيرها، والتي تحول دون سقوط النظام الاجتماعي في الفوضى رغم الحجم المتنامي للساكنة الهشة.
يحدث الانتقال إلى ”الليبرالية” بكيفية متبلِّدة الشعور، إذن غير ملموسة، مثل انجراف قاري، وقد أخفت تأثيراتها الأكثر رعبًا عن الأنظار، لمدة بعيدة الأمد. نتائج تجد نفسها كذلك مستترة، على نحو متناقض، جراء أشكال المقاومة التي أحدثها، منذئذ، المدافعون عن النظام القديم معتمدين بهذا الصدد على الموارد التي احتواها، من خلال الارتباطات التضامنية القديمة، وعبر احتياطات الرأسمال الاجتماعي اللذين يحميان جزءًا كاملاً من النظام الاجتماعي الحالي بعدم السقوط في الفوضى (رأسمال، إذا لم يجدد، ويبعث ثانية، يكون مآله الإنهاك، غير أن اضمحلاله لن يحدث بين عشية وضحاها).
بيد أن نفس هذه القوى المتكلفة بـ”الحفظ”، والتي يسهل كثيرًا تصنيفها باعتبارها قوى محافظة، تعتبر كذلك، حسب علاقة أخرى، قوى مقاومة لتثبيت النظام الجديد، بوسعها أن تصير قوى انقلابية. وإذا أمكننا أيضًا الإبقاء على بعض من الأمل الحصيف، فلا زالت موجودة دائمًا، داخل المؤسسات المرتبطة بالدولة وكذلك مع تدابير الفاعلين (لاسيما الأكثر ارتباطًا بهذه المؤسسات، مثل نبلاء الدولة الصغار)، قوى من هذا القبيل، والتي خلف مظاهر كونها تدافع ببساطة، مثلما يُؤَاخذ عليها فورًا، عن نظام منقرض وكذا ”الامتيازات” المترتبة عن ذلك، يلزمها في الواقع، حتى تصمد أمام اختبار التجربة، العمل على إبداع وبناء نظام مجتمعي لن تحكمه فقط قاعدة البحث عن المصلحة الأنانية والشغف الفردي بالربح، بل أخلت مكانًا أمام تعاونيات تسعى نحو الاقتفاء العقلاني لغايات تهيأت وأقِرَّت بشكل جماعي.
فكيف لا تحظى الدولة بمكان خاص، وسط هذه التعاونيات، الجمعيات، النقابات، الأحزاب.الدولة الوطنية، أو بشكل أفضل، الأسمى منها، يعني أوروبية (مرحلة نحو دولة عالمية)، قادرة على أن تضبط وتفرض بفعالية المكاسب المتحققة في الأسواق المالية، لا سيما التصدي لفعل الأخيرة التدميري على سوق العمل، من خلال تنظيم، بمساعدة النقابات، الإعداد للدفاع عن المصلحة العمومية، والتي سواء أردنا أم رفضنا، لن تنزاح أبدًا، حتى مع بعض الأخطاء في الصياغة الرياضية، عن منظور المحاسب (في وقت آخر، كان بوسعنا نعته بـ”البقّال”) حيث يقدمه الاعتقاد الجديد باعتباره الصياغة القصوى للإنجاز البشري.
الهوامش:
(1) مصدر النص: جريدة لوموند ديبلوماتيك، مارس 1998. بيير بورديو(1930 – 2002)،عالم اجتماع، وأستاذ بكوليج دو فرانس.
(2) أوغست ولرز (1800-1866)، اقتصادي فرنسي، وصاحب كتاب: طبيعة الثراء وأصل القيمة (1848)، أحد الأوائل الذين سعوا إلى تطبيق الرياضيات على الدراسة الاقتصادية.
(3) إيرفينغ غوفمان: ملاجئ، دراسات حول الوضع المجتمعي للأمراض العقلية، منشورات مينوي، باريس 1968.