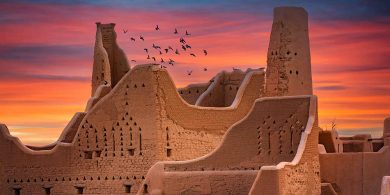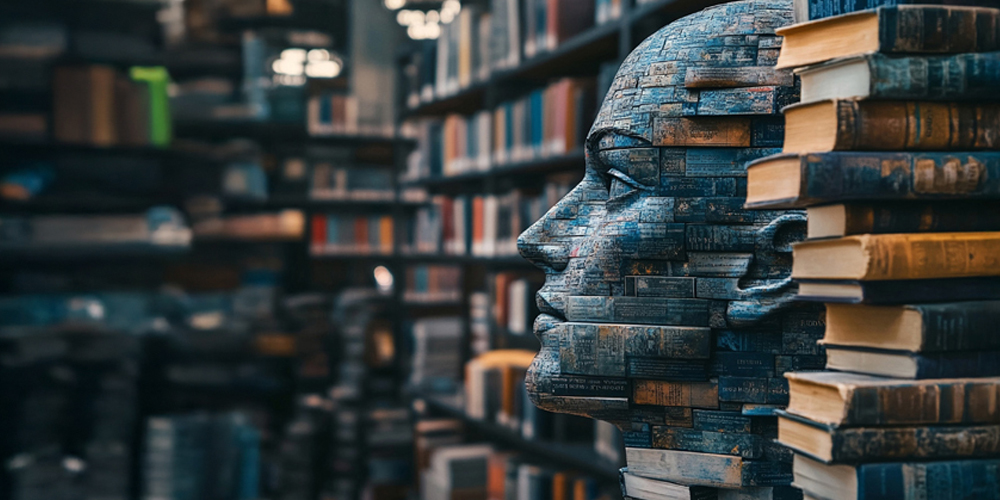
تاريخيًا ومنذ نشأتها لدى اليونان، تمثلت الفلسفة نفسها باعتبارها سيدة الحقيقة، المالكة للجوهر النهائي للوجود، والمعبرة عن وضعية الذات البشرية. كانت الفلسفة دائما تنظر إلى ذاتها كما يقول جاك ديريدا من منطلق “مركزية قضيبية”. إنها الأب الذي يعلو باقي الخطابات ويمارس وصايته عليها.
يقدم لنا تاريخ الفلسفة أمثلة كثيرة عن هذا الاستعلاء، الذي ميز الخطاب الفلسفي على باقي الخطابات، وعلى رأسها الفن والأدب. فالفلسفة عند أفلاطون أفضل من الشعر الذي يقتصر عمله على محاكاة الطبيعة، بينما الفلسفة وحدها بفضل الجدل الصاعد، تستطيع أن تبلغ بنا إلى عالم المثل، أي أن تحلق بنا في سماء المعقولات. كما أن المفهوم أفضل من الاستعارة عند هيجل، الأول يستطيع أن يجسد الكلي والروح المطلقة، بينما الثاني يظل حبيسا لما هو حسي.
ولكن أما آن الأوان لإعادة النظر في هذا الامتياز Le privilège الذي تحظي به الفلسفة، وذلك على الأقل لسببين: أولاً بفعل الأزمة الكبيرة التي عرفتها العقلانية الكلاسيكية، والمراجعات التي أنجزت من أجل قلب الميتافيزيقا والخروج عنها. وثانيًا بفعل الانفجار الكبير الذي عرفته المعارف الفلسفية، سواء من خلال ظهور العلوم الإنسانية، أو من خلال الثورة الأدبية، التي عرفها القرن العشرون في عالم الرواية والشعر. لقد بدا واضحًا أن الموضوع الذي اعتبر مقصورًا على الفلسفة، ألا وهو الوجود بصفة عامة، والوجود الإنساني بصفة خاصة، قد أصبح موزعًا داخل حقول معرفية عديدة وتخصصات متباينة. مثل علم النفس، والإيبستمولوجيا، والأنثروبولوجيا وغيرها.
واليوم تنظر الفلسفة إلى ذاتها كممارسة كتابية مثلها مثل الأدب، مضطرة للاشتغال على اللغة. بل ومجبرة على تعلم الطابع اللعبي ludique للأدب، ومعيدة النظر في ذاتها كعلم شامل للوجود. فما هي إذن أشكال هذه التقاطعات والانفصالات الحاصلة بين الفلسفة والأدب؟
اتصالات وانفصالات
على طول التاريخ عرف الخطاب الفلسفي والأدبي اتصالات وانفصالات، هناك العديد من التقاطعات والتمايزات بينهما. أحيانًا يلتقيان مع بعضهما البعض، وأحيانا أخرى يتباعدان. مرة يكون هناك تأثير من الفلسفة على الأدب ومرة أخرى العكس. لدينا شعراء فلاسفة مثل المعري، عمر الخيام، هولدرلين، رلكه، تراكل… ولدينا فلاسفة شعراء مثل نيتشه، باسكال، سيوران… هناك روائيون أثاروا قضايا فلسفية كبيرة مثلاً مع دوستويفسكي، كافكا، جيمس جويس، بروست وغيرهم، ولدينا في المقابل فلاسفة تأثروا أيما تأثر بالمنجز الأدبي، وأكبر مثال على ذلك كيركيجارد، نيتشه، وهيدغر… هذا الأخير كما هو معروف رفع القول الشعري إلى مقام الحقيقة، حيث لم تعد الفلسفة هي وحدها التي تمتلك ناصية الكلام في مسألة الوجود.
ولكن لنتريث قليلاً فالقسمة الحادة بين الفلسفة والأدب، هي ثنائية لاحقة في تاريخ الفكر الإنساني. بينما في المرحلة الما قبل سقراطية كانت هناك وحدة ملتحمة بينهما. لقد كتب هيراقليطس وبارمينيد وطاليس، وحكماء الشرق مثل لاو تسو وبودا بطريقة خاصة، يتمازج فيها المفهوم والاستعارة. لم يظهر هذا التوتر بين الفلسفة والأدب بشكل واضح وحاد إلا مع أفلاطون، الذي اعتبر ـ كما هو معروف ـ أن الشعراء لا مكان لهم داخل مدينته الفاضلة.
هذا الموقف الاستعلائي من الفلسفة اتجاه الأدب، هو الذي سيتردد صداه بطرق مختلفة داخل تاريخ الفلسفة. لم يحدث أن تمت إعادة الاعتبار للأشكال الكتابية الأخرى وعلى رأسها الآداب، إلا في نهاية القرن التاسع عشر مع نيتشه، والقرن العشرين مع مارتن هيدغر. ورغم الاختلاف الكبير بين المشروعين الفلسفيين إلا أنهما معًا، اكتشفا أهمية ما يقوله الأدب، وذلك بعد النقد والقلب الكبير الذي قاما به للميتافيزيقا الغربية.
هكذا لا يمكننا فهم إشكالية العلاقة بين الفلسفة والأدب، إلا من خلال فهم المقصود بتجاوز الميتافيزيقا، هذا التجاوز الذي من شأنه أن يدفعنا للانفتاح على طريقة مغايرة في التفكير والتعبير. يمكننا أن نستعرض هذا الأمر من خلال العناصر الآتية:
أولاً: في الأدب نجد ما يمكن أن نسميه بـ”تعبيرات المفهوم” وليس المفهوم في صورته المنطقية الخالصة. هذا معناه أن الأدب لا يفصل بين المفهوم والاستعارة. إنه يعبر عن الفكرة، ولكنه في الآن ذاته لا يريد أن يضحي بالصيغة الجمالية. إن مثل هذا المشروع الذي يهدف إلى إنزال المفهوم من عليائه، نجد صيغته الواضحة مثلاً مع ديريدا، فكما أوضح بيير زيما في كتابه التفكيكية فإن: “التفكيكية التي يتصورها جاك ديريدا كهدم منهجي للميتافيزيقا الأوروبية، يمكن تحديدها في طور أول كمحاولة لتفكيك الفكر النقدي للتراث الفلسفي الممأسس، ولطرح سيطرة المفهوم والمفهمة للنقاش “1
ثانيًا: التموقع خارج المفهوم وخارج الميتافيزيقا، يعني أيضًا تجاوز الفكر النسقي المغلق، نحو شكل تعبيري أكثر رحابة، وهذا هو ما يوفره السرد الروائي بنوع من السخاء، خاصة في بعض الاتجاهات الأدبية المعاصرة، التي تتجاوز الصيغة الكلاسيكية للرواية، مثل ما نجد في الرواية الجديدة في فرنسا مع ميشيل بوتور ونتالي ساروت وآخرين. أو الرواية الما بعد الحداثية مع بول أستير وجون ديليلو واللائحة طويلة. لقد ابتكر كل هؤلاء تقنيات سردية عديدة من أجل جعل العمل الأدبي: “أثرًا مفتوحًا” كما سماه أمبرتو إيكو2. هكذا يظهر الأدب بعيد تمامًا عن تلك البناءات الهندسية المغلقة التي ميزت الأنساق الميتافيزيقية.
ثالثًا: تجاوز الميتافيزيقا يقتضي كذلك تجاوز مركزية الذات المفكرة، وأوليتها في الوجود. والقادرة بفضل العقل على اختزال الوجود في فعل الإدراك العقلي، وكأن ما أتمثله عقليا هو وحده الموجود.
البحث عن المطلق
ثمة مع ذلك هدف مشترك يربط كلاً من الفلسفة والأدب، إنه البحث عن المطلق. سواء بواسطة اللغة والتعبير الكلي في الأدب، أو بواسطة المفهوم العقلي مع الفلسفة، أو كما قال جان فرانسوا وأركييه: “الفلسفة الساعية لجمع كل شيء في مفهوم واحد، والأدب الساعي لجمع كل شيء في شكل واحد”3
لكن رغم هذا الاتفاق يمكننا أن نقول بأن كلي الفلسفة، يختلف تمامًا عن كلي الأدب. الأول يتم عرضه على شكل مفهوم مغلق داخل نظام متراص، يزعم وصف الواقع والإحاطة به بشكل شمولي. أما الثاني فهو كلي معروض بشكل قلق، بحيث يتم التساؤل عنه باعتباره نوعا من الفقدان، إنه الكلية المفقودة.
يتفق الجميع على أن الأدب العظيم يتضمن فلسفة، والفلاسفة الكبار بمن فيهم من أعلن صراحة عداءه للأدب (حالة أفلاطون مثلاً) قد تركوا لنا نثرًا بديعًا، لكن في كل الأحوال ليست هذه هي المشكلة. الأمر يتعلق كما قال بيير ماشيري بطرح السؤال الأساسي الآتي: بم يفكر الأدب؟4 وهو السؤال الذي يمكننا طبعًا أن نعكسه، بم تفكر الفلسفة؟ إن صياغة الإشكال على هذا النحو، يريد أن يقول بأن ما يفكر فيه الأدب يختلف عما تفكر فيه الفلسفة، غير أن هذا الاختلاف مع ذلك لا يجعلهما في تعارض كلي مع بعضهما البعض، لأن الموضوع واحد. إنه شرط الوجود البشري. لكن ما يقوله الأدب عن هذا الموضوع يختلف كليا عما تقوله الفلسفة.
إن الهدف من وراء طرح هذا الإشكال، يرمي إذن إلى الكشف عن الإمكانات المتضمنة في كل منهما لإضاءة فعل الوجود. ليس المقصود إذن قراءة الأعمال الأدبية في ضوء الأفكار الفلسفية، وإرغامها على كشف مضمونها الفكري. فالفلسفة على الأقل في صيغتها الميتافيزيقية كان لها دومًا هذا الطموح إلى تأسيس علم بالوجود، وهو الطموح ذاته الذي تمت مراجعته بدءًا من نيتشه وإلى غاية ظهور الفلسفات المعاصرة، سواء في فرنسا (دولوز ـ ديريدا ـ فوكو …) أو في أمريكا (ريتشارد رورتي). ليس من الغريب إذن أن تنفتح هذه التجارب الفكرية وهي الطامحة إلى تجاوز الميتافيزيقا على الأدب، فهو يبرز اليوم وبالخصوص الأدب الحديث بدءًا من بودلير وإلى غاية فيرناندو بيسوا، كما لو أنه الخصم العنيد للميتافيزيقا، إذ بدل أن يبحث عن الهوية الخالصة، والنسق المغلق، والراوي المتحكم في كل شيء، هذا الإله الخفي كما وصفه لوسيان غولدمان. يقوم بالعكس من ذلك بالبحث عن التشظي، والعلاقات المتوازية، والسياقات المتشابكة…
وعلى ما يبدو فإن الفلسفة والأدب يقفان على الأرض نفسها أرض الوجود، والاختلاف يكمن في كيفية التناول، وفي ما يمكن قوله بصدد الكينونة. إن الشعر يريد استعادة عالم مفقود، والوقوف على المعنى الضائع. تلكم هي المهمة التي يضطلع بها ما يسميه كريستيان دوميه في كتابه جنوح الفلاسفة الشعري: “تجربة القصيدة الجوهرية”5 فالشعر والأدب بصفة عامة، يملك هذه القدرة على الاعتراف بأن كل قول حول الوجود، لا بد أن ينتهي إلى الصمت. بينما الفلسفة تظل متمسكة دومًا على أنها قادرة على قول ما هو أساسي بصدد حقيقة الحياة.
خاتمة
واليوم إذ نلاحظ انهيار الحدود بين التخصصات، ووجود تأثير وتأثر بين الإنتاجات المعرفية البشرية، تبرز بقوة هذه التكاملية بين الخطابات ضمن ما يسميه إدغار موران “الفكر المركب” أو ما يطلق عليه أيضًا الفيلسوف الأمريكي كين ويلبر الفلسفة التكاملية. لم يعد بإمكان أي خطاب أن يزهو بنفسه كما لو أنه المالك الوحيد للحقيقة، وبدل هذا الادعاء ينبغي أن يكون هناك تعاون فعلي بين المعارف. ليس هناك أدب خالص، أي خال من الفكر، كما أنه في المقابل ليس هناك فلسفة خالصة، أي خالية من الأسلوب ومن الخيال. ثم إن سقوط الميتافيزيقا، من شأنه أن يعثر داخل الأدب على برنامج عمل واسع المدى، فالرواية والتجارب الشعرية أصبحت تبرز كما لو أنها امتداد Un prolongement للنشاط الفلسفي، الذي يميل إلى تجاوز الميتافيزيقا. لقد اعتنت هذه الأخيرة ببناء أشكال التعالي، بينما في المقابل أولى الأدب عناية خاصة لتصوير أشكال السقوط البشري، ووصف الهشاشة التي يوجد عليها الوضع الإنساني. وإذن نحن في حاجة إلى رأب الصدع بين الخطاب الأدبي والخطاب الفلسفي، وإلى تجاوز هذه القسمة الحادة بينهما. إن الأدب هو آخر الفلسفة والفلسفة هي آخر الأدب.
الهوامش:
1 ـ “التفكيكية”. بيير زيما ترجمة أسامة الحاج. الطبعة الاولى 1996 ص 9 .
2 ـ “الاثر المفتوح”. أمبرتو إيكو، ترجمة عبد الرحمان بوعلي. الطبعة الثانية 2001 .
يناقش أمبرتو ايكو في هذا الكتاب كيف الأدب والفن يترك مساحة للقارئ في حرية التفسير والتأويل، بدل فرض المعنى الواحد عليه. إن هذا هو ما يعكس الدور الفعال للمتلقي في انتاج الدلالة. كما يعرض ايكو كذلك في هذا الكتاب فكرة كون النصوص يمكنها أن تحتوي على مستويات مختلفة من المعنى، وهذا هو ما يجعلها أكثر تعقيدًا وإثارة للاهتمام.
3 ـ “مرايا الهوية، الأدب المسكون بالفلسفة” جان فرانسوا وأركييه. ترجمة كميل داغر ص 13.
4 ـ “بم يفكر الأدب”. تطبيقات في الفلسفة الأدبية. بيير ماشيري، ترجمة جوزيف شريم. الطبعة الاولى 2009 .
ينتقد الكاتب في هذا المؤلف الاعتقاد السائد بان الأدب يعكس الواقع، بل هو في نظره يشكله من جديد ويعيد انتاجه. فالأدب لا يعبر عن شيء آخر غير ذاته، إنه تفكير مغاير وليس مجرد انعكاس آلي للواقع.
5 ـ “جنوح الفلاسفة الشعري”. كريستيان دومييه. ترجمة ريتا خاطر. الطبعة الاولى 2013 ص 46.
عدد التحميلات: 0