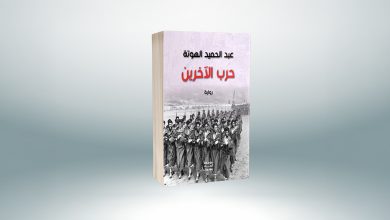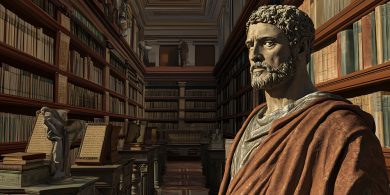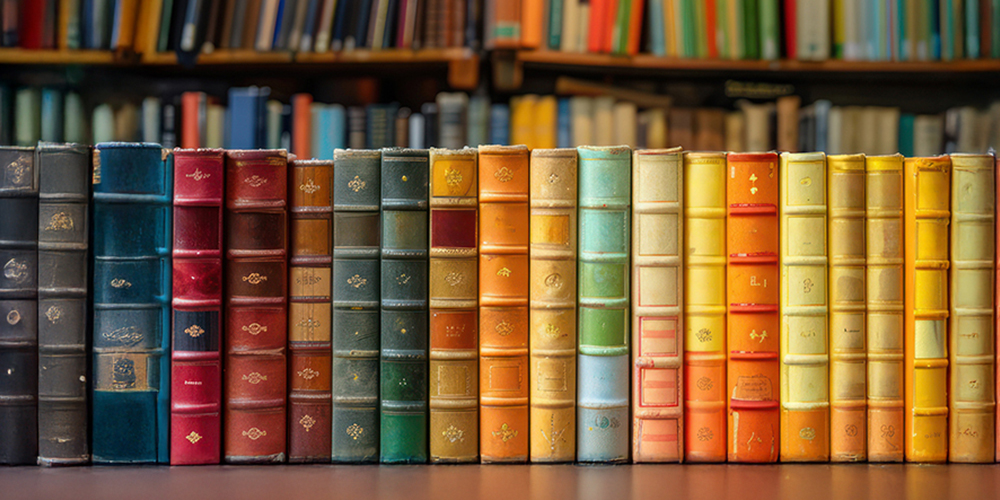
هناك دائمًا علاقة أزلية تجمع بين الكاتب والقارئ، ولكن يبقى السؤال ما طبيعة هذه العلاقة؟ فأول ما تقع عليه عين القارئ؛ عنوان المؤَلف والمؤلِف، حينها يتخذ قراره من المقروء؛ أيواصل أو ينسحب، أيبقى في وجه الصفحة أو يغادرها؟ والعادة أن اسم الكاتب أو عنوان المقروء هو الذي يحدّد ابتداءً طبيعة العلاقة بين الطرفين، ويبقى العنوان عامل جذب لاهتمام القارئ، أو منفر له بحكم أنه خارج دائرة اهتمامه الفكري، ونشاطه العلمي.
في حالة إقبال القارئ على المقروء، تنمو علاقة فكرية ونفسية بينهما، فإن استوعب القارئ مضمون النص، ينشب خلاف فكري ونفسي لدى القارئ، ورغم الخلاف صار القارئ شريكًا للكاتب. وأثناء القراءة تترسب في نفس القارئ وعقله قناعات أو اعتراضات، فهل المقروء معبر ومقنع، أم يبقى المقال أو الكتاب مجرد عرض جُمل وألفاظ – بالنسبة له – لا يضيف جديدًا.
وإذا كان الاعتراض على مضمون المقروء، مبنيًا على قناعات مذهبية أو عقدية أو أيديولوجية مسبقة، فلا تنتهي العلاقة والمقروئية إلى شيء ذي بال، أي غير مفيدة لفكر الفرد أو مصلحة الأمة والمجتمع، بسبب المواقف والأحكام المسبقة، والتي تكون سببًا في النفور والابتعاد عن المقروء، فيضيع على القارئ إدراك حقيقة المقال وأبعاده مع احتمالية الاختلاف، وسوء إدراك المقروء من قبل القارئ، إما لسطحيته وغياب الإبداع فيه، أو لضعف القارئ وقلة حيلته.
ومن عوامل إصدار الأحكام المسبقة، وغير المبينة على أسس موضوعية، والمغلفة بغلاف الأنا الأعلى، الأحكام المؤدلجة، والقناعات المتطرفة، (قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ) (غافر، الآية 29)، وكلما كان الاختلاف بيّنًا بين القارئ والمقروء، ينشأ جدار صد لدى المتلقي في رواسب اللاشعور، لسوء فهم، أو لغموض المقروئية لدى القارئ، ولا يتحقق الاتفاق والوفاق بينهما، إلا في حالة التقارب المعرفي، والنظرة المشتركة من الزاوية الواحدة. على أن هذا التقاطع الإبستمولوجي بينهما لا يتحقق إلا بالقراءة المتأنية والحيادية، والفهم الحسن، ويعطي لهذه العلاقة تقاربًا في الإدراك، وتحقيق وحدة الذات، فتُفتح مسارات وآفاق حوار هادئ ومنسجم.
ويؤدي حسن التفهّم إلى نبذ الأحكام العاجلة والمسبقة المغلّفة بلباس الأيديولوجية، والعقائدية، فلا تصدر الأحكام إلاّ بعد تقليب القارئ لكل وجهات النظر، حينها يكون النقد عملية إيجابية في صالح تحسين النص وتطويره. فمثل هذه القراءة الواعية يمكنها أن تغيّر من المسلّمات، وتشجع على إعادة النظر في بعض الرواسب الفكرية، فيحدث التغيير في العقائد والقناعات، وينتقل التغيير الإيجابي النظري إلى الممارسة، فكثيرًا ما يحمل بعض الناس رواسبًا، ومخلّفات فكرية، وأيديولوجية خاطئة، ومتزمّتة، تحتاج إلى المراجعة والتصحيح.
وبغض النظر عن تباين المقروئية من قارئ إلى آخر، يرى البعض استحالة تحقق تماثلية مقروئية موحدة للنص، ومع ذلك “ليس هناك سوى قراءة واحدة صحيحة، هي التي يجتهد القارئ لبلوغها، أمَّا القول بأن هناك أكثر من قراءة صحيحة للنص الواحد فلم يكن مطروحًا، وذلك بسبب ما سبق ذكره؛ من ترسبات عقدية، وخلفيات أيديولوجية، وقناعات فكرية، فكل فرد يحمل قناعات ينفرد بها عن غيره حتى داخل المجموعة الواحدة، فالاختلاف يظل قائمًا في حده الأدنى، فالقراءة “فعل غير بريء، لأنها تعكس مفاهيم مترسبة في ذهن القراء، لها خلفيات فكرية وأيديولوجية واقتصادية واجتماعية وقيمية”. ومع هذا التباين والاختلاف يمكن الالتزام بالحد الأدنى من الموضوعية، وإعمال القارئ لآلية النقد الآني -أثناء القراءة- دون ربطه بمرجعياته، وترسباته التاريخية، يقلّل في حده الأدنى من الأحكام والنيات المسبقة.
يقول مؤسس علم البلاغة عبدالقاهر الجرجاني (1009-1078م): “مَن له طبع إذا قدحته وَرِيَ وقلب إذا أَرَيْتَه رأى”، وهو القادر على اكتشاف ما في النص من جلي وخفي، الناظر إليه على أن صاحبه: “قد تحمَّل فيه المشقة الشديدة، وقطع إليه الشقَّة البعيدة، وأنه لم يصل إلى درِّه حتى غاص، وأنه لم يَنَل المطلوب منه حتى كابَد منه الامتناع”.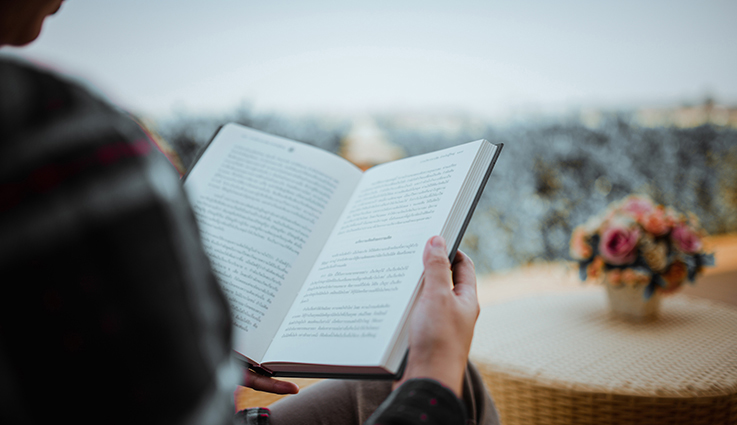
ولهذا يجب على القارئ أن يعي مقدار الجهد، الذي بذله الكاتب، وما تحمّله من مشقة، وما كابده من عَنَةٍ وعسر، حتى يصل المعنى إلى قلبه، واللفظ إلى سمعه. لا يظن أحد أن الأمر سهل على المؤلف، فحال كاتب النص سواء لكتاب أو بحث أو مقال؛ حاله كحال الأم الحامل التي يمر حملها بمراحل، وتعاني منه الوهن والعنت، كذلك المؤلف يمر بمرحلة المخاض والألم، والقارئ المدرك الواعي يشارك في إعادة إنتاج المقروء بأسلوبه، وفكره، وعقله، وفق منظوره وفهمه، وقد يتجاوز ذلك إلى إعادة صياغة بنيته وإظهار إيجابياته، وليس مجرد اجتراره، والوقوف عند محاولة نقده؛ بل عليه أن يتجاوز القراءة السطحية الظاهرية للنص، لأن القراءة الواعية والمتمهّلة والمتبصّرة هي شكل من أشكال الاحترام لصاحبه، فالكلمات المعروضة في النص قبل أن تكتب كانت كلمات منطوقة من قبل فكر وعقل الكاتب. فهو قبل أن يعرضها للمقروئية عرضها على نفسه وعقله، واستنطقها في حدود إدراكه الواعي.
ويفترض ألا يقع القارئ تحت قاعدة النص المحظور، مُمَاثَلَةً لما كان عليه حال بعض النصوص الممنوعة والمحرّمة من القراءة والاطلاع، بل وصل أمرها إلى حد الحرق، والأمثلة كثيرة؛ فكتاب إحياء علوم الدين، وكتب ابن حزم، تم حظرها ثم أحرقت بفتوى الفقهاء، فما الضير من وراء قراءتها ومطالعتها؟ فالفعل ذاته زاد من انتشارها، وإصرار الناس في البحث عنها وقراءتها. وإن عرضنا مثالين؛ أحداهما من المشرق، والثاني من المغرب (الأندلس)، إلا لنؤكد أن الحال واحد.
والكاتب والقارئ يجمعهما عامل مشترك؛ لأنهما يمثلان استثمار فكري بالكامل، لأن الاستثمار فيه سيكون له أثره اللاحق، من حيث تطوير أفكارنا، وتحسين مستوانا، ويكون لكليهما دور ثقافي في المجتمع، ناهيك على تحصيل الشهادات على المستوى الأكاديمي، والأهم من ذلك أن المقروئية تشكل بداية نهضة الأمم. وعليه هناك أكاديميون إنتاجهم العلمي مهلهل، لأنهم لا يقرأون، طبيعتهم في البحوث النقل والإلصاق، بالمقابل قلة من البحوث تجذب الألباب وتلقى الثناء، لأنها لا تُكتب إلا بعد مشقة القراءة وطول بلاء. زد على ما سبق أن الكتابة والقراءة يجمعهما استثمار في وقت الفراغ، وتحقيق المتعة الجمالية.
ويبقى النص المعروض للمقروئية يمثل مجال صدام، ودائرة جدل فكري بين الكاتب والقارئ، وهذا الصراع العقلي هو بداية لتحقيق المنافسة الفكرية لإقرار الأفكار الإيجابية والإبقاء على الأصوب. وبغض النظر عمن سيكون المهيمن، ومجال انتمائهما، فإن هذا التفاعل يقلل من إهمال النص وضعف المقروئية. والقارئ الجاد هو الذي يستنطق النص ليجعله يتكلم بأفكار صاحبه، فينتقل بالقارئ من فيض المتعة إلى مرتبة التحليل العلمي الرصين والتفكير القويم.
إن العلاقة الحتميّة بين المؤلف والقارئ هي علاقة تأثر وتأثير متبادل، مع ميل نحو تأثر أكبر للقارئ بالكاتب، بحكم أنّ القارئ يقرأ ليتفاعل مع النص والمؤلف في آن واحد، بينما يكتب المؤلف ليعبّر عما يراه وما يريد أن يعرضه، قال الكاتب الصحفي الليبي محمد النعّاس (ولد 1991): “إنّ الكاتب ليس بحاجة إلى أن يتأثر بالقارئ، بمدى تأثر الأخير بالكتابة والمنتج الأدبي الذي أصدره المؤلف، أو الطريقة التي دخل بها القارئ مغامرة القراءة، هل هي بداعي الاستكشاف وحب الاطلاع على هذه التجربة، أم دخل بداعي التجارب السابقة؟”، وفي ذات المعنى قال الأديب الكويتي خالد النصر الله (ولد 1987): “في السابق ربما كانت العلاقة بين القارئ والمؤلف منفصلة ولا يوجد محطات تلاقٍ كثيرة، ولكن اليوم تغيّر الحال، فالكاتب يطلب من القارئ التفاعل، وعلى الكاتب مقابل ذلك أن يتقبّل هذا التفاعل مهما كان نوعه، وألّا يخشى ردة فعل القارئ، فهي في النهاية تغذية راجعة قد تقدّم الفائدة للكاتب من حيث يعلم أو لا يعلم، المهم أن يكتب المؤلف بصدق لأنّ مهمته تنتهي عندها، ويبدأ دور القارئ في التلقي”. وأضاف: “إن النصّ الذي يستفزّ القارئ هو ذاته النصّ الذي يستفز الكاتب، مع أنّ القارئ متعدد المزاجيات ويصعب اصطياده أو تحديد هدف معيّن لاستفزازه به، ولذلك نؤكّد أن أهم عناصر تميز الكاتب يكمن في الصدق”. وعلى القارئ أن يقرأ ويفهم ويتفاعل ثم يحكم، أو كما عبّر الكاتب والأديب المصري توفيق الحكيم (1898-1987): “أريد من قارئي أن يكون مكملًا لي، لا مؤمنًا بي.”
ومع ذلك تبقى العلاقة بينهما علاقة ثنائية معقدة تحكمها عدة عوامل، أهمهما طبيعة النص من حيث المحتوى والمستوى والارتقاء، ويقابلها بالمقابل موقف القارئ من النص؛ فهل يجيب على تساؤلاته ويحقق اهتماماته؟ ثم درجة وعي القارئ لما يقرأ، فهل النص يرقى إلى مستواه أم هو دونه، أم أن النص معقد البنية والبيان؟ وبالتالي فهو لا يجيد التعامل معه، فلا مندوحة عنده من قراءته؟
إن جدلية النص والقارئ تظل قائمة رغم ما يواجه المقروئية من تحديات تكنولوجيا جديدة، تغيّب النص من عن المقروئية والمتابعة والنقد. وعليه يبقى القارئ هو الأصل في هذه العلاقة الجدلية، فلا مكانة للنص المعروض ولا قيمة له دون قارئ متفاعل، مهما بلغت قيمته البحثية؛ العلمية والبنيوية، ولن يستمر صاحب النص في الإبداع دون حضور وتفاعل القارئ الجاد والمدرك. فربما ملاحظات القارئ وتفاعلاته ونقده للنص قدمت إضافات وتصويبات، وهذا الذي تقرره نظرة الناقد والمنظر الألماني هانس روبرت (1921-1997)، كيف أن القارئ يمكن أن يؤثر في معنى النص، وبالتالي فإن النص يصبح مساحة حوار بين الكاتب والقارئ بدلًا من أن يكون مجرد عرض لأفكار الكاتب، ويُعيد القارئ تشكيل النص وفقًا لتجاربه ومعارفه، مما يؤدى إلى نتائج جديدة مع كل قراءة مختلفة.
وتعد القراءة عملية ديناميكية تتجاوز فهم الكلمات في النص، فهي تُعتبر عملية تكوين المعاني التي تعتمد على خلفية القارئ الثقافية وتجربته الحياتية ومهاراته النقدية. ووفقًا لأفكار روبرت، فإن القراءة ليست مجرد استجابة سلبية للنص؛ بل هي ذلك التفاعل النشط الذي يسهم فيه القارئ في تشكيل المعنى. ويبقى النص الجديد والمعروض للقارئ كالوليد الجديد بين يدي أمه تقلبه وتفتّشه لينمو ويكبر.
ومن أبرز مفاهيم المؤلف والناقد الفرنسي رولان بارت (1915-1980) هو مفهوم “موت المؤلف”، الذي تم تقديمه في مقاله سنة 1967، وفيه يشير إلى أن النص يجب أن يُفهم بشكل مستقل عن نيات كاتبه، وبحسب نظريته، فيجب على القارئ أن يكون محور الفهم، حيث إن كل قارئ يُدخل تجاربه ووجهات نظره الخاصة في تفسير النص، مما يجعله شريكًا في عملية إنتاج المعنى.
إن ضعف المقروئية، وغياب نقد النص يحكم على الكاتب بالإعدام والموت البطيء، فلا مناص أن يفكر الكاتب فيما يكتب وكيف يكتب فهو عرضة للنقد حتى وإن أجاد، فما بالك إن مال وحاد.
المراجع:
– عيد محمد شبايك: “العلاقة بين فعلي الكتابة والقراءة”، الألوكة، 28/2/2011م – 25/3/1432 هـ.
– حبيب مؤنسي: القراءة والحداثة: مقاربة الكائن والممكن في القراءة العربية، (دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، مكتبة الأسد، 2000).
– عبدالقاهر الجرجاني: أسرار البلاغة في علم البيان، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1988).
– عيد محمد شبايك: “العلاقة بين فعلي الكتابة والقراءة”، الألوكة، 28/2/2011م – 25/3/1432 هـ.
– “روائيون: الصدق والموضوعيّة عناصر تُحدّد شكل الحوار بين الكاتب والقارئ الشارقة”، صحيفة البيان، (7/11/2022).
– منال رضوان: “بين ياوس ورولان بارت مقاربة نقدية لدور القارئ في النصوص الأدبية”، جريدة المصري اليوم، (06-11-2024).
عدد التحميلات: 4