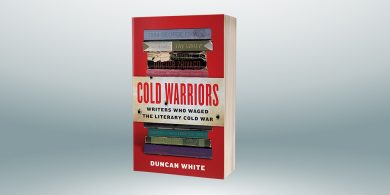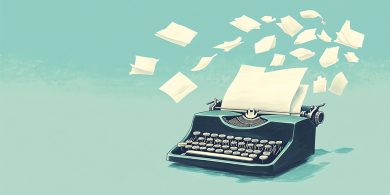فن الجداريات: من الهوية إلى توالد الهويات
يستدعي هذا البحث فنّ الغرافيتش بعد غياب عن المتن الفلسفي لم تبرّر دواعيه، يستدعيه ليستكمل معه المعنى ويرصد مواطئ الجماليّة التي ظلّ الإنسان في حاجة إليها لمواجهة طغيان التقنية الحديثة. يستوجب استكمال الجماليّة الانتقال من بدْء إلى بدْء يمتدّ فيه الفهم من الصمت إلى التكلّم دون أن يتيه في شواردها، ففي الذات تتوطّن الجماليّة وفي الفنّ تودع حتّى وإن لم يكن العمل الفنّي موضوعها ومطلبها.
الكلمات المفتاحيّة: (التكلم، التحرر، الافتراضية، الأيديولوجيا)
المقدّمة:
يطرح موضوع الخربشة استشكالًا فلسفيًّا لم يفكّر فيه كسؤال جذريّ لسؤال مضامين الفعل في الأشياء، بعد أن وقفت التقنية أمام تجاهل المصير وتجلّت كسدّ حصين يُبيد المقاصد ويطعن في أسس الوعي. وحتّى وإن أعادت السؤال فيه، فإنّه يكون من جهة النفْع، بما يكشف أنّ أزمة الفكر الإنساني لا تتعيّن في نسيان الموضوعات المصيريّة وإنّما تتعيّن في أساليب طرحها وطريقة معالجتها. كان لاستعمال الغرافيتش في الجانب النفعي الشبح المُفزع الذي ضاعف من الهاوية بين الإنسان والتحرّر وظلّ الحدث الأساسي الأكثر جدارة بالسؤال، إذ: ما علاقتنا بالغرافيتش؟ هل لتمرّد النفوس تمثّلات للهويّة أم تماثل في الهويّات؟ كيف يُمكن أن نفكّر في خطاب الخربشة حتّى نكتشف أعمق ما فيه؟
1- الغرافيتا القلقة:
تمنح الهويّة للغرافيتش فهما أساسيّا تحت تأثير نداء المخزون الثقافي والتمثّلي لمعياريّة الفعل توافقًا والإرادة خارقة، قصد تمثّل ما يمكن السيطرة عليه واستخدامه لغرض الفهم. فكّر ديكارت من داخل هذا المرسم وفرض قطيعة بين الذات والعالم واتّجه بإرادة غازية إلى فرض نظام عقلاني داخل نظام مسطّر سابقًا، يستخدم العقل الطبيعي تحت اليد، تنبيها لأن يكون الإنسان سيّدًا ومالكًا للطبيعة وتفعيلًا له نحو بداية الإبداعات الانسانيّة بعد اكتمال رهاناتها أو منحها للإرادة الإلهية، تماثلًا وانسجامًا مع الأفكار الفطريّة كمقام للحقيقة. سكن الإنسان مضاءة الجماليّة، إلى درجة أصبحت إبداعاته – والتي سنّها قصدا للتغلّب على عوائق قرارًا لاختراق ما لا يحدّ من الثقافات دون التورّط في شقّ الطرق أو تعبيدها. بذلك، تتعمّق الهاوية التي يستحيل تخطّيها بما ينتزع من الذات القُدرة على الانتماء «ويقتلع نداء المبدأ الكلّي من الأرض التي كان مشدودًا إليها» ويبعث على الانزعاج من هوس غياب الطريق الذي يمنح الإنسان سلامًا عالميًّا ويعجّل بانكشاف مقام الحرّية، وإلاّ سيظلّ الوجود مقفرًا ويتحوّل داخل هذا المقام إلى معضلة يصعب التفكير فيها.
بين تعرّج الثنايا في دروب الهويّة المستقبليّة وما لا تعرفه عن ذاتها، يسلك فرويد في كتابه (كرب الحضارة) دروبًا بلا أمكنة راسخة، أفاضت بطريقة تحليليّة فهم ما بين الوعي واللاّوعي من تعاد منذ أن نُسيت مقاصد الأفعال. تعِد هذه الدعوة لإيقاظ المقاصد، بالنظر لفنّ الجداريّات وتقنيته المبدعة كفعاليّة عليا لإنسانيّة مترحّلة بأدائيّتها وضدًّا على تلقائيّة وعيها أو بديلًا تحريفيًّا لعقلانيّتها، لغرض المسك بالجنون وزحزحة الأصل عن ثوابتها والتمّرد على حدودها الواعية.
ليس في القول بالهويّة هنا ما يفيد تميّز الانسانيّة عن أخريّتها أو يستحضر طفولة وعيها كما تصوّر ذلك ألان، وإنّما فيها أبعادًا دقيقة ومختفية تتّجه إلى سدم الوعي وتعرية اللاوعي كمعرّف أخر يضاف بالمساحات المجهولة التي يقرّ الحكيم الصادق مع نفسه أنّه لا يعرفها ما دام الحقّ في التعبير لا يزال مجازيًا في كلّ مستوياته. قد يكون عصر التمثّل هو العصر الأعمق فهمًا لعنصر الجماليّة حين حاول أن يقنعنا بتعبيرّيّة القبيح واعتبره أدورنو كشرط أساسي لإمكان قول الجميل في كتابه (في القبيح والجميل وفي التقنية نظريّة جماليّة). إنّ العودة لهذا الكتاب من أجل إضاءة مفهوم القبح، لا يعني تباعده عمّا يناظره من تأكيد للذات، لأنّه منه كان ومن دونه لا يكون، وإذا كانت الخربشة تّتسم بالبساطة وسرعة التنفيذ، فإنّ هذه السمة لا تعود إلى خصوبة وعي وتفوّقه وإنّما تستحضر في جانب خفيّ منها لا وعي مترسّب يريد لنفسه أن يخرج ويعبّر بلغة تفتّح الحياة وليس بلغة العنف أو الهدم.
يجد هذا التوجّه منبته بالأساس في فنّ الغرافيتش والذي ظلّ الإبصار فيه يُغْني عن الأدلّة المنطقيّة في إظهار عناصره الجماليّة، فحتّى النظر لهذه الأثار لم يكن متأسّسًا تأسيسًا يمسّ ماهيتها وإلاّ لما أمكن لأحد أن يرفعها إلى الفهم أو الترجمة. يرفع فرويد الحقيقة من مضمونها التقليدي إلى أصلها السيكولوجي، بوصفها ما يسمح برؤية ما احتجب. يفهم هذا الرفع بمعنى مصارعة الاختفاء والبحث عن إمكانات استدعائه ورصد بواطنه، حتّى وإن كان الأمر عسيرًا.
يتحوّل تعرية المتخفّي هذا، إلى نصّ ثريّ لعمل فلسفي جديد يمتدّ نحو إعادة فهم هذا الفاعل المتغاير مع نفسه باستمرار منذ أن تأكّدت النقلة النوعيّة مع فرويد من الوضع الهووي البدئي إلى وضع الهويّات المتغايرة والمؤثّرة على الفعل، ذلك أنّه بين الخربشة والعبارة تواشج، فكلاهما لبعضهما البعض ولا يختلفان إلاّ في التسمية، بعد أن تغيّر الفاعل..
تدوم الهويّة الفاعلة في الاختفاء وينتشر حديث الهويّات في أعمال الخربشة المرشّحة للنبذ أو الطرد، بعد أن توسم خواصها بالسلبيّة، ذلك أنّ المقصود بتوالد الهويّات إنّما هو قناع يخفي معركة التمييز والترحّل ما بين الوعي واللاوعي بعد أن حكم ما بين هويّتهما بالأنوار كترميز لتفاضله النهائي، ضمن تكثّر الهووي الإنساني. يعترف فرويد في تحاليله النفسيّة بأهميّة هذا الهووي الإنساني الجديد كما لو كان متجسّدًا كغيره من الهويّات، والدليل على ذلك أنّ تاريخ الطفولة غنيّ بصيغ التعامل مع الهويّة المضادّة للوعي باعتباره كامن ويطوق للتحدّث، حتّى ولو مارس فعل الاختلاس كما أتاه الفنان مارسال دي شامب لمّا سمح لنفسه مجاوزة المؤسسة الفنية القائمة واستولى على لوحة الموناليزا ليضيف إليها الشوارب.
يأخذ مفهوم اللاوعي في المتن الفرويدي معنى في أعمال العُصابيّين دون أن يحدّد نمطًا معيّنًا من التفكير، بما يسمح بالتحرّك داخل وحدة أسمى هي البحث عن المعنى والذي يتّجه لمقام عناصر دلالاته الواهبة معان للذوات والمسطّرة لخرائطهم وحدودهم، ففي حدودهم المجسّمة، يتحدّد المعنى الذي يختفي وراء النبش. نزع فرويد إلى الانفتاح على معبر التأويل للعبور إلى فكر مخفيّ دون السقوط في هاوية الذاتي وسلطة المراوغات التي تسم أعمال مرضاه. تلك هي رسالة الحفر في أنماط الرسوم بعد أن ظلّت تجيب عن تردّدات معكوسيّتها النشطة بأشكال متعدّدة.
2- من فائض اللاوعي إلى مبدأ الأداء:
يضرب الفنّان الخربشي علاقة حميميّة بين الغرافيتش والفكر في لغة مخصوصة بالصمت، وهي لغة لا تدرك معانيها إلاّ في جواهر أخرى بعد أن أفاض القمع طاقة إحيائيّة سمحت بظهور الحضارة أو ما يسميه ماركيز بمبدأ الأداء، الذي يعمل على سحب الطاقة من موضع الجسد الثائر وتحويلها إلى الأعضاء التناسليّة، ممّا يسمح للجسد أن يفعل دون متطلّبات للذائذ حتّى يُستخدم في الإنتاج.
ليست الفجوة بين العمل الغرافيتي ومبدأ الأداء هذا، فراغًا وعبثًا يُنجزه الواقع، وإنّما هو تخفّ يُثبت أنّ الفكر مهما أبدع، فإنّه يظلّ يحتاج إلى ضرب من ضروب الغيّريّة التي تسمح باستمرار الحضارة في ذاتها، وهو ما يصبغ أعمال الخربشة بوعي البعد الجسدي وأثره على السلوك والتصرّفات. يحتّم هذا المبدأ انتفاء الحاجة لأيّ شكل من أشكال البؤس الزائد وإفراغ الذات من عمليّات الإبداع، بعد أن تحوّلت أجساد البشر إلى مناطق وأعضاء للذائذ جديدة بدلًا من الألم.
هكذا يخلط الغرافيتي في قاموسه بين اللاوعي والأداء، ويتخوّف من سقوط أعماله في الابتذال والغرق في العادة اليوميّة، التي تساهم في تفقير النظر إليه، فيسعى إلى موضعة نفسه ضمن المسار السائد، أي ذاك المسار الذي يفترض وجود تبادل لا متوقّف بين الجسدي والواقعي، ويعود بالفكر الثائر إلى موقف الإنكار لما تصنعه له الذاتيّة، محوّلًا كلّ إبداع إلى أعمال مألوفة تحلّ الغضب الفائر.
توالد الهويّات وأمريّة الغرافيتي:
حين تلغى مسافة المفارقة بين الإبداع والاستسلام، يصبح الواقع السائد هو المرجعيّة الأولى سعيًا لتوطّنه وتوقًا في تخطّي الألم والبؤس إلى اتيقا الفرح الدائم. تلك هي سمة الهويّة بلا رؤوس والمنبثقة من الثقافة العالميّة، التي لا ترى في تشافي النفس إلاّ معيارًا لسعادتها الساديّة. على هذا الأساس، يطلق فرويد بتأويليّته المفرطة القطب المضاد لأعمال مرضاه، بإعلان حاكميّة الجنسي وحده على أساس تأهيلهم وإعادة تصالحهم والواقع، كما لو أنّ المصالحة لا تأتي إلاّ كمرحلة لا حقة لمنعطف هووي تمّت هندسته في حدود االبرونوغرافيا أو الجماع التفاعلي كما رأى ذلك بودريار لمّا تعرّش لنقد قيم الكوني.
يحمل هذ المنعطف الواقعي الجديد الفنّان نحو دهاليز الصمت، بعد أن تُجرّد أعماله من معانيها وتُفرغ من كلّ دلالة ابتداء من ما يزيد من التماسف بين المادّة والفنّان، فيتموضع المعنى ويسلبه على سبيل الاختفاء، لاعتبار أنّ الجماليّة لا تأتي إلاّ من خلال الخضوع لسلطة العقلانيّة، والاعتراف بخصوصيّتها. ما يعني أنّ الغرافيتي الحقيقي، هو من يتغلّب على إحباطات الآمال المغدورة ويتجنّح بأهواء السلطة حتّى يُعيد التكلّم طبقا لكلّ مفصل من تطوّرات الثقافة الجديدة. تلك هي الصفة التعيسة لفنّ الجداريّات، والتي بموجبه سارت الهويّة العالميّة المنتصرة بخيارات الحداثة، نحو البحث عن طريق أخر وترويجه تحت عناوين نظاميّة ونهائيّة، لأجل الاتصال بالإنسانيّة الملطّخة بالميديا السمعيّة والبصريّة. يمتزج الفن واللاوعي وتتقاطع الرموز ورغبات السياسي في الفكر كما يفضحه ريجيس دي بري، لتصير الخربشة علّة فاعلة للمجون وتنسج ضفيرة الفضاء العمومي والفردي، فتنزوي به في غرف الإتّجار وقصور الاستهلاك حتّى تروّج منتوجها من وراء دفق وسائلها المخصوصة كبخّاخ الرسوم وأقلام الإمضاء التي راحت تتخصّص فيها شركات الإتّجار كشركة مونتانا الألمانيّة التي تمتلك تقنيات واسعة من بخاخات قولد وبلاتينيوم وبلاك. هكذا، عندما تتدخّل الثقافة الموهومة في أعمال الغرافيتي، فإنّ الفنّان في نظرهم هو من يمتثل لأوامرهم ويتسلّح بأدواتهم ليتذوّق الملذّات التي يبيحونها، بذلك، يضحى الفنّ تجربة هويّات لا هويّة، ولكن هل يعني ذلك أنّ اللاوعي قد أطرد شبح التمرّد؟
على سبيل الخاتمة:
يتحوّل الغرافيتش إلى عمل فنّي يتطلّب التأويل ليكشف عن مقام وجود، يحمل الصمت فيه استعدادات فنيّة يشكّلها اللاوعي ويبحث لها عن جواهر لجماليّة بديلة. فما ينبع من الهويّة، غير ما نفهمه في محاولات المتون الديكارتيّة أو فلسفة الذات. افتتح فرويد شغف الذات المتطلّعة للإشباع، لكنّها بقيت فاعلة في سيكولوجاه مع أخر وجوه السعي نحو مطالبها. صار الغرافيتي منذ البدايات حاملًا لمعناه في جوفه واتّجه يبحث لنفسه عن سكن بين الصمت والتكلّم تحت صدمة فقدان اللغة المخصوصة التي يمكن أن تنفرد بقول المسكوت عنه. وتحت عدم التعيّن في اللّغة ورموزها هذه، فإنّ الرائي هو وحده من يكون مخصوصًا بعمق هذا الصمت في احتجابه وانكشافه، بذلك يلتقي الرائي والمرئي على أرض التحرّر والإبداع لأجل حدوث الحقيقة وتحققّها مقامًا في الوجود، لِما قد يمّكنه من التحكّم في التاريخ وممارسة التفكير الذي يُغْني لحظة العبور من ضفّة الخربشة إلى ضفّة الجماليّة والتي نحتاجها أكثر من أي زمن مضى. إذ، ليس العبور من بدِء إلى أخر هيّنا إلاّ على العابرين، أصحاب إرادات الاقتدار للقفز على ملذّات الواقع نحو فجوة تكون مقامًا للقدّيسين، لذلك علينا أن نُهيّئ لهم أسباب المجيء وعوامل العبور إلى ضفّة تُحدث من فجوتها التحرّر والانعتاق.
الهوامش:
1 – نذكّر في هذا المقام بكتاب مقالة الطريقة التي يعلن ديكارت في طيّاته بنيّته نحو إعادة التحكّم في الطبيعة وجعل الإنسان سيّدا ومالكا لها.
2 – Heidegger, Le principe de la raison, traduit par A. Préau, Gallimard 1962, p 56.
عصر التمثّل، يتمّ فهمه في هذا السياق على أساس الفترة الزمانيّة التي يتمّ فيها التعبير عن الأشياء أو الأفكار أو الأحداث بشكل تمثيلي أو رمزي كوسيلة لفهم العالم.
في هذا السياق يتّجه فرويد نحو فهم وتفسير أعمال مرضاه من أجل الكشف عن مكامن اللاوعي وتبيّن زيف الوعي.
ارسيل دي شامب (1887- 1968)، فنّان فرنسي تحدّى الفكر التقليدي وحوّل العمليّة الفنية وسوّقها عبر أفعال هدّامة، شُهر من خلال قيامه بعمل فنّي لمبولة وأسماه النافورة. أنتج دو شامب أعمالًا فنّية قليلة نسبيًّا واعتبر أنّه ليس بإمكان الفنّان أن يؤدّي العمل المبتكر وحده، بل أنّ المشاهد هو من يجلب العمل من خلال الاحتكاك بالعالم الخارجي عن طريق فكّ رموز وتفسير مؤهّلاته الداخليّة..
مبدأ الأداء، وهو مبدأ كان قد تحدّث عنه ماركيز بالأساس في كتابه إيروس الحضارة، أين تقوم الحضارة الرأسماليّة بإفراغ الجسد من مطالبه اللذويّة لأجل استخدامه في الإنتاج.
المصادر والمراجع:
– البسيوني محمود، أسس التربية الفنيّة، عالم الكتاب، القاهرة
– عبيد كلود، نقد الإبداع وإبداع النقد، دار الفكر اللبناني، بيروت، 2005
– Stranger R, 1974, Psychology of personality, New York, M.C. Grow hill, fourth edition.
دراسات ونشريّات:
– حداد زياد، «الفن الغرافيتي والمؤسسة الفنية»، مجلة أبحاث اليرموك، سلسلة العلوم الانسانيّة والاجتماعيّة، 1997
– إلينا أرونتس، «الجرافيتي أثناء الأزمات»، ترجمة محمد الجوهري، 23 أوت 2012.
– مها مزيد، «فنّ الشارع كمثير لتنمية السلوك الجمالي في المجتمع»، مجلة بحوث، كلية التربية الفنيّة، جامعة حلوان، مصر 2008
-العبيدي جبار محمود حسن، «إشكالية القيمة والمعيار الجمالي في النحت المعاصر»، رسالة دكتوراه غير منشورة كلية الفنون الجميلة، جامعة بغداد 1993
عدد التحميلات: 0