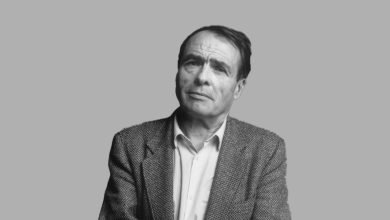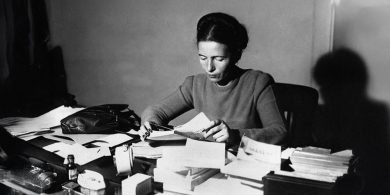سوكي كيم Suki Kim
أنا الكاتبة الوحيدة، على حدّ علمي، التي عاشت متخفية في كوريا الشمالية. في عام 2011، قمت برحلتي الخامسة إلى بيونغ يانغ، تحت ستار ومدرسة للغة الإنجليزية كلغة ثانية، عشت لمدة ستة أشهر مع 270 من الذكور الكوريين الشماليين في مجمع عسكري. بالنسبة لهذا الفعل، غالبًا ما يوصف بأنني “شجاعة”. الناس ينادونني بالشجاعة. لكن حتى لو بدا الأمر غير منطقي، فأنا أعتبر نفسي شخصًا خائفًا للغاية. أكثر من ذلك، أعتقد أن خوفي هو الطريقة الوحيدة التي يمكنني من خلالها البدء في شرح وقتي متخفيًا في أمة غولاغ.
ربما تكون كوريا الشمالية هي المكان الأكثر ظُلمة في العالم. البلاد تفتقر إلى الكهرباء. كل شيء رمادي ورتيبة، والضوء الوحيد هو الذي يُعطى للقائد العظيم، شخصية سلطوية شبيهة بالآلهة، يتحكم بها الآن كيم جونغ أون البالغ من العمر 33 عامًا للجيل الثالث، والذي يعتبر الشمس، على الرغم من أن تلك الشمس لا تنضح بالدفء لشعبها. لا توجد دولة معاصرة أخرى خالية تمامًا من الضوء.
لطالما كنت أخاف من الظلام. نادرًا ما أحلم، وكنت أمشي أثناء نومي عندما كنت طفلاً هربًا من سواد كوني نائمة. حتى الآن، لا يمكنني إطفاء الضوء في الليل. هذه عادة كئيبة لأن الضوء الاصطناعي مدمر للغاية لدرجة أنني لا أنام جيدًا أبدًا. لكن خوفي من الظلام يغلبني.
الصباح لا يجلب الراحة. غالبًا ما أستيقظ بشعور غارق، ثم أقضي ساعات مبكرة عديدة في التحديق في رسائل البريد الإلكتروني غير المفتوحة بفزع، لقد كنت أتجنب حتى رسائل البريد الإلكتروني حول هذا المقال، الذي كنت أخشى أن أبدأ به منذ أسابيع. لقد قمت بتعطيل تطبيق التقويم على هاتفي حتى لا يتم تذكير بالموعد النهائي الذي يقترب. اضطررت مؤخرًا إلى السفر من نيويورك إلى سيول، وأصبحت أسباب تلك الرحلة ثانوية بالنسبة للرحلة نفسها، والتي اقترحت لي ملجأ لمدة 14 ساعة عندما لا يتمكن أحد من الوصول إلي أو يتوقع مني الرد بالمثل.
أختبر العالم، أي كخريطة للمخاوف من الإبحار، تنسق إحداثيات كل الأجزاء المحطمة التي تأتي بسرعات غير متساوية. ظل هذا الشعور يلاحقني بقدر ما أتذكر، وتعمل الخريطة كعقدة تزداد تشابكًا بداخلي كل يوم. أجزاء منه – أصعب الطرق لفهمها – كانت موجودة منذ فترة طويلة على ما أستطيع تذكره. يؤدي أحد هذه المسارات إلى كوريا الشمالية، والتي غالبًا ما تبدو لي تلك الليلة المظلمة التي عشت منها طوال حياتي.
انفصلت عائلتي بسبب الحرب الكورية، ولدت وترعرعت في كوريا الجنوبية. عندما كنت في الثانية عشرة من عمري، أفلس والدي، الذي كان مليونيرًا، فجأة. في منتصف الليل، استيقظت ودُفعت إلى سيارة وتم نقلي إلى مدينة بعيدة، إلى منزل أحد أقاربي، حيث انتظرت أن ينضم إلي والداي. لأن الإفلاس يعاقب عليه بالسجن، فقد اختبأ والداي. كنت طفلة ولم أفهم، لذلك انتظرت، كل يوم أتوقع عودتهم. لكنني لم أراهم مرة أخرى إلا بعد عام، في مطار جون إف كينيدي، في نيويورك، بعد أن فرت عائلتنا من كوريا.
كما هو متوقع، لا أتذكر الكثير من تلك السنة من الانتظار؛ بقي ذلك الوقت في ذهني كظلام أجوف أحسست منه فقط بالعطش، ذلك النوع الضخم الذي لا قاع له والذي لا يمكن إخماده. لم يهدأ الظلام حتى عندما هاجرت إلى أمريكا والتقيت بوالدي، المفلسين الآن. لم أتحدث كلمة واحدة باللغة الإنجليزية. كل ما أعرفه اختفى في لحظة واحدة، وأعتقد أنني علقت في الزاوية الغامضة حيث كنت أختبئ عندما كنت فتاة في الثانية عشرة من العمر.
ربما بسبب كل هذا، كنت أجيد الانتظار. يمكنني الانتظار لأيام وسنوات، خلال المطر والعواصف – حتى في الظلام – وبالكاد أطرح الأسئلة. في مكان ما في أعماق ذهني، يجب أن أتخيل أنه إذا كنت هادئةً جيدًا، فسيعود والداي. كان بإمكاني أن أجعل، على ما أعتقد، زوجة صالحة لرجل محافظ للغاية. لكن بدلاً من ذلك أصبحت كاتبةً باللغة الإنجليزية على الرغم من، أو ربما بسبب، حقيقة أن اللغة الإنجليزية، التي اعتمدتها عندما كنت مراهقة، كانت طريقًا آخر على خارطة الخوف لدي.
بينما أكتب هذا، تذكرت بئر بالقرب من منزل طفولتي. كانت بئرًا أسطوانية عميقة قديمة الطراز مصنوعة من الحجر، وكان أطفال الحي يلعبون حولها، يرمون الأشياء ويصرخون في قبوها لسماع صدى الصوت. كنت دائمًا أخاف ولم أقترب منها أبدًا. في وقت لاحق من حياتي، أصبحت مهتمة لفترة وجيزة بعمل هاروكي موراكامي لأنه استمر في استخدام الآبار كرموز في رواياته. لكن في النهاية مللت من قراءته. أدركت أن ما كان يطاردني لم يكن كتابات موراكامي، بل بئر طفولتي. كان شغفي بعمله مجرد الجانب الآخر لخوف أقوى.
قد يبدو مدى ارتباط كل هذا بكوريا الشمالية، كما أدرك، مجرد فكرة مجردة. لا أستطيع أن أقول أنه يقدم تفسيرًا مباشرًا. ربما سافرت إلى أحلك مكان على وجه الأرض لأنني تعاطفت مع مواطنيها العالقين في ذلك الظلام ولا يمكنهم الخروج. ربما أصبح صمتهم لي يذكرني بنفسي. أو من الممكن أن تكون كوريا الشمالية، بطريقة أثيرية، قد أصبحت نوعًا من أحلك الليل، أطول انتظار، البئر منذ طفولتي.
تابعت تغطية البلاد طوال عقد من الزمان، وكل خطوة على الطريق كدت أن أصاب بالشلل من الخوف. لم أكن أحد هؤلاء المراسلين الأجانب الجريئين الذين قفزوا إلى مناطق الحرب، ولم يكن لدي فريق من المحررين والمنسقين والمصورين الذين يعملون جنبًا إلى جنب للمساعدة في اكتشاف الخدمات اللوجستية وترتيب النسخ الاحتياطية الاحترازية. على الرغم من أنني وقعت عقد كتاب قبل عام 2011 بفترة طويلة – عندما دخلت أخيرًا في بيونغ يانغ لتلك الأشهر الستة – كان عقدي الهزيل مجرد قطعة من الورق بموعد نهائي غامض، ولم يكن أبدًا شبكة دعم يمكنني الاعتماد عليها للحماية. في بيونغ يانغ كان يراقبني على مدار الساعة الحراس الذين يعيشون تحتي مباشرة في عنبر للنوم تحت مراقبة كاملة. تم تسجيل فصولي والإبلاغ عنها، واضطررت إلى الحصول على إذن لكل درس من الموظفين الكوريين الشماليين. لقد قمت بحفظ ملاحظاتي على أقراص USB، والتي احتفظت بها على جسدي في جميع الأوقات. لقد حرصت على حذف آثاري من الكمبيوتر المحمول الخاص بي في كل مرة أقوم فيها بتسجيل الخروج. لقد قمت بحفظ نسخة احتياطية على بطاقة SD، والتي قمت بإخفائها في أماكن مختلفة في الغرفة، مع إطفاء الضوء دائمًا. لقد أنشأت مستندًا داخل مستند، وأدفن الملاحظات في منتصف ما يشبه مادة درس الفصل. كنت بمفردي تمامًا ولم أكن أعرف أي شخص يمكن أن يأتي لإنقاذي إذا تم القبض علي مع أربعمائة صفحة من الملاحظات التي قمت بتدوينها سرًا. كان السيناريو الأكثر احتمالاً هو أنني سأختفي في ذلك الظلام المجهول المجهول.
كوريا الشمالية هي الدولة الأكثر صعوبة في الوصول إليها في العالم، وقد ارتكب نظامها انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع، وفقًا للأمم المتحدة، “لا مثيل له في العالم المعاصر”. إنه مجتمع مبني بالكامل على المخاوف. لقد تلاعب ديكتاتوريتها واستغلوا نقاط الضعف البشرية لدمجها في نظامها للسيطرة وسوء المعاملة. لا يستطيع مواطنوها مغادرة البلاد وحركتهم داخلها مقيدة. المعلومات خاضعة للرقابة، وكل تفاعل يتم مراقبته. التعليم يدور فقط حول عبادة القائد العظيم، وكذلك الإعلام، ويتم التعامل مع المواطنين كعبيد وجنود لدعم الأسطورة. أولئك الذين يدخلون حدودها دون إذن أو الذين يرتكبون أفعالًا محظورة من قبل النظام – حتى لو كان شيئًا يبدو غير ضار مثل تمزيق ملصق زعيمهم العظيم – يمكن أن يواجهوا أحكامًا تصل إلى أكثر من عقد من الأشغال الشاقة. يعاقب النظام على الإعدام العلني، وهو معروف أيضًا بخطف الأجانب. لن يتسلل أي شخص لديه أي شعور بالحفاظ على نفسه إلى كوريا الشمالية لكتابة كتاب.
هذا يقود الناس إلى الوطن في الولايات المتحدة، أو في كوريا الجنوبية أو أوروبا، حيث سافرت في السنوات الأخيرة لإلقاء محاضرات – نفس الأشخاص الذين يحبون مناداتي بالشجاعة والشجاعة – لطرح الأسئلة التي لا مفر منها: أنا خائفة؟ ولماذا ذهبت؟
هذه الأسئلة دائمًا توقفني. ربما يكون من غريزة الإنسان الطبيعية البحث عن دافع منطقي وأنيق لأي قصة تبدو مذهلة. غالبًا ما يرغب القراء في التعرف على الراوي وأسباب أفعالها، أو ربما يريدون فقط أن يطمئنوا إلى أن مؤلف القصة لم يغيب عن عقلها. قبل بضع سنوات، عندما نشرت روايتي الأولى، كان هناك قراء بدا أنهم يتعاملون مع الأمر بإهانة شخصية من كون القصة مفتوحة النهاية. حتى أن القليل منهم أخبرني أنه يجب أن أكتب تكملة لإعادة النهاية بنهاية مناسبة.
ومع ذلك، فإن هذه الغريزة تهزم نفسها؛ لا توجد قصة حقيقية تستحق وقت أي شخص يتم تشغيلها وفقًا لنمط يمكن التنبؤ به. غالبًا ما يتم اختلاق المؤامرات المقبولة. من الممكن تمامًا أن تكون خائفًا وغير خائف في الوقت نفسه، على الرغم من أن هذه الفكرة نادرًا ما يُسمح بها. مثل هذا الخط غير الواضح يذكرنا بمدى محدودية السيطرة على ظروفنا؛ فرياضيات الخوف هذه لا تترك مثل هذه المنطقة الرمادية. في محاولتنا أن نكون راضين عن قوس القصة، نود أن نقتصر على سرد أحادي البعد لبطل يحارب الشر، على الرغم من أننا نعلم أن الحياة دائمًا ما تكون في مكان ما بينهما.
أحد الأسئلة الأكثر تكرارًا التي أطرحها على كوريا الشمالية هو ما إذا كان الناس هناك “يتعرضون لغسيل أدمغة تحت قيادة قائدهم العظيم.” يبدو لي هذا السؤال متعصبًا بشدة؛ المواطنين لا يوجد روبوتات مبسطة. قد يؤمنون ولا يصدقون كلهم مرة واحدة. طلابي الكوريون الشماليون سيقسمون، في انسجام تام، ضد أمريكا الإمبريالية وكوريا الجنوبية الدمية لها كأعداء رئيسيين ويقولون إنه إذا اندلعت حرب، فإنهم سيقتلون أعدائهم دون تردد. لكن عندما سألتهم، “وماذا عني؟ أنا كورية جنوبية وأمريكية على حد سواء، “بدوا محرجين وضحكوا بخجل، ويتمتمون،” لكنك معلمتنا. أنت مختلفة.”
أليست هذه هي المفارقة التي يعمل بها العقل البشري؟ هناك مكان في كياننا يسمح بالاعتقاد المتزامن في شيء ما مع العلم أنه ليس صحيحًا – أو للتحدث بهدوء مع الطلاب في الفصل الدراسي بينما نشعر بالرعب المطلق بشأن عواقب اكتشاف السلطات له. أعتقد أنه نوع من البقعة العمياء.
على الرغم من الاختلافات في الظروف في أمريكا، فقد رأينا الكثير من الأمثلة على النقطة العمياء التي تعمل خلال الدورة الانتخابية الأخيرة. يبدو أن قطاعًا هائلاً من السكان أصبح مقتنعًا بأن الرجل العقاري الذي لعب دور زعيم يطرد الأشخاص لمدة أحد عشر عامًا في برنامج تلفزيوني واقعي شهير كان مؤهلاً بشكل فريد لقيادة الأمة. حتى في هذا البلد، حيث يبدو أن مكانة المشاهير تملي الضمير العام، لا يمكن أن يخلط الناس بين لعب الرئيس على التلفزيون وبين أن يكون لهم أي علاقة بكونهم الرئيس الفعلي للأمة – ولكن ربما كان هذا هو الراحة في العادة التي يتم تلقينها.. إنها قطعة من علم النفس الأمريكي سمحت للمزاح عن القائد العظيم أن يكون معيارنا الثقافي. أفلام مثل الرسوم المتحركة (فريق أمريكا: الشرطة العالمية) Team America: World Police والكوميديا (المقابلة) The Interview هي من بين النقاط المرجعية الأكثر شعبية لكوريا الشمالية؛ بلد يُحاصر فيه 25 مليون شخص ويعذبون حاليًا، تم اعتباره إلى حد كبير في الثقافة الأمريكية السائدة على أنه مجرد دعابات.
في كل مرة يسألني أحد الحضور كيف وما إذا كان جميع الكوريين الشماليين يتعرضون لغسيل المخ، أذهلني مدى عدم وضوح مثل هذا السؤال، وإلى أي مدى يفترض وجود اختلاف جوهري بين عمليات عقولهم وعقول الكوريين الشماليين. غالبًا ما أشعر أنني أشاهد كائنًا من الخوف ينمو للسيطرة على عقل الجمهور وإيقاف فهمهم. ربما يكون هناك راحة في حرمان الكوريين الشماليين من إنسانيتهم، وإبعاد تجاربهم على أنها غير واقعية. للقيام بذلك لا نتحمل أي التزام أو مسؤولية تجاههم، كما أنه يحررنا من الشعور الغامض بتواطؤنا. لا يمكنهم لمسنا. تسمح النقطة العمياء لأي شخص في مثل هذه الحالة بالتظاهر بعمل وكالة يخفي نقصًا أعمق في الوكالة؛ إنه جهل متعمد وحماية ذاتية في الوقت نفسه.
في كل مرة يناديني أحدهم بلا خوف، أفكر في هذه النقطة العمياء، حيث أعتقد أنها تساعد في شرح وقتي في كوريا الشمالية. لا أقصد الإشارة إلى أنني كنت ساذجةً لمخاطرها، ولكن في كل مرة كنت أفكر فيها في أن يتم القبض عليّ، كنت أوقف آلام الخوف التي أتت، وحاولت إبعادها عن مقدمة وعيي بقدر ما أستطيع..
في بيونغ يانغ، سُمح لي بمغادرة الحرم الجامعي فقط في مجموعة مع مدربين لبضع ساعات في عطلات نهاية الأسبوع، وتم تحديد أيامي بدقة، لذا كانت الاستراحة الوحيدة التي حصلت عليها هي الركض في دائرة حول الحرم الجامعي الصغير. لقد ارتديت أقراص USB الصغيرة التي تحتوي على ملاحظات لكتابي على قلادة مثل المعلقات، وكنت أخشى دائمًا أن الخيط قد ينفصل عني وينزلق مني بينما لم أكن منتبهةً. في تلك اللحظات العابرة، عندما صدمتني احتمالية الاكتشاف على أنها هلاك وشيك لا مفر منه، حبست أنفاسي، وكنوع من آلية البقاء على قيد الحياة، كنت سأغمض عيني وأبعد الفكرة.
غالبًا ما يبدو لي أن الرغبة في فهم الخوف تضرب لغزًا في قلب الحياة. نحن نتنفس نحو الموت. كل لحظة على قيد الحياة هي علامة على مدار الساعة نحو عدم العيش لفترة أطول. لا توجد نهاية سعيدة، وللمساعدة في جعل كل هذا منطقيًا بالنسبة لنا، فإننا نكرر التواريخ، ونخوض حروبًا لا داعي لها، ونتلو الصلوات، ونقع في الحب، غالبًا أكثر من مرة، مع أشخاص يكسرون قلوبنا. تولد الحياة من تلك النقاط العمياء، مع كل حادث، وكل حادث.
نظرًا لأنني أتعرف على الخوف، فقد تبين لي بقدر ما يمكن للمرء، أن أكون مناسبةً تمامًا لمتابعة كوريا الشمالية وتحمل كل يوم مخيف هناك كما لو كنت باحثةً في مختبر يعمل على قضية. لم أكن أعتمد على الاهتمام كثيرًا بطلابي، لكنني فعلت ذلك، وقد أعطتني هذه النتيجة من وجهة نظري العمياء. فاجأني كل تفاعل، وصدمني من الجهل إلى المعرفة، وأعطاني أسماء ووجوهًا نحو فهم أعمق للرعب الكوري الشمالي. توقف الظلام عن أن يكون مظلمًا لثانية واحدة مضيئة في كل مرة، وحتى لو عاد الليل في كل مرة لتعتيم السماء تمامًا، فإن الظلمة التي تلت ذلك لم تكن أبدًا كما هي.
لا توجد دائرة كاملة أو خاتمة مرتبة أو حل بسيط لأي من هذا. ما زلت خائفة من كوريا الشمالية. صندوق الوارد الخاص بي مليء برسائل البريد الإلكتروني غير المقروءة. الصباح صعب، وأحاول تجنب قراءة الأخبار العاجلة من فوق خط العرض الثامن والثلاثين، وهو أمر سلبي حتمًا؛ اثنان من الأمريكيين محتجزين كرهائن من قبل النظام. عندما ألقي نظرة أخيرة على الأخبار، لا أنظر إلى الصور لأنني أخشى أن أرى وجوه طلابي، مما قد يجعلني أتعثر وأفقد توازني غير المستقر.
أحيانًا ما زلت أخشى أن يأتي كل هذا ليطاردني يومًا ما، وأن شخصًا ما أرسله القائد العظيم سيجدني أثناء سفري في مكان ما بعيدًا عن المنزل، وإما أنني سأعود إلى بيونغ يانغ أو أُعاقب على الكتابة حول ما لا يريدون كشفه. لكن في كل مرة يذهب فيها ذهني إلى هناك، أوقف نفسي، وعلى الرغم من أنه ليس من الواضح إلى أين تتراجع أفكاري، فغالبًا ما يكون هناك هدوء؛ للحظة وجيزة أشعر بالخدر والخوف لا يصلني.
المصدر:
https://www.laphamsquarterly.org/fear/land-darkness
عدد التحميلات: 0