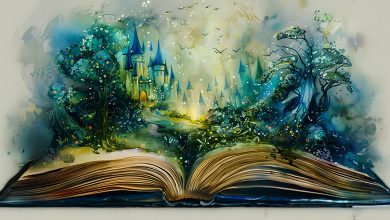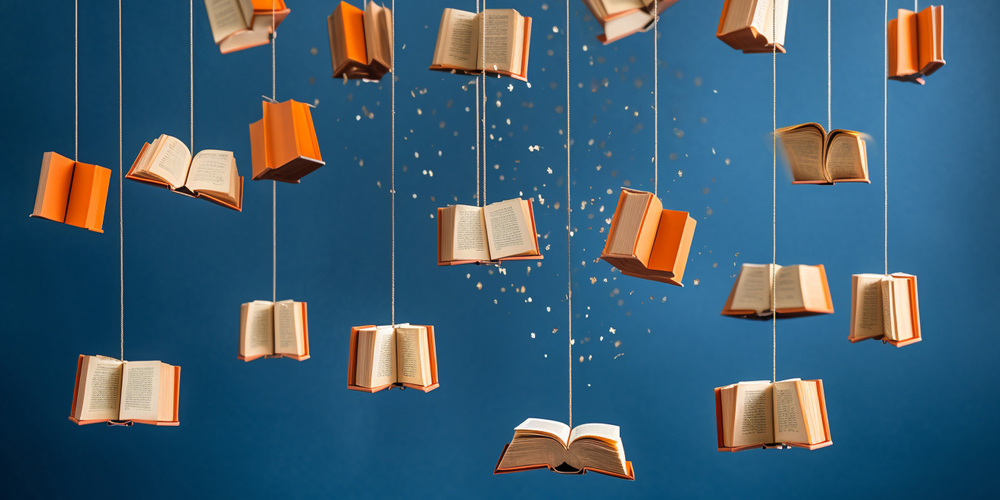
تأويلية القراءة النقدية
يمكن البعض يتساءل، لماذا وقع اختيارنا على عنوان (تأويلية القراءة) النقدية؟ وماهي الغاية المتحققة من تأويلية القراءة؟ تساؤلات كثيرة سوف تتوضح في الأسطر القادمة، عند تناولنا لمسالة القراءة والتأويل والنقد من كافة الجوانب.
بداية يمكن اعتبار النص هو الأساس في عملية التأويل، لأن هنالك عملية شرط أن تتوفر قبل كل شيء، ما بين النص والتأويل، عملية تكون متوسطة بينهما، التي وهي القراءة. أي أن القراءة تقع ما بين النص والقارئ، أما الكتابة فتقع ما بين النص والقارئ أيضًا، ولكن الكاتب غائب عن القراءة، والقارئ غائب عن الكتابة، فيكون النص هو الوسيط بينهما على هذا الشكل:
الكتابة/النص، القراءة/النص.
الكتابة ــــــــــــ النص ــــــــــــــ القراءة.
لقد جاء مصطلح القراءة بمفهوم التأويل في النقد العربي الحديث على اعتبار أن: «نتيجة القراءة هي مضمون التأويل»1، وأن أي فصل بينهما، أي بين التأويل والقراءة يلغي خصوصية الترابط المستند على المفاهيم بينهما، فلا فائدة من قراءة لا تستطيع من انتاج معنى، كذلك لا يصدر أي تأويل ما لم تسبقه قراءة، فنتيجة القراءة هي مضمون التأويل، أي أن القراءة عملية سابقة لكل عملية تأويلية، حيث أخذ هذا الطرح من الناقد أيزر، الذي تعامل معه على أنه مسألة مُسلمة منتهية «هناك شيء واحد واضح هو أن القراءة هي شرط مسبق ضروري لجميع عمليات التأويل الأدبي»2، أي أن القراءة تسبق التأويل الذي يخضع لمعطيات القراءة الذاتية التي تعتمد على اختيار مقاطع معينة من النص استنادًا على عمق ثقافة الناقد/القارئ، وتعدد مرجعياته وقراءته، وشمولية رؤيته، ومدى انفتاحه على العالم، أثناء مزاولة العملية القرائية النقدية، لاختيار وحداته الدلالية، واستبعاد أخرى، من أجل اكمال عالمه الدلالي على معنى يختاره هو. بمعنى أن تعدد القراءات يقود إلى تعدد التأويلات الذي يفضي إلى تعدد المعاني أيضًا، من خلال القراءة العميقة الناقدة للنص.
إمّا القراءة عند بارت فتغدو فعلاً انتاجيًا من قبل القارئ أثناء عملية القراءة فهو «ينزع بها نحو الابداعية، فيمثلها ابداعًا آخرًا يكتب من حول ابداع آخر»3.
يُعرّف الجرجاني، التأويل في كتابه (التعريفات)4، بقوله: التأويل في الأصل: الترجيع. وفي الشرع: صرفُ اللفظ عن معناه الظاهر الى معنى يحتمله، إذا كان المحتمل أما في المعاجم الحديثة، فنجد «التأويل في أدق معانيه هو تحديد المعاني اللغوية في العمل الأدبي من خلال التحليل وإعادة صياغة المفردات والتركيب ومن خلال التعليق على النص» 5.
وعليه ومن خلال ما طرحناه، تتعزز قناعتنا، بأن هنالك عمق كبير في التفاعل والتداخل ما بين التأويل والقراءة، حيث تعمل مفردة قراءة في المعاجم الغربية على تزاوج المعاني اللغوية والمعاني الاصطلاحية، ويرد مصطلح القراءة فيها بعدة معان أهمها «تأويل النص: وهي القراءات المتعددة التي تنجز على نص أدبي، والقراءة هنا تأتي بمفهوم التأويل، حيث يبدو هذا المصطلح أحيانًا مرادفًا للتفسير الذي هو فهم ظاهر المعنى، وأحيانًا أخرى يأتي بمفهوم التأويل الذي يعبر عن معنى المعنى»6، هنا يجعل القارئ يشعر بأن القراءة أصبحت جزءًا من النص، فهي منطبعة فيه محفورة عليه، تشتغل على إعادة كتابته، وهذا ما ذهب إليه عبدالقاهر الجرجاني من أن «المعنى ومعنى المعنى تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل اليه بغير واسطة وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنىّ ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر»7. أن القراءة هنا تؤسس عوالم، وإذا كانت تبحث عن فهم النصوص بالتحايل على الموانع الموضوعة في الطريق، أو بتأويلها من خلال منحها دلالاتٍ جديدةٍ، فإن هدف القارئ لا يتغير أبدًا: أن يعرض نفسه داخل عالمٍ آخر من أجل أن يتبين من خلاله صورةً عن ذاته. ولقد اعتبر بول ريكور عملية القراءة في حد ذاتها ممارسة للتأويل، وهي الفكرة نفسها التي يقف عندها غادامير، حين يعتبر فهم الفهم مرادفًا «للتطبيق» بالمعنى التأويلي للكلمة.
من هذا المنطلق يمكننا أن نقول بأن هناك علاقة جدلية – تكاملية قوية ومتينة بين التأويل (بوصفه عنصرًا تفسيريًا) والقراءة (باعتبارها وسيلة تواصلية)، حيث يشكل هذا «وشائج قربى بين المعاني اللغوية والمعاني الاصطلاحية داخل كل مصطلح، إذ أنه من شروط المصطلح وجود مناسبة أو مشاركة أو مشابهة بين مدلوله الجديد ومدلوله اللغوي، وأن كانت هذه الوشائج في المعاجم الغربية، حيث يندرج مفهوم القراءة من معنى الأداء بوصفه مهارة لغوية، إلى تعلم القراءة، إلى فهم المحتوى المكتوب، فإلى طريقة منهجية للفهم وأخيرًا يصل إلى التأويل الذي هو تجاوز التعامل السطحي مع النص، إلى سبر أغواره، وكشف خباياه»8.
استنادًا على هذا الخطاب، يتشكل لدينا سؤال، هل ينبغي لنا أن نفهم لكي نؤول ما نقرأ؟ إن علامة الفهم خاضعة لمقاييس الناقد/ القارئ وثقافته وابستمولوجيته، أمّا علامة التأويل فهي مقذوفة نحو دلالاتٍ جديدةٍ. وينتج من خلال ذلك أن هذه التأويلات المستمدة من عمل التأويل تعود لتغذي فهمنا لتعددية المعنى التي كان النص خاليًا منها قبل القراءة المُعّمقة، وعليه نؤكد أنهما الفهم – التأويل يشتغلان سويًا، ويتشارك كلُ واحدٍ منهما في العلامات التي ينتجها الآخر، وهنا ستحقق قراءة مثمرة ومنتجة. وهكذا، يستكشف الناقد/القارئ ممكنات علامات النص من أجل أن يعود إلى إغناء فهمه بواسطة دلالاتٍ هو نفسه من صنعها «أي أوجدها» ومنحها التخويل من باطن النص. لأن «التأويل هو عمل الفكر الذي يتكون من فك المعنى المختبئ في المعنى الظاهر، ويقوم على نشر مستويات المعنى المنضوية في المعنى الحرفي، وإني إذ أقول هذا، فإني أحتفظ بالمرجع البدئي للتفسير، أي لتأويل المعاني المحتجبة. وهكذا يصبح الرمز والتأويل متصورين متعالقين. إذ ثمة تأويل، هنا حيث يوجد معنى متعدد. ذلك لأن تعددية المعنى تصبح بادية في التأويل»9.
إن طبيعة الفهم المسبقة تعني أنه عندما نفهم، فإننا نشارك في حوار يشمل فهمنا الذاتي وفهمنا للمسألة المطروحة. في حوار تفهمنا تظهر الأحكام المسبقة في المقدمة. لأنها تلعب دورًا حاسمًا في اظهار ما يجب فهمه، وبقدر ما تصبح واضحة في تلك العملية، فإن كل «قارئ، خاصة إذا كان ناقدًا، يمتلك أفقًا فكريًا وجماليًا كذلك يشترط تلقيه للنص الأدبي وتعبئته بالمعنى وتأويله لبنيته الشكلية. وحين تتحرك آلية القراءة، ينشأ حوار خاص بين الأفقين، حوار يُحتمل أن يتمخض عن تماهي أفق النص مع أفق توقّع القارئ»10.
بقدر ما يحدث الفهم دائمًا على خلفية مشاركتنا السابقة، لذلك دائمًا ما يحدث على أساس تاريخنا. فهم، بالنسبة إلى غادامير، هو دائمًا تأثير للتاريخ، في حين أن الوعي التأويلي هو نفسه اسلوب الوجود الواعي لتأثره التاريخي. ولذا رأى بأن القراءة تعتمد على الفهم الذي يقوم بإسقاط مفاهيم سياقية تاريخية وأحكام مسبقة على النص.
أراد ريكور أن يقول إن على المرء أن يشرح أكثر ليفهم أفضل. خصوصًا عندما تتعقد عملية الفهم. مع التقنيات التأويلية التي تلعب دورًا أيضًا، وهذا يظهر لنا اتفاق ريكور مع نظرية غادامير في الهرمينوطيقا/التأويلية والتي تنطوي على أن التأويل نوع من الاستيعاب/ الاستملاك، رأى ريكور ذلك باعتباره موجه للممارسة في الحاضر أكثر مما كان غادامير يسميه استيعاب التراث/استملاك التراث، إذ يظل للتراث دور في الحاضر حتى حين رفضه أو انتقاده. واتفق مع غادامير كذلك أن هدف التأويل هو أن نتمكن من اضفاء معنى على وجودنا المتجسد مع آخرين، وأخيرًا أن التأويل عند ريكور هو الانتقال من فهم أولي إلى فهم أعمق على أساس التأمل النقدي واستثارة الخيال واستقراء تقنيات واجراءات الشرح متى تعسر الفهم، واستيعاب معنى الخطاب في العالم الذي يعكسه باعتباره عالمًا يمكننا أن نسكنه. وأخيرًا مزيدًا من فهم الذات. ومع ذلك «يتكشف من وراء ذلك بعدُ أوسع، متجذرُ في الوجود اللغوي الأساسي أو القرابة اللغوية. ففي كلّ إدراك للعالم وتوجه في العالم يشتغل عنصر الفهم، ومن خلال ذلك يقام الدليل على شمولية التأويل»11.
إن القراءة التأويلية النقدية تجعلنا أكثر فهمًا لوعينا الذاتي، أن أيزر يرى أن القارئ الحقيقي هو الذي يرتكن إلى القراءة التأويلية النقدية التي تستكشف الرموز بشكل جيد وواع، وبطريقة عميقة: فالقراءات متعددة ومتنوعة، ولكن القراءة الصحيحة هي التي تتوافق مع معنى النص. ولقراءة وفهم النص يجب علينا أن نكون بالفعل على دراية بالرموز التي تستخدمها هذه القراءة. وهنا فهم النص «يعني أن تحاوره في حدود مسندات السياق، عن الدلالات التي تميز العالم welt عن البيئة Umwelt. وهذا التوسع لأفق وجودنا في العالم، هو الذي يسمح لنا أن نتحدث عن الإحالات التي يفتحها النص»12. فالعالم هو هنا مجموع الإحالات التي تفتحها كل النصوص المختلفة. لقد ذهب أيزر الى أن إنتاج معنى العمل الأدبي لا يكون إلا من خلال المتلقي، وفي حالة غيابه يفقد النص معناه، فالمعنى ينتج من التفاعل الحاصل بين البنية اللغوية للنص، وفعل الفهم لدي المتلقي، أي في نقطة التفاعل بينهما، ويربط أيزر إنتاج المعنى بمفهومات هي: القارئ الضمني، ومفهوم الذخيرة، والاستراتيجية النصية، إضافة إلى مفهومي وجهة النظر الجوالة، ومفهوم الفراغات.
نحتاج في قراءة درستنا إلى تفكيك العنوان الذي يتألف من: التأويل، والقراءة، والناقد، وعلينا هنا التركيز على التأويلية النقدية، وخاصة إذا عرفنا أن «النقد قراءة عميقة. وإن «المعنى» الذي يعطيه النقد للعمل، وله الحق في ذلك، ليس في نهاية الأمر سوى ازدهار للرموز التي تصنع العمل، ونقول، لمرة اضافية، إنه إذا كان في العمل معنى «خفي» و«موضوعي»، فإن الرمز ليس إلا تورية، والأدب ليس إلا قناعًا تنكريًا، والنقد ليس إلا فقهًا للغة»13. ولكن يبقى هنالك عائق أمام الناقد كما يصوره بارت والذي يطلق عليه تسمية وهمُ يجب التخلص منه: «إن الناقد لا يستطيع، في أي شيء من الأشياء، أن ينصب نفسه بديلاً عن القارئ. لماذا؟ إننا إذا عرفنا الناقد بأنه قارئ يكتب، فهذا يعني أن هذا القارئ سيلتقي بوسيط خطير: هو الكتابة »14. باعتبار الكتابة النقدية التي تستمد آلياتها ورؤيتها وأساليب اشتغالها على ضوء «القراءة التأويلية النقدية»، فهي تعمل بشكل ما، أو أن وظيفة الكتابة النقدية العمل على تفكيكها للنص وإعادة تشكيله، وأن هذا الوسيط الخطير الذي هو الكتابة سيعمل على الحفر بين النقد والقراءة جرفًا، وبما أن «القراءة، وحدها تحب العمل. ولذا، فهي تقيم معه علاقة أساسها الرغبة. فالقراءة، هي رغبة العمل، والرغبة هي أن يكون المرء هو العمل»15. حتى الذهاب من القراءة الى كتابة النقد يعتبر تغيير الرغبة أو رغبة بديلة. فالنقد ما هو إلا كتابة حقيقية. فالناقد لا يكون ناقدًا إلا بجمع الصفتين القراءة – الكتابة. تحت خيمة واحدة مع مدخل واحد من أجل التفاعل والتداخل لهذه الثنائية المحمولة شرطًا من قبل المسمى ناقدًا، أي هو متلقي ومنتج في الوقت نفسه. حيث تكونا جمالية التلقي وجمالية الإنتاج متكاملتين، لذا فإن كل قارئ، خاصة إذا كان ناقدًا «يمتلك أفقًا فكريًا وجماليًا كذلك يشترط تلقيه للنص الأدبي وتعبئته بالمعنى وتأويله لبنيته الشكلية. ويتألف هذا الأفق المدعو بأفق التوقع من خبرته المسبقة بالجنس الأدبي الذي ينتمي إليه النص المقروء، ومن وعيه المسبق بالعلاقة التناصية التي تربطه بنصوص أخرى، وحين تتحرك آلية القراءة، ينشأ حوار خاص بين الأفقين قد يتسم بالتوتر والتجاذب، حوار يُحتمل أن يتمخض عن تماهي أفق النص مع أفق توقّع القارئ. وفي نوعية استجابة النص لأفق القارئ، تكمن قيمته الفنية»16. وسوف يشكل أفق التوقع هذا عند تلقي عمل ما، بوصفه استجابة ووساطة بين الحاضر والماضي، أو بتعبير أفضل «بين أفق التوقع النابع من الماضي وأفق التوقع الذي ينتمي للحاضر. ويكمن الهم الموضوعي (الثيمي) لتاريخ الأدب في هذه الوساطة التاريخية»17. وأن أفق التوقع يمتلك خواص منها مهمة جدًا تبرز على خلفيته تلقَ جديد غير متوافق في الصميم معه من ناحية المقابلة الثقافية «بين اللغة الشعرية واللغة العملية، والعالم
باستطاعتنا الآن أن نُعْرّف (القراءة النقدية)، ببضع كلمات بسيطة ولكنها عميقة جامعة لكل العمليات التي تجري ما بين النص والقارئ/الناقد، بهذه الكلمات التعريفية المهمة والبليغة يفتتح الناقد وليم راي كتابه الموسوم (المعنى الأدبي) على إنها: «دمج وعينا بمجرى النص»19، أي دمج وعي الناقد بقصد النص، أي أن القراءة هنا تشتغل على التفاعل بين الوعي الذاتي وموضوع النص الإبداعي، هذا التماهي بينهما لا يكتمل ولا يعطي نتائجه الايجابية إلا بقراءة مخلصة متفانية من قبل الناقد للنص، حتى يتسنى له إضاءة مكامنه والوقوف على خباياه، جماليًا ودلاليًا وتأويليًا، وعليه فإن معنى أي نص يقرأ، هو في الواقع المعنى المقصود لذلك النص، حيث يؤكد موريس بلانشو ذلك حينما يقول «القراءة إذن لا تعني كتابة الكتاب من جديد، بل تجعل الكتاب يكتب نفسه أو يُكتب – في هذه المرة دون وساطة المؤلف. دون وجود شخص يكتبه»20. فيصبح الكتاب من خلال القراءة نتاجًا متحررًا من مؤلفه. ويصبح كيانًا مستقلاً متميزًا مختلف عن الواقع الذي نعيشه. أما القراءة عند سارتر فتكون واقعة ما بين الخيال والعمل على حل شفرات الرموز، إذ يقول سارتر: «إن الكلمات تؤدي إلى الصور الذهنية حين نحلم بها أحلام اليقظة، ولكن حين أقرأ لا أحلم أحلام اليقظة، بل أحل الرموز»21. وما يقوله سارتر قد تردد في القرن الثامن عشر على لسان لورانس ستورن حول مشاركة القارئ، حينما يكتب في روايته تريسترام شاندي «من جانبي فأنا سأقدم للقارئ دائمًا كل ثناء من هذا النوع، وسأفعل كل ما في جهدي لأجعل خياله يشتغل مثلما يشتغل خيالي»22، وهكذا فليس أمام المؤلف والقارئ/ الناقد إلا أن يشتركا في لعبة الخيال.
يشير أيزر إلى الإشارة على أنه يجب من القارئ/الناقد، أن لا يتجاهل التأويل طبيعة النص بوصفه حدثًا وتجربة للقارئ23، لأن «النص بنية في ذاتها ولذاتها، وأن القراءة تحدث للنص بوصفها حدثًا خارجيًا وعرضيًا»24.
وبما أن الأدب لا يتحقق إلا بوجود المؤلف، أصبح الأدب اليوم كذلك لا يتحقق إلا بوجود القارئ، وعليه يجب أن ننظر إلى الأدب اليوم من زاوية جمالية التلقي، أي من الزاوية التي تبين لنا مدى تفاعل القارئ مع النص، ونتيجة لِتَغيُرِ الزاوية هذه «تصبح تاريخية الأدب مرتهنة بالعلاقة الحوارية بين النص والمتلقي»25، وهذا ما أشار إليه ريكور حينما اعتبر أن هذا المتلقي يكون عنصرًا أساسيًا في صناعة التاريخ: «أن معنى العمل الأدبي يعتمد على العلاقة الحوارية الراسخة بين العمل وجمهوره في كل عصر»26، وأشار كذلك إلى أن جمالية التلقي عند ياوس هدفها هو تجديد تاريخانية الأدب ولم «يكن الهدف من جمالية التلقي عند ياوس، أن تكمل نظرية ظاهراتية عن القراءة بل كانت تريد تجديد تاريخ الأدب»27. من اجل تشكيل جمالية تأويلية أدبية محكومة بأفق التوقع، حيث يحدد ياوس خصائص العملية التأويلية بثلاث خصائص:
1 -الصنعة الفنية.
2 – التذوق الجمالي.
3 – التطهير.28
ونتيجة هذه العملية التأويلية، هو تلاحم بنية النص وتجربة القارئ، ويتم تحرير النص من قصدية المؤلف ومرجعياته المختلفة والحاقه بأفق القارئ وعالم القراءة، لتصبح القراءة تحققًا ضمنيًا لإمكانيات النص الدلالية عن طريق عملية التأويل التي تعيد تشكيله من جديد. حالما يصبح النص خارج دائرة المؤلف يبدأ في البحث عمن يعطيه الديمومة والحيوية ألا وهو القارئ/الناقد، المؤول للنص، لذلك لا يكون في استطاعتنا تحصيل المعنى دون فعل القراءة، لأن القارئ بالأساس هو شريك في إنتاج الفهم، وكذلك التأويلية التي تعتبر من شروطها هو البحث في إمكان الفهم، فأن تقرأ يعني أن تنتج نصًا جديدًا، وكذلك يجب أن تكون مهمة المؤول «هي توضيح المعاني الكامنة في النص، وأن لا يقتصر على معنى واحد فقط، فمن الواضح أن المعنى الكامن الكلي لا يمكن أبدًا إنجازه من خلال عملية القراءة ولكنّ هذا الأمر ذاته هو ما يجعله أكثر جوهرية إلى حد أن المرء يجب عليه أن يتصور المعنى كشيء يَحْدُثُ، وهي النقطة التي تفْتَرِقُ عندها مختلف تقنيات التأويل»29. تدلّ التأويلية على البحث عن المعنى في مجال الابستمولوجية، باعتبار أن كل كلمة هي فتحُ على دلالات لا متناهية بالقوة. فالتأويلية إذا هي التي تعطي الفهم المشروعية، وهذا يعني أنّ تأويل نص ما لا يكون الا بموجب تصور مسبق يحمله المؤول/الناقد، فالتصور المسبق هو المعرفة الموظَفة في الفهم، لأن الفهم يحدّد التأويل، أي ينتجه. أي «إن الفهم تأويل دائمًا، ومن هنا، فإن التأويل هو الفهمُ بشكله الصريح»30.
إمّا الفهم عند غادامير، هو حدث لغوي جدلي تاريخي، يقول غادامير في ذلك: «المؤول لا يرمي إلى أكثر من أن يفهم هذه الشيء الكلي العام، النص، أي أن يفهم ما يقوله النص، وما يشكل معنى النص ودلالته، ولكي يفهم ذلك يتعين عليه ألا يتغافل نفسه ويتغافل موقفه الهرمينوطيقي الخاص، بل يجب أن يطبق النص على هذا الموقف إذ شاء أن يظفر بأي فهمٍ على الإطلاق»31.
وبناءً على ما ذكرناه آنفًا، يجب أن تكون تأويلية القراءة النقدية متسمة بالحوار الجدلي بين النص والقارئ، لأن بينهما علاقة التمثيل والنيابة، رغم أن التكوين الجدلي للقراءة ليس بغريب عن جدل المطابق والآخر والمثيل، وأخيرًا أن تقارب الكتابة والقراءة يميل إلى الاستقرار بين التوقعات التي يخلقها النص، والتوقعات التي تسهم فيها القراءة، وهذه علاقة تمثيل، لا تخلو من مشابهة مع علاقة النيابة – عن التي يبلغ فيها الماضي التاريخي أوجه32.
الهوامش:
1 – حميد لحمداني – القراءة وتوليد الدلالة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء/المغرب، بيروت/لبنان، 2003، ص 262.
2 – فولفغانغ أيزر – فعل القراءة: نظرية جمالية التجاوب، ترجمة وتقديم: حميد لحمداني والجلالي الكدية، منشورات مكتبة المناهل، فاس/المغرب، 1995، ص 11.
3 – عبدالمالك مرتاض – القراءة بين القيود النظرية وحرية التلقي، مجلة تجليات الحداثة، جامعة وهران العدد 4 /1996، ص 14.
4 – علي بن محمد الجرجاني – كتاب التعريفات، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت / لبنان، 2007، ص 51.
5 – د. ميجان الرويلي و د. سعد البازعي – دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء / المغرب، بيروت / لبنان، ط3، 2002، ص 88.
6 – العيد جلولي وخليف عبدالقادر – القراءة والتأويل من منظور اصطلاحي، مجلة الأثر، العدد 28 /جوان 2017، ورقلة /الجزائر. ص 76.
7 – عبدالقاهر الجرجاني – دلائل الإعجاز: في علم المعاني، علق عليه: محمد رشيد رضا، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت / لبنان، 2001، ص 177.
8 – مجلة الأثر – ص 77.
9- بول ريكور – صراع التأويلات: دراسات هيرمينوطيقية، ترجمة: د. منذر عياشي، دار الكتاب الجديد المتحدة، طرابلس / ليبيا، 2005، ص 44.
10 – هانس روبيرت ياوس – جمالية التلقي: من أجل تأويل جديد للنص الأدبي، ترجمة: رشيد بنحو، المجلس الأعلى للثقافة، 2004، ص 11 مقدمة المترجم.
11 – هانز جورج غادامير – التلمذة الفلسفية: سيرة ذاتية، ترجمة: حسن ناظم وعلي حاكم صالح، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت / لبنان، 2013، ص 302.
12 – بول ريكور – نظرية التأويل: الخطاب وفائض المعنى، ترجمة: سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء – المغرب، بيروت – لبنان، 2003، ص 71.
13 – رولان بارت – نقد وحقيقة، ترجمة وتحرير: د. منذر عيّاشي، تقديم: د. عبدالله الغذامي، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق/سوريا، 2019، ص 88.
14 – المصدر نفسه، ص 93.
15 – المصدر نفسه، ص 95.
16 – هانس روبيرت ياوس – جمالية التلقي، ص 11 مقدمة المترجم.
17 – بول ريكور – الزمان والسرد: الزمان المروي، ج3، ترجمة: سعيد الغانمي، راجعه عن الفرنسية: د. جورج زيناتي، دار الكتاب الجديد المتحدة، طرابلس/ ليبيا، 2006، ص 258.
18 – المصدر نفسه – ص 259.
19 – وليم راي – المعنى الأدبي: من الظاهراتية إلى التفكيكية، ترجمة: د. يوئيل يوسف عزيز، دار المأمون للترجمة والنشر، بغداد / العراق، 1987، ص 17.
20 – المصدر نفسه – ص 20.
21 – المصدر نفسه – ص 29.
22 – فولفغانغ أيزر – فعل القراءة، ص 56.
23 – المصدر نفسه، ص 14.
24 – بول ريكور – الزمان والسرد: الزمان المروي، ج3، ص 246.
25 – هانس روبيرت ياوس – جمالية التلقي، ص 11 مقدمة المترجم.
26- بول ريكور – الزمان والسرد: الزمان المروي، ج3، ص 256.
27 – المصدر نفسه – ص 256.
28 – المصدر نفسه – ص 266.
29 – فولفغانغ أيزر – فعل القراءة، ص 14.
30 – هانس جورج غادامير – الحقيقة والمنهج: الخطوط الأساسية لتأويلية فلسفية، ترجمة: حسن ناظم وعلي حاكم صالح، دار الكتاب الجديد المتحدة، طرابلس / ليبيا، 2007، ص 418.
31 – عادل مصطفى – فهم الفهم: مدخل الى الهرمينوطيقا، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2007، ص 365.
32 – بول ريكور – الزمان والسرد: الزمان المروي، ج3، ص 266.
عدد التحميلات: 4