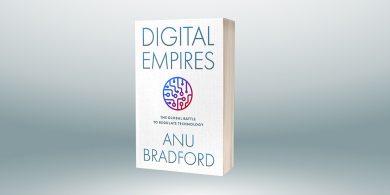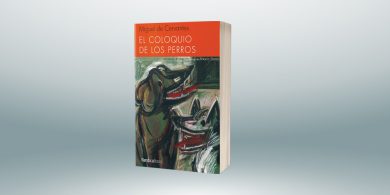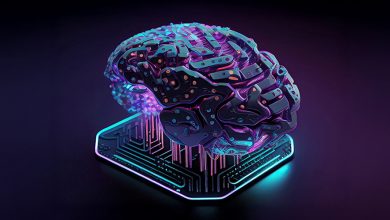تأليف: جوليا طوماس
ترجمة: لبنى بن البوعزاوي
ملخص
تعد اللامرئية الاجتماعية من المفاهيم الأكثر توظيفًا في علم الاجتماع. فطالما لاحظنا استعماله المتنامي، على مدى سنوات، بالعديد من المجالات ذات الصلة بالعمل الاجتماعي: أكان ذلك على الصعيد الميداني أو النظري. في الواقع، هناك تزايد في المجموعات الاجتماعية التي تعتبر نفسها غير مرئية، ونضرب مثالًا على هؤلاء بممتهني الجنس، ومدمني المخدرات، فالسجناء ثم المعاقين. الأدهى، أن بزوغ مرئية هذه المجموعات لا يتجلى إلا في حال ما كان ثمة حدث مأساوي وفُرجوي. بهذا الشأن، يبرز كتاب “فرنسا غير المرئية” الذي صدر سنة 2006، أن العدد المتعاظم للمجموعات “غير المرئية” يكشف عن قضايا اجتماعية جديدة تحول دون تعديل النقاش العمومي. من ثم، بدت الضرورة الملحة لإماطة اللثم الأيديولوجية في سبيل منح الكلمة لأولئك الذين لا نريد سماعهم.
تقدم مقالتنا هذه تحليلًا معجميًا لمفهوم اللا مرئية الاجتماعية، وإن كان الأخير ليس مفهومًا حديثًا أو أصيلًا. فإذا ما عدنا إلى محرك البحث غوغل سكولار Google Scholar ، سنجد حوالي واحد وعشرين ألف بحث أكاديمي مُدرجًا باللغة الفرنسية، إلى جانب مئة وواحد وخمسين ألف ورقة في نفس الموضوع باللغة الانجليزية. وبعد تعميق البحث على هذه المواد، نستطيع عرض مختلف استخدامات هذا المفهوم الذي ارتبط في جوهره بموضوعة الاقصاء. على أن الدراسات التي استخدمته، تكتسي أهمية بالغة بالوقت الراهن؛ في ظل مجتمع فرجوي) بمفهوم جي دوبور Guy Debord ) ومتلصص على نحو مطرد. بتعبير آخر، هناك إقصاء جلي للفئات غير المرئية في المجتمع.
الكلمات المفتاحية: اللامرئية الاجتماعية، الاقصاء.
***
يعود أول استعمال لمفهوم “المرئية الاجتماعية” Social visibility إلى جون إدوارد أندرسون John Edward Anderson بسنة 19492 في سياق علم النفس والنمو السلوكي. ليتبلور لاحقًا على يد إدوارد كليفورد Edward Clifford في مجال سيكولوجيا نمو الطفل3 عام 1963، بما أنه عمل على ترجمة مرادف الكلمة النقيض ولأول مرة إلى اللامرئية الاجتماعية Social invisibility ، بالمعنى الذي يحيل على الحيز الهام الذي تشغله الذات، في الوقت الذي يظل حضورها حضورًا عاديًا بالنسبة للآخرين؛ بوصفها ذاتا غير فاعلة في اللعب الاجتماعي4. لكن في العام 1968 ستتم الإحالة على هذا المفهوم، في بحثين أمريكيين آخرين، باعتباره إقصاءً اجتماعيًا5.
أما الاستعمال الفرنسي الأول للمفهوم، فيرجع لـ«إيف باغيل» Yves Barel في كتابه، الذي أضحى من المؤلفات الكلاسيكية، الموسوم بـ”التهميش الاجتماعي”، والذي من خلاله رأى إيف اللا مرئية الاجتماعية كواقع مستتر تستعصي دراسته وتفسيره6 نظرًا لاشتغاله على الطبقة العاملة كأول طبقة اجتماعية غير مرئية بفرنسا. كما استخدم المفهوم علاوة، في العام نفسه، من لدن جون ديديي أوربان Jean Didier Urbain ضمن مجال اللغويات بالإحالة إلى اللغة الأم «باعتبارها لسانًا أدنى تراتبية من اللغة، محكوم عليه بالاحتجاب الاجتماعي، وكأنه طبقة جيولوجية من “عصر الزواحف،” يستعار منه من لدن كل ذات ناطقة»7.
عرف المصطلح خلال السنوات الموالية من العقد ذاته، تداولا جليا في سوسيولوجيا الهجرة والتمييز العنصري، فضلًا عن توظيفاته في الدراسات التي أجريت عن العمل المنزلي النسائي. ليصبح بعد ذلك مرادفًا للتمييز، والاستغلال8 ثم التمييز العنصري9، وكذا الاحتجاب10. أما فيما يخص علم النفس، فقد تعدو «اللا مرئية الاجتماعية تكون، وبصورة عامة، حالة نفسية تبعث على الاستياء، بالنظر إلى تشويشها على شعور الهوية والفرادة الشخصية11». نستطيع إذن الفهم، وعلى نحو أفضل، مشاعر العامل الأجنبي الذي ما لبث يعتبر إلى حدود الساعة «مجرد قوة عاملة بسيطة كأن لا ماض ولا تاريخ ولا ثقافة لها»12.
برزت إبان التسعينيات، مجموعة من الدراسات مستخدمة ذات المصطلح؛ حيث تحددت تعريفاته في بعض الكلمات المفتاحية من مثل: اللا اعتراف13، انعدام المعطيات والمعلومة14، الإقصاء15، اللا مساواة16. تجدر الإشارة أن الموضوعات، التي تم استكشافها سابقا، تتبلور وتتطور وتنقسم إلى تخصصات، نذكر منها سوسيولوجيا العمل الاجتماعي المتخصص17 أو سوسيولوجيا عمل المرأة18 مثالًا على ذلك. والحالة كذلك غدت المواضيع متنوعة وتشمل التقسيم االجنسي للعمل الديني19، والبناء الهوياتي للنساء المهاجرات (العاملات أو العاطلات عن العمل)20، بالإضافة إلى انعدام التضامن بالسوق الرأسمالية21 وقطاع الصحة العمومية22.
حيط علمًا أيضًا، أن مفهوم اللا مرئية الاجتماعية قد استعمل قديمًا من قبل فيليب مورو Philipe Moreau، بمعرض مراجعته لأحد الكتب الألمانية؛ في أن اللامرئية الاجتماعية التي يقصدها، تتجسد في إحدى شخصيات الكتاب المذكور وهي شخصية Titus Pomponius Atticus، تحيل على اغتراب تيتوس ومكوثه على هامش التاريخ جراء رفضه الانخراط في العمل المدني والسياسي بقلب الجمهورية الرومانية23. في النهاية، يتعين علينا الاعتراف، على غرار أفكارنا الأصيلة – والساذجة-، بأن المصطلح المعني غير حديث الاستخدام لطالما يشهد تداولًا متصاعدًا على نطاق واسع منذ سنوات الألفين إلى يومنا هذا. من هنا نستطيع القول، لقد أصبحت اللا مرئية الاجتماعية مسعى شائعًا «à la mode ».
ليس من الضرورة بمكان، العودة لمجموع الإسهامات التي تناولت هذا المفهوم، لئلا يكون الأمر مبعثًا على الملل لأن القائمة طويلة. سينصب التركيز، خلافًا لذلك، على بعض المؤلفين والموضوعات الجديرة بالاهتمام: كمقالة الأنثروبوجية فرونسين سييون Francine Saillant، التي نشرت سنة 2000 تحت عنوان «الهوية، اللا مرئية الاجتماعية، الغيرية؛ تجربة ونظرية أنثروبولوجية في قلب ميدان التمريض». وهي دراسة تحليلية، تجمع فيها فرونسين بين أفكار ما بعد الحداثة والنظرية الاجتماعية النقدية، عمدت من خلالها إلى إلقاء الضوء على اللامرئية المعيشة من قبل الممرضات باعتبارها معاناة. بصيغة أخرى، ليس ثمة أي اعتراف سواء من قبل المرضى أو من لدن الإدارة الوصية بمجهوداتهم المبذولة24. تُظهر أبحاث فروسين في مجال التدبير الاجتماعي للصحة العمومية25 اهتمامها الكبير بمشكلات خفية أو غير مرئية.
وعلى غرار فرونسين، تكشف سيمون بينيكSimone pennec بدورها عن «اللامرئية الاجتماعية المعيشة في الحياة المهنية» “للموظفين الأشباح” بقطاع الصحة، أولئك الذين يقدمون، عند التقاعد، على مزاولة أنشطة غير معترف بها من قبيل العمل التطوعي26. وتكاد تكون الملاحظة نفسها التي استخلصها هيوجز جوبلين Hughes Joublin عن المصاحبة الطبية والنفسية للمرضى، من قبل محيطهم الذي لا تظهر عليه ملامح الاستعداد لمواجهة وضع مماثل27.
شرعت أبحاث أخرى بقطاع الصحة العمومية في الكشف عن مشكلات جديدة، بدأ، بالكاد، المجتمع المعاصر في اكتشافها، ومنها على سبيل المثال “السرطانات المهنية”28 في مجال الصناعة النووية. وبهذا المقام، تقدم آني ثيبو موني Annie Thébaut- Mony دراستها (2000، 2006) عن التمثلات الاجتماعية للسرطان، إذ لاحظت أن السرطانات المهنية بفرنسا ما تلبث تنضوي تحت اللامرئيات الاجتماعية والسياسية، خاصة تلك المتعلقة بعاملي التعاقد من الباطن: أي العاملين بدوام جزئي. غير أن ما يبعث على القلق في الساعة الراهنة، هو عدم الاعتراف بالأمراض النفسية الناتجة عن العمل، يعني حالات الاكتئاب المقترنة بمهنة العامل أو الموظف29، وتداعياتها على مسألة التعويض: تعويض العامل أو الموظف عن عدم مقدرته السيكولوجية30.
ما تزال الهجرة، في سياق اللا مرئية الاجتماعية، تشكل موضوعًا مثيرًا للغاية31 على أننا في هذه الحالة، سنعير اهتمامًا خاصًا بالنساء المهاجرات (شملت الاستطلاعات جنسيات عديدة32) ممن لديهن أنشطة منزلية، والنسوة المهاجرات المتقاعدات عن العمل33. فما يبرح المفهوم مستخدَمًا في سوسيولوجيا العمل (على الصعيدين: الوطني34 والدولي35)، خاصة حينما يتعلق الحديث بالمهن المهمشة والمحتقرة؛ فبالإضافة إلى البغاء، هنالك خدمات الغرف الفندقية، أعمال الطبقة البروليتارية في المجتمع الصناعي37 أو مهنة التنظيف الصناعي38.
يشهد المفهوم توظيفًا آخرًا في موضوعات رئيسية أخرى، عرفت ذيوعًا في العقد الحالي، يمكن تحديدها في ثلاثة وهي: شباب الحضر39، المثلية الجنسية، ثم النساء. أما في عام 2001 فقد نُشر مقالًا عن اللا مرئية الاجتماعية، ونقصد بها أنونيما Anonymat شباب التبليغ (حركة دينية إسلامية مجددة)، رغم أنهم يظهرون مرئية دينية مبالغة40. كما قدم غفان تيتلي Gavan Titley تقريرًا للمجلس الأوروبي يلقي الضوء على موضوعة العنف بين الشباب في ظل الافتقار إلى هياكل التحسيس الملائمة41. كون الباحث قد اختبر، بصورة خاصة، حالة اللا مرئية الاجتماعية لدى ضحايا الاعتداءات الجنسية. بينما تعدو اللا مرئية تكون، إذا ما تعلق الأمر بالمثلية الجنسية، شكلًا من أشكال الإقصاء ومؤشرًا على اللا مساواة المعيشة ضمن المجتمع السحاقي البالغ42 فضلًا عن عالم الشغل43.
غدت النساء أخيرًا، مجموعة من ضمن المجموعات الاجتماعية الأخرى، لطالما مكثت طويلًا في الظل؛إذ إن الأنشطة والأدوار النسائية كما يشير دومينيك لوتيغون Dominique le Tirant قد تم طمسها وحجبها «تحت ظلال عمل أزواجهن» مما نتج عنه «غياب حيز التمثل الجمعي»44. باختصار شديد، إننا نجد أنفسنا أمام احتقار تام لأدوار المرأة على صعيد سجلات التاريخ الصناعي والاجتماعي للقرن العشرين.
باستطاعتنا القول إن العنف المنزلي بدأ يتخطى ببطء الحدود المجالية الخاصة للكشف عما وراء جدران المنازل45؛ ذلك أن الاعتداءات ضد النساء (على سبيل المثال اضطهاد النساء في الحروب علاوة على وضعهن اللاإنساني في بعض الدول) باتت معلومة لدى العموم وتشهد ذيوعًا حول العالم بشكل متنام، لا سيما بعد ما «نُزع الحجاب عن الأوضاع المأساوية غير المرئية في المجتمع، التي غالبًا ما يتم تجاهلها، وخُلع القناع عن الأسباب الهيكلية التي يتم طمرها أحيانًا بفعل التحديد الماهوي للمرأة أو بسبب تجنيس العلاقات بين الجنسين وكذا الوظائف المتعلقة بهما»46.
مجمل القول، يقترن مصطلح اللا مرئية الاجتماعية، عمومًا، بالإقصاء واللا اعتراف. لكن، يبقى الموضوع في أمس الحاجة إلى تحليل نهائي للدراسة الفلسفية والابيستيمولوجية المتعلقة بـ«أنماط اللا مرئية الاجتماعية»47. اقترح غابرييل كاتي Gabriel Gatti بهذا الصدد، سنة 2003، من أجل دمج المصطلح ضمن التصور السوسيولوجي، ما يسميه بـ “مبدأ بارييل” (إحالة إلى إيف بارييل Yves Barel، 1982). غير أنه يعرف “الحياة الاجتماعية اللامرئية” بـ: «ما يبقى من سيرورة الممارسات المعرفية وما تقوم عليه من بلاغة في النظر، تلك التي تجعل من الحالة الاجتماعية غير المرئية، خاصية مميزة تبتدع منها استراتيجياتها الخاصة المشكلة لهويتها»48.
ولا ريب أن أكسيل هونيث Axel Honneth، هو الأكثر إسهامًا في التنظير لعين المفهوم. لقد رأينا سلفًا، أنه انطلق، كعالم اجتماع، من فينومينولوجيا اللامرئية الاجتماعية لينتهي به المطاف إلى سوسيولوجيا الاعتراف. عساه بذلك يعرب عن اهتمام مطرد بالكيفية التي يرى بها الفرد ويتعرف عن طريقها على مرئيته الخاصة49. إن غياب أشكال التعبير والتفاعل في علاقتنا بالأفراد (عدم الاكتراث للشخص) لا يمكنه أن يعبر إلا عن لا مرئية هؤلاء الاجتماعية. فأن «ترى الفرد عن طريق شخص آخر» هو أيضًا إيحاء لا يخرج عن نطاق الايحاءات الأخرى التي تحيل على غياب الاعتراف وانعدام الاحترام لهذا الشخص. «تتضمن اللا مرئية الاجتماعية هذا الطابع العام ليس إلا لكونها تنم عن تعبير مفارق لها يتجلى في غياب أشكال التعبير الايجابية عن التعاطف والتي عادة ما تكون مرتبطة بفعل تحديد الهوية الفردية»50.
عمل مؤلفون آخرون أوليفيي فوارول51 Olivier Voirol، وجون طومبسون52 John Thompson وغييوم لو بلون Guillaume Le Blanc على تطوير المفهوم في حقل البناء الاجتماعي للهوية، بدءًا من تصور هونيث، في سبيل بلورة فلسفة اجتماعية لمفهوم اللامرئية الاجتماعية.
هذا بالإضافة إلى أن غييوم لو بلون53 Guillaume Le Blanc، هو الوحيد الذي ألف كتابًا بعنوان: (اللامرئية الاجتماعية)، ومن المذهل أنه وبمحض الصدفة، تم صدوره خلال السنة الجارية (مارس 2009). وإن كان، يستند في كتابه على تعريف واحد للمفهوم يبرز في اعتبار اللا مرئية الاجتماعية «سيرورة غايتها القصوى هي استحالة المشاركة في الحياة العامة»55. فإنه ينهج تركيبًا لفكرته بتجزيئ المفهوم إلى ثلاث اتجاهات: أما الأول فهو: التهميش بوصفه سيرورة، أما الثاني: فأن يكون المرء معدومًا، أما الثالث والأخير: «فأن يكون المرء بلا مميزات»55. ولذلك تعد اللا مرئية الاجتماعية «مصدرًا في حد ذاته للمأساة»56. يكمن مكمن ضعف هذا الكتاب، في تناوله للا مرئية الاجتماعية من منظور واحد هو: اللا مرئية المعيشة. تعرض هذه الأطروحة تحليلًا جديدًا، عن الأنونيما L’anonymat بوصفها سلوكًا تخريبيًا نمطيًا للمجتمع المعاصر.
بهذا نكون إذن قد تجاوزنا المنظور الاجتماعي بجهد يأخذ بعين الحسبان شباب اليوم، فضلًا عن عالم القرصنة السيبرانية في المستقبل.
باختصار، لقد أضحى موضوع هذه الدراسة، في وقتنا الحالي، مفهومًا مصادقًا عليه أكاديميًا كأداة مهمة في التحليل الاجتماعي. بحيث باتت مرئية المهمشين تمتد أكثر فأكثر وبدأ حدود مجال الكلمة في الفضاء العام يتسع ليشملهم أيضًا. ثم بزغت المجموعات “غير المرئية” من ظلال الاهمال سعيًا، فيما يبدو استمرارًا منطقيًا، لسيرورة تطور العلوم الاجتماعية. بصيغة أخرى، من الطبيعي أن تصبح المجموعات المتجاهَلة سلفًا، موضوعات بحثية كلما تقدمت العلوم الإنسانية في طريق المعرفة. مادامت الأقليات تتيح الإمكانية لبلوغ المجهول أو للولوج إلى تصور بديل.
يمكننا في الأخير، تقديم حجة تتجاوز الحجة الأولى التي بمقتضاها يُنظر للا مرئية الاجتماعية كأداة مناسبة لتحليل الواقع الراهن. غير أنه يمكن اعتبار مفهومنا المفتاح بمثابة أداة نظرية تندرج ضمن تاريخ علم الاجتماع نفسه. وعلى هذا الأساس، نستطيع، نحن كعلماء اجتماع، مواصلة الكشف عن موضوعات للدراسة، ماتزال إلى الوقت الراهن يطالها نكران وحجب فاحتقار.
الهوامش:
1 – مصدر المقال المترجم:
1 – Julia Tomas. « La notion d’invisibilité sociale », Cultures et Sociétés, nº 16, 2010, pp. 103- 109. Paris: Téraèdre. ISBN : 978 -2- 36085- 002 -0
2 – John Edward Anderson, The Psychology of Development and Personal Adjustment, New York, H. Holt, 1949.
3 – Edward Clifford, «Social visibility», Children development, n° 34, 1963, pp. 799-808, [https://www.jstor.org/stable/1126773].
4 – Ibid., p. 800.
5 – Perry London et al.,Foundations of Abnormal Psychology, Austin (USA), Holt, Rinehart and Winston, 1968. Barry Schwartz, «The social psychology of privacy”, American Journal of Sociology, vol. 73, n° 6, 1968, pp. 741- 752.
6 – Yves Barel, la Marginalité sociale, Paris, Presses Universitaires de France, 1982, p. 7.
7 – Jean-Didier Urbain, «La langue maternelle, part maudite de la linguistique», Langue Française, vol. 54, 1982, p. 28.
8 – Yvonne Mignot-Lefebvre, «La sortie du travail invisible. Les femmes dans l’économie», Revue Tiers-Monde, n° 102, 1985, pp. 242- 478.
9 – René Gallissot, Misère de l’antiracisme : racisme et identité nationale, le défi de l’immigration, Paris, Arcantères, coll. «Migrations plurielles», 1985.
10 – Occultation des rapports sociaux entre les sexes […] dans les sciences sociales », Danielle Chabaud-Rychter, Dominique Fougeyrollas-Schwebel et Françoise Sonthonnax, Espace et temps du travail domestique, Paris, Librairie des Méridiens, 1985, p. 8.
11 – Jean-Paul Codol, « Estimation et expression de la ressemblance et de la différence entre pairs », L’Année psychologique, n° 86, 1986, p. 529.
12 – Catherine Wihtol de Wendel, Citoyenneté, nationalité et immigration¸ Paris, Arcantères, 1987, p. 8.
13 – «Ce que je fais ne compte pas.», Geneviève Cresson, « La santé, production invisible des femmes », Recherches féministes, vol. 4, n° 1, 1991, p. 33. Voir aussi Jeanne Bisilliat, Femmes du sud, chefs de famille, Paris, Karthala Éditions, 1996.
14 – Irène Albert, Des femmes, une terre : une nouvelle dynamique sociale au Bénin, Paris, L’Harmattan, coll. «Alternatives rurales», 1993, p. 7.
15 – Teresa Cristina Carreteiro, Exclusion sociale et construction de l’identité: les exclus en milieux “défavorisés” au Brésil et en France, Paris, L’Harmattan, coll. « Santé, sociétés et cultures», 1993.
16 – Colette Vallat, «Des immigrés en Campanie!», Revue européenne des migrations internationales, vol. 9, n° 1, 1993, pp. 47- 58, [http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/remi_0765- 0752_1993_num_9_1_1048]. Voir aussi Françoise Morin, «Entre visibilité et invisibilité : les aléas identitaires des Haïtiens de New York et Montréal », Revue européenne des migrations internationales, vol. 9, n° 3, 1993, pp. 147 -176, [http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/remi_0765-0752_1993_num_9_3_1373].
17 – Jean-Marie Foucart, « L’éducateur social spécialisé : crise, utopie et position de classe », Déviance et Société, vol. 16, n° 2, 1992, pp. 143- 156, [http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ds_0378-7931_1992_num_16_2_1258].
18 – Margaret Maruani, « L’emploi féminin à l’ombre du chômage», Actes de la recherche en sciences sociales, Vol. 115, n° 115, 1996, pp. 48-57 [http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/arss_0335-5322_1996_num_115_1_3203].
19 – Martine Haag, «Statut des femmes dans les organisations religieuses : l’exemple de l’accès au pouvoir clérical», Archives des sciences sociales des religions, n° 95, 1996, pp. 46- 67.
20 – Michèle Laaroussi Vatz et al., «Femmes immigrantes en région : une force pour le développement local ?», Nouvelles pratiques sociales, vol. 8, n° 2, 1995, pp. 123 -137, [http://id.erudit.org/iderudit/301332ar].
21 – Jean-Louis Laville, « Économie solidaire et crise de l’État en Europe », Lien Social et Politiques, n° 32, 1994, pp. 17- 26.
22 – Francine Saillant, «Chercher l’invisible, épistémologie et méthode de l’étude de soins», Recherches Qualitatives, vol. 20, 1999, pp. 125-158, [http://www.recherche-qualitative.qc.ca/Textes_PDF/20Saillant.pdf].
23 – Philippe Moreau, «Olaf Perlwitz, Titus Pomponius Atticus. Untersuchungen zur Person eines einflussreichen Ritters in der ausgehen- den römischen Republik», compte-rendu, Annales, histoire, sciences sociales, vol. 50, n° 5, 1995, pp. 1097-1099, [http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ahess_0395-2649_1995_num_50_5_279418_t1_1097_0000_001].
24 – Francine Saillant, «Identité, invisibilité sociale, altérité. Expérience et théorie anthropologique au coeur des pratiques soignantes» Anthropologie et sociétés, vol. 24, nº 1, 2000, pp. 155- 171.
25 – Francine Saillant et al., « Politiques sociales et soins de santé : conséquences et enjeux pour les femmes », in Dominique Masson (dir.), Femmes et politique : l’État en mutation, Ottawa, University of Ottawa Press, 2005, pp. 181 -210.
26 – Simone Pennec, « Les tensions entre engagements privés et engagements collectifs, des variations au cours du temps selon le genre et les groupes sociaux », Lien social et Politiques, n° 51, 2004, p. 101.
27 – Hughes Jobulin, «De l’univers du “care” à celui des soins : le grand écart des familles», Revue Francophone de Psycho-Oncologie, vol. 5, n°4, 2006, pp. 210- 214.
28 – Annie Thébaut-Mony, L’Industrie nucléaire : sous-traitance et servitude, Paris, Inserm, coll. «Questions en santé publique», 2000. Annie Thébaut-Mony, «Histoires professionnelles et cancer», Actes de la recherche en sciences sociales, n° 165, Travail et santé :Déni, visibilité, mesure, 2006/3, pp. 18- 31. Voir aussi Isabelle Paillart et Géraldine Strappazon, «Les paradoxes de la prévention des cancers : publicisation et
29 – Dominique Huez, «Souffrances invisibles et dépressions professionnelles. Mettre l’organisation du travail en délibération», Travailler, n° 10, Psychopathologie du travail, 2003/2, pp. 39-55, [http://www.cairn.info/revue-travailler-2003-2-page-39.htm].
30 – Cristina Ferreira, Danièle Lanza et Anne Dupanloup, « La contribution des statistiques publiques à l’invisibilité sociale : le cas de l’invalidité psychique en Suisse », Revue suisse de sociologie, n° 34/1, 2008, pp. 165- 185.
31 – Gilles Ascaride et Salvatore Condro, La ville précaire: les isolés du centre-ville de Marseille, Paris, L’Harmattan, coll. «Logiques sociales», 2001. Azouz Begag, «Les relations France-Algérie vues de la diaspora algérienne», Modern and Contemporary France, vol. 10, n° 4, 2002, pp. 475-482. Bernard Roux, « Agriculture, marché du travail et immigration. Une étude dans le secteur des fruits et légumes méditerranéens », Mondes en développement, n° 134, 2006/2, pp. 103 -117.
32 – Francesca Scrinzi, «“Ma culture dans laquelle elle travaille”. Les migrantes dans les services domestiques en Italie et en France», Cahiers du Cedref, n° 10, Genres, travail et migrations en Europe, 2003, pp. 137- 162, [http://hal.inria.fr/docs/00/08/19/90/PDF/Article_Cedref_def.pdf]. Marie-Laure Cadart, «La vulnérabilité des femmes seules en situation de migration », Dialogue, n° 163, 2004, pp. 60- 71, [http://www.cairn.info/article_p.php?ID_ARTICLE=DIA_163_0060]. Lucie Fréchette et Rosalie Aduayi-Diop, « La main d’oeuvre féminine chez les jeunes d’Afrique : regard sur trois situations aliénantes », Centre d’Études et de Recherche en Intervention Sociale, 2005, [http://oai.erudit.org/retrieve/2325/GR.35.doc.].
33 – Fatima Aït Ben Lmadani, «Les femmes marocaines et le vieillissement en terre d’immigration», Confluences Méditerranée, n° 39, 2001, [http://www.revues-plurielles.org/_uploads/pdf/9_39_8.pdf]. Atmane Aggoun, «Vieillissement et immigration: le cas des femmes kabyles en France», Retraite et Société, n° 37, 2002/3, pp. 209- 233.
34 – Margaret Maruani, «Activité, précarité, chômage: toujours plus?», Revue de l’OFCE, n° 90, Travail de femmes et inégalité, 2004/3, pp. 95- 115, [http://www.cairn.info/revue-de-l-ofce-2004-3-page-95.htm].
35 – Aurélie Varrel, «Itinéraires du travail domestique en Inde: les filles d’Erayiur», Tiers-Monde, vol. 43, n° 170, pp. 353- 371, 2003, [http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/tiers_1293-8882_2002_num_43_170_1598].
36 – Armelle Testenoire, « Ségrégation sexuée des emplois et (in)dignité au travail : les femmes de chambre », Travail, emploi, formation. Quelle égalité entre les hommes et les femmes ?, colloque international CLERSÉ (Université de Lille I), 23 et 24 novembre 2006, [http://clerse.univ-lille1.fr/site_clerse/pages/ActualitesEtColloques/TravailEmploiFormation/fr/pdf/Testenoire_VF%2018VA.pdf].
37 – Giuliana Comisso, «Subjectivité au travail. Une analyse de la résistance ouvrière dans l’Usine Intégrée de la Fiat en Italie», L’Homme et la Société, n° 163-164, 2007/1-2, pp. 125- 154.
38 – Jean-Michel Denis, «“Dans le nettoyage, on ne fait pas du syndicalisme comme chez Renault !” Implantations et stratégies syndicales dans le secteur du nettoyage industriel», Politix, n° 85, 2009/1, pp. 105- 126.
39 – Véronique Bordes, « Jeunes et construction identitaire. Lutter pour une reconnaissance », Congrès International d’Actualité de la Recherche en Education et en Formation, Strasbourg, 28-31 août 2007, [http://www.congresintaref.org/actes_pdf/AREF2007_Veronique_BORDES_072.pdf]. Véronique Bordes, « Les effets d’une politique municipale sur les déplacements des jeunes. Une approche socio-ethnographique », Sociétés et jeunesses en difficulté, n° 4, automne 2007, [http://sejed.revues.org/document1953.html].
40 – Moussa Khedimellah, «Jeunes prédicateurs du mouvement Tabligh. La dignité identitaire retrouvée par le puritanisme religieux?», Socio-Anthropologie, n° 10, Religiosités contemporaines, 2001, [http://socio-anthropologie.revues.org/index155.html].
41 – Gavan Titley, Les Jeunes et la prévention de la violence : recommandations politiques. Réponses à la violence quotidienne dans une société démocratique, Bruxelles, Conseil d’Europe, 2004.
42 – Line Chamberlan, « “Plus on vieillit, moins ça paraît” : femmes âgées, lesbiennes, invisibles », Revue canadienne de santé mentale communautaire, vol. 22, n° 2, 2003, pp. 85-103.
43 – Christophe Falcoz, «Virilité et accès aux postes de pouvoir dans les organisations. Le point de vue des cadres homosexuel-le-s», Travail, genre et société, n° 12, 2004/2, pp. 145- 170. Line Chamberlan et Julie Théroux-Séguin, «Sexualité lesbienne et catégories de genre. L’hétéronormativité en milieu de travail», Normes, expériences et stratégies de travail, n° 1, 2009.
44 – Dominique Le Tirant, «Mémoire invisible, mémoires taboues», Pour, n° 181, 2005, [http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00001387/fr/].
45 – Mathieu Habji, «Le mariage mixte : du désir à la haine», Vie sociale et Traitement, n° 76, La place de l’usager, 2002, pp. 64 -67.
46 – Marie-Laure Cadart, «Jane Freedman et Jérôme Valluy (sous la direction de), Persécutions des femmes. Savoirs, mobilisations protections», Compte-rendu, Bulletin Amades, n° 74, 2008, [http://amades.revues.org/index488.html].
47 – Guillaume Le Blanc, L’Invisibilité sociale, op. cit., p. 196.
48 – Gabriel Gatti, «Les ruses de l’identité. De la sociologie dans une époque sans société », in Pierre Boudreault (dir.), Retours de l’utopie : recomposition des espaces et mutations du politique, Laval, Presses Universitaires Laval, 2003, pp. 31- 54
49 – Axel Honneth, «Invisibilité : sur l’épistémologie de la “ reconnaissance”», Réseaux, n° 129/130, Visibilité/Invisibilité, 2005/1-2, pp. 39- 57.
50 – Axel Honneth, «Visibilité et invisibilité : sur l’épistémologie de la “reconnaissance” », Revue du MAUSS, n° 23, De la reconnaissance, 2004/1, p. 140.
51 – Olivier Voirol, « Les luttes pour la visibilité. Esquisse d’une problématique », Réseaux, n° 129/130, Visibilité/Invisibilité, 2005/1-2, pp. 9- 36. Olivier Voirol, «Visibilité publique versus visibilité négative», Voir, être vu, L’injonction à la visibilité dans les sociétés contemporaines, Colloque du 29 au 31 mai 2008, ESCP-EAP, Paris.
52 – John Thompson, «La nouvelle visibilité», Réseaux, n° 129/130, Visibilité/Invisibilité, 2005/1-2, pp. 59- 87.
53 – Pour Le Blanc, l’invisibilité sociale c’est «être relégué socialement dans la périphérie de la malédiction sociale.» Guillaume Le Blanc, «Soi-même comme un étranger», La Pensée de Midi, n° 24- 25, Le Mépris, 2008/2-3, p127.
54 – Guillaume Le Blanc, L’invisibilité sociale, op. cit, p. 1.
55 – Ibid., p. 6.
56 – Ibid., p. 3.
57 – Serge Moscovici et Juan Pérez, «A study of minorities as victims», European Journal of Social Psychology, vol. 37, n° 4, 2006, pp. 725- 746, [http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/113385520/PDFSTART].
عدد التحميلات: 2