
ماريّا غراسيّتي بيسي1
ترجمة: أحمد الويزي
«إذا كانتْ هناك شاهدةٌ ما على القبر، من شأنها أن تلائمني، فقد تكون هذه: هنا يرقد السّيد فلان، وهو رجلٌ ساخط. وأنا لستُ ساخطًا بسبب الموت وحده، وإنّما أيضًا لأنّي منذ أن جئتُ إلى هذا العالم سنة 1922، لا [أرى بأنّ] شيئًا قد تغيّر!»
جوزيه ساراماغو
أصبح جوزيه ساراماغو في ظرف سنوات معدودة، وهو ذلك الكاتبُ البرتغاليّ الأول الحائز على جائزة نوبل للآداب سنة 1998، الروائيَّ الأوفر حظًّا بالتّرجمة في البرتغال، والأديب النّموذجي الملتزم الذي تكشف مواقفُه عن وعي أخلاقيّ قويّ، يُسمع في كافّة أنحاء العالم. وقد شكّلت مسيرة هذا الأديب المنضبط إلى أبعد حدّ للخطّ اليساريّ2 معجزةً حقيقيّةً بحسب عبارة الفيلسوف إدواردو لورينسو3. فقد وُلِد بالفعل، في وسط زراعيّ أمّي يوم السّادس عشر نوفمبر من عام 1992، ضمن عائلة أجداده التي تقطن بقرية أزينهاغا الصّغيرة والواقعة بمنطقة ريباتيجو4. ثمّ التحق بعد ذلك بثانوية لشبونة المهنيّة، حيث تمرّس على مهارة إصلاح الأقفال، وهي المهنة التي مارسها في عدّة ورشات أولاً، ثمّ بالمصالح الإداريّة للمستشفيات المدنيّة بلشبونة. وبعد هذه المرحلة، أصبح مستخدمًا بصندوق المعاشات وصندوق آخر للتّأمين.
ولأنّ ساراماغو ظلّ قارئًا شديد النّهم للكُتُب، فقد درّب نفسه على قضاء فترات لا يستهان بها من زمن المساء، ليتعاطى إلى القراءة وعشقه للكتابة في الخزانة البلديّة بالعاصمة. إلاّ أنّ باكورته الرّوائية: أرض الخطيئة، لم تحظ بأيّ اهتمام يُذكر غداة صدورها سنة 1947. وكذلك حصل مع روايته الثّانية: الكُوَة، التي بقيت مخطوطة غير منشورة لمدّة طويلة، بعد أن انتهى منها سنة 1959، ولم يُكتَب لها الخروج أخيرًا إلى العموم إلا في 2011. وقد اشتغل جوزيه ساراماغو ابتداء من عام 1959، بدار للطّبع والنّشر يقع مقرّها بلشبونة، ثمّ أصبح بعدها محرّرًا بصحيفة دياريو دي ليشبوا Diario de Lisboa، التي أشرف على تحرير الملحق الثّقافي أيضًا. وفي ذروة الحكم الاستبدادي الذي فرضه نظام سالازار الديكتاتوريّ، ينضمّ ساراماغو إلى الحزب الشّيوعي سنة 1969؛ وهو الإطار التّنظيمي الذي ظلّ يعمل في السّرية. ورغم الاختلاف الأيديولوجيّ الذي أخذ يصدر عنه مع توالي الوقت، لاسيما إزاء بعض الاختيارات التي كان يفرضها مسيّرو الحزب، فإنّ الكاتب لم ينفصل قطّ عن هذا الإطار. ثمّ جاءه التّعيين بعد ثورة الياسمين5، ليصبح مديرًا مساعدًا بصحيفة أخرى تدعى دياريو دي نوتيسياس Diario de Noticias، وكانت أوسع شهرة وانتشارًا من دياريو دي ليشبوا. إلاّ أنّ ساراماغو لم يمكث بها إلا لأشهر معدودة.
ولأنّ قطع الطّريق يتحقّق بالسّيْر، مصداقًا لما قاله الشّاعر أنطونيو ماتشادو Antonio Machado في إحدى قصائده6، فإنّ مسار الكاتب سيأخذ في الارتسام على نحو متدرّج، بناء على تعدّد مقروئيه ولقاءاته وتجاربه؛ وهي جميعها ما شحذ سَنّ قلمه الرّصين والواضح. وهكذا وسّع هذا العصاميّ الجسور، خلال السّنوات القليلة التي سعى خلالها إلى تأكيد موهبته، من نطاق تجربته الإبداعيّة التي انفتح فيها على فنون قولٍ جديدة، مستكشفًا بذلك عوالم الشّعر والمقال الأدبيّ والقصّة القصيرة، إلى جانب كتابة الحكاية والمتابعة الصّحفية أيضًا. وبعد نشره لأضمومتين شعريتين7، عاد ساراماغو إلى عالم الرّواية، فأصدر نصّا بعنوان: دليل الرّسم والخطّ، سنة 1977. إلاّ أنّ هذا المحكي، الذي ظلّ البطل فيه يطرح الأسئلة بشأن المرتكزات والأسس الفنّية، لم يحظ بأيّ اهتمام من لدن الجمهور، رغم أنّ بإمكان المتلقّي أن يعثر فيه على أبرز التّوجهات، التي سيجدها ضمن كتابات ساراماغو المواليّة، ويتعلّق الأمر هنا خاصّة بثيمة السّفر والمُضاعَف Le double.
وانطلاقًا من سنة 1979، سينعطف ساراماغو نحو المسرح، الذي جاءت الكتابة فيه بدورها كي تزيد من غنى وتنوّع تجربته الإبداعية8. إلاّ أنّ لحظة التّحول الأساسيّة في مساره قد تحقّقت خلال فترة الغليان الثّوري للبلاد عام 1975، وهي الفترة التي ترافقت مع فقد الكاتب لمنصبه في صحيفة دياريو دي نوتيسياس. وعلى إثر هذا الحادث، قرّ عزم ساراماغو على العيش على ما بمقدور ترجماته فقط أن تحقّقه له، بغاية تكريس نفسه بشكل حصريّ للكتابة فحسب9. وقد قاده هذا الاختيار الحاسم إلى منطقة ألينتيجو Alentijo، حيث عايش لعدّة أسابيع معارك بعض المزارعين، ونضالهم الذي خاضوه من أجل تحقيق الكرامة والعدالة. وقد سمحت له هذه التّجربة، التي احتكّ فيها بقسوة الواقع المعيش لهؤلاء المزارعين العاملين بالضّيعات الكبرى Latifundium (وهو نفس الوضع الذي عاشه جَدّاه من والده تقريبًا، في منطقة ريباتيجو)، بالتقاط الموضوعة المهمّة التي اتّخذها حكاية رئيسيّة في تحفته الرّوائية: ثوار الأرض، الرّواية التي صدرت سنة 1980، بينما كان سنّه هو يقترب من السّتين. وفي هذا النّص البديع، صوّر ساراماغو بأسلوب أصيل ومبتكر، ظلّ يميّزه تعاملٌ خاصٌّ مع علامات التّرقيم (ما سيغدو منذ ذلك العهد، إحدى السّمات الأساسيّة في كتابته الأدبيّة!)، الاضطرابات والقلائل الكبرى التي عرفها القرن العشرين، من خلال تتبّع حكاية مزارعين ينتمون إلى منطقة ألينتيجو، عاشوا ضحية البؤس والقمع. وقد ساوق هذه الحكاية السِّيرية صوتٌ سرديٌّ قويٌّ، عمل بشكل مشحون بطاقة كبرى ساخرة، على تفكيك نسيج التّاريخ البرتغاليّ، والكشف عن طبقاته المسيطرة منذ العهد الملكيّ، وإلى حدود نهاية مرحلة الحكم الدّيكتاتوري وحلول التّجربة الدّيموقراطية.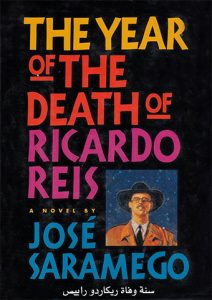
وفي ذات الفترة، خاض ساراماغو رحلة طويلة، تنقّل خلالها بين ربوع البلاد البرتغاليّة، بفضل دعوة قدّمها له أحد النّاشرين. وقد أسفرت هذه الرّحلة عن محكي رائع، صدر سنة 1981 بعنوان: جولة في ربوع البرتغال؛ وهو نصٌّ يُقدّم نفسه للقارئ بوصفه تقريرا خاصّا جدّا عن رحلة، سلك فيها الكاتب مسارًا استكشافيًّا خُطَّط له سلفًا بعناية فائقة الدّقة، بحكم أنّه يتضمّن عتباتٍ تمهيديّةً ومسلكًا تتخلّله مراحل ومختصرات، بدءًا من تراس أوسْ مونتيس Trás-Os-Montes ووصولاً إلى ألغار في Algarve، وذلك وفق إيقاع يتخلّله تعاقب الفصول، وحركة الشّمس ودورانها، وأهمية المطر والضّباب، علاوة على الأدوار التي يلعبها الضّوء والظّل. وبحكم القرابة التي تجمع بين هذا المُؤَلَّف واليوميات التّسجيلية، وارتباطه الوثيق بمحكي السّفر والدّليل السّياحي، وتنقّل متنه أحيانًا بين البُعد التّسجيلي التّعليمي والبُعد الاقناعيّ، إلى جانب توزّع عناصره بين الواقعيّ والتّخييلي، فإنّه يحيل بفعل كلّ ذلك على طبيعة الهُجنة المرتبطة بجنسه الأدبيّ، لتقاطع عناصر السّيرة الذّاتية فيه بعناصر أخرى تنتمي إلى التّاريخ، وإلى جنس الرّواية كذلك10.
إنّ كلّ عمل من أعمال جوزيه ساراماغو الأدبيّة ليُعَدّ كآلة معقّدة، تنفتح دومًا على السّؤال، بينما تخترقها ديناميّة بأبعاد قويّة. ولعلّ رواية النُصْب التّذكاري للدّيْر الصّادرة سنة 1982 11، لخير دليل على ذلك. ونتيجة لهذا، حقّقت لكاتبها شهرة طبّقت الآفاق، ومهّدت له بذلك الطّريق نحو نجاح متواصل، لن يصاب صرحه بأيّ تزحزح بعد ذلك أبدًا. ففي هذا المحكي، يعيد ساراماغو رسم مدينة لشبونة الباروكيّة رسمًا شديد الدّقة، كما كان عليه عهدها في القرن الثامن عشر، وذلك من أجل استحضار مظاهر المجد المترافقة مع عناصر البؤس أيضًا، التي كانت منتشرة في عهد الملك المستبدّ جان الخامس، الذي اشتهر بغرور المفرط والمعزّز بوفرة كبرى في الذّهب البرازيليّ. وبناء على ذلك، تعيد هذه الرّواية المؤلّفة على شكل مرآة، تشكيل المظهر المسرحيّ الاستعراضيّ الذي عرفته ردهات القصر الملكيّ، في تعارض تامّ مع طبيعة الحياة التي كانت تعيشها مختلف الفئات والشّرائح الشّعبية. ويرتكز النّص في حبكته على تنافر يقع بين صرحَيْن متعارضين بشدّة: صرحُ ديْر المارفا Marfa المهيب من جهة، الذي يُترجم رغبة ملكيّة ملحّة في الظهور والاستعراض، وصرْحُ آلةِ طيرانٍ من جهة أخرى، كان قد أنشأها مخترع راءٍ، وانتهى بجعلها تُحلّق في سرّية تامّةٍ جدًّا، بمساعدة من زوجين غير عاديين، وذلك في محاولة للهروب من سطوة محاكم التّفتيش. وعلى امتداد عناصر هذا المحكي المضاعف، تعمد قدرة هؤلاء القابعين في الظّل، وقد تمسّكوا بالرّغبة في تحقيق يوتوبياهم، إلى مقاومة تفاهة أولئك الأقوياء وممانعة قسوتهم كذلك؛ ولعلّ بليموندا Blimonda الشّخصية الأنثويّة في هذه الرّواية، لخير مثال على قدرة هؤلاء على التّصدي، بحكم أنّها من قبيل الشّخصيات التي لا يمكن للمرء نسيانها بالملّ، لما تتّصف به من قوة فوق طبيعيّة12.
إنّ اهتمام جوزيه ساراماغو باقتفاء آثار الذّاكرة الجماعيّة طال أيضًا روايات أخرى، من قبيل ما كتبه بعد ذلك؛ ويتعلّق الأمر بتلك النّصوص التي يمكن للمرء أن يكتشف فيها تارة، بعض الحلقات التي ميّزت سنة 1936، من خلال العودة المتخيّلة مثلاً إلى شّخصية شهيرة من الشّخصيات المضاعفة لفرناندو بيسوا F. Pessoa، التي غادرت نحو البرازيل في نهاية العهد الملكي (رواية: سنة وفاة ريكاردو راييس، 1984)، كما يمكنه أن يكتشف فيها تارة أخرى، قضية من القضايا التي تهمّ الشّأن الإيبيري، وقد جدّد طرحَها بقوة حدوثُ كارثة جيولوجيّة بجبال البرانس (رواية: العَبّارة الحجريّة، 1986)، أو وقع بالأحرى طرحها نتيجة للتّقاطع بين العصور الوسطى والقرن العشرين (رواية: تاريخ حصار لشبونة، 1989)؛ وهذا ما ظلّ يسمح للرّوائي بالتّوسع في طرح أسئلته الخصبة، بخصوص كتابة التّاريخ. لكنّ ساراماغو سرعان ما تجاوز هذه المرحلة من إبداعه، التي هيمن عليها إلى حدّ كبير شغفُه بالمحكي التّاريخي المحلّي، لمّا سعى الى الانفتاح في ممارسته التّخييلية على بُعد أوسع من ذلك لتحقيق الكونيّة، من غير التّخلي بالكلّ عن قدرته الإبداعيّة المترافقة دومًا مع قسط وافر من الاشتراط الجماليّ. وللتّعريف بهذه الانعطافة الجديدة في برنامجه الإبداعيّ، ظلّ الرّوائي يستعين في عدّة مرّات باستعارة التّمثال والحجر، قائلا إنّه وإلى حدود تأليف رواية الإنجيل بحسب يسوع المسيح (سنة 1991)، لم يكن يعمل بوصفه نحّاتا سوى بكيفية يكتفي فيها بوصف الأشياء من خلال ظاهرها السّطحي وحسب، بينما شرع يفرض عليه عملُه النّفاذ فيما بعد إلى الأعماق، قصد بلوغ الغور الرّوحي السّحيق للإنسانيّة، حيث لا يدرك التمثال الحجريّ في هذا المستوى، بأنّه مجرد تمثال وحسب. وقد استتبعت عملية الخوض في هذا المسار الجديد، استعمالًا متكرّرًا للحكاية الرّمزية La parabole وخاصّة التمثيل الرّمزيّ L’allégorie، الذي يُخوّل للمحكي بُعدًا مزعجًا ومحيّرًا، وذلك من خلال عملية تحويل الشيء المعقول إلى محسوس.
إنّ النّطاق الأليغوريّ في كتابة ساراماغو ليفرض نفسه بقوة في العمى (1995)، الرّواية التي تدور أحداثها حول حادثة انتشار وباء العمى، الذي أصاب مجتمعا شملته الرّذالة، وصار محكومًا بقانون الأقوى، ومع ذلك نكتشف في خضم انتشار هذه الكارثة، سخاوة كريمة من امرأة منقذة، وإنسانيّة محيّرة من كلب يبكي على المحنة التي صار يعيشها النّاس13. إنّ الالتزام الذي يميّز الكاتب في هذه الرّواية يستدعي بشكل واضح، مسؤولية القارئ المطلوبة منذ نصّ الاستهلال، الذي يضعه المؤلِّف في بداية الرّواية، داعيًا بذلك القارئ إلى التّصرف هكذا: إذا استطعتَ أن ترى، فانظر. وإذا استطعتَ أن تنظر، فلاحظ. إنّ التّمثيل الرّمزي الأليغوريّ في هذه الرّواية/المقالة14، التي تصوِّر معالم نظام أيديولوجيّ استبداديّ على نحو خالص، يسعى الى تحقيق بُعد تعليميّ، مصداقًا لما ورد في كتب الإنجيل: أعمى يقود عميانا نحو الهلاك؛ ما دام أنّ المرمى المعقود عليها هو مساءلة نظام عالمي سياسيّ واجتماعيّ، يتّجه بشكل بديهي تماما، نحو البربريّة الأشدّ بدائيّة.
إنّ التّنديد بالنّظام الرّأسمالي المتوحّش، كما أنّ التّفكير في صيرورة الفرد ضمن مجتمع تبدو فيه القيم الإنسانيّة، التي تنبني على الاحترام والكرامة والتّآزر وكأنّها قيم منتفيّة، هما معًا الموضوعتان التي تمّت إعادة الاشتغال عليهما بكثير من الانسجام والخيال، في الرّوايات الصّادرة فيما بعد للكاتب: كلّ الأسماء (1997)، الكهف (2000)، الآخر الذي يشبهني (2002)، والوضوح (2004). وهذه الأخيرة تتقدّم لقارئها على أنّها محكي سياسيّ بشكل تامّ، يعمد عنوانها الأصلي: مقالة في الوضوح، إلى تجديد اللّعب على خلفية السّجل المقاليّ، لأجل مساءلة طريقة اشتغال الديموقراطيّة المأزومة. وفي الرّواية المواليّة: تقلّبات الموت (2005)، يستعين الكاتب بالتّمثيل الرّمزي مرّة أخرى، كي يحكي بكثير من المكر حدثًا خارقًا للعادة، عن طريق استدراج وجه من وجوه الموت غير المألوفة في متن الحكاية. وبعد ذلك بأشهر، يعود ساراماغو إلى ماضيه ليقدّم لنا ذكريات زهيدة (2006)، وهو محكي أوتوبيوغرافيّ مختصر، جمع فيه الكاتب بين ذكريات الطّفولة والشّباب، بعد التّمهيد لها مجدّدًا بنصّ استهلاليّ، جاء على شكل دعوة موجّهة للقارئ، يقول فيها: دع نفسك تنقاد إلى الطّفل، الذي كنته.
إنّ روايتيْ ساراماغو الأخيرتيْن الّلتين صدرتا قبل وفاته بلانزاروتي Lanzarote، يوم 18 من يونيو 2010، عن سنّ السّابعة والثّمانين، تتميّزان بطابع خاصّ من الفكاهة والسّخرية اللاّذعة. وبذلك، تمّ ردّ الاعتبار للتّقليد الشّطاري الإيبيريّ في رواية رحلة الفيل (2008)، لوصف جولة رهيبة قام بها فيل يُدعى سليمان، قرّر ملك البرتغال جان الثّالث تقديمه هدية لابن عمّه ماكسيميليان، أرشيدوق النّمسا. ولهذه الغاية، اعتُمدت آلية تخييل تؤسِّس لاستراتيجيات خطابيّة غايتها الكشف عن بعض الحقائق الخفيّة، إلى جانب توجيه النّقد اللاّذع لمؤسسات الدّين والسّياسة، التي تنتمي إلى القرن السادس عشر. أمّا رواية قابيل (2009)، فتقترح من جهتها تقديم قراءة جديدة ومدهشة للكتاب المقدّس، الذي عُدّ بمثابة سِفْر تعليميّ لمساوئ الأخلاق، وهو ما حذا بالرّوائي إلى إعادة تشكيل الصّورة اللّصيقة باليهوديّ التّائه. وفي مجموع هذه الرّواية، يعمد جوزيه ساراماغو إلى صياغة أفكار تقدّمية، وإلى تصوير أخلاقيّ يدين بلا هوادة، بلادةَ القوى القمعية. كما يقوم فيها أيضًا بالتّشكيك في المظاهر العامّة الخدّاعة، ويدعو إلى جانب دفاعه عن حرّية الإنسان، إلى إعمال الذّهن للتّفكير والتّأمل.
ورغم التّنوع الواضح في العوالم الممكنة، التي ينشئها ساراماغو في كلّ رواية من رواياته، إلاّ أنّ بمقدور القارئ اليقظ أن يلتقط بفطنته ضمن هذا التّنوع، وبلا أيّ عناء يذكر، وحدة عامّة تجمع بين لفيفها، وصوتًا تطبعه فرادة من طبيعة خاصّة، إلى جانب سلسلة من الخصائص المهيمنة التي تُبيِّن بالملموس، سَعَة النّطاق الفكريّ الذي يعتمده المؤلِّف في رفض التّقيد بكافّة أشكال التّقاليد والأعراف الضّيقة، وهي الاهتمامات الاجتماعيّة والسّياسية التي تثير في بعض الأحيان، ردّات فعل مدوّية: ونفكّر هنا بشكل خاصّ، في ما صدر عن الكنيسة من مواقف معاديّة، وفي الغموض الذي اكتنف موقف كاتب الدّولة في الثّقافة، حُيال صدور رواية الإنجيل بحسب يسوع المسيح15، وفي السّجال الذي دارت رحاه أيضًا على خلفية صدور رواية قابيل، وصيغتها المتمرّدة على ما ورد في الكتاب المقدّس.
إنّ ساراماغو لم ينس قطّ بأنّ ممارسة الحرّية الكاملة هي تحديدًا، الشّرط الذي يتطلّبه كلّ التزام يدعو الكاتب إلى طرح السّؤال، سواء بخصوص السّلط الأدبيّة أو الدّور المنوط بالمثقّف في المجتمع. ولأنّه كان على دراية تامّة بما تملكه الكلمة من أثر قويّ في المجتمع، فإنّه ما انفكّ يخوض لفترة طويلة أطوار النّضال بقلمه، قصد إيقاظ الهمم والعقول ومقاومة كافّة أنماط القمع، محاولًا تغيير العالم من خلال صهر الحكاية بالتّاريخ، والمصير الفرديّ بالجماعيّ، والهوية الذاتية بالغيرية، لأجل إيصال صوت تجربة قادرة على رسم خريطة لحوزته الأشدّ حميميّة، التي يندرج ضمنها تاريخ ذاكرته الخاصّة الموصوفة هنا، بهذه العبارات:
إنّنا نحكي دائمًا حكاياتنا الخاصّة، ولا أقصد قصّةَ حياتنا بالذّات، أي تلك التي يُقال عنها إنّها سيرة ذاتيّة، وإنّما أقصد تلك الحكايات الأخرى، التي قد نجد بشأن سردها باسمنا الخاص عَنَتا وصعوبةً، لا لأنّا نخجل من ذلك، وإنّما لأنّ الأمر العظيم في الإنسان دائمًا ما يستعصي عن الإحاطة بالكلمات بشكل كبير، ولأنّ ما يجعلنا أيضًا صغارًا وتافهين بشكل عامّ هو إلى حدّ بعيد، ذلك الشّأن اليوميّ والعاديّ الذي نعدم فيه العثور حقًّا على أيّ شيء جديد، بخصوص ذلك الكائن الإنساني الآخر الكبير والصّغير أيضًا، الذي هو القارئ. ولعلّ هذا هو السّبب الذي حذا ببعض الكُتّاب إلى (…) أن يفضّلوا في الحكايات التي يروونها، ليس قصّة معيشهم (…)، وإنّما قصّة ذاكرتهم الخاصّة. وإنّا لهذه القصّةُ التي نعيشها، وهذه القصّةُ التي نرويها. وبتمام الإحاطة16.
إنّ ثمّة مدخلين اثنين بالفعل، يُقدّمان نفسيهما للقرّاء الذين يقتربون للوهلة الأولى من أعمال هذا الكاتب البرتغاليّ الأدبيّة القويّة. هناك من جهة، الجانب الأشدّ وضوحًا في نصوصه، الذي يتكوّن من غنى العالم الحكائيّ الموصوف أعلاه، حيث يمكن أن نزعم بأنّه ينقل فيه فكرًا تأمّليًا بصدد الطّيش، وفق ما أشار إلى ذلك الكاتب نفسه؛ وهناك من جهة ثانيّة، ذلك الجانب الآخر الذي يكمن في بُعْد أقلّ شهرةً من سابقه، الذي تغذّيه نصوص متناثرة، سبق للكاتب أن حرّرها على فترات متفرّقة، وبدافع ظروف عديدة ومتنوّعة. ويتعلّق الأمر هنا بنصوص تسلّط في بعض الأحيان، إضاءة غير منتظرة بشأن صورة الكاتب والمجالات المتنوّعة، التي انفتح عليها إبداعه (…). كما تقترح هذه النّصوص على قارئها، عددًا من المقاطع والمقتطفات التي تندرج ضمن سياقات ثقافية وسياسيّة وثقافيّة متنوّعة، داعيّة إياه بذلك إلى الولوج إلى كواليس العمليّة الإبداعيّة، لكي يتعرّف بشكل أفضل على الإطار الإنسانيّ والأدبيّ، الذي أحاط بالكاتب أثناء فترة لا يستهان بها في حياته…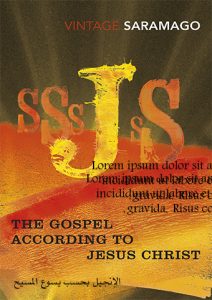
إنّ مجموع النّصوص التي تضمّها هذه الأنطولوجيا، تُشكّل مصدرًا ثمينًا حقيقة، سواء بالنّسبة إلى أولئك الذين يهتمّون بساراماغو الإنسان، أو بالنّسبة للمتحمّسين لساراماغو المبدع فقط. ولذلك، لن تفوت القارئَ ملاحظةُ أنّ القصائد الثلاثة عشرة، التي وقع عليها الاختيار في بداية الأضمومة، هي قصائد تكشف عن شكل غنائيّ غالبًا ما يتضافر فيه النّزوع الذّاتي للأديب بعملية استقباله واستضافته للآخر، فيترجم بهذا تجارب كان قد عاشها على نمط خروجه المنزاح عن المركز، أو تكشف عن نمط الافتتان باللّقاء. وعلى نحو مماثل أيضًا، فإنّ المقتطفات التي تضمّها المذكّرات اليوميّة المتكوّنة من ستّة أجزاء، والتي درّب جوزيه ساراماغو نفسه على تسجيل وقائعها يوميّا ما بين 1993 و1998، لا تُقدِّم تفاصيل سرّية أو استعراضًا متنفّجًا للذات، وإنّما هي تقدّم بالأحرى فكرًا متحرّكًا، ومعلومات تخصّ عملية تَكَوُّن بعض الرّوايات، إلى جانب تأمّلات بشأن الحياة الأدبيّة، وملاحظات ناجمة عن الارتحال والسّفر، أو حتّى تمرينات في البوح المرتبط بوطأة الأيام التي تمضي. لذلك، تأتي وكأنّها شذرات ممّا يقال في الحياة الواقعيّة، التي تبدو في ظاهرها وكأنّها غير مبنية بإحكام، غير أنّها رغم تباينها وتناثر عناصرها، تحظى ببُعد تأمّلي جوهريّ. ويظهر هذا الجانب على نحو مثير للانتباه أكثر، في الخطاب الذي ألقاه الكاتب سنة 1998 بمناسبة حصوله على جائزة نوبل؛ وهو ذلك الجانب الذي يكشف فيه ساراماغو عن مسيرته الأدبيّة، ويحتفي فيه بأصوله الزّراعية، اعتمادًا على ما تسميه البلاغة بإيثوس الكاتب L’éthos de l’écrivain 18. كما يتصدّى قلمه في نصوص أخرى، للإمبريالية والأديان والفكر الشّوفيني المنغلق، إلى جانب أنّه بالإمكان أن يتّخذ صيغة خطاب أيضًا، يتمّ بعثه إلى سالفادور ألّيندي مثلاً، أو يتّخذ هيئة ترافع للدّفاع عن الثّقافة، من غير أن ننسى إشارته إلى نتائج الأزمة الاجتماعيّة. ومن ثمّ، تكشف جميع هذه المقتطفات عن مقدار لا يستهان به من الارتباط بالآخر، الذي ظلّ ساراماغو مقتنعًا به، كما أنّها تسهم في تطوير سلسلة متواصلة من اللّعب المرآويّ أيضًا، الذي يسهل فيه إيجاد تماسك عميق لدى المؤلِّف، يتأسّس على خلفية موقفه الأخلاقيّ، الذي يقوده إلى إدانة العنف الاجتماعيّ والسّياسي، مثلما يقوده أيضًا إلى الحلم بعالم أكثر عدالة.
ولأنّ مسار ساراماغو ظلّ مسار كاتب ملتزم، ما انفكّ يقاوم كلّ أشكال الظّلم، فإنّه يكشف بذلك للمتأمّل فيه حقًّا، عن قدرة هذا الكاتب الهائلة عن الاحتجاج وإعلان السّخط، وهو ما حذا به كذلك إلى مؤازرة نضال المزارعين المعدمين، الذين لم يكونوا يملكون أيّ أرض في البرازيل19، وإلى رفع صوته عاليًا نصرةً للقضيّة الفلسطينيّة، خصوصًا بعد رحلته إلى رام الله في مارس 2002، التي كان لها أثر كبير عليه. كما أنّه وبالمثل، لم يتردّد في توجيه انتقاده أبدا لبعض الزّعماء السّياسيين المعاصرين، مثل بوش Bush الذي وصفه بأنّه شخص بذكاء متواضع، أو بيرلسكوني Berlusconi الذي عدّه مجرد جانح (ما تسبّب لناشره الإيطالي إينودي Einaudi، في التّعرض للرّقابة بحكم أنّ الدّار كانت في ملكية الكافالييري )20…
إنّ هذه الباقة المنتقاة من نصوص ساراماغو غير المنشورة من قبل، لتعمد – وهي تراوح بين التّنويع حينًا، وبين الرّسوخ على الثبات حينًا آخر – إلى الاستعانة بخيط أريان، حتّى تروي تفاصيل رحلة فريدة من نوعها، وحتى تكون في ذات الآن صدى لمختلف الاضطرابات الاجتماعيّة والثّقافية، التي عاشها روائيّ كبير استعان بمختلف الأدوات والوسائل التّعبيرية، كي يُشكّل رؤية للعالم تتوخّى إثارة الارتباك والفضول والسّؤال، أو إبهار قارئها. وإنّ لبمقدور هذا الأخير أن يُثمّن إذن، السّيرورة التي قطعها تطوّر أعمال ساراماغو الأدبيّة في مجموع تنوّعها، وأن يضع إذا ما هو رغب في ذلك، الأسس لعملية استكشاف تطال المسار، الذي قطعه كاتب منخرط أشدّ الانخراط في صراعات عصره؛ كاتب أراد أن يثبت لنفسه على أنّه مواطن متبصّر، مناهض للامبرياليّة والصّهيونية، ومناضل بشكل فعليّ في الحركة المتصدّية للعولمة، ومدافع عن قيمة الأخوة؛ وأنّه بالجملة شخص لم يكف عن التّفكير قطّ بصيغة الجمع، ولا عن الرّد عن مستجدّات اللّحظة – وبكيفية ساخرة أحيانا – جاعلا من الأدب، فضاء مفتوحًا وتشاركيّا.
إنّ الممارسة في المجال الاجتماعيّ والسّياسي هي عند ساراماغو، شأن غير قابل فعلاً للانفصال عن الكتابة الواعيّة بعمق لمسؤوليتها الكبرى، إزاء الأجيال المستقبيّلة. وعلينا أن نشير مع ذلك، بأنّ الكاتب لا يدّعي فرض أيّ مسار من المسارات المتعيّن اتّباعها، لأنّه ظلّ يدرك بأنّ الأدب لا يمكنه أن يُختزل في مجرد مكتبة لتصنيف السّلوك النّموذجي والواجب تبنّيه. وإنّما هو يُقدّم نفسه بالأحرى، على أنّه فضاء بمقدوره إيقاظ وعي القارئ، والسّماح له عند الاقتضاء بفهم بعض الاختيارات الأكسيولوجيّة فهما أفضل، وطرح السّؤال بالتّالي على نفسه وعلاقته بالعالم، للمساهمة ربّما في بناء مستقبل يكون أفضل…
الهوامش:
1 – ماريّا غراسيّتي بيسي Maria Graciete Besse أستاذة جامعيّة فرنسيّة من أصول برتغاليّة، وضعتْ هذه المقدّمة المتميّزة كتمهيد لأنطولوجيا مختارة، من نصوص لم يسبق لها أن نشرت من قبل لساراماغو. وقد صدرت هذه الأنطولوجيا بعنوان: نظرة إلى العالم Un regard sur le monde، بمناسبة مرور عقد من الزّمن على وفاة جوزيه ساراماغو (José Saramago 1922 /2010). وتضمّ هذه الباقة المنتقاة من نصوص الكاتب، التي اختارتها وقدّمت لها ماريّا غراسيّتي بيسي، مجموعة متنوّعة من الكتابات التي بقيت شاردة بدرج مكتب هذا الرّوائي، فيها ما هو شعريّ، وما هو يوميّ تسجيليّ، وما هو تأمليّ أو قصصي أو ينتمي للكتابة التّراسلية. وجميع هذه النّصوص مترجم عن البرتغاليّة من طرف دومينيك نيديليك Dominique Nédellec، ومنشور في كتاب صادر عن دار النّشر لسُّويْ seuil الفرنسيّة، سنة 2020.
2 – كان يحلو لساراماغو أن ينعت نفسه بالشّيوعي الهرمونيّ Communiste Hormonal، وهو ما يعني أنّ موقفه اليساريّ ظلّ جزءًا من طبيعته البيولوجيّة، وكأنّما هو عنصر هرمونيّ يَسْري بين كريات دمه!
3 – إدواردو لورينسو Eduardo Lourenço كاتب وفيلسوف برتغالي (1923/2020).
4 – قدّم جوزيه ساراماغو بمناسبة الحصول على جائزة نوبل للآداب سنة 1998، تحيّة مفعمة بالتّقدير والعرفان لجدّيه من جهة أمّه جيرونيمو ميلرينو وجوزيفا كايغسينا، في الخطاب الذي ألقاه أمام هيئة الأكاديميّة الملكيّة السويديّة. تراجع ترجمتنا الكاملة لهذا الخطاب وغيره من الخطب الأخرى المنتقاة، ضمن الكتاب الذي أصدرته مشكورة مجلة الرّافد البحرينيّة بعنوان: في مديح الأدب، عدد 38، نوفمبر 2012.
5 – بتاريخ: 25 أبريل 1974.
6 – Al handar se hace el camino.
7 – الدّيوانان هما: قصائد ممكنة Os Poemas Possiveis (1966)، وربّما هو فرح Possivelmente Alegria (1970).
8 – أصدر جوزيه ساراماغو بين سنة 1979 و1980، مسرحيتين اثنتين هما: “الليل”، التي تدور أحداثها خلال الفترة المسائيّة ليوم 25 أبريل 1974، في هيئة تحرير بجريدة. أمّا المسرحية الثانية فعنوانها: “ما الذي سأصنعه بهذا الكتاب؟”، وهو نصّ مخصّص للشّاعر لويس كامويس Luis Camoes، الذي صادف الكثير من المصاعب خلال القرن السّادس عشر، لأجل إصدار قصيدته الملحميّة Os Lusíadas، بعد عودته من الهند. وقد واصل جوزيه ساراماغو خلال مساره الإبداعي كتابة ونشر مسرحيات أخرى، عددها ثلاث: الحياة الثانية للقديس فرانسيسكو الأسيزي A Segunda Vida de Francisco de Assis (1987)، وباسم الله In Nomine Dei (1993)، ودون جيوفاني أو المُبرّأ الفاسق Don Giovanni ou o Dissoluto Absolvido (2005).
9 – من بين أهمّ الأدباء الذين نقل جوزيه ساراماغو بعض أعمالهم إلى اللغة البرتغاليّة، نذكر: بودلير وموبّاسان وكوليت وتولستوي. وإلى جانب هؤلاء، عمد ساراماغو إلى ترجمة بعض الأعمال التاريخية والفلسفية والسياسية لكُتّاب متنوّعين، منهم جورج دوبي G. DUBY وبولنتزاس G. Poulantzas وإيتيان باليبار E. Balibar، وغيرهم.
10 – جوزيه ساراماغو: جولات برتغاليّة Pérégrinations Porugaisese، (1981)، ترجمته إلى الفرنسيّة جونفيّف لييبريش Genevieve Leibrich، وصدر عن منشورات السُّويْ seuil سنة 2003.
11 – صدرت بالتّرجمة الفرنسيّة تحت عنوان: Le Dieu manchot، بمعنى: الإله الأقطع!
12 – كانت النُصْب التّذكاري للدّيْر الرّواية التي ألهمت الموسيقيّ الإيطاليّ أزيو كورغي Azio Corghi، وحذت به الى تأليف أوبّرا في ثلاثة فصول بعنوان بليموندا Blimunda؛ أخرجها جيروم سافاري Jérome Savary، وتمّ تقديمها على خشبة مسرح لاسْكالا بميلانو، شهر مايو 1990.
13 – وقع اقتباس هذه الرّواية للشّاشة السّينمائية في سنة 2008، من طرف المخرج البرازيلي فيرناندو مييرليس F. Meiremmes بعنوان: Blindness (العمى).
14 – يوحي عنوان هذه الرّواية الأصليّ للتلقي (وهو: مقالة في العمى Ensaio sobre a cegueira)، بأنّ ثمّة نوعًا من الدّرس التّجريبي حول موضوع الرّذالة والعنف، انطلاقًا من ثيمة الوباء المطروقة.
15 – اتُّهِم جوزيه ساراماغو جرّاء الضّجة التي أحدثتها هذه الرّواية، بتهمة “المساس بالتراث الدّيني البرتغاليّ”، فقرّر مغادرة البرتغال، والاستقرار بجيرزة لانزاروتي إحدى جزر الكاناريه، رفقة زوجته الثانية بيلار ديل ريو Pilar del Rio، وهي صحافية إسبانيّة ومترجمة أعماله إلى اللّغة القشتاليّة.
16 – جوزيه ساراماغو: مونولوغ داخلي أو السّارد المحيط بكلّ شيء؛ وهو مقال ترجمه إلى الفرنسيّة: ليين ستروك Lyne Strouc، ونشرته مجلة كي فولتير Quai Voltaire، في عددها رقم: 4، باريس، 1992.
17 – يدور الحديث هنا، عن أعمال جوزيه ساراماغو غير المنشورة من قبل، التي تتضمّنها الأنطولوجيا المختارة والصّادرة مؤخّرا. أنظر تفاصيل أوفى عنها في الهامش السّابق رقم: 1.
18 – تتجلّى أخلاق الإيثوس ضمن البلاغة الغربيّة من خلال إبداء مصداقية المتكلّم (أو المؤلِّف)، والكشف عن سلطته الخطابيّة مصداقًا لما يُعتمَد عليه بلاغيّا، من خلال خلق ما يُسمّى بالانطباع الأخلاقي الهادف إلى إبراز خبرة المتكلّم، ودرجة تعاطفه الأخلاقي مع ما يحيل عليه الخطاب. ويشكّل الإيثوس L’éthos، إلى جانب البّاثوس le pathos (الاستناد إلى العواطف) والّلوغوس le logos (الاستناد إلى المنطق)، الوسائل الثلاثة الكفيلة بعملية التّأثير البلاغيّ.
19 – في سنة 1999، رفض جوزيه ساراماغو درجة الدكتوراه الفخريّة من جامعة بارا Pará الفيدراليّة بالبرازيل، احتجاجًا منه على الكيفية التي جرت بها محاكمة المسؤولين عن مجزرة كاراجاس Carajàs سنة 1996، التي فتح خلالها رجال الشّرطة النّار على هؤلاء المزارعين الذين لا يملكون أرضا، بعد تظاهرهم على هذا الوضع، فنجم عن ذلك الحادث سقوط العديد من الضّحايا.
20 – الكافالييري Cavaliere أو الفارس لقبٌ اشتهر به بيرلسكوني.
عدد التحميلات: 1





