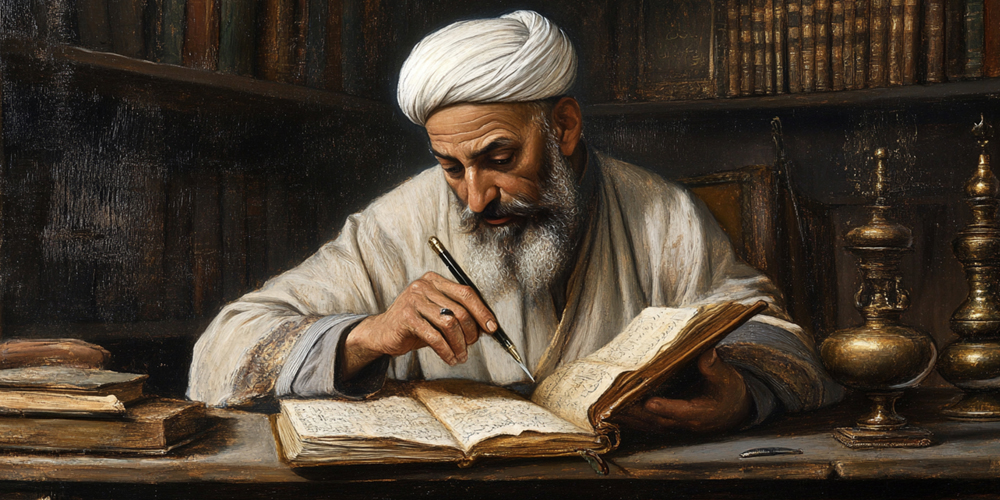
الملخص: يحاول هذا المقال تقديم صورة مركَّزة عن مشروع الجاحظ في الكتابة، مركزًا في ذلك على رصد الخيوط الواصلة بين اهتماماته المتعددة (البلاغة– جمع الأخبار – طبائع الحيوان- السلوك الإنساني …)، بشكل يجعلها تصب في مجرى واحد، ارتأينا أن نُطلق عليه «مجرى الحكمة»، ويصب في سؤال وظيفي مهم، وهو: ماذا يمكن أن نتعلَّم من الجاحظ في سياقنا المعاصر.
عندما يُطالع أحدٌ ما سؤالَ هذا المقال، قد يذهب به الظن إلى القول إن الإجابة الدقيقة عنه قد تكون مكلِّفة للوقت والجهد، لأن مؤلفات الجاحظ كثيرة، وبعضها ضخم، ولأن طريقته في التأليف صعبة ومعقدة، ولا تسلمك الفكرة بسهولة، غير أن الإجابة العامة، أو التقديرية، سيكون أمرها سهل، لأن الجاحظ عُرِف بصفة «البلاغي» أكثر من أي صفة أخرى، ولذلك يجوز الحسم بأن ما يمكن أن نتعلَّم منه لن يَخرج عن نطاق البلاغة وبقية المفاهيم المتصلة بها، مثل الأسلوب والبيان والتصوير.
والواقع أن هذه الإجابة العامة تنطوي، قياسًا إلى ما ترسَّخ عن البلاغة، في فترة ما بعد الجاحظ، من أفكار تقرنها بالأسلوب، عن معقولية لا تُنكر، لأن الجاحظ مُفيد حقًا في أرض البلاغة العربية، بل إن أفكاره فيها هي التي شكلت شرارة ما طوَّره البلاغيون بعده من أفكار نيرة، وتكفي الإشارة في هذا الصدد، إلى فكرة التصوير1 التي استطاع من خلالها تحرير منطقة التميز في الشعر، من خلال فصله بين المعنى وصورة المعنى، وهي الفكرة التي تردَّدت بقوة في مشاريع بلاغية مرموقة، مثل مشروع قدامة بن جعفر، ومشروع عبدالقاهر الجرجاني، وبُنيت عليها قضايا نقدية متعددة لا يتسع المقام لذكرها. من هنا إذن، يكون القول بإفادة الجاحظ لدرسنا البلاغي الحديث قولًا دقيقًا ومعقولًا، فعلى حد عبارة الباحث التونسي حمادي صمود، يشكل الجاحظ حدثًا استثنائيًا في البلاغة العربية (الحدث الجاحظي)2، فهو المؤسس الذي فتح آفاقًا واسعة للبحث لمن أحسن فهمه واستثماره، ومازال قادرًا على فتحها في وجوه الأنظار المعاصرة الجادة.
غير أن ما يُمكن أن يؤخذ على هذه الإجابة، من وجهة نظر أخرى، هو اختزالها للبلاغة الجاحظية في المسألة الأسلوبية، أو حتى في المسألة اللغوية، لأن الجاحظ أكبر من هذا بكثير، فهو صاحب مشروع يروم قراءة كل ما يمكن أن يصنع دلالة ما، سواء كان لغة (لفظية/خطية)، أو إشارةً، أو سلوكًا بشريًا، أو ظاهرة كونية طبيعية، أو كان شيئًا آخر يمكنه تشييد دلالة يعْقلها الإنسان، ويخضعها للتحليل، ولذلك فإن بلاغة الجاحظ ليست نظرية في الخطاب اللغوي، إنما هي نظرية في الحياة كما يقول محمد مشبال3.
وحسب الجاحظ، فإن «جمِيعُ أَصناف الدَّلالاتِ على المعَاني مِنْ لَفظٍ أَوْ غَيرِ لَفظٍ خمسةُ أشياءَ، لا تَنقصُ وَلا تَزيدُ، أوّلُهَا اللَّفظُ، ثُمَّ الإشارَةُ، ثُمَّ العَقدُ، ثُمَّ الخَطُّ، ثُمَّ الحالُ التي تُسمَّى نِصْبَةً، والنِّصبَةُ هي الحالَ الدَّالَةُ التِي تَقومُ مَقامَ تلكَ الأَصناف وَلا تقَصِّرُ عن تِلك الدَّلالات»4. وإذا استثنينا «النِّصبة» من هذا التقسيم الخماسي، نظرًا لطبيعتها الفلسفية المتعلقة بالقدرة على استنباط الحكمة من عناصر الكون5، يجوز أن نسجل استنتاجًا مُفاده أن العلامات الأربع الأخرى، كلها تدور في فلك الفعالية التواصلية الإنسانية، في بعديها اللغوي والسلوكي؛ ومثلما أن الكلام يستوعبه اللفظ والكتابة، فالسلوك إما تستوعبه العلامة الإِشارية التي يجترحها الإنسان بقصد التواصل، وإما تستوعبه الإشارة غير القصدية (السلوك الطبيعي) التي يُفهم منها ما يمكن أن يُفهم من دلالات.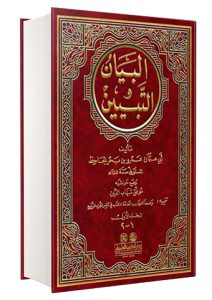
وبالإضافة إلى هذا التوسيع على مستوى أنواع العلامات، يتسع نظر الجاحظ إلى الدلالة من جانب الإحاطة بها؛ فهو لا ينظر إلى بنيتها فقط، يل يتعدى نظره إلى أسبابها وأبعادها وخلفياتها؛ فوراء كل كلام توجد دوافع نفسية ورغبات وتربية وعقل، والأمر كذلك بالنسبة إلى السلوك الإنساني، والصمت، وسائر التعبيرات الدالة؛ فنحن دائما ما نحس مع الجاحظ، بوجود سؤال يرافق الدلالة، وهذا أهم ما يميز تفكيره المنهجي المولع بالبحث عن الخفايا.
وصحيح أن الجاحظ اهتم، من بين أكثر ما اهتم به من العلامات التواصلية، بالعلامة اللفظية، في جانبها الأدبي مُمثَّلاً في الشعر والخطابة، لكن العلامات الأخرى نالت من عنايته، هي أيضًا، الشيء الكثير؛ فهو كما تتبع جماليات الكلام وعيوبه، تتبع جماليات السلوك وقُبحياته، فإذا رجعنا إلى كِتاب (البيان والتبيين)، يمكننا أن نُطالع عددًا كبيرًا من النصوص بشأن ما يزين الكلام أو ما يشينه، كما يمكننا أن نقرأ نصوصًا أخرى بخصوص قيمة السلوك الإنساني، والمستويان معًا، الكلامي والسلوكي، يدخلان ضمن بلاغة الجاحظ العامة، أي البلاغة بمفهومها «العلامي»، على حد تعبير حمادي صمود6.
لقد نظر الجاحظ، ضمن مشروعه العام، إلى الإنسان بوصفه محلاً للعلامة التواصلية، أي بكونه ذاتًا تختزل إمكانات تواصلية عديدة، لغوية وإشارية وفكرية، ثم نظر في إمكان تأسيس علم يدرس هذه الإمكانات، ويميز بين جيدها وسقيمها، ويؤسس قواعد مقنعة بخصوص ذلك، ومن هذه القواعد مثلًا، قاعدة «التوسط»، وقاعدة «مراعاة مقتضى الحال»، وقاعدة «جلب المنفعة»، وهي كلها قواعد في الكلام اللفظي، والسلوكي أيضًا، وكما يقول الدكتور الإمام العزوزي في محاضراته7، فإن الجاحظ يتحدث بوعي واحد، وبقواعد واحدة، لا في كلامه عن البلاغة الأسلوبية، ولا في كلامه عن السلوك البشري؛ فكما يخطئ المهذار، أو المتزيِّد في الكلام، أو الساكت بسبب العجز، يخطئ المسرف، والبخيل، والمتكبر، ولعله يحسن بنا أن نستحضر له نصًّا مهمًا في هذا الباب، يقرن فيه بين الخطأ اللغوي والخطأ السلوكي على نحو واضح؛ حيث يقول: «والنَّبيل لا يتنبَّل، كما أن الفصيح لا يتفصَّح، لأن النبيل يَكفيه نبلُه عن التنبل، والفصيح تُغْنيه فصاحتُه عن التفصّح. ولم يتزيد أحدٌ قط إلا لنقص يجده في نفسه، ولا تطاول متطاول إلا لوهن قد أحس به في قوته»8.
والواقع أن نصوص الجاحظ، تتيح لنا أن نذهب إلى أبعد حد في الإتيان بالنظير السلوكي للخطأ البلاغي-الأسلوبي، حيث إن أحمد بن عبدالوهاب بطل رسالة «التربيع والتدوير» هو نموذج الادعاء والتزيد، وقاضي البصرة عبدالله بن سوار9 الذي كان يتكلف الوقار، ويقضي بين الناس ثابتًا دون يتحرك فيه عضو، هو نموذج التزمت (أو التقعر)، والبخيل نموذج الخروج عن حد الوسط (…). وقس هذا على الجوانب الإيجابية أيضًا؛ حيث لا نعدم النظير السلوكي للصورة البلاغية، أو للوجه الأسلوبي الحسن.
نستطيع أن نستخلص من هذا التفكير المركب الذي تميز به الجاحظ في كلمة «الحكمة»؛ حيث لكل شيء ظاهر في الكون حكمة يختص بها، ولكل كلمة ممكنة أو فعل ممكن، حكمة يجب أن يعتصم بها، إذ لا مجال للعبث في الحياة، وهو الأمر الذي يذكرنا بنحلته الاعتزالية التي نحى بها، رفقة علماء المعتزلة الآخرين، هذا المنحى في قراءة الشريعة الإسلامية، وفي التأمل في الكون وعجائبه الدالة على حكمة الخالق.
وفي مستوى قضايا الحياة الاجتماعية، كان الجاحظ يفكر بالحكمة نفسها، حيث يرى وجوب أن نقرأ القواعد الأخلاقية قراءة نفعية، ونغلِّب المنفعة العامة على الخاصة، ونراعي تباين الفئات والعقليات في التعليم وصناعة الخطاب، ونفهم علل الأشياء بدقة متناهية.
ومن أمثلة كلامه في هذا الشأن، قوله إن المعلمين عليهم أن يقتصدوا في تعليم النحو للأطفال، وألا يدرسوهم إلا ما هو ضروري لاستقامة التواصل10، وقوله إن معرفة الدنيا أولى من معرفة الدين! لأن حجج الدين قائمة على المعرفة بمقدمات دنيوية ضرورية، إذ لا يمكن للمرء أن يعرف معجزات الأنبياء إذا لم يكن عارفًا بالممكن والممتنع في قانون الدنيا الطبيعي، كما لا يمكنه أن يميز بين الحجة والحيلة إذا لم يجرب الدنيا ويختبر معانيها، ثم إن التكليف لا يأتي إلا بعد البلوغ، أي بعد بلوغ الإنسان معرفة دنيوية تؤهله لتعقل أمور الدين والعمل بتكاليفه11.
ولعله من الطريف هنا، أن نذكر أن الجاحظ كان ضد مقولة «لم يترك المتقدم للمتأخر شيئًا يضيفه» التي بدأ تأسيسها انطلاقًا من عصره تقريبًا، لأنها غير محفزة (بناء على قاعدة “جلب المنفعة”)، وتحد من قدرات الإنسان على الاجتهاد، وتخالف مبدأ «العدل الإلهي»؛ ففي نظره، إن الله سبحانه وتعالى، قد عدل بين جميع القرون والفئات، وأعطاهم فرصا متساوية للإسهام في الحضارة الإنسانية، فما على الإنسان إلا أن يجتهد ويبدع بعيدا عن المقولات التي تقف حجر عثرة أمام طموحه12.
وبعودتنا إلى سؤال هذه المقالة، نسجل أن مشروع الجاحظ، على النحو الذي لخصناه في الفقرات السابقة، يتيح لنا فرصة الإفادة منه في درسنا الثقافي العربي المعاصر، من خلال ثلاثة مستويات على الأقل:
أولهما، ضرورة الانطلاق من الحياة وقضاياها في صياغة الخطاب الثقافي والنظريات والمناهج، لا العكس؛ فما يحدث اليوم في الدراسات النقدية الأدبية العربية، وحتى الغربية، يلخص الإسراف في التنظير على حساب دراسة الأدب ذاته، وهذا أمر يضر بفهمنا للنصوص، ويقلص فرص إفادتنا منها في فهم العالم، ويحول الخطاب النقدي إلى جهاز وصفي بارد على نحو ما يقول تودوروف في كتابه (الأدب في خطر)13، وكما رأينا مع الجاحظ، فإن الخطاب التنظيري المفيد هو الخطاب الذي يعكس قضايا الحياة وتفاعلاتها، على نحو ما يعكس حضور الإنسان داخلها. وبكلمة مختصرة، فإن من يقرأ الجاحظ يقرأ ما يجعله يفهم طبيعة الإنسان وأسرار الكون وخفايا الحياة والمجتمع، قبل أن يقرأ القواعد النظرية. ولا نعتقد أن اثنين سيختلفان حول أن واقعنا العربي المعاصر في حاجة ماسة إلى عقل يفهمه من الداخل، على غرار ما كان يحاول الجاحظ فعله في فترته التاريخية.
أما ثاني هذه المستويات، فإنه يتمثل في يمكن أن نسميه بـ«التفكير المركب»؛ فقد كان الجاحظ يفكر في الحياة في أبعادها المختلفة (التاريخ – الشعر – الخطابة – حكمة الكون – سيرورة الحياة وتحولاتها – التعليم – الدين …)، انطلاقًا من قواعد منسجمة، الأمر الذي أعطى لتراثه صورة نسقية متناغمة، وهذا النوع من التفكير النسقي الشمولي، يكاد يكون منعدمًا في سياقنا الثقافي العربي الحديث، حيث كل باحث يشتغل بمعزل عن المجالات الأخرى، الأمر الذي أفقد الكثير من المشاريع الفكرية والأدبية فعاليتها، وقلص فرصها في الانتشار والتأثير.
أما المستوى الأخير فإنه مندمج في المستويين السابقين، أو مؤطر لهما؛ فالجاحظ صدر في مشروعه المذكور عن سؤال الكتابة؛ أو عن سؤال الكتابة الناجعة التي يمكنها أن تعوِّض القول الشفوي المهيمن على الثقافة العربية إلى حدود عصره، وفي سياق أخذه على عاتقه قيادة مشروع هذا التحول الكبير من الثقافي إلى الكتابي14، طرح ضمنيًا أهم فكرة يمكنها أن تضمن النجاح للمشروع، وهي فكرة النسقية؛ فمن يتأمل نصوص الجاحظ، يجدها عبارة عن مرويات مأخوذة من «ديوان السماع» العربي حسب عبارة أبي حيان التوحيدي15، إلى الدرجة التي دفعت الباقلاني إلى انتقاد مؤلفاته بحجة الغياب المفرط لصوت الجاحظ عنها لصالح أَصوات الرواية الشفوية16، لكن ما فات الباقلاني، هو أن هذه المرويات (الأشعار والأخبار والنوادر …)، لم تأت في صورة فوضوية، أو تابعة لمناسبات القول الساذجة، بل جاءت وفق شكل منظم يبني المعرفة بناءً مُتقنًا، فأخبار البخلاء والأعراب والنساء، والأشعار، والمعارف الخاصة بالحيوان والأرض، وغير ذلك مما كان مُتداولًا شفويًا، كل ذلك يحضر في مؤلفاته وفق خطوط معرفية واضحة، ينوِّر مداركنا بشأن الهوية والأخلاق والتعليم والبلاغة والعلاقات الاجتماعية، وغير ذلك من مستويات.
المعرفة المتداخلة
بالإضافة إلى البعد النسقي، نادى الجاحظ، في مشروعه المؤسس لفعل الكتابة، بتغليب البعد الوظيفي على حساب صفة الفصاحة الثابتة التي كان ينادي بها غيرُه؛ فهوى يرى أن الكتابة لابد أن تكون خاضعة لقواعد السياق، وتمزج بين الجد والهزل إذا اقتضت الضرورة، وتكون تابعة لطبيعة من تتوجه إليه، لا لقواعد غير متحركة.
والواقع أن هذا التفكير الوظيفي في الكتابة سمة مهمة جدا في التفكير الحضاري، والجاحظ يقدم إلينا، في سياق التحول الفكري في الثقافة العربية، نموذجا جيدا للتفكير فيها بوصفها آلية غير ثابتة، يمكن إخضاعها لروح العصر وتحولاته غير المتناهية، الأمر الذي يمكن الإفادة منه، من زاوية المنهج أو النزوع، من أجل ترسيخ التناول الوظيفي-المتنوع للكتابة في ثقافتنا المعاصرة.
هذه إذن؛ هي أهم المستويات التي يمكن، حسب قراءتنا الخاصة، وحسب ما يتيحه حيز هذه المقالة، أن نستدعي من خلالها أبا عثمان الجاحظ إلى لحظتنا الراهنة، لغاية الإفادة من عقله المميز على نَحْوٍ إيجابي، ولغاية خلق حيوية مفيدة في درسنا المعاصر؛ فالرجل دائمًا ما كان متميزًا عن أقرانه في التراث العربي الإسلامي بحيويته المفرطة، وبنظره الوظيفي-السديد في مجالات الحياة المختلفة.
الهوامش:
1 – هذه الفكرة تلخِّصها قولتُه المشهورة: «المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي، والبدوي والقروي، والمدني. وإنما الشأن في إقامة الوزن، وتخيّر اللفظ، وسهولة المخرج، وكثرة الماء، وفي صحة الطّبع، وجودة السبك، فإنما الشعر صناعة، وضرب من النسج، وجنس من التصوير». الحيوان، شرح وتحقيق: عبدالسلام هارون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الثانية، 1965، ج3، ص: 131-132.
2 – انظر: حمادي صمود: التفكير البلاغي عند العرب، أسسه وتطوره إلى القرن السادس، المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، تونس، 1981، ص: 137-307.
3 – محمد مشبال: البلاغة والسرد، جدل التصوير والحجاج في أخبار الجاحظ، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة عبدالمالك السعدي، المغرب، ط1، 2010، ص: 39.
4 – الجاحظ: البيان والتبيين، تحقيق وشرح: عبدالسلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط7، 1998،ج1، ص: 76.
5 – اُنظر: إدريس بلمليح: الرؤية البيانية عند الجاحظ، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط1، 1984، ص: 122.
6 – حمادي صمود: التفكير البلاغي عند العرب، ص: 157.
7 – أستاذ البلاغة والنقد القديم بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان (جامعة عبد المالك السعدي بالمغرب) من سنة 1982 إلى سنة 2023.
8 – الجاحظ: رسائل الجاحظ، تحقيق: عبدالسلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط1، 1979، ج4، ص: 175.
9 – انظر خبره في كتاب الحيوان، ج3، ص: 343-345.
10 – رسائل الجاحظ، ج3، ص: 38.
11 – نفسه، ج 4، ص: 61-62.
12 – رسائل الجاحظ، ج4، ص: 103.
13 – ترجمة: عبدالكبير الشرقاوي، دار توبقال للنشر، المغرب، ط1، 2007، ص: 20.
14 – انظر: حمادي صمود: التفكير البلاغي عن العرب، ص: 38 وما بعدها.
15 – البصائر والذخائر، تحقيق وداد القاضي، دار صادر، بيروت، د.ت، ج1، ص: 02.
16 – أبو بكر الباقلاني: إعجاز القرآن، تحقيق: السيد أحمد صقر، دار المعارف، مصر، د.ت، ص: 248.
عدد التحميلات: 4





