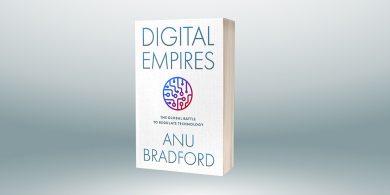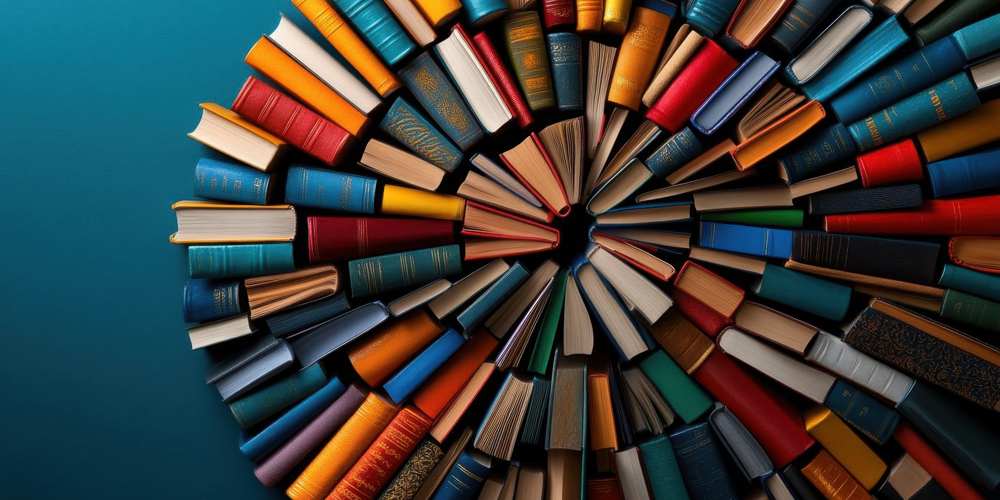
تُعتبر الثقافة، بوصفها ممارسة معرفية قائمة على القراءة والاطلاع وتوسيع المدارك الفكرية والحسّية، من أهم أدوات الإنسان في بناء وعيه وتطوير فكره، وتكوين موقفه من مختلف جوانب الحياة. فليست الثقافة هنا مجرد مظاهر تفاخرية أو تقاليد اجتماعية، بل هي السعي المستمر نحو تعميق الفهم عبر مصادر متعددة من المعرفة، والانفتاح على تجارب الآخرين، والنقد الذاتي، وإعادة النظر حتى في المسلّمات. غير أن هذه الأهمية التي ظلّت الثقافة تحتلها عبر العصور، لا تعني بالضرورة أنها مصونة من التراجع أو الضياع. إذ تطرح التحولات المعاصرة، خصوصًا في ظل تسارع التكنولوجيا، والانغماس في مخرجاتها وأدواتها، والانصراف عن القراءة، تساؤلات جدّية حول إمكانية أن تفقد الثقافة قيمتها العملية والرمزية، وحول الظروف التي تجعل الإنسان يهمّش دور الاطلاع في حياته اليومية، رغم أثره العميق في تشكيل العقل والوجدان وصقل الشخصية.
إن الإنسان المثقف بالمعنى المعرفي ليس هو من جمع قدرًا من المعلومات وحسب، بل هو ذاك الذي درّب عقله على السؤال، وعلى مقاومة السطحية، وعلى الربط بين المعطيات والتمهّل في إصدار الأحكام. ومن هنا فإنّ القراءة ليست مجرد وسيلة لجمع المعلومات، بل هي فعل داخلي لبناء الذات وتحقيق التراكم المعرفي لدى الإنسان. لكنها أيضًا ممارسة تتطلب تفرّغًا ذهنيًا، وانضباطًا، ومثابرة، وهي شروط بدأت تضعف في العصر الرقمي، حيث أصبح السواد الأعظم من الناس يفضّلون السرعة على العمق، والصورة والصوت على الكلمة، والمعلومة السريعة على الفهم المتأنّي.
يبدو أنّ الثقافة المعاصرة قد فرضت أنماطًا جديدة من التلقّي والتعلّم، لكنها في كثير من الأحيان تُقصي القراءة الجادة لصالح المحتوى القصير والمجزّأ، الذي يُشبع حاجة آنية للمعرفة لكنه لا يبني رؤية بعيدة ولا يرسّخ فهمًا عميقًا. وهكذا فإن كثيرًا من الأفراد باتوا يعتقدون أنّ الاطلاع غير ضروري طالما أن المعلومة متاحة عند الطلب، وكما نقول «بضغطة زر»، دون الحاجة إلى البحث الطويل والتمحيص الدقيق. وهذا التحوّل لا يعكس فقط تغيرًا في وسيلة اكتساب المعرفة، بل يعبّر عن تغيّر في النظرة إلى المعرفة ذاتها؛ حيث تحولت المعرفة من عملية تراكمية طويلة وشاقة إلى منتج قابل للاستهلاك الفوري.
ولا يمكن إغفال تأثير التعليم الرسمي في هذا السياق؛ إذ إن الأنظمة التعليمية التي لا تُنمّي حب القراءة ولا تدرّب الطلاب على مهارات التفكير النقدي، تسهم بشكل غير مباشر في تراجع مكانة الثقافة عند النشء. فحين ينظر كلّ من المعلم والطالب إلى القراءة كواجب مدرسي أو امتحاني فقط، فإن الطالب لا يربط بينها وبين نموه الشخصي وتطوّره الفكري. وعندما يُصبح التعلّم مقتصرًا على تحصيل الشهادات بدلًا من النموّ الفكري والمهاري، تفقد الثقافة معناها الأصيل وتتحول إلى وسيلة عمليّة لتحقيق أهداف مرحلية مؤقتة.
وقد تفقد الثقافة أهميتها أيضًا حين تنشأ قناعة لدى شريحة كبيرة من الناس بأن النجاح في الحياة لم يعد مرتبطًا بالمعرفة أو الفهم العميق، بل بالمهارة العملية، أو القدرة على التكيّف السريع، أو حتى بالحضور على شبكات التواصل الاجتماعي. وفي مثل هذه البيئات، يصبح المثقف شخصًا معزولًا أو غير “عملي”، وينظر الناس إلى القراءة كما لو أنها جهدٌ فكريّ لا حاجة له، أو مضيعة للوقت مقارنة بمكاسب سريعة قد تأتي من مجالات أخرى لا تتطلّب مثل هذا الجهد أو الوقت. ولعل هذا التغيّر في التقدير الاجتماعي للقراءة من أخطر ما يهدّد حضور الثقافة في عصرنا هذا وأهميتها في زيادة الوعي العام.
ومع انتشار التكنولوجيا الرقمية، تغيرت علاقة الإنسان بالمعلومة. فقد جعل توفر المحتوى الرقمي والمرئي من المعرفة أمرًا متاحًا وسهلًا، لكنه أيضًا ساهم في إضعاف الارتباط العاطفي والذهني بفعل القراءة كعملية تأمّل وتحليل ونشاط فكريّ ضروري. فالقارئ اليوم محاط بمنصات لا تعدّ ولا تُحصى، لكن القليل منها يتيح له التأمل أو التفكير العميق أو إعمال الفكر، بل إن أغلبها يدفعه إلى القفز من موضوع إلى آخر ومن موقع إلى آخر بغرض التسلية ليس إلا. وهذا النمط من التلقي السريع لا يُبقي أثًرًا حقيقيًا في النفس، ولا يُنتج ثقافة بالمعنى الفعلي، بل هو مجرد وهم بالمعرفة.
ومع ذلك، لا يمكن القول إن الثقافة تختفي كليًا. بل هي تتحوّل، وتعيد تشكيل نفسها بوسائل وأدوات جديدة، لكنها قد تفقد جوهرها إذا ما افتقرت إلى العمق وطبيعتها التراكمية. فالاطلاع السطحي قد يمنح الفرد شعورًا مؤقتًا بالكفاءة والمقدرة، لكنه لا ينتج فكرًا نقديًا أو استقلالًا فكريًا. ولذلك فإن فقدان أهمية الثقافة لا يحدث مرة واحدة، بل تدريجيًا، حين تتراكم ممارسات وتوجهات تقلّل من قيمة القراءة وتضعف من دافع الإنسان للمعرفة لأجل الفهم والإدراك وليس لأجل الاستخدام المؤقت فقط.
من المؤشرات التي تدل على تراجع أهمية الثقافة انخفاض معدلات القراءة المستقلة بين فئات المجتمع، وندرة النقاشات العامة التي تتناول كتبًا أو قضايا فكرية، وتراجع الاهتمام بالمعرفة النظرية مقابل صعود المحتوى الترفيهي أو العملي المحض. كما يُمكن ملاحظة غياب الشخصيات الثقافية من المشهد العام، أو انحسار دورهم لصالح المؤثرين الرقميين الذين لا تستند شهرتهم إلى معرفة أو قراءة، بل إلى الحضور البصري أو المهارة التواصلية أو الظهور الترويجي التجاري. إن من شأن هذه التحولات أن تخلق مناخًا عامًا يُفضّل السطح على العمق، والانتشار على الجوهر، وهذا ينعكس سلبًا على تقدير المجتمع لقيمة الثقافة كوسيلة مفيدة لفهم الذات والعالم من حولنا.
إلا أننا لا ينبغي أن نقابل هذا الواقع الجديد والمؤقت بالتشاؤم المطلق، لأن الثقافة، في معناها المعرفي، تظل حاجة إنسانية لا تزول؛ فالإنسان بطبيعته كائن فضولي يسعى للفهم، وقد تضعف قدرته على ذلك حينًا لكنه سرعان ما يستعيدها حين يواجه أسئلة عميقة، أو تحديات جديدة، أو حتى لحظة فراغ فكري تدفعه نحو البحث. وفي كل مرة يعود الإنسان إلى الكتاب، وإلى السؤال، وإلى التفكير العميق، وإلى البحث المعرفي، فإنه يُعيد إحياء الثقافة ويؤكد ضرورتها وأهميتها في استمرار الحياة. ومن هنا، فلا ينبغي لنا أن نفهم فقدان الثقافة لأهميتها في مرحلة من المراحل كنهاية حتمية لها، بل كمؤشر على حاجة المجتمعات لإعادة التوازن بين المعرفة والتأمّل، وبين السرعة والعمق، وبين التقنية ودورها في تعزيز الثقافة والمعرفة.
لذا فإن السؤال الحقيقي الذي ينبغي أن يُطرح ليس فقط: متى تفقد الثقافة أهميتها، بل كيف يمكن الحفاظ عليها في زمن تبدو فيه القراءة خيارًا صعبًا؟ وهذا بدوره يدفعنا إلى طرح السؤال التالي: كيف يمكن للمجتمع أن يعيد للمعرفة مكانتها، وللكتاب هيبته، وللقارئ احترامه؟ ولا تكمن الإجابة على هذين السؤالين المتلازمين في تجاهل طبيعة العصر الذي نعيش فيه، بل في إعادة تعريف الثقافة على نحو يُلائم الأدوات الجديدة دون التخلي عن جوهرها. فالثقافة ضرورة وليست ترفًا، ومتى ما تم تجاهل هذه الحقيقة، فإن الإنسان لا يفقد المعرفة فحسب، بل يفقد أيضًا قدرته على التفكير والتخيّل والتغيير.
عدد التحميلات: 2