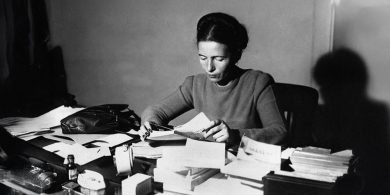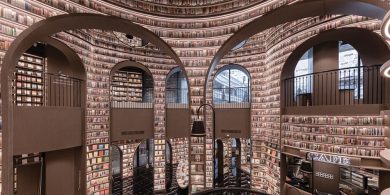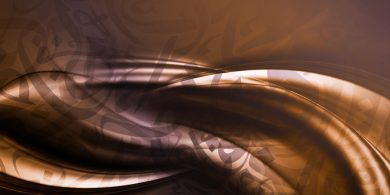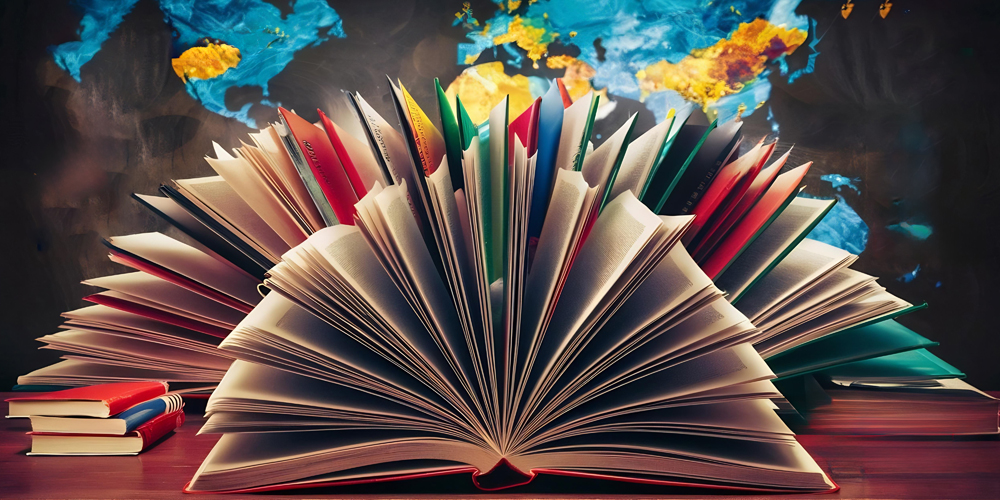
حين صرّحت المنظّرة النسوية دونا هاراواي في كتابها المهم (القردة والسايبورغ والنساء: إعادة اختراع الطبيعة) بأن “القواعد النحوية هي سياسة بوسائل أخرى”، كانت تقدّم نقدًا لفكرة حيادية انظمة اللغة المزعومة. لم يكن هذا التصريح معزولًا، بل نابع من مشروعها الأوسع الذي يهدف إلى كشف كيف أن ما يُقدَّم لنا كمعرفة موضوعية – بما في ذلك القواعد والبُنى الأساسية للغة – مرتبط بعلاقات القوة والهيمنة والمقاومة. إن دعوة هاراواي هذه تدفعنا إلى النظر إلى القواعد النحوية على إنها ليست أداة محايدة للتواصل، وانما ساحة مشحونة بالصراعات المستمرة بخصوص المعنى والهوية والواقع الاجتماعي.
المعرفة المتموقعة والقوة اللغوية
ينبع رأي هاراواي في القواعد النحوية بوصفها سياسة من نظريتها للمعرفة المتموقعة، التي تتحدى وهم التنوير في المعرفة الموضوعية المجردة من الجسد. بالنسبة لهاراواي، تأتي جميع مزاعم المعرفة من مواقع معينة داخل شبكات القوة، واللغة تعمل باعتبارها الوسيلة الأساسية التي يتم عبرها التعبير عن هذه المنظورات الموقعية والتنازع عليها. وتصبح القواعد النحوية، بعيدًا عن كونها مجموعة محايدة من القواعد لتنظيم الأفكار، أداة للسلطة تشكل ما يمكن قوله، ومن يستطيع التحدث من موقع قوة، وأي طرق للمعرفة يُعترف بها طرقًا شرعية. يستند هذا المنظور إلى عمل هاراواي في الدراسات النسوية، إذ تُبيّن هاراواي كيف أن الخطاب العلمي الذي يُقدم نفسه كخطاب موضوعي كان يستبعد فئات كاملة من المجتمع. هذا الإقصاء طال النساء والأشخاص الملونين والفئات المهمشة الأخرى. لم يكن هذا الإقصاء عفويًا، بل جرى بواسطة قواعد لغوية محددة. هذه القواعد تبدو محايدة في الظاهر، لكنها تحمل تصورات مسبقة عن العالم. تعتمد قواعد الكتابة العلمية على عدة تقنيات. منها استخدام المبني للمجهول والأساليب غير الشخصية. كما تتضمن ادعاءات الموضوعية المطلقة. هذه الممارسات هي التي تصفها هاراواي بـ”خدعة الإله”. هذه الخدعة تمنح المتحدث سلطة رؤية كل شيء من موقع محايد مزعوم. في الحقيقة، هذه الرؤية نفسها مشروطة بسياق وموقع محددين. رغم ذلك، تدّعي الحيادية المطلقة وتتجاهل انحيازاتها الضمنية.
تحدي السايبورغ للقواعد النحوية المعيارية
يقدّم بيان السايبورغ الشهير لهاراواي منظورًا مهمًا لفهم الجانب السياسي الكامن في القواعد النحوية. فالسايبورغ، كما تصوّره هاراواي، هو كيان يتجاوز الحدود التقليدية، ويتحدى الثنائيات الراسخة مثل الطبيعة مقابل الثقافة، والعقل مقابل الجسد، والذكر مقابل الأنثى، وهي الثنائيات التي شكّلت أساس الفكر الغربي. كما أن القواعد النحوية الخاصة بالسايبورغ ستكون بطبيعتها مقاومة لهذه الثنائيات الجامدة التي تحكم أنظمة القواعد النحوية المعيارية، مثل ثنائية الصحيح والخاطئ، أو الرسمي وغير الرسمي، أو المعياري وغير المعياري.
إن الطبيعة الهجينة للسايبورغ تفتح المجال أمام إمكانيات متعددة في اللغة، مثل الدمج بين الأساليب النحوية المختلفة، وتبديل الرموز، وتجاوز الحدود اللغوية التي تعتمد عليها السلطات التقليدية في ضبط الخطاب. وكما أن السايبورغ يطمس الحدود بين الإنسان والآلة، وبين العضوي والاصطناعي، فإن قواعد السايبورغ النحوية يمكن أن تدمج بين تقاليد لغوية متنوعة، فتنتج أساليب تعبير جديدة يصعب تصنيفها ضمن التسلسلات الهرمية القائمة في اللغة. ويُعد هذا التهجين النحوي تحديًا مباشرًا لمشاريع “النقاء اللغوي” التي تبنّتها القواعد النحوية تاريخيًا، والتي سعت إلى رسم خطوط فاصلة واضحة بين ما يُعتبر استخدامًا صحيحًا وما يُعتبر خاطئًا.
يعبر سايبورغ هاراواي أيضًا عن رفض لفكرة “قصص الأصل” التي تُستخدم لتأسيس السلطة على أسس يُقال إنها طبيعية أو تقليدية. فعادة ما تبرر القواعد النحوية المعيارية وجودها بالاعتماد على سوابق تاريخية أو ضرورات منطقية، لكن منظور السايبورغ يكشف أن هذه المبررات ما هي إلا سرديات مصنوعة تخدم مصالح محددة. ومن هنا، فإن قواعد السايبورغ النحوية ستكون قواعد مُعلنة بوضوح ومؤقتة وقابلة للتعديل وفق الاحتياجات المتغيرة، بدلًا من الادعاء بأنها قواعد أبدية وصحيحة في جميع الأوقات.
اللسانيات النسوية والمقاومة النحوية
لا ينفصل تحليل هاراواي عن تراث الدراسات اللسانية النسوية التي كشفت، على مدى عقود، كيف تحمل اللغة في طياتها تحيزات جندرية عميقة. فقد أظهرت النسويات كيف تشفر القواعد النحوية المنظورات الذكورية فتبدو وكأنها “معيارًا كليًا”، بينما تُوصَمُ التجارب الأنثوية بالهامشية أو الشذوذ. على سبيل المثال، يحوِّل استخدامُ “هو” ضميرًا “عامًا” الرجلَ إلى مرجعيةٍ كونية، بينما تُختزل المرأة إلى مجرد استثناء. أو يُفرض علينا، حتى اليوم، أن نُخاطب المجموعات المختلطة بضمائر ذكورية، وكأن وجود النساء مجرد ظلٍّ باهت. ولا ننسى كيف ظلّت أصوات النساء مستبعدة من سجلات اللغة الرسمية لقرون، كأن التاريخ يُكتب بلسان الرجل وحده. هذه ليست مجرد تفاصيل لغوية عابرة، بل أدواتٌ تكرّس هيمنةً أبويةً تخترق حتى أبسط قواعدنا النحوية.

لا يقف إسهام هاراواي عند كشف هذه التحيزات اللغوية، بل يغوص أعمق ليبيّن كيف تتشابك مع أنظمة قهرٍ أوسع، حيث يذوب الجندر في خيوط العرق والطبقة والجنسانية وغيرها من أشكال الاختلاف الاجتماعي. فمن خلال مفهومها للتقاطعية، الذي طورته بالحوار مع مفكرين مثل كيمبرلي كرينشاو، تتجاوز هاراواي التحليل الأحادي للغة. تُظهر أن “سياسة القواعد النحوية” لا تُفكك بمجرد تتبع التحيز الجندري، بل بفهم ذلك النسيج المعقد الذي تتداخل فيه أنظمة الهيمنة، فتتشكل اللغة في نقطة تقاطعها جميعًا.
تُظهر هذه الرؤية التقاطعية كيف أن القواعد النحوية ليست مجرد أداة محايدة، بل هي في الواقع سلاحٌ غير متكافئ – يضرب بقسوة حين تتراكم هوامشُ متعددةٌ في حياة الإنسان. تخيّل امرأةً سوداءَ يُوصمُ كلامُها بـ”الجهل” لمجرد خروجها عن القواعد النحوية السائدة، بينما يُغتفرُ نفسُ “الخطأ” إذا صدرَ عن رجلٍ أبيضَ متعلم. أو فكّروا في عاملٍ بسيطٍ يُسخرُ من لهجته العامية، بينما تُعتبرُ أخطاءُ النحوِ ذاتُها “سِمةً شخصيةً ظريفة” حين ينطقُ بها أبناءُ النخبة. هنا لا نتعامل مع تحيزاتٍ منفصلةٍ يمكن عزلُها، بل مع شبكةٍ معقدةٍ من القهر اللغوي الذي ينسجُ خيوطَ الجندر والعرق والطبقة في آنٍ واحد. هذا ما تمنحنا إياه هاراواي: عدسةً نرى من خلالها كيف تتحولُ القواعدُ النحويةُ من أداةٍ للتواصل إلى أداةٍ للفرز الاجتماعي، تُحددُ من يُسمعُ صوتُه، ومن يُنبذُ كلامُه قبل أن يُنطق.
تقنيات الكتابة والسلطة النحوية
تفتح هاراواي نافذةً جديدةً لفهم السياسة الكامنة في القواعد النحوية من خلال عدستها التكنولوجية، فتكشف كيف أن أدواتنا الكتابية – من المطبعة القديمة إلى برامج تصحيح النحو الآلي اليوم – لم تكن محايدةً قط، بل تشكلت دومًا وفق موازين القوة السائدة. تاريخيًا، ارتبط توحيد القواعد النحوية ارتباطًا وثيقًا بصناعة الاتصال الجماهيري، حيث ساهمت المطبعة في ترسيخ لهجة النخبة كـ”لغة معيارية”، بينما تحولت اللهجات المحلية إلى مجرد “أخطاء” يجب تصحيحها. اليوم، تستمر هذه الدينامية عبر تقنياتنا الحديثة: فخطوط التصحيح الحمراء في برامج الكتابة تعمل كحراس غير مرئيين للغة “المقبولة”، ومنصات التواصل الاجتماعي تكرّس هيمنة لغوية جديدة، حيث ترفع بعض اللهجات إلى مصاف الظواهر العالمية، بينما تهمش أخرى كعلامات على “الجهل” أو “الرداءة”. في كل عصر، تتحول التكنولوجيا إلى أداة لغربلة الأصوات، فتوسع مساحة بعضها بينما تضيّق على أخرى، تماماً كما فعلت المطابع قديماً حين قررت أيّ اللهجات تستحق أن تُطبع وأيها تستحق أن تُمحى.
في عصرنا الرقمي، تخلق التقنيات الجديدة مفارقة لغوية مثيرة للاهتمام: فهي من ناحية تفتح أبوابًا غير مسبوقة للإبداع النحوي والتحدي اللغوي، ومن ناحية أخرى تفرض قيودًا خفية لكنها قاسية. تخيل تلك اللحظة المحبطة حين يحكم برنامج تصحيح النحو تلقائيًا على جملتك العامية بأنها “خطأ”، أو حين تدفن خوارزميات التواصل الاجتماعي منشوراتك لأنها لا تتوافق مع المعايير اللغوية للنخبة. هذه ليست مجرد أخطاء تقنية عابرة، بل هي استمرار للصراع التاريخي حول من يملك حق تحديد “ما هو صحيح” لغويًا.
تذكرنا رؤية هاراواي بأن هذه الأدوات الرقمية ليست محايدة، بل هي ساحات صراع جديدة في الحرب الدائمة على السلطة اللغوية. المسألة التي تطرحها ليس بخصوص قبولنا بهذه التقنيات أو رفضنا لها، بل بخصوص تسخيرها لخدمة التعددية اللغوية بدلاً من قمعها. كيف يمكننا تحويل هذه المنصات من أدوات رقابة لغوية إلى مساحات للتحرر اللغوي؟ كيف نضمن أن تعكس خوارزمياتنا التنوع الثري للغات البشر بدلاً من فرض لغة واحدة مهيمنة؟ هذه التحديات تضعنا أمام مسؤولية إعادة تصور علاقتنا مع التقنية واللغة معًا.
نحو سياسة المساءلة النحوية
في عملها المتأخر حول”قابلية الاستجابة” والعلاقات بين الأنواع، تطرح هاراواي رؤيةً ثوريةً للسياسة النحوية تتجاوز الثنائيات التقليدية. فهي لا تدعو إلى معايير نحوية جامدة تفرض هيمنةً لغوية، ولا تنحاز إلى النسبية المطلقة التي قد تُفقدنا إمكانية التواصل الفعّال. بل تقدّم بديلاً ثالثًا: “المساءلة النحوية” – ذلك الموقف الأخلاقي الذي يجمع بين الوعي بآثار خياراتنا اللغوية والانفتاح على تعددية التعبير. هذا المنظور يشبه إلى حد كبير محادثةً دائمةً بين لغات العالم ولهجاته، حيث كل مشارك يتحمل مسؤولية تأثير كلماته، بينما يظل متقبلاً لاحتمالات التعبير المختلفة. إنه يشبه بستانيًّا ماهرًا يعتني بحديقة لغوية متنوعة، يعرف متى يرشّد النمو ومتى يفسح المجال للتنوع الطبيعي. السؤال المهم هنا ليس “ما هي القواعد الصحيحة؟”، بل “كيف يمكن لقواعدنا أن تكون أكثر استجابةً وتفاعلاً مع التنوع الهائل للخبرات الإنسانية؟”.
في عصر التكنولوجيا اللغوية والذكاء الاصطناعي، يصبح هذا المنظور أكثر إلحاحًا. فهو يدعونا إلى تصميم أنظمة لغوية قادرة على التعرف على شرعية اللهجات المختلفة، والاستجابة للسياقات الثقافية المتنوعة، مع الحفاظ على إمكانية التفاهم المتبادل. هذه الرؤية لا تمثل مجرد نظرية أكاديمية، بل خريطة طريق لأخلاقيات لغوية جديدة في عالم يتشكل أكثر فأكثر عبر التكنولوجيا الرقمية.
يتطلب هذا المنهج من المتحدثين والكتاب أن يصبحوا أكثر وعيًا بكيفية تأثير اختياراتهم النحوية على الآخرين، خاصة أولئك الذين قد تهمشهم المعايير اللغوية المهيمنة. وهذا يتضمن خلق مساحات للتجريب اللغوي وأشكال التعبير الهجينة ويضمن أيضاً أن جميع أعضاء المجتمع يمتلكون وصولًا للموارد النحوية التي يحتاجونها للمشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية والسياسية.
وتتطلب المساءلة النحوية أيضًا تغييرات مؤسسية في كيفية تدريس اللغة وتقييمها وتنظيمها. وقد تقوم المؤسسات التعليمية بتطوير مناهج أكثر مرونة للتعليم النحوي يحتفي بالتنوع اللغوي ويبني القدرة التواصلية. وقد يعيد ارباب العمل النظر في ممارسات التوظيف التي تستخدم التوافق النحوي كبديل للكفاءة. قد تجرب المؤسسات الإعلامية معايير وأدلة الأسلوب التي تستوعب تقاليد نحوية مختلفة بدلاً من إنفاذ معيار واحد.
خاتمة
تذكرنا هاراواي بحقيقة مؤلمة: قواعد النحو التي نتعلمها في المدارس ليست محايدة أبدًا. إنها تشبه خريطة قديمة يرسمها الأقوياء، تُمحى فيها معالم التجارب المهمشة. حين نصرّ على “الفصحى” وحدها، ونهمل اللهجات المحلية، فإننا لا نصحح أخطاءً لغوية، بل نُسكت أصواتاً بشرية. كم من قصصٍ ضاعت لأنها كُتبت بلسان “غير معياري”؟ كم من أفكارٍ عظيمة رُفضت لأنها نقلت بقالب نحوي “مختلف”؟
وفي الوقت الذي تتشابك فيه لغات العالم في الفضاء الرقمي، تزداد هذه الأسئلة إلحاحاً. لنتصور طفلاً يكتب رسالته الأولى على هاتف ذكي، فينذره البرنامج بأن جمله “غير صحيحة”. من يقرر ما هو الصحيح هنا؟ ومن يحق له أن يصدر هذه الأحكام؟ هاراواي لا تقدم إجابات جاهزة، بل تدعونا إلى اسئلة أكبر: كيف نبني عالماً لغوياً يتسع للجميع؟ عالمٌ لا تكون فيه القواعد النحوية سياجًا يحبس الإبداع، بل جسرًا يصل بين التجارب الإنسانية المتنوعة. هذه الاسئلة ليست أكاديمية فحسب، وانما هي في صميم العمل من أجل عالم أكثر عدلاً.
عدد التحميلات: 2