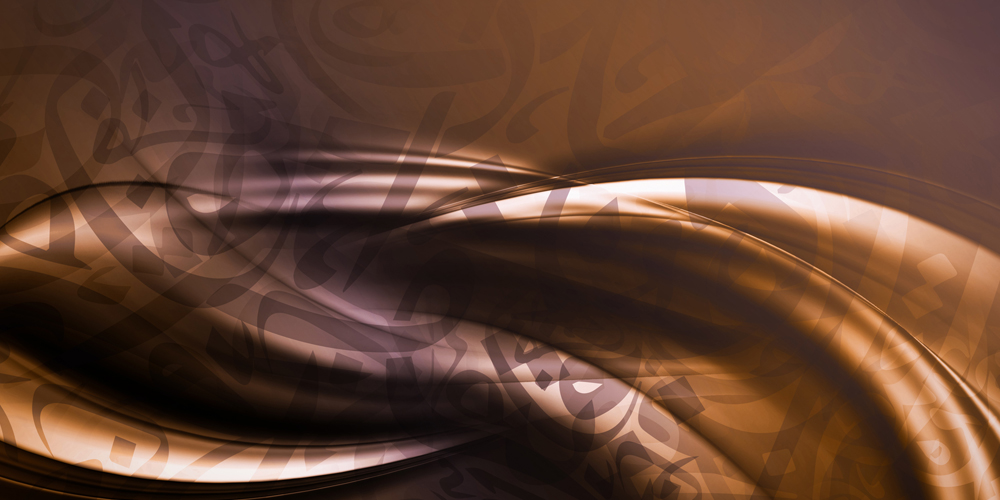
المقدمة
تحتاج الدراسة العلمية في أي مجال من مجالات العلوم المختلفة إلى تحديد مصطلحات خاصة بهذا العلم تكون مفاتيح لفهمه، وقد أدى التسارع الشديد في نمو وازدهار العلوم اللغوية الحديثة إلى تشكل طوفان من المصطلحات اللغوية، التي تتباين وتتفاوت في اللغة الأصل التي أُخذت عنها: فرنسية، ألمانية، روسية، أمريكية، وهي مصطلحات تنتمي إلى مناهج ونظريات، ومدارس متعددة.
ومن المسلم به أنه يستحيل إضفاء الصفة العلمية على أية دراسة لا تستعمل مصطلحات محددة المدلول، إذ إن المصطلحات هي ألفاظ مخصوصة، للدلالة على شيء مخصوص، لدى مجموعة مخصوصة؛ فالمصطلحات في العلم الواحد يجب أن تكون موحدة، وذات دلالة دقيقة على المفاهيم التي تطلق عليها.
فما هو واقع المصطلح في اللغة العربية في العصر الحديث؟ وما الأسباب التي أدت إلى تداول مصطلحات حديثة في الدرس اللغوي الحديث؟؟ وما مدى التزام المصطلح اللغوي الحديث بالقوانين الحاكمة لصياغة المصطلحات؟ وللإجابة على هذه الأسئلة جاءت هذه الدراسة في محاولة لإلقاء الضوء على واقع استعمال المصطلح اللغوي العربي عند المحدثين.
بهدف تبيين واقع المصطلح اللغوي الحديث، ودراسة الأسباب التي أدت إلى تداول مصطلحات لغوية متباينة، وعرض جملة من التوصيات التي خلصت إليها الدراسة.
المصطلح لغة واصطلاحًا:
جاء في معجم لسان العرب(1) أن مادة صلح تعني ضد الفساد، وأنها تدل على خلاف الفساد وتعني الاتفاق.
أما معناه اصطلاحًا فهو: «العرف الخاص، وهو اتفاق طائفة مخصوصة على وضع شيء، وهو لفظ اتفق العلماء على اتخاذه للتعبير عن معنى من المعاني العلمية»(2)، ويذهب الجرجاني إلى أن الاصطلاح هو اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موقعه الأول(3)، ومن خلال تعريف الجرجاني للمصطلح تتضح لنا سمتان يتسم بهما:
الأولى: لا يكون مصطلحًا إلا عند اتفاق جماعة من المعنيين في علم معين على دلالة دقيقة. الثانية: أن المصطلح يختلف عن الكلمات الأخرى، نتيجة تغير دلالي يطرأ على الكلمة، فيجعلها مصطلحًا له دلالة خاصة في حقل خاص.
ونلاحظ أن بين المعنيين اللغوي ولاصطلاحي تقارب دلالي؛ فإصلاح الفساد لا يتم إلا بالاتفاق بين الجماعة المعنية به.
والأصل في المصطلح أن يدل على مفهوم معين في علم من العلوم، وأن لا يلتبس بغيره بحيث متى حضر المصطلح، حضر معه المفهوم، والعلاقة بين المصطلح والمفهوم مبررة عقلية تلازمية، على عكس ما هي في الوضع الأصلي لدلالة الألفاظ على معانيها.
والعلوم مقترنة بمصطلحاتها، لا يقوم العلم إلا بها، وصاحب العلم يحتاج إلى معرفة مصطلحاته، ليكون قائمًا على فهمه، وكلما كان المصطلح دالًا ودقيقًا كان الفهم واضحًا، أما إذا استغلق الفهم على المصطلح فيتعسر فهم العلم لا محالة.
وسائل صياغة المصطلح
أولًا: الاشتقاق
هو أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما معنى ومادة أصلية، وهيئة تركيب لها، ليدل بالثانية على معنى الأصل بزيادة مفيدة لأجلها اختلفا حروفًا وهيئة(4)، والاشتقاق ينشأ من تقاطع المادة اللغوية مع الصيغة الصرفية، وهو أساسي في وضع المصطلحات.
ثانيًا: التعريب
وهو أمر مفروغ منه في وضع المصطلحات، يقول الدكتور صبحي الصالح: «إن تبادل التأثر والتأثير بين اللغات قانون اجتماعي، وإن اقتراض بعض اللغات من بعض ظاهرة إنسانية»(5)، ويقول في توضيح مفهوم التعريب: «إن هذه الحروف بغير لسان العرب في الأصل، ثم لفظت بها العرب بألسنتها فعربته، فصار عربيًا بتعريبها إياه، فهي عربية في هذه الحال أعجمية الأصل»(6)، ولا نلجأ للتعريب في المصطلحات إلا عند الضرورة، انسجامًا مع طريقة العرب القدامى في تعريبهم(7)، وإحياءً للفصيح من العربية وتجنبًا للدخيل، مع إنزال اللفظ المعرب منازل الأوزان العربية باختيار وزن عربي مناسب له على نحو تعريب كلمة «Phyzique» فيزياء بالألف الممدودة، ويرى الدكتور عبدالوهاب النجم ضرورة عدم اللجوء إلى التعريب فيما إذا تمكنت الترجمة الدقيقة للمصطلحات من الإيفاء بالغرض يقول: «يتوجب ترجمة جميع المصطلحات الأجنبية إلى العربية عند وجود ما يقابلها وما يؤدي معناها في لغتنا، وبعبارة أخرى أن تحتل الترجمة المرتبة الأولى في عملية النقل وهذا مؤشر لمدى سعة اللغة العربية، وما تتمتع به من مظاهر الحياة والتطور»(8).
ثالثًا: الترجمة
وتقوم الترجمة الدقيقة مقام التعريب إذا كانت تراعي اللفظ العربي الأمثل لأداء مدلول اللفظ الأعجمي، ويتطلب ذلك أن يكون المترجم عالمًا بأسرار العربية، والإحاطة بتقنيّات الترجمة الأساسيّة، ابتداءً من التحليل البنيويّ للنصّ الأجنبيّ وانتهاءً بالصياغة السليمة للمصطلح، ومرورًا بكيفيّة التعامل مع السوابق واللواحق واللواصق وغيرها من قضايا علم الترجمة، وتتطلب أيضًا فهما عميقًا للغة العربية، وذلك لاختيار المصطلح المناسب الذي يربط المادة اللغوية بالمفهوم الاصطلاحي ربطًا دقيقًا..
رابعًا: النحت
تلجأ العربية إلى النحت في صياغة وتعريب المصطلحات، ولكن ذلك مقيد عند الضرورة، لأن أساليب الاشتقاق الشائعة تغني عنه.
السمات العامة لوضع المصطلح
- ينبغي توخي الدقة والدلالة المباشرة، وكلتاهما سمة جوهرية في وضع المصطلحات؛ فلغة العامة تختلف عن لغة الخاصة، ويندرج في باب الدقة والتخصص أن يكون للمفهوم الواحد مصطلح واحد في الحقل الواحد، وكذلك ينبغي تجنب تعدد الدلالات للمصطلح في علم من العلوم.
- يتسم المصطلح بسمة الوظيفية، حيث يدل على معنى التعريف، ويكون فهمه خاصًا بأهل العلم المعنيين به، ويستغلق فهمه على من ليس له علاقة بهذا العلم.
- ليس من الممكن أن يحمل المصطلح كل الصفات والمعلومات الواردة في المفهوم، ولكن يشترط وجود مناسبة أو مشاركة بين المدلول اللغوي والمدلول الاصطلاحي.
عرض تطبيقي لواقع المصطلح اللغوي العربي الحديث
يجد القارئ للكتب التي تتعرض للدراسات اللغوية الحديثة اضطرابًا باستعمال المصطلحات اللغوية عند الباحثين وقد قمت بدراسة المصطلحات اللغوية الواردة في كتابين متقاربين في موضوع البحث، الأول: كتاب «نحو النص، اتجاه جديد في الدرس النحوي» للدكتور أحمد عفيفي وهو صادر عام 2001 في مصر، ويبحث في نحو النص وشروطه، ووسائل الترابط النصي، والفروق بين نحو النص ونحو الجملة وأوجه الالتقاء بينهما.
الثاني: كتاب «نسيج النص، بحث فيما يكون الملفوظ نصًا «للدكتور الأزهر الزناد، وهو صادر عام 1993 في تونس، ويبحث في نحو النص ووسائل الترابط النصي، والفروق الفاصلة بين نحو النص ونحو الجملة، أي أن الكتابين يبحثان الموضوع نفسه ويتقاربان في الفترة الزمنية التي صدرا فيها، غير أن أحدهما صدر في مصر والآخر في تونس، وفيما يأتي عرض لبعض المصطلحات اللغوية التي وردت في الكتابين، ذلك في محاولة لإلقاء الضوء على واقع استعمال المصطلح اللغوي العربي عند المحدثين.
- مصطلح السياق(9) ويقصد به أحمد عفيفي مجموعة الظروف المحيطة بالحدث الكلامي، وقد عبر عنه بمصطلحات عدة منها: سياق الحال في الصفحة (82)، المقام في الصفحة( 83)، سياق الموقف( 72 )، الموقفية في الصفحة (76) رعاية الموقف في الصفحة 75، وقد استعمل الأزهر الزناد مصطلح المقام(10) ويقابل هذه المصطلحات في التراث اللغوي العربي مصطلح المقام.
- مصطلح التداولية(11) ويقصد به أحمد عفيفي العلاقة بين المتكلم والسامع، وقد استعمل الدكتور أحمد عفيفي مصطلحات أخرى للدلالة على المفهوم نفسه وهي: التواصلية في الصفحة (28)، ومصطلح البراجماتية في الصفحة (120) أما الأزهر الزناد فقد استعمل مصطلح التواصلية(12).
- مصطلح التفكيك(13) ويقصد به أحمد عفيفي التحليل، وهو مصطلح متأثر بالنظريات النقدية فيما يتعلق بالنظرية التفكيكية للعالم الفرنسي دريدا، وقد عبر الدكتور أحمد عفيفي عنه بمصطلحات أخرى منها مصطلح التحليل في الصفحة (29)، ومصطلح التجزئة في الصفحة (30)، وقد استعمل الأزهر الزناد مصطلح التفكيك(14) ويقابله في التراث اللغوي العربي مصطلح التحليل.
- مصطلح الإحالة(15) ويقصد به أحمد عفيفي العود الضميري وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وألفاظ التفضيل، وقد قسمها إلى إحالة قبلية، وإحالة بعدية، وإحالة مقامية، وقد استعمل الأزهر الزناد مصطلحي الإحالة على السابق، والإحالة على اللاحق(16) ويقابله في التراث اللغوي العربي مصطلح مرجعية الضمير.
- مصطلح الإعلامية(17) ويقصد بها أحمد عفيفي توقع المعلومات الواردة في النص على سبيل الجدة وقد عبر عنها بمصطلح الإخبارية(18) أيضًا، أما الدكتور الأزهر الزناد فقد استعمل مصطلح الإخبارية(19).
- مصطلحًا التقابل والتطابق (20) ويقصد بهما المقابلة والطباق كما يعرفان في التراث البلاغي العربي، وقد استعمل الأزهر الزناد مصطلح التطابق(21) للمفهوم نفسه بينما استعمل مصطلح التوافق(22) لمفهوم التقابل عند الدكتور أحمد عفيفي.
- مصطلح المتلقي(23) ويقصد به أحمد عفيفي القارئ أو السامع للنص، وهو مصطلح متأثر بالنظريات النقدية الحديثة فيما يعرف بنظرية التلقي، وقد عبر عنه علماء اللغة في التراث العربي بمصطلح السامع، وقد يكون مصطلح المتلقي أعم من السامع لاشتماله على وجهي التلقي السمع والقراءة.
- مصطلح المبدع(24) ويقصد به أحمد عفيفي المتكلم أو الكاتب، وقد عبر عنه في موضع آخر من الكتاب نفسه بمصطلح المنتج(25)، ويقصد به المفهوم نفسه، ويقابله في التراث اللغوي العربي مصطلح المتكلم أو القائل.
- مصطلح الاستبدال(26) ويفصد به أحمد عفيفي تبديل عنصر لغوي مكان عنصر لغوي آخر، وقد عبر عنه الأزهر الزناد بمصطلح وحدات متبدلة(27).
- مصطلح الوحدة النحوية(28) ويقصد بها أحمد عفيفي الكلمة التي تتكون منها جمل الكلام، ويقابلها في التراث اللغوي العربي مصطلح الكلمة سواء أكانت اسمًا أو فعلًا أو حرفًا.
- مصطلح التوزيع(29) ويقصد به أحمد عفيفي العلاقات الإسنادية بين الكلمات التي تتألف منها الجملة، ويقابلها في التراث اللغوي العربي مصطلح الإسناد: المسند والمسند إليه.
- مصطلح التناص(30) ويقصد به أحمد عفيفي استفادة الكاتب من نصوص أخرى سبقته، ويقابله في التراث اللغوي العربي مصطلح التضمين أو الاقتباس.
- مصطلح إعادة اللفظ (31) ويقصد به أحمد عفيفي تكرار اللفظة وقد قسمة إلى التكرار الكلي والتكرار الجزئي وشيه التكرار ويقصد بهذا الأخير ما يسمى في البلاغة العربية بالجناس الناقص كما في (اسم، ورسم) والتكرار الجراماتيكي ويقصد به ما يعرف بالبلاغة العربية بالتوازي بين الجمل.
وفي استعراض ثلاثة كتب تبحث في علم الأصوات وهي كتاب : (علم الأصوات) للدكتور كمال بشر صادر في القاهرة، وكتاب: (التشكيل الصوتي) للدكتور سلمان حسن العاني صادر في جدة، وكتاب: (دراسة الصوت اللغوي) للدكتور أحمد مختار عمر صادر في القاهرة، تبين الاضطراب في استعمال المصطلحات للدلالة على المفهوم الواحد ، ومن أمثلة ذلك: مصطلح علم الأصوات الأستاتيكي فقد استعمله الدكتور أحمد مختار بمعنى علم الأصوات الفيزيائي وسماه بالأستاتيكي(32)، أما الدكتور العاني فقد استعمله بمعنى علم الأصوات السمعي(33) ، واستعمل الدكتور كمال بشر هذا المصطلح (الأستاتيكي) بمعنى علم الأصوات الفيزيائي، واستعمل مصطلح علم الأصوات السمعي للدلالة على مصطلح آخر وهو علم الأصوات العضوي(34).
نلاحظ من خلال هذا العرض أن وضعية المصطلح يشوبها الاضطراب وعدم الاستقامة فقد أصبحت المصطلحات اللغوية تحت رحمة الباحثين، فترجم المصطلح الواحد بعشرات الأشكال حتى اختلفت ترجمة وتعريب المصطلح الواحد من بلد إلى آخر، وقد أنتجت هذه الجهود الفردية اتجاها جديدا في معالجة الدرس اللغوي الذي ابتعد يوما عن يوم عن أصول وقواعد اللغة العربية ليرتبط بلغة الثقافة الأجنبية، لذلك اتسم الدرس اللغوي بالغموض في التعبير عن ذاته بمفاهيم ومصطلحات يحكمها التفرد والاضطراب, وفي غياب مؤسسات عربية مراقبة وموحدة لعملية التعريب والترجمة، سادت مجموعة من المصطلحات المتضاربة وغير المتقنة، بل لم تكلف صاحبها سوى عملية التقليد.
ولابد من الإشارة إلى أن اختلاف التصورات والاتجاهات اللغوية كان عاملا وراء ظهور مصطلحات لغوية مترامية الأطراف وغير محددة التوجه، الشيء الذي انعكس على معظم العلماء الذين لم يسلكوا طريقًا واحدًا في تعريب المصطلح، ولم يتفقوا على قاعدة واحدة تساعدهم على مقابلة المصطلح باللفظ العربي، وعلى هذا الأساس، فلا مناص من التأكيد أنه لا يوجد أي اتفاق أو إجماع حول المصطلحات اللغوية الحديثة التي يتم تداولها الآن في الدرس اللغوي. وبالتالي فعوض أن تكون المصطلحات عاملًا مساعدًا على وحدتنا، أصبحت هاجسًا وعائقًا أمام تطويرنا ثقافيًا، ولغويًا، وفكريًا، وبالتالي خلق فجوة مصطلحية داخلية، ولمّا كان المصطلح لفظًا يطلق للدلالة على مفهوم معيّن عن طريق الاصطلاح (الاتّفاق) بين الجماعة اللغوية على تلك الدلالة المقصودة، التـي تربط بين اللفظ والمفهوم لمناسبة بينهما؛ فإن جوهر المشكلة هو الاتفاق بين الجماعة، والأسس والمبادئ التـي يقوم عليها هذا الاتفاق، وسبل تحقيقه، فالمصطلح رمز لغوي محدّد لمفهوم معيّن، أي أنّ معناه هو المفهوم الذي يدلّ عليه هذا المصطلح، وتعتمد درجة وضوح معناه على دقّة موضع المفهوم ضمن نظام المفاهيم ذات العلاقة.
أسباب الاضطراب والتباين في المصطلحات اللغوية الحديثة
يمكن تلخيص أسباب هذا الاضطراب والتعدد في استعمال المصطلحات الحديثة بما يأتي:
- اختلاف التصورات والاتجاهات اللغوية، والتنوع في مصادر التكوين العلمي للغويين يؤثر بشكل سلبي في مسالة توحيد المصطلح، إضافة إلى توزيع اللغويين عبر مشارب معرفية مختلفة، فرنسية، وإنجليزية، وألمانية، وأمريكية مما يعكس النزعة الإديولوجية التي تطبع أبحاثهم.
- الجهود الفردية التي بذلت في وضع بعض المصطلحات دون تنسيق جماعي، ولا تكتل مجامعي، إضافة إلى اختلاف الآليات التي تولد المصطلح من مجمع أو معهد لغوي إلى آخر، بل من لغوي إلى آخر مما يعكس أن عملية التنسيق غائبة وغير حاضرة بأي شكل من الأشكال، مما انعكس سلبا على فهم وإدراك الدرس اللغوي الحديث، وخلق حاجزًا بين مصطلحاته.
- الطريقة المتبعة من طرف مجموعة من المؤسسات أو المجامع التي تضطلع بصوغ المصطلح فندرك أن مصطلحًا واحدًا يمكن أن يصاغ بناء على ترجمة المعنى، أو بناء على التعريف أو بناء على نقل اللفظة الأجنبية إلى اللغة العربية مع إخضاعها للصوت والنطق العربي.
- وجود المترادفات الكثيرة الدالّة على مفهوم واحد، ويمكن أن تعدّ المترادفات سببًا ومظهرًا للتشتّت في آن واحد. وقريب من الترادف أيضًا ظاهرة المشترك اللفظي، إذ قد يطلقون مصطلحًا واحدًا على عدد من المفاهيم ومقابل عدد من المصطلحات الأجنبية؛ بسبب عدم الوضوح والدقة.
- ضعف الاتصال الثقافي بين الأقطار العربية وواقع التبادل العلمي الجامعي العربي الضئيل.
المؤسسات المعنية بصياغة وتوحيد المصطلحات
أولًا: المنظمة الدولية للتوحيد المعياري
مسؤولية هذه المنظمة هي وضع المقاييس والمواصفات الموحدة في العالم، وفروع هذه المنظمة موزعة على العالم كله، وفي الوطن العربي تنتظم فروعها الوطنية في منظمة قومية هي المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس التي تتخذ العاصمة الأردنية – عمان – مقرًا لها وهي تتضمن لجنة مختصة بالمصطلحات، وقد قررت اللجنة أن يكون نطاق عملها هو التوحيد المعياري لطرق وضع المصطلحات وتصنيفها وتنسيقها(35)، وقد حققت هذه المنظمة نجاحات مشهودة في مجال توحيد المقاييس والمعايير في عالم الصناعة، ولكن توصياتها الخاصة بتوحيد المصطلحات معياريًا لم تحقق ذات النجاح؛ لأن التعامل مع اللغة ليس كالتعامل مع الآلات، واللغة هي جزء من السلوك الإنساني، ولا يمكن إخضاع مصطلحاتها إلى المقاييس المقننة.
ثانيًا: المجامع اللغوية العربية
تتولى المجامع اللغوية العربية وضع المصطلحات العربية، وهذه المجامع هي: مجمع اللغة العربية في دمشق، ومجمع اللغة العربية في القاهرة، ومجمع اللغة العربية في عمان، والمجمع العلمي العراقي، وهي مجامع لغوية تتألف من علماء ولغويين متخصصين في العلوم اللغوية المختلفة، وهم على دراية تامة بالمبادئ العلمية، والأسس الموضوعية لوضع المصطلحات وتوحيدها.
وقد بدأ اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية العمل على تحقيق أهدافه منذ تأسيسه، حيث عني بتنظيم الاتصال بين المجامع اللغوية، وأولى معجمات المصطلح التي تصدرها المجامع والمؤسسات العلمية جل اهتمامه بغية تيسير تعريب التعليم العالي، وتوحيد المصطلحات في أرجاء الوطن العربي ونشرها، والعمل على متابعة تطبيقها، وقام بعقد الندوات الرامية لتحقيق ما يصبو إليه، ونشر ما توصل إليه في هذه الندوات في كتيبات خاصة.
ويواصل اتحاد المجامع العمل على تحقيق ما يناط به من مهام أملًا في توحيد المجامع في مجمع واحد نظرًا لوحدة الأهداف والآمال والآلام وسعيًا للم شتات الأمة العربية بوساطة لغة واحدة موحدة.
ثالثًا: دور مؤسسات التعليم العالي
ينبغي أن تقوم الجامعات العربية بدور قومي كبير يستمد أهميته من طبيعة المرحلة التاريخية التي تعيشها أمتنا العربية حاليًا، ويتمثل هذا الدور بالجهد المبذول في توحيد المصطلحات، وما سيحققه هذا الجهد من وحدة في المفاهيم التي نعني وحدة في التفكير، أي أنها وحدة في الوجود العربي، وحتى تقوم الجامعات العربية بهذا الدور يتطلب منها الالتزام بما يأتي:
- نشر الوعي المصطلحي بين الأساتذة اللغويين فهم أولى الناس بتوحيد المصطلحات اللغوية.
- إثراء مكتبات الجامعة بكل ما يستجد من معاجم في المصطلحات اللغوية موثوق بها.
- إيجاد مركز للمصطلح اللغوي في اتحاد الجامعات العربية يقوم بمهمة متابعة ما يستجد من مصطلحات.
- متابعة الجامعات مدى التزام الأساتذة في تدريسهم وبحوثهم فيما وحد من مصطلحات لغوية
- تنشيط لجان التعريب الجامعية، وتحفيزها ماديًا ومعنويًا والإشراف عليها بشكل جدي ومثمر، وإشراكها في الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بالمصطلح اللغوي.
- إقامة دورات للأساتذة اللغويين على المستويين القطري والقومي يتم فيها الاطلاع على آخر الجهود المبذولة في منهجية توحيد المصطلحات اللغوية
خطوات توحيد المصطلحات اللغوية الحديثة
- حصر المصطلحات المختلفة في التعبير عن مفهوم معين، وتحديد معانيها عن طريق تعريفها.
- الاتفاق على تعيين مصطلح واحد من المصطلحات المترادفة للتعبير عن ذلك المفهوم، أو الاتفاق على وضع مصطلح جديد للتعبير عنه إذا ثبت عدم صلاحية المصطلحات المستعملة.
النتائج والتوصيات
- لا يوجد اتفاق أو إجماع حول المصطلحات اللغوية الحديثة التي يتم تداولها الآن في الدرس اللغوي. وبالتالي فعوض أن تكون المصطلحات عاملا مساعدا على وحدتنا، أصبحت هاجسًا وعائقًا أمام تطويرنا ثقافيًا، ولغويًا، وفكريًا، وبالتالي خلق فجوة مصطلحية داخلية.
- أدى اختلاف التصورات والاتجاهات اللغوية، والتنوع في مصادر التكوين العلمي للغويين إلى التباين والاضطراب في صياغة المصطلحات اللغوية، إضافة إلى الاعتماد على الجهود الفردية، وغياب التنسيق الجماعي، ووفرة المترادفات في اللغة العربية.
- يتوجب الضبط الدقيق للحالات التي ينبغي فيها ترجمة المصطلح، والحالات التي يجب فيها تعريبه، واللجوء إلى الوسائل التي بموجبها اشتغل الباحثون في المجال الاصطلاحي وهي: الاشتقاق، والنحت، والتوليد، والعمل على إيجاد المقابل العربي وتجنب الوافد الأجنبي ما أمكن.
- ينبغي أن تقوم المؤسسات العلمية المعنية بالمصطلحات بدوها الطليعي، وتعمل على صياغة المصطلحات وفق أسس ممنهجة موحدة، ومن هذه المؤسسات: المجامع اللغوية العربية، ومؤسسات التعليم العالي.
- خطوات توحيد المصطلحات اللغوية الحديثة هي: حصر المصطلحات المختلفة في التعبير عن مفهوم معين، وتحديد معانيها عن طريق تعريفها، ثم الاتفاق على تعيين مصطلح واحد من المصطلحات المترادفة للتعبير عن ذلك المفهوم، أو الاتفاق على وضع مصطلح جديد للتعبير عنه إذا ثبت عدم صلاحية المصطلحات المستعملة.
الهوامش:
1 – انظر ابن منظور، محمد بن مكرم – لسان العرب – 1990 – دار صادر – بيروت.: مادة صلح.
2 – مطلوب، أحمد – بحوث لغوية – 1987- دار الفكر للنشر والتوزيع – عمان:207.
3 – الجرجاني، علي بن محمد – كتاب التعريفات – 1985 – مكتبة لبنان – بيروت: 28.
4 – السيوطي، أبو الفضل جلال الدين عبدالرحمن بن الكمال – المزهر في علوم اللغة وأنواعها – شرح وضبط: محمد أحمد جاد المولى وآخرين – ط3 – دون تاريخ دار التراث – القاهرة: 1: 346.
5 – الصالح، صبحي – دراسات في فقه اللغة – 1960 – دار العلم للملايين – بيروت: 317.
6 – المرجع السابق 317.
7 – انظر المزهر1: 283.
8 – بحب بعنوان المصطلح العلمي بين الترجمة والتعريب – محمد عبد الوهاب نجم – مجلة اللسان العربي – العدد 32 – 1989.
9 – انظر عفيفي، أحمد – نحو النص ، اتجاه جديد في الدرس النحوي – 2001 _ مكتبة زهراء 10 – الشرق – القاهرة :74.
11 – انظر الزناد ، الازهر – نسيج النص ، بحث في ما يكون به الملفوظ نصًا – 1993 – المركز – الثقافي العربي – بيروت: 16.
12 – انظر نحو النص 103.
13 – انظر نسيج النص 15.
14 – انظر نحو النص 28
15 – انظر نسيج النص 75.
16 – انظر نحو النص 116.
17 – انظر نسيج النص 75.
18 – انظر نحو النص 86.
19 – انظر المرجع نفسه 86.
20 – انظر نسيج النص 15.
21 – انظر نحو النص 39.
22 – انظر نسيج النص 68.
23 – انظر نسيج النص 68.
24 – انظر نحو النص 9.
25 – انظر نحو النص 9.
26 – انظر المرجع السابق 76.
27 – انظر نحو النص 122.
28 – انظر نسيج النص 65.
29 – انظر نحو النص 17.
30 – انظر المرجع السابق 17.
31 – انظر المرجع السابق 28.
32 – انظر المرجع السابق 107.
33 – انظر عمر ، أحمد مختار – دراسة الصوت اللغوي – 1997 – عالم الكتب – القاهرة: 19.
34 – انظر العاني ، سلمان حسن – التشكيل الصوتي – 1983 – النادي الأدبي الثقافي – جدة: 50.
35 – انظر بشر ، كمال – علم الأصوات -2000 – دار غريب للطباعة والنشر – القاهرة: 43.
36 – بحث بعنوان: إشكالية توحيد المصطلح العربي، النظرية والتطبيق – مجلة اللسان العربي – العدد 32 – 1989.
عدد التحميلات: 6



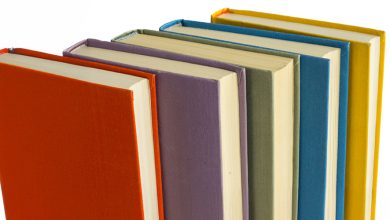


مقال علمي ثريّ بالتحليل والعمق، يسلّط الضوء على واحدة من أعقد إشكاليات البحث اللغوي المعاصر وهي اضطراب المصطلح وتشتته بين المناهج والمدارس. لعل ما يميز هذا البحث هو الجمع بين التأصيل التراثي والتحليل اللساني الحديث، مما يبرز الحاجة الملحة إلى هيئة عربية موحدة تُعنى بتقنين المصطلحات وضبطها توحيدًا للجهد العلمي وتحصينًا للغة من الفوضى المفهومية.
تحية تقدير للدكتورة هالا مقبل على هذا الطرح الواعي، ولـ مجلة فكر الثقافية على اهتمامها الراقي بموضوعات اللغة والفكر
كل الاحترام والتقدير الأخ الموقر شاعر النبراس وأشكرك على المتابعة والاهتمام وأرجو من الله أن أكون عند حسن ظنكم بي وكل الشكر لمجلة فكر التي أتاحت لنا هذا المنبر الثقافي . مع كل الود