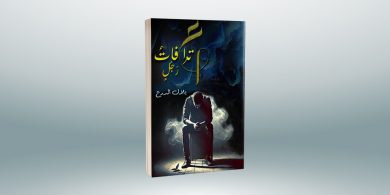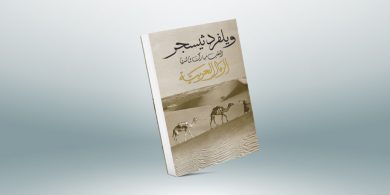لا يقتصر تيار اليسار كله على حركات سياسية أو أحزاب، فهو في الأساس تيار فكري، يجمع أشتاتًا مختلفة، بعضها منظم في أحزاب وجماعات، وبعضها يؤمن بالفوضوية، ومن المنضوين في سياقه العام ويحملون مسمى «جماعات يسارية»؛ تيار يؤمن بــ«اللا سلطوية»، ويرفع شعارات «الأناركية» أو الفوضوية والذي يمكن اعتباره أقصى اليسار أو اليسارية الراديكالية، وتلك بلا شك لا تحرض على العمل السياسي والوصول إلى السلطة، ولكنها تعني المزيد من الحرية المطلقة فكرًا وممارسات وسلوكًا. فالأناركية: حالة من الثورة الدائمة، التي تتعاطف مع المخالفين، الخارجين عن السلطة، فالأناركي إنسان ثائر يرفض المجتمع بهيئاته ومؤسساته، وهم يعارضون في الوقت نفسه حديث ماركس وإنجلز عن البروليتاريا الرثة. ويرى الأناركيون أن الثورة الحقيقية والتغيير مع هذه الفئة البسيطة الفقيرة، وليست مع البروليتاريا البرجوازية. فهم في المجمل يرفضون الاستبداد وتسلط الدولة الشمولية، وتحويل الإيديولوجية إلى أحزاب ومناصب وبيروقراطيات جامدة (1).
فمبدأ الثورية المستمرة من أهم المبادئ التي تميز «الأناركي»، وتجعله في حالة تمرد دائم، وسعي إلى التحرر، وهو أيضًا رافض للتحجر الإيديولوجي، ويناصر المهمشين والضعاف والطبقات الدنيا في المجتمع. وقطعًا هناك حالات من اليساريين، يؤمنون بهذا التوجه، وإن كانوا قلة في أعدادهم، ولكن طروحاتهم غذَت الكثيرين بالأفكار والرؤى، لأنها ببساطة تعيد نبض الاشتراكية الثورية الطامحة للتغيير، والحالمة بالمجتمع الاشتراكي المثالي، وتحارب الاشتراكيين في المنغمسين في أوحال السياسة، والركض وراء المناصب والأضواء، أو هؤلاء المنظرين الاشتراكيين المهمومين بجدليات فكرية؛ يتجرون بها أفكار وفلسفات سابقة.
ولكن الأناركية في المقابل، لا تعد مثقفًا أو ناشطًا يمكنه التغيير سياسيًا، لأن سلوكه لا يعرف استقرارًا، ويتخيل أن كل شيء يمكن تغييره إذا تحولت الأفكار في الرؤوس وتبدلت، ويتناسى أن القضية أعمق من هذا بكثير، لأنها ترتبط بسلوكيات أفراد وبنية مؤسسات وتشابكات مصالح، لا يمكن تغييرها بسهولة.
كذلك، هناك جدل بين اليساريين أنفسهم حول معنى اليساري، فالبعض يرفض رفضًا قاطعًا أي صلة لليسار بالماركسية والشيوعية واللاسلطوية، بينما يرى البعض الآخر أن اليساري الحقيقي يجب أن يكون شيوعيًا أو اشتراكيًا. وبينما يعتبر الكثيرون النظام الشيوعي في الاتحاد السوفيتي السابق والصين أثناء حكم ماوتسي تونج تيارات يسارية، فإن البعض الآخر يرفض ذلك على اعتبار أن الشمولية التي كانت موجودة في أنظمة الحكم هذه كانت تتبع سياسة قمعية (2).
أما عن علاقة اليسار بالليبرالية، فإن الفكرة السائدة تشير إلى أن دلالة اليساري ترتبط كثيرًا بالفكر الاشتراكي في تجلياته وأطيافه المختلفة. وفي واقع الأمر، فإن اليسار السياسي متفق مع اليمين الليبرالي في العديد من القضايا منها: تبنيه لمنظومة الحريات الشخصية وحقوق الإنسان، وقيم العلمانية واحترام القوانين، والدستور، وقواعد اللعبة الديمقراطية، ولكنهم يخالفون الليبراليين في كون اليساريين أكثر تشددًا في قضايا العدالة الاجتماعية ونقض الرأسمالية وآثارها الوخيمة على الشعوب، وينادون بمنظومة اجتماعية اقتصادية تحمي حقوق العمال والبسطاء والمهمشين، وأهمية الرقابة القوية على الأسواق، ومنع الاحتكار بشكل عام.
فلا عجب أن يظهر ما يسمى «اليسار الليبرالي» المتأثر بتجليات الفكر الماركسي ونقضها للطبقية الأوروبية ونهب المستعمرات، ونتيجة مباشرة لمساهمة الفكر الاشتراكي في تحويل مسارات الاقتصادات الغربية المعتمدة على النظام الرأسمالي وآلياته، حيث تم تطعيم الفكر الرأسمالي بكثير من الأفكار الاشتراكية التي ساهمت في علاج توحش الرأسمالية، وفي إزالة الاستعمار القديم، ومقاومة احتكار القلة، وظهور ما يسمى نظام الاشتراكية الوطنية (3).
على جانب آخر، هناك تيار ما يسمى «الاشتراكية القومية» التي تخالف الاشتراكية الأممية العالمية التي لا تعترف بالوطن، وهي منفصلة عن كل رابطة تاريخية أو اجتماعية، ومتمردة على الدين السائد والأخلاق المعروفة، وبالجملة فهي ثورية إلى أبعد حد، وترتكز طروحات الاشتراكية القومية على أهمية مراعاة الأبعاد الثقافية المتوارثة في الثقافات مثل: العادات والتقاليد، والدين، والعلاقات الاجتماعية، والأصالة التاريخية للشعوب. وهذه الفكرة تزعم وجود تنافر مبدئي بين الشرق والغرب، وبين الثقافتين الغربية والشرقية (الآسيوية والإفريقية)، وتستند هنا إلى اتجاه إنساني، يرى أن الإنسان هو مركز الصدارة، وهو المقياس لكل القيم والمعايير، فيما يسمونه العوامل البشرية للثقافة، والتي تظهر في الشعور بالرفق وروح التعاون المتبادل والإخوة والقدرة على المشاركة. وأن الدين هو رابطة عميقة تكتّل الناس في جماعات متآلفة روحيا، وتقودهم إلى الخير والصفح والمحبة.
يأتي ذلك التيار في مواجهة الاشتراكية الوافدة من الغرب التي تحمل الثقافة الغربية، ونمط حياة الإنسان الغربي البرجوازي، المتكون في المجتمع الغربي العلماني المادي، والذي تقوم علاقاته على المنفعة الشخصية، واستغلال الإنسان، وتحدي الطبيعة، واستخدام العنف في قهر الشعوب المستَعمَرة. وكلها ثقافة تخالف الثقافات الأخرى خاصة الثقافة الشرقية، بما لها من خصوصية دينية واجتماعية. وقد أدى هذا التوجه إلى ظهور اشتراكيات قومية مختلفة: اشتراكية آسيوية، واشتراكية إفريقية، واشتراكية عربية، واشتراكية إسلامية..، وكلها تحمل نضالاً ضد الاستعمار والرأسمالية، ولكن الاشتراكية الأممية ترى أن روحها التقدمية محدودة، مقيدة بأغلال المحلية والقومية، فلن تصبح في يوم ما أساسًا للنضال الناجح من أجل التحولات الاجتماعية العميقة في الحرية والاستقلال(4).
وهذا ما نجده وقد انتشر هذا الفكر في عقود الأربعينيات والخمسينيات والستينيات، في البلدان المتحررة في آسيا وأفريقيا، وربما كانت إيديولوجية حزب البعث معبرة عن هذا التوجه، حيث ترى أن الاشتراكية الأممية توجهت نحو بيئة ونوع من البشر فقد روابطه بالوطن فعلاً تحت شعار أن خطابها للعمال في العالم أجمع لأن الأزمة الاقتصادية والتنافس الرأسمالي القاسي قضوا عليهم، لذا جاء خطابهم مبتورًا عن مجتمعه، قد قطعت جذوره من أرضه وقوميته، فلم تبق له إلا تلك الصفة الحيوانية التي تقتصر على الغذاء فقط، ولم يعد العامل غير مخلوق، لا يهتم إلا بما يغذي جسمه وينقذه من الجوع. أما المؤسسات الفكرية والروحية في الأمم الغربية فقد وقفت على الغالب في صف الرأسمالية المستثمرة. فالدين انحاز إلى الحكومات الرأسمالية وأخذ يحميها بنفوذه ويدافع عنها، والفكر بصورة عامة انحاز إلى الطبقة المحافظة، أي أن الكتّاب وممثلي الفكر أخذوا يدافعون عن الوضع الراهن والماضي ويطلبون المحافظة عليه والدفاع عنه، فأدى هذا إلى حدوث تلك الموجة الطاغية من الثورة والتطرف اللذين حملت الاشتراكية لواءهما.
إن الاشتراكية في الغرب اضطرت إلى الوقوف ليس ضدًا للرأسمالية فحسب، بل ضدًا للقومية أيضًا التي حمت الرأسمالية، وضد الدين الذي دافع عنها، وضد كل فكرة تدعو إلى المحافظة وتقديس الماضي، كل ذلك لأن الرأسمالية استغلتها للدفاع عن مصالحها، فباتت عدوة للحركة الاشتراكية.
أما الاشتراكية المأمولة في مجتمعاتنا فهي الاشتراكية المتلائمة مع ثقافة الأمة ونضالها القومي فلا تكون أداة للتآمر على الوطن، وعامل تفرقة أو ستارًا لحركات شعوبية، فنحن نريد من الاشتراكية أن تخدم قضيتنا القومية، بأن تزيدنا جرأة في الإقدام على حرية التفكير وعلى المناداة بحرية الفرد والدعوة إلى خصب الروح وغناها، لا ان تقضي على حريتنا الوليدة في مهدها(5).
لقد كانت الفكرة القومية في مزجها بالاشتراكية، تحمل رؤية «المجموع/ الشعب/ الجماهير» ورغبتهم في الخلاص من التأخر والتخلف، ونظرت إلى الأفكار القومية والاشتراكية على أنها رؤى تحررية تعالج مشكلاتها، فالجماهير هم المضخة الحقيقية لنجاح أي تجربة قومية سياسيًا والتعويل عليهم أساس لذلك، فلابد من مراعاة ثقافتهم والدين أساس لها، على نحو ما نرى في الثقافة العربية، فلا ضرورة لأية حركة تجعل الدين خصمًا لها، بل إن «عفلق» يعدّ الإسلام دينًا أنهض القومية العربية، وجعلها تندفع لبناء حضارة زاهرة(6). ونفس هذا التوجه نجده في التجربة الناصرية (نسبة لعبدالناصر في مصر)، حيث وضع القومية العربية ضمن إيديولوجية نظامه، مع سعيه إلى التطبيق الاشتراكي في المجتمع، وجعل هناك ثلاث دوائر تتحرك فيها الدولة وهي الدائرة العربية والإسلامية والإفريقية، التي هي مكونة للوطن، واعترف بأهمية الدين في الثقافة المصرية/ العربية، وعدّه رافدًا أساسيًا للفكر القومي العربي. وقد اختلطت الدعوة بالبعد الشخصي لعبدالناصر ورغبته في الزعامة لمئة مليون عربي، ومئتي وعشرين مليون إفريقي، وأربعمئة مليون مسلم، وبالطبع كان اتجاهًا فرديًا(7).
كما أن الاشتراكية جاءت ضمن الهجمة الاستعمارية الغربية على الشرق عامة، بما جلبت معها من قناعة مسبقة أساسها ثنائية الغرب والشرق أو بالأدق الغرب وبقية العالم، أي الغرب المستعلي على الشعوب الفقيرة في الشرق، فلما احتك الغربيون بالشرق، ورأوه عن كثب، ثم تحررت دول الشرق من الاستعمار الأجنبي، حدثت تحولات ثقافية في الاستشراق، وتراجعت النظرة المحورية الأوروبية للعالم، وأضحت هناك هويات متداخلة، وازدهر التبادل الثقافي، وبدأ الغرب يعيد إنتاج هويته، ويراجع موقفه من العالم حوله، ومن الشرق الذي هو طائفة متنوعة ومتعددة الشرائح من العوامل الثقافية والحركات الفكرية المنبثقة عن ضروب متباينة من الأوضاع التاريخية(8). وهذا التوجه امتد إلى الاشتراكيين العرب أنفسهم، الذين وجدوا مجتمعاتهم لا تتقبل الفكرة الاشتراكية في سياقاتها الثقافية الغربية، ولا في مصطلحاتها الفلسفية المنقولة كما تلفظ في لغاتها، فبدأت محاولات جادة للبحث عن هوية للاشتراكية عبر إعادة قراءتها في سياقاتها الثقافية والاجتماعية المحلية.
وفي ضوء ما تقدم، يمكن قراءة واقع ومستقبل اليسار العربي عامة واليسار المصري جزء منه في القرن الواحد والعشرين، والتأثرات التي بات عليها، فمن الخطأ أن لا نعي الحركة الفكرية والتغيرات الإيديولوجية التي ألمّت باليساري العالمي، وإلا كيف سنفهم تطور اليسار في بلادنا، فالانطباع الشائع أن اليساريين هم المنضوون تحت الأحزاب الشيوعية القديمة، أو بقايا الحقبة الاشتراكية التي قويت وازدهرت في فترة الخمسينيات والستينيات، وأن الشباب الحالي هم امتداد لهم. والواقع غير ذلك، فالأجيال اليسارية الجديدة تخالف الأجيال القديمة، كما أن القدامى تبدلوا فكريًا وطوروا قناعاتهم وصاغوها بخيال سياسي جديد، وبعضهم غيّر من قناعاته الاشتراكية من الأساس وتحول إلى الإسلامية أو الليبرالية أو انكفأ على ذاته الفردية، وهناك آخرون تمسكوا برؤاهم، متجمدين في شيخوختهم على ما استهلوا به شبابهم/ واكتفوا باجترار ذكرياتهم، متحسرين على حقبة اشتراكية عربية وعالمية. وهناك أيضًا تواصل مع اليسار العالمي الجديد، وأعاد طرح رؤى تقدمية اجتماعية ديمقراطية، على يقين أن حركة اليسار هي قيم ومواقف وسلوكيات، تواجه جبروت الاستبداد، وتحارب طغيان رأس المال، وتسلط الفاسدين.
الهوامش:
1) الأناركية من النظرية إلى الممارسة، دانييل غيران، ترجمة: حسن دبوق، الأرشيف الأناركي العربي، 2012م، ص18، 19.
2) مفهوم اليسارية، أحمد العتوم، موقع المعهد العربي للبحوث والسياسات، http://www.airssforum.com/forum/ وقد استخدم الحزب الشُّيُوعي في روسيا مفهوم اليسار في عام 1918، على يد جماعةٍ رأَسَها «نيكولاي بوخارين»، تدعو إلى شنِّ الحرب الثَّوْرية على سياسة «لينين»، وإلى قيادة البروليتاريا للاقتصاد، ورقابتها على المشروعات الصناعية.
عرَّف «كولا كويسكي» اليسار بأنه حركة نفْيٍ للعالَم القائم، أما «كارلأوجنسي» فرآه الرغبةَ في التقدُّم، والإيمانَ بأن الإنسان سينتصر في النهاية. وتُعتبر فكرة «الثورة وتغيير الأوضاع» أوَّلَ فكرة يرتبط بها مفهوم اليسار. ا. ه. وربما تكون جذوة الأناركية.
3) انظر تفصيلًا: تاريخ الفكر الاقتصادي: الماضي صورة الحاضر، جون كينيث جالبريث، ترجمة: أحمد فؤاد نعنع، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، 2001م، ص199- 205.
4) ما هي المنظومة الاشتراكية العالمية ؟، ص14، 15.
5) معالم الاشتراكية العربية، ميشيل عفلق، موقع في سبيل البعث (الكتابات السياسية الكاملة لميشيل عفلق)، http://albaath.online.fr/ .
6) تحولات مفهوم القومية العربية من المادي إلى المتخيل، هاني عواد، الشركة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، 2013م، ص54، 55.
7) انظر تفصيلاً: نظرات في القومية العربية حتى العام 1970 م، الجزء الثاني: سبل ملتوية، جرجيس فتح الله، دار آراس للطباعة، منشورات الجمل، ط1، 2012م، ص1062 -1073. وأيضًا كتاب فلسفة الثورة، لعبدالناصر، طبعة دار الهلال، 1953 في الحديث عن رؤيته للعروبة والإسلام وإفريقية.
8) التنوير الآتي من الشرق (اللقاء بين الفكر الآسيوي والفكر الغربي)، جي. جي. كلارك، ترجمة شوقي جلال، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، 2007م، ص227، 328.
عدد التحميلات: 1