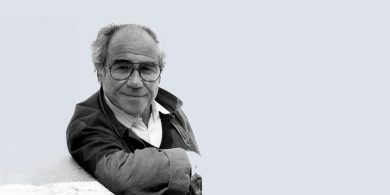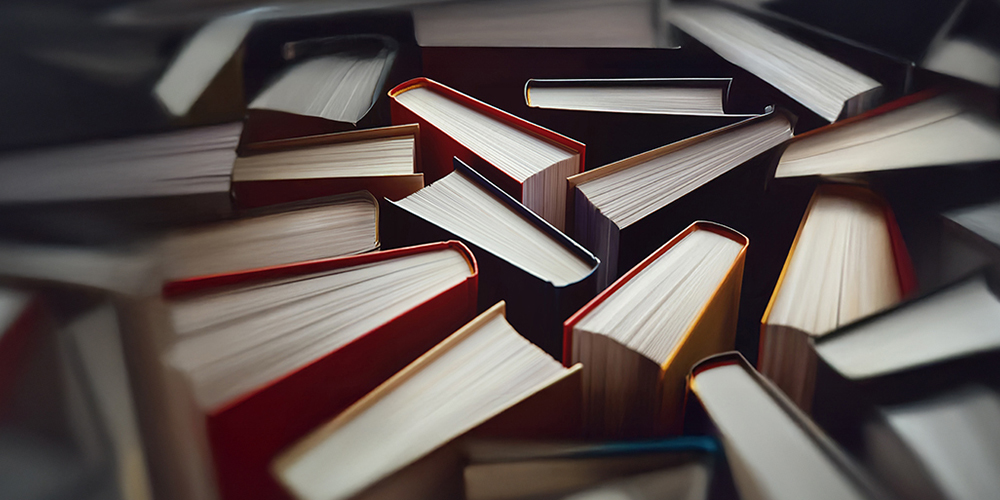
تعريف الاستلاب الثقافي
وفقًا لمحرري الموسوعة البريطانية، ظهر مصطلح الاستلاب الثقافي في الثمانينيات، واستخدم لأول مرة في الأوساط الأكاديمية لمناقشة قضايا مثل الاستعمار، والعلاقات بين مجموعات الأغلبية والأقليات، وفي النهاية شق طريقه مثل العديد من هذه المصطلحات للخروج من الأكاديمية إلى الثقافة الشعبية. ويحدث الاستلاب الثقافي عندما يتبنى أعضاء من مجموعة الأغلبية عناصر ثقافية لمجموعة أقلية بطريقة استغلالية أو مهينة أو نمطية.
في البداية يجب أن نفهم معني كلمة “ثقافة”؛ حتى نتمكن من فهم وإدراك عواقب الاستلاب الثقافي، فتاريخيًا لم يكن تعريف الثقافة أمرًا سهلاً؛ حيث يأتي التفسير الأول والأكثر اقتباسًا من عالم الأنثروبولوجيا الإنجليزي إدوارد بورنيت تايلور، الذي كتب في عام 1871: إن الثقافة تشمل: المعرفة والإيمان والفن والأخلاق والقانون والعرف وأي قدرات وعادات أخرى يكتسبها الإنسان بوصفه عضوًا في المجتمع، ويوضح جيمس أو. يونج (2008) أن الثقافة ليست موروثة بيولوجيًا، إنها الأشياء التي يتعلمها ويفعلها الشخص عندما ينتمي إلى مجموعة معينة، وتشير “الثقافة” إلى سمات معينة لمجموعة من الأشخاص وإلى الأشخاص الذين يتشاركون هذه السمات، ويرى أن الثقافة متغيرة ومتداخلة ومتشابكة (ص 10-13).
ويرى يونج أن بعض الفنانين المنتمين لثقافات مختلفة ينخرطون باستمرار في عملية الاستلاب الثقافي؛ إذ اشتهر (بيكاسو) بالموتيفات/الأفكار التي ظهرت في أعمال النحاتين الأفارقة؛ واستخدم الرسامون الذين ينتمون إلى الثقافة الأسترالية السائدة أساليب طورتها ثقافاتُ السكان الأصليين في أستراليا؛ وضمن (بول سايمون) في موسيقاه عناصر موسيقية لبعض القبائل في جنوب إفريقيا؛ وأعاد الشاعر (روبرت برينجهيرست) سرد القصص التي قدمها فنانون وكتاب منتمون للسكان الأصليين في أمريكا الشمالية؛ واستعار (جوته)، في ديوان الشرق والغرب (1814-1819)، أفكارًا من شمس الدين محمد حافظ، الشاعر الفارسي من القرن الرابع عشر؛ واتخذ الروائيون مثل (توني هيلرمان) و(دبليو. بي. كينسيلا) الثقافات الأصلية لأمريكا الشمالية موضوعًا للعديد من أعمالهم. إن الفنون، والآداب، وبقايا الإنسان، والاكتشافات الأثرية، والبيانات الأنثروبولوجية، والمعرفة العلمية، والمواد الجينية، والأرض، والمعتقدات الدينية، ومجموعة من العناصر الأخرى، خاضعة للاستيلاب الثقافي. وأحيانًا يكون للاستلاب بعدًا دينيًا عندما يكون للعناصر المستلبة أهمية طقوسية أو روحية في سياقها الثقافي الأصلي، ويسبب هذا الاستلاب تدنيسًا لهذه المعتقدات، ويخبرنا علماء الأنثروبولوجيا أن كل ثقافة لديها تصور للأشياء المقدرة لخصائصها الجمالية، ولكن هناك جدل حول ما إذا كان مفهوم الفن عالميًا (ص 1-3). وعندما يعيد روبرت برينجهيرست سرد قصص الهايدا (Haida) الشعرية العظيمة، فإنه يأخذها على أنها ملكه (لإعادة استخدامها)، ونظرًا لأنه ليس هيدا؛ فهو منخرط في الاستلاب الثقافي. ويتبنى إريك كلابتون ثقافة البلوز، ويوظفها في أعماله، وبما أن ثقافة كلابتون ليست تلك التي نشأت فيها موسيقى البلوز؛ لذا فإن استملاكه يعد استيلابًا ثقافيًا.
وقد أثار مصطلح الاستلاب الثقافي كثيرًا من الجدل والنقاش فيما يتعلق بالقضايا الأخلاقية والجمالية التي تنشأ عندما يحدث هذا النوع في سياق الفنون؛ إذ يراه البعض إخفاقًا جماليًا أو غير أخلاقي أو كليهما، وقد يتسبب في إلحاق ضرر بأعضاء الثقافة المستلبة؛ فعلى سبيل المثال قد يحرف العمل الثقافة الأصلية بطريقة ضارة. ويميز بعض الأشخاص بين الاستلاب الثقافي والتبادل الثقافي أو الاقتراض الثقافي، وهو أمر لا يمكن الاعتراض عليه، ومع ذلك فإن العديد من أعمال الاستلاب الثقافي لا يمكن الاعتراض عليها من الناحية الأخلاقية، وبعضها ينتج عنه أعمال فنية ذات قيمة جمالية كبيرة.
أنواع الاستلاب الثقافي
تم تصنيف ما لا يقل عن خمسة أنواع مختلفة تمامًا من الأنشطة على أنها أعمال استلاب ثقافي.
أولاً: يحدث الاستلاب المباشر للأشياء المادية عندما يتم نقل حيازة عمل فني أو آثار مثل الآثار المصرية في الخارج أو اللوحات من أعضاء من ثقافة لأعضاء ثقافة أخرى، ولكن ليست كل حالات الاستلاب من هذا النوع مثيرة للغاية؛ فإذا كنت مسافرًا إلى غينيا، واشتريت قطعة من الفن السياحي المنتج محليًا؛ فذلك لا يعد استيلابًا ثقافيًا.
ثانيًا: الاستلاب على المحتوى/غير ملموس: قد يكون هذا الاستلاب مقطوعة موسيقية أو قصة أو قصيدة، وعندما يحدث هذا النوع من الاستلاب يقوم الفنان بإعادة استخدام فكرة ذات أهمية تم التعبير عنها لأول مرة في عمل فنان من ثقافة أخرى؛ فـــ أكيرا كوروساوا منخرط في الاستلاب على المحتوى؛ حيث استعار الحبكات من مسرحيات شكسبير، وأعاد استخدامها في أفلامه.
ثالثًا: الأسلوب: لا يعيد الفنانون في بعض الأحيان إنتاج الأعمال التي أنتجتها ثقافة أخرى، لكنهم يأخذون شيئًا من تلك الثقافة؛ ففي مثل هذه الحالات ينتج الفنانون أعمالًا ذات عناصر أسلوبية مشتركة مع أعمال ثقافة أخرى، ويمكن القول إن الموسيقيين الذين ليسوا جزءًا من الثقافة الأمريكية الأفريقية ولكنهم يؤلفون أعمال موسيقى الجاز أو البلوز الأصلية قد شاركوا في الاستلاب.
رابعًا: الأفكار (الموتييف): يحدث ذلك عندما يتأثر الفنانون بفن ثقافة غير ثقافتهم دون إنتاج أعمال بنفس الأسلوب؛ فأفكار بيكاسو، على سبيل المثال في آنسات افينيون (1907)، مستوحاة من النحت الأفريقي، لكن لوحته ليست بأسلوب أفريقي. وبالمثل، فإن الشريط الأخضر (1905) لهنري ماتيس تتبنى أسلوب الوحوش البرية، لكنها تدمج بشكل غير واعٍ بعض الموتيفات من الفن الأفريقي.
خامسًا: الموضوع: من السهل تقديم أمثلة على الاستلاب الثقافي الخاص بالموضوع؛ إذ تتضمن العديد من روايات جوزيف كونراد استيلابًا للموضوع؛ حيث نقل كونراد كثيرًا عن ثقافات أخرى غير ثقافته؛ وكيم لكبلينج (1901) مثال كلاسيكي آخر على هذا النوع؛ فعلى الرغم من أنه ولد في الهند إلا أن الثقافات الهندية التي مثلها لم تكن ثقافته، وقد اعتُبرت أعمال الاستلاب الثقافية الخاصة بالموضوع سرقة.
طرق تحقيق الاستلاب الثقافي
تلقي الموسوعة البريطانية الضوء على بعض الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها تحقيق مفهوم الاستلاب الثقافي: مصطلح صكه ورعاه الأمريكان إلى حد كبير.
أولاً: يحدث الاستلاب الثقافي عندما يحقق عضو من الأغلبية ربحًا ماليًا أو اجتماعيًا من ثقافة الأقلية؛ فقد استفادت الفنانة الأمريكية مادونا من ثقافة المثليين في البومها (Voguing)، وكذلك استفاد الأمريكان من موسيقى الأفارقة السود، وفي مسرحية الدراسة استفادت إيميلي من الفنون الإسلامية.
ثانيًا: يحدث الاستلاب الثقافي عندما يبالغ عضو في مجموعة الأغلبية في تبسيط ثقافة مجموعة الأقلية، أو يتعامل مع ثقافة الأقلية على أنها استهزاء وسخرية، مثال ذلك: تصوير أمير على هيئة عبد.
ثالثًا: يحدث الاستلاب الثقافي عندما يفسر عضو في مجموعة الأغلبية عنصرًا ثقافيًا لمجموعة أقلية بطريقة تبعده عن معناه الأصلي، كتفسير النصوص الدينية بطريقة مشوهة لغرض معين، كما هو الحال مع أمير وإسحاق وجوري في المخزي.
رابعًا: يحدث الاستلاب الثقافي عندما يتبنى عضو في مجموعة أغلبية عنصرًا من ثقافة الأقلية دون عقاب، بينما يواجه أعضاء الأقليات رد فعل عنيفًا لنفس العنصر الثقافي، مثال ذلك: تَعَرُّضُ الأمريكيين الأفارقة للعنصرية بسبب تسريحة شعرهم (cornrows)، ولكن عندما استخدمها البيض تحولت إلى “ترند”، والشيء نفسه حدث مع آبي وصديقه طارق وإمام المسجد.
لقد تجاهلت الموسوعة البريطانية إمكانية حدوث الاستلاب الثقافي من قبل أعضاء المجموعات المهمشة؛ إذ تستلب بعض أوجه الثقافة المسيطرة، وتقوم بتعديلها أو تشويهها لتحقق غرضًا معينًا، وتعيد مرحلة ما بعد الكولونيالية قراءة التاريخ وخاصة الفترة الاستعمارية من أجل تأكيد قوتهم ومقاومتهم، ويظهر ذلك في رواية ميرل هودج كريك كراك، أيها القرد.
عيوب الاستلاب الثقافي
يمكن أن يؤدي الاستلاب الثقافي إلى إدامة الصور النمطية، واستغلال الجماعات التي يتم التمييز ضدها، ويمكن أن يتسبب أيضًا في إرباك الفئات المهمشة التي تريد التعرف على ثقافتها وهوياتها؛ فعلى سبيل المثال تُعَدُّ لعبة اليوجا ممارسة تعبدية مجانية، ولكن عندما يستغلها البعض ويوظفها بوصفها رياضة تحافظ على لياقة الإنسان، ويطلب من المتدربين مبالغ مالية قد تكون عالية جدًا؛ فالاستلاب الثقافي لهذه الممارسة يبعدها عن أصولها وقواعدها ونوياها الطيبة. باختصار يسبب الاستلاب الثقافي الضرر، والتشويه، والمضايقة، وتدنيس المقدسات، وأخيرًا يعبر عن السرقة، وعدم الأصالة وغياب التفرد، والزيف والخداع.
مزايا الاستلاب الثقافي
قد يكون الاستلاب الثقافي في نظر الرأي العام مرادفًا للاستيلاب القسري، وإعادة تفسير ثقافة ضعيفة من قبل ثقافة قوية من أجل الحصول على ترخيص فني وربح تجاري ونهب ثقافي؛ وبناء عليه، يعد الاستلاب الثقافي سرقة وضارًا وخاطئًا ومسيئًا، وفي المقابل تبدو بعض الأعمال المستلبة حميدة أخلاقيًا؛ حيث نجد بعض الفنانين يلائمون المحتوى، ويخلقون روائع، كما هو الحال مع شكسبير، الذي قدم لنا أعمالًا عالمية رغم أنه ممارس للاستيلاب الثقافي بامتياز: تمثيل المغاربة في عطيل، والثقافة اليهودية في تاجر البندقية؛ إذ استحوذ على المحتوى الفني لمجموعة متنوعة من الثقافات بما في ذلك الإغريق والرومان القدماء، وفي المقابل تم استيلاب بعض المزايا الشكسبيرية من قبل الثقافات في جميع أنحاء العالم عن طريق الترجمة بما في ذلك لغة إينوكتيتوت لسكان جرينلاند الأصليين، ولغة ثقافة سامي في شمال فنلندا.
يقول عثمان أحمد: إن الاستلاب الثقافي يمكن أن يكون إيجابيًا وسلبيًا؛ إذ يشجع على الابتكار الثقافي، ويسهل التواصل بين الثقافات؛ مما يثري الآفاق التعبيرية للمصممين والفنانين وصانعي الأفلام والمهندسين المعماريين والأدباء والفلاسفة (ص 12). وتتشابك وتتناص النظريات النقدية مع بعضها البعض، وتقدم للقارئ وجهات نظر مختلفة مثل: النقد الجديد، البنيوية وما بعدها، الحداثة وما بعدها…إلخ. وقد أدت الهجرة العرقية والتعددية الثقافية والانتشار الهائل للمعلومات إلى إحداث تغييرات جذرية في الديناميات الثقافية، وقد جعلت العملية الاقتصادية الكبرى للعولمة من مفهوم الاستلاب الثقافي في سياقات ما بعد الاستعمار وما بعد الحرب الباردة فعلًا ثنائي الاتجاه، أو ربما متعدد الاتجاهات للتفاعل بين الثقافات؛ حيث يتضمن التشفير وفك التشفير لسد الثغرات والفجوات بين الشرق والغرب، وتحسين النقص الحالي في كافة أنواع الخطاب في بعض البلدان.
دراسة تطبيقية
تتعدد صور الاستلاب الثقافي في مسرحية إياد أختر؛ إذ توظف إيميلي، المنتمية إلي أبناء الثقافة المهيمنة والمسيطرة، إحدى عناصر الثقافة الإسلامية في أعمالها الفنية، وتحقق ربحًا ماديًّا ومكانة اجتماعية نظير ذلك، وهناك إشارة أخرى في المسرحية إلي كل من الفنان هنري ماتيس وفيلازكويز ومدى استفادتهما من الفنون المنغولية والمغاربية على الترتيب، وفي المقابل يتعرض المهاجرون، سواء من أصول إسلامية أو غيرها، إلى المضايقة والسجن الترحيل أحيانًا؛ نتيجة محاولة الاستفادة من تراثهم الثقافي، ويبدو ذلك بوضوح في عدم ترقية أمير، وتعرض كل من إمام المسجد فريد وآبي جينسن للسجن وللتحقيق على الترتيب. ومن خلال هذا التجاور تسلط المسرحية الضوء على سبب عدم عدالة الاستلاب الثقافي؛ إذ تمكن الأشخاص الذين لا يعانون من العنصرية من الاستفادة من ثقافة ليست ثقافتهم، بينما يتم وصم الأشخاص الذين ينتمون إلى تلك الثقافة بالإرهاب والهمجية والتخلف، كما تقوم إيميلي أيضًا—بالإضافة إلي بعض الشخصيات الأخرى- بتفسير بعض آيات من القرآن الكريم بطريقة قد تبعده عن معناه الأصلي، ويتخذ مورت لعبة اليوجا كوسيلة لفقدان الوزن وخفض الكوليسترول بدلًا من كونها رياضة تعبدية روحانية (المخزي 10)، وتقوم أم أمير التي تمثل ثقافة المهمشين أيضًا بإساءة تفسير بعض سلوكيات النساء البيض بطريقة تشوههن وتحط من قيمتهن، بالإضافة إلى بصقها هي وابنها في وجه رفكا وإسحاق اليهوديين- مرحلة التشويه المتبادل خاصة في مرحلة ما بعد الاستعمار. وأخيرًا، تمثل الصورة التي رسمتها إيميلي لزوجها إلى الدونية وعدم المساواة، وتؤكد فشل الذوبان الثقافي الذي يسعى إليه المهاجرون ليل نهار.
إحدى عناصر الثقافة الإسلامية في أعمالها الفنية، وتحقق ربحًا ماديًّا ومكانة اجتماعية نظير ذلك، وهناك إشارة أخرى في المسرحية إلي كل من الفنان هنري ماتيس وفيلازكويز ومدى استفادتهما من الفنون المنغولية والمغاربية على الترتيب، وفي المقابل يتعرض المهاجرون، سواء من أصول إسلامية أو غيرها، إلى المضايقة والسجن الترحيل أحيانًا؛ نتيجة محاولة الاستفادة من تراثهم الثقافي، ويبدو ذلك بوضوح في عدم ترقية أمير، وتعرض كل من إمام المسجد فريد وآبي جينسن للسجن وللتحقيق على الترتيب. ومن خلال هذا التجاور تسلط المسرحية الضوء على سبب عدم عدالة الاستلاب الثقافي؛ إذ تمكن الأشخاص الذين لا يعانون من العنصرية من الاستفادة من ثقافة ليست ثقافتهم، بينما يتم وصم الأشخاص الذين ينتمون إلى تلك الثقافة بالإرهاب والهمجية والتخلف، كما تقوم إيميلي أيضًا—بالإضافة إلي بعض الشخصيات الأخرى- بتفسير بعض آيات من القرآن الكريم بطريقة قد تبعده عن معناه الأصلي، ويتخذ مورت لعبة اليوجا كوسيلة لفقدان الوزن وخفض الكوليسترول بدلًا من كونها رياضة تعبدية روحانية (المخزي 10)، وتقوم أم أمير التي تمثل ثقافة المهمشين أيضًا بإساءة تفسير بعض سلوكيات النساء البيض بطريقة تشوههن وتحط من قيمتهن، بالإضافة إلى بصقها هي وابنها في وجه رفكا وإسحاق اليهوديين- مرحلة التشويه المتبادل خاصة في مرحلة ما بعد الاستعمار. وأخيرًا، تمثل الصورة التي رسمتها إيميلي لزوجها إلى الدونية وعدم المساواة، وتؤكد فشل الذوبان الثقافي الذي يسعى إليه المهاجرون ليل نهار.
استفادة إيميلي من فن كسوة الجدران والحوائط الداخلية والخارجية بالبلاطات الخزفية الإسلامية
إن إيميلي فنانة أمريكية بيضاء شابة، وزوجة أمير الأمريكي من أصل باكستاني، وقد بدأت مسيرتها الفنية الناجحة في الرسم عندما بدأت في تطبيق فن كسوة الجدران بالخزف الإسلامي في لوحاتها الفنية، ويثير هذا التوظيف جدلًا واسعًا؛ لأنها تستحوذ على ثقافة لا تنتمي إليها، وتستفيد منها مع زميلها إسحاق وهو أمين المعرض الفني الذي سيقوم بعرض أعمالها في معرضه القادم. إن استخدام إيميلي للثقافة الإسلامية في عملها يعد عملًا استغلاليًا، ولكنه ليس مهينًا للأشخاص الذين ينتمون بالفعل إلى تلك الثقافة كما وضحت الموسوعة البريطانية، وإنما يعد عملًا مهمًّا جديدًا فريدًا مختلفًا، ويؤكد فكرة التناص بين الفنون، وخاصة أن هذا الفن الإسلامي ما هو إلا نتاج لثقافات مختلفة كما توضح الفقرة السابقة.
وتؤكد إيميلي أن فكرة التأثيرات الإسلامية في فنها ليست مؤذية وإنما ممتعة، ولكنها قد تتهم بالاستشراقية؛ لكونها امرأة أجنبية ليس لها الحق في استخدام عناصر من ثقافة أخرى محققة ربحًا ماديًّا ومكانة اجتماعية: “هل تعرفين ما الذي ستتهمين به؟ الاستشراق. لا مفر منه. أعني الجحيم. لديك زوج بني/ملون” (المخزي 20). ووفقًا لإدوارد سعيد في كتابه تغطية الإسلام (1977)، تم تصوير المسلمين/المهاجرين الملونين على أنهم خارجون عن القانون وعنيفون وبدائيون ومتطرفون وإرهابيون وكارهون للنساء ومعارضون للمصالح الأمريكية، ويتم تصنيفهم بشكل روتيني على أنهم يمثلون تهديدًا جماعيًا، ويتعرضون لإجراءات قانونية وغير قانونية، ويتم تشويه سمعتهم، والتمييز ضدهم، ومراقبتهم من قبل الدولة ص(x) .
في المقابل نجد أن أمير-المسلم المرتد- يفضل أعمالها التي تمثل المناظر الطبيعة-لأنها لا تمثل الإسلام؛ فهو يبغضه وينكره ويشوهه كما سنوضح لاحقًا (المخزي 29) -على لوحاتها التي تقتبس من هويته السابقة التي ضحى بها ليكون أمريكيًّا خالصًا، وقد أيده إسحاق قائلًا: “إنه ليس اتجاهًا خصبًا لها” (المخزي 29)، لكن يتراجع إسحاق عن ذلك لاحقًا بعد متابعته الثناء والاطراء والمدح الذي نالته أعمال إيميلي المستلهمة والموظفة لـــلفنون الإسلامية، ويعترف أمير بقيمة فنها، ولكن قد فات الميعاد.
وترى إيميلي الفنون الإسلامية مدخلًا وبوابة إلى مزيد من الحرية المختلفة، وهذا لا يأتي إلا من خلال نوع من الخضوع العميق؛ فبالنسبة لحالتها لا يتعلق الأمر بالخضوع للإسلام بالطبع، ولكن للغة الرسمية التي تتمثل في الاستقرار والهدوء. إن دور الفنون الإسلامية فعَّال منذ ألف عام، حيث يتضمن الكثير من الجمال والحكمة: “حان وقت استيقاظنا، الوقت الذي يجب أن نتوقف فيه عن التشدق بالإسلام والفن الإسلامي، نحن نعتمد على الإغريق والرومان— لكن الإسلام جزء من هويتنا أيضًا” (المخزي 20). كما يؤكد إسحاق أيضًا أن توظيف الفنانة لبعض عناصر فن كسوة الحوائط بالخزف الإسلامي مهم جديد، ويجب أن ينظر إليه على نطاق واسع (المخزي 27)؛ فالإسلام من وجهة نظره غني، وعالمي، وجزء من تراث روحي وفني، ويمكننا جميعًا أن نستمد منه ونطوره (المخزي 29). بناءً عليه استفادت/استلبت إيميلي من الفنون الإسلامية دون أن تسيء إلى أصحابها، ولكنها أساءت إلى زوجها الذي صورته على صورة عبد، وتم معاقبة الإمام فريد وآبي وطارق لتبنيهم الثقافة والهوية الإسلامية، وحرفت تفسير بعض آيات القرآن وأبعدتها عن معناها الأصلي كما سيتضح في الأجزاء التالية.
الاستهزاء والسخرية: تصوير أمير على هيئة عبد
يتناول هذا الجزء مدى التوتر والاحتقار والصدام المتبادل بين شخصيات المسرحية، التي تمثل الديانات السماوية الثلاثة، من خلال الصورة المستلبة من الفنان الإسباني فيلازكويز، بالإضافة إلى البصق في وجهي رفكا وإسحاق، ووصف النساء البيضاوات بأنهن عاهرات، وترقية جوري اليهودية بدلا من أمير ذي الخلفية المسلمة، ووصف إسحاق اليهودي لصديقه أمير بالجهادي الفاشي. إن هذه القضايا تسلط الضوء على المفاهيم الخاطئة والقوالب النمطية والصدامات الصامتة بين الحضارات، سواء عن غير قصد (بورتيريه إيميلي) أو عن قصد (البصق في الوجوه/اتهام البيضاوات بالإباحية).
وترمز صورة إيميلي لأمير إلى الصراع بين طموحات أمير المهنية وخلفيته الأقلية المسلمة، تكشف صورتها عن التعصب والاستياء غير المتعمدين: “بورتريه لــ جوان دي باجيرو— الذي تصادف أنه من أصل مغاربي […] إذن ها أنت، في قميص ماركة شارفيت الذي تبلغ تكلفته ستمائة دولار، مثل عبد فيلازكويز” (المخزي 28). استلهمت إيميلي رسم اللوحة بعد أن رأت كيف يسيء نادل عنصري معاملة أمير، تمامًا كما أظهر فيلازكويز عبده خوان دي باريجا في وضع كله كبرياء وعزة، وتسعى إيميلي إلى تصوير أمير بوصفه محاميًا ناجحًا في شقته في مانهاتن، ويتعارض هذا التمثيل مع التحيز الأمريكي الأبيض السائد الذي يصور الرجال من جنوب آسيا على أنهم مهاجرون فقراء أو إرهابيون إسلاميون، ومع ذلك فإن تصويرها لأمير معقد بسبب انزعاجه من تشبيهه بالعبد، ويزيد إسحاق من تعقيد انزعاجه عندما يرى أن لوحة إيميلي، مثل اللوحة الأصلية، تطرح مسألة “وضع” الشخص على الرغم من الكرامة التي تنسبها الصورة. وبهذه الطريقة فإن هذه اللوحة ترمز لكيفية استمرار تهديد رغبة أمير في أن يُعامل ويُنظر إليه على أنه محامٍ قوي بسبب التحيز ضد هويته الإسلامية رغم نجاحه؛ فمن خلال جعل أمير يحدق في اللوحة في نهاية المسرحية، يشير أختر إلى أن أمير يطرح نفس السؤال، فهو غير متأكد من مكانه ووضعه في ثقافة المجتمع الأمريكي السائدة: “إيميلي: إلى اللقاء أمير. لو سمحت. لا تكتب لي بعد الآن. (تخرج. وقفة طويلة. بينما يعود أمير إلى تحزيم الأمتعة، لاحظ … القماش الملفوف جزئيا على الحائط. يمشي إليها، يلتقطها. ثم يمزق بقية الغلاف. من موقعه على خشبة المسرح، سنرى فقط ما يكفي من اللوحة. يدرك: إنها صورة إيميلي له. الدراسة بعد فيلازكويز المغربي. يأخذ نظرة فاحصة طويلة. تطفئ الأنوار)” (المخزي 51).
تمثل الصورة الاستشراق، وهو نزعة بين الفنانين الأمريكيين لتصوير ثقافات المهاجرين على أنها غريبة، وشاذة، وأقل شأنًا. تقدم إيميلي زوجها من جنوب آسيا أمير في ضوء مشكوك فيه من خلال مساواته بعبد محرّر وتصويره على أنه غريب يحاول الاندماج في الثقافة الأمريكية، ولكن لا يعامل على قدم المساواة مع الأثرياء البيض، ويذكرنا هذا أيضًا بكيربال، بطل رواية مايكل أونداتجي المريض الإنجليزي (1995). ويرى الباحث أن أمير وبعض المسلمين الآخرين مسؤولون عن ذلك؛ لأنهم يتصرفون أحيانًا بشكل مخجل، ويسمحون للآخرين بتشويه صورهم.
يظهر موضوع معاداة السامية جنبًا إلى جنب مع الإسلاموفوبيا من خلال البصق والتشويه المتعمد بين شخصيات المسرحية، وقد ظهرت المشاعر المعادية لليهود لأول مرة في المشهد الأول عندما أخبر أمير (إيميلي وآبي) قصة علاقته بالفتاة اليهودية (رفكا)، وكيف بصقت والدته في وجهه، وهددته بكسر عظامه عندما اكتشفت القصة، وكيف بصق هو الآخر في وجهها عندما تأكد من المعلومة في اليوم التالي في المدرسة، ومع نهاية المسرحية بصق في وجه صديقه إسحاق: “سوف ينتهي بك الأمر مع يهودية على جثتي، ثم بصقت في وجهي […] لديك اسم يهودي. ضَحِكَتْ. “نعم، هذا لأنني يهوديةٌ”، كما تقول. (وقفة خاطفة) ثم بَصَقْتُ في وجهها […] ثم فجأة […] أمير يبصق في وجه إسحاق. يمسح إسحاق البصاق من وجهه. إسحاق: هناك مبرر لنعتكم بالحيوانات” (المخزي 13-44). والبصق على الوجه، يعني الاحتقار الشديد وهو من أشد أنواع الاحتقار والإهانة، وقد يعتبر الإنسان العادي حياته رخيصة أمام الدفاع عن هذه الإهانة؛ فعادةً يكون البصق على الأرض، أما من يبصق في وجه إنسان فقد يقصد بذلك أن وجهه يشبه الأرض التي يبصق عليها وتداس، لقد بصق اليهود في وجه المسيح عدة مرات؛ ويمكن القول: إن ألم البصق هو أحد أكثر الآلام وجعًا، وله أكبر تأثير على الروح من كل العذاب والمعاناة الجسدية والمعاناة النفسية التي عانى منها يسوع: “لقد بصق بعض الناس على يسوع بعد أن أدانه السنهدريم (مرقس:14.65). شيلوك يبصق عليه أنطونيو في مسرحية شكسبير تاجر البندقية، وباختصار: إن البصق يؤكد الاشمئزاز وعدم الراحة والشعور بالذنب والعار والغضب والازدراء. وعلى الرغم من عدم وجود آراء معينة حول اليهود قبل تدخل والدته، إلا أن أمير يبصق في وجه الفتاة، تمامًا كما بصقت والدته في وجهه. ويروي أمير القصة لتبرير نبذه للإسلام؛ حيث يراه سلبيًا تمامًا، ويربطه بمعاداة السامية من بين أشكال أخرى من الكراهية. ويوضح أختر من خلال الاستخدام المتكرر لهذه الفكرة كيف أن الاحتقار اللاسامي الذي تعلمه أمير من والدته لا يزال يعيش بداخله، وهذا بدوره يبرز أسباب فشل الذوبان للمهاجرين في الخارج، وبالطبع لا ينادي الإسلام بذلك، بل يدعو إلى الاحترام المتبادل بين جميع الأديان؛ فالإسلام شيء، والمسلمون شيء آخر.
كما يبني أختر كذلك على موضوع عداء اليهود الواضح تجاه المسلمين عندما أخبر رئيسه في العمل أنهم ما كانوا لينتقدوه إذا تم تصويره في الصحيفة مع حاخام بدلاً من إمام مسجد: “ألا تعرفين هذا؟ قالت جوري: إن زوجك قد فصل. كان يبكي في اجتماع للموظفين، ويبدو أنه قال شيئًا حول كيف لو كان الإمام حاخامًا، لما كان ستيفن ليهتمه، اعتقد ستيفن أن التعليق معاديًا للسامية” (المخزي 42)، بينما كان وحيدًا على خشبة المسرح مع جوري في المشهد الثالث، وصف أمير نفسه وجوري بأنهم “اليهود الجدد” في نيويورك، ويقترح أن رؤساءهم اليهود لن يسمحوا لهم بالترقية أبدًا ليكونوا شركاء متساوين؛ لأنهم ملونون، ومن عرقيات دنيا: “نحن اليهود الجدد” (المخزي 26). ومما كان غامضًا في النهاية معاداة أمير لرؤسائه من عدمها؛ لأنهم ينتقدون خلفيته الإسلامية، أو لأنه لم يتخلص من معاداة السامية التي غرستها والدته فيه عندما كان طفلاً.
ويعتقد أمير أن المسلمين يرون النساء الغربيات عواهر، ويحرصن دائمًا على فتنة الآخرين من خلال تجردهن من ملابسهن حيث تقول أم أمير أن: “النساء البيضاوات لا يحترمن أنفسهن، كيف يمكن لشخص أن يحترم نفسه عندما يعتقد أنه يجب عليه خلع ملابسه لجعل الناس يحبونه؟ إنهم عاهرات” (المخزي 13). ويسلط ارتكاب إيميلي لجريمة الزنا، وعدم كفاءة جوري، وافتقار إسحاق لرأي حازم الضوء على كيف أن أدبيات ما بعد الاستعمار تسعى للانتقام ورد الصاع صِيعَانًا؛ إذ تم تصوير النساء الشرقيات، في أدبيات فترة الاستعمار، على أنهن بدائيات للغاية، غير متعلمات، فقيرات، مسجونات/محاصرات، مطيعات، خاضعات، محجبات، مفعمات بالحيوية وجزءًا ماديًا من المنزل؛ وفي الصور المعاصرة للشرقيين نرى الرجال ملتزمين دينيًا ولكنهم مثليون، والنساء يقمن علاقات غرامية رغم ارتدائهن الحجاب، وكلاهما يصنف إرهابيًّا أو يعمل لحساب المخابرات المركزية؛ وللأسف ينظر إلينا الغرب بشكل سلبي بسبب أعمالنا الدنيئة والمخزية؛ فــأمير يقاتل بضراوة ضد الإسلام والمسلمين، بينما تدافع إيميلي بقوة عن كليهما، إما بأمانة أو بغير إخلاص.
الكيل بمكيالين: معاقبة المهاجرين على محاولة التمسك بهوياتهم الأصلية
يُوصم الأشخاص الذين ينتمون إلى خلفيات إسلامية وصمة عار بدلاً من المديح عندما يربطون أنفسهم بالثقافة الإسلامية، وتشير المسرحية إلى أن الأشخاص غير البيض لا يتلقون اعترافًا إيجابيًا أو فرصًا للاعتماد على ثقافتهم— في الغالب تذهب تلك الفرص إلى الأشخاص البيض، الذين يستفيدون من تمثيل الثقافات غير البيضاء، ويوضح هذا سبب كون الاستلاب الثقافي ضارًا وغير عادل.
بينما تستفيد إيميلي- على سبيل المثال- من استحواذها على الثقافة الإسلامية، يتم إغفال أمير للحصول على ترقية في العمل عندما يكتشف رؤساؤه أن لديه تراثًا إسلاميًا عندما نقلت الصحف عن أمير أنه دافع عن الإمام فريد، وهو رجل دين مسلم اتُهم خطأ بتمويل نشاط إرهابي، ويرى رؤساؤه هذا المقال، وإدراكًا منهم أن أمير ينحدر من خلفية إسلامية فإنهم يشعرون بعدم الارتياح تجاه علاقات أمير بالمجتمع المسلم، ويجعلون زميلته الأقل تأهيلًا “جوري” شريكةً في مكتب المحاماة بدلاً منه، فبينما يتم الإشادة بإيميلي لدعمها للثقافة الإسلامية، يُعاقب أمير لارتباطه المفترض بها.
وهناك حادثة مماثلة لابن أخت أمير “آبي” عند تواجده مع صديقه طارق في ستاربوكس، حيث كانا يرتديان ملابس شرقية تنم عن ثقافتهم الإسلامية، وقد أثار هذا التواجد شك وريبة الباريستا، وظنت أنهما إرهابيان، واتصلت بالشرطة، وينتهي الأمر باستجواب آبي وطارق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، وطُلِب من آبي أن يتعاون مع المخابرات ليبلغ عن زملائه؛ لذا يعبر عن غضبه ويعلن عن تبنيه فكرة الانتقام: “منذ ثلاثمائة عام أخذوا أرضنا، ورسموا لنا حدودًا جديدة، واستبدلوا قوانيننا، وجعلونا نسخة منهم، نبدو مثلهم، نتزوج نساءهم، لقد أصابونا بالعار. لقد أصابونا بالعار. ثم يتظاهرون بأنهم لا يفهمون الغضب الذي لدينا؟” (المخزي 50). فعلى عكس إيميلي التي تحقق النجاح من خلال تبني عناصر من الإسلام يتعرض آبي وطارق للمضايقة عندما يحاولان دعم ثقافتهما الإسلامية علانية. ويختلف أمير وآبي إلى حد كبير؛ حيث يمكن تصنيف الأول على أنه مهاجر من الجيل الثاني، بينما الثاني من الجيل الأول؛ فآبي لا يزال يحتفظ بلسانه الأصلي ومعاييره الثقافية، كما يحتفظ بهويته الباكستانية، ويشعر بمزيد من الحزم والتألق بجذوره؛ نتيجة لذلك من المحتمل أنه يعتنق إما الاستيعاب أو التطرف، لكنه يختار التطرف لكونه يتعرض للتمييز العنصري.
من خلال هذا التباين، تعزز المسرحية فكرة أن المجتمع الأمريكي يعاقب الأقليات العرقية والدينية التي تحاول تمثيل ثقافتها أو دعمها؛ فـــ إيميلي استفادت من الثقافة الإسلامية بطريقة لا يستطيع سكان جنوب آسيا مثل أمير وآبي والإمام فريد اتباعها، وتؤكد هذه الأمثلة أيضًا أسباب فشل الذوبان الثقافي للمهاجرين كما سنوضح لاحقًا.
تفسير القرآن وإبعاده عن معناه الأصلي
يتضمن أحد طرق الاستلاب الثقافي تفسير ثقافة الأقليات بطريقة مشينة مسيئة؛ إذ تقوم إيميلي وجوري بتفسير بعض آيات القرآن الكريم بطريقة تبعده تمامًا عن معناها الحقيقي، والغريب والتفكيكي في آن واحد أن أمير ذو الخلفية الإسلامية من أشد المشوهين للقرآن؛ ليثبت للغرب أنه أمريكي أكثر من الأمريكان، بالإضافة إلى تقديم صورة رومانسية لليهود والتلمود، وقد يتفق معه إسحاق في بعض الأمور؛ لذا تأتي الهزيمة دائمًا من الداخل أولاً، ومن ثم يكون من السهل للعدو اغتصابنا وتولي زمام الأمور.
وتؤكد بعض شخصيات المسرحية سواء من أصول إسلامية أو غير إسلامية على كراهية الإسلام للفن: “إنه ليس اتجاهًا خصبًا لها […] لا تهم اللوحات؟” (المخزي (29. وعدم صلاحية الإسلام للعصر؛ لأنه بعث من أكثر من 1500 سنة، وأنه جاء من الصحراء: “أتى الإسلام من الصحراء. من مجموعة من أشخاص قاسين يعيشون حياة قاسية، مَن رأى الحياة شيئًا صعبًا لا هوادة فيه عانى شيئًا ما” (المخزي 33)، ولا يتسم القرآن بالمرونة كما هو الحال في التلمود: “أعني أنظر إلى التلمود؛ إنهم ينظرون إلى الأشياء من مئات الزوايا المختلفة، ويحاولون التفاوض معها، وجعلها أسهل وأكثر ملاءمة للعيش” (المخزي 33)، وضرب الزوجة: “الرجال هم المسؤولون عن النساء […] إذا لم يطيعوا […] تحدثوا إليهن. وإذا لم يفلح ذلك […] لا تنم معهم. وإذا لم يفلح ذلك […] اضربهم […]، يمكن أن يعني جذر “يضرب”، ولكن يمكن أن تعني أيضًا “يغادر”؛ لذلك يمكن القول، إذا لم تستمع زوجتك، اتركها. لا تضربها” (المخزي 36). وتحريم النقاب: “هل أنتِ متفقة معهم في حظر الحجاب؟ […] الحجاب شر، أنت تمحو وجهًا، وتمحو الفردية. لا أحد يجعل الرجال يمحون فرديتهم” (المخزي 36). دافع النبي (صلى الله عليه وسلم) عن المرأة قبل الوحي، ولكن تغير كل ذلك بعد لقاء سيدنا جبريل: “هذا بالضبط ما لم يفعله محمد. إليكم المفارقة: قبل أن يصبح نبيًا؟ أوصى أتباعه ألا يسيئون معاملة النساء، ثم يبدأ في التحدث إلى مَلَك. أعني حقًا؟” (المخزي 36). من يحاول تطبيق الشرع سيكون مثل “طالبان”: “يدور القرآن حول الحياة القبلية في صحراء القرن السابع. الموضوع ليس أكاديمي فقط. هناك نتيجة للاعتقاد بأن الكتاب الذي كتب عن الحياة في مجتمع معين منذ خمسة عشر قرن هو كلمة الله: تبدأ بالرغبة في إعادة إنشاء هذا المجتمع. بعد كل شيء، إنه الوحيد الذي يجعل القرآن فيه أي معنى حرفي” (المخزي 38). يفتخر القرآن بالقتال والقتل من أجل الإسلام: “إسحاق (بحرارة): كلماتهم القتالية […] هذا يعني أنك تقاتل من أجله أيضًا. السياسة تتبع الدين؟ لا فرق بين المسجد والدولة؟” (المخزي 20- 38). تعدد الزوجات: “يمكن أن يكون لديك عدة زوجات” (المخزي 38). منع دخول الكلاب للبيوت: “كان يقول إن الملائكة لا تدخل منزلًا توجد به صور أو كلاب” (المخزي 33)، وأخيرًا: “دعونا نرجم الزناة بالحجر. دعونا نقطع أيدي اللصوص. دعونا نقتل الكفار” (المخزي 38).
تعد كل هذه التجاوزات بعضًا من ضروب الاستلاب الثقافي؛ إذ تشوه الثقافة الأصلية عن طريق إبعاد النص عن معناه الحقيقي إما بغرض أو بجهل، وهذا ما يثير اشمئزاز الأقليات بسبب تدنيس معتقداتهم المقدسة وتراثهم الثقافي.