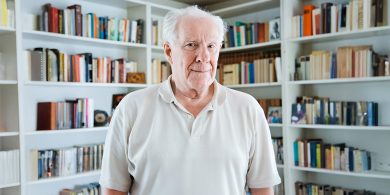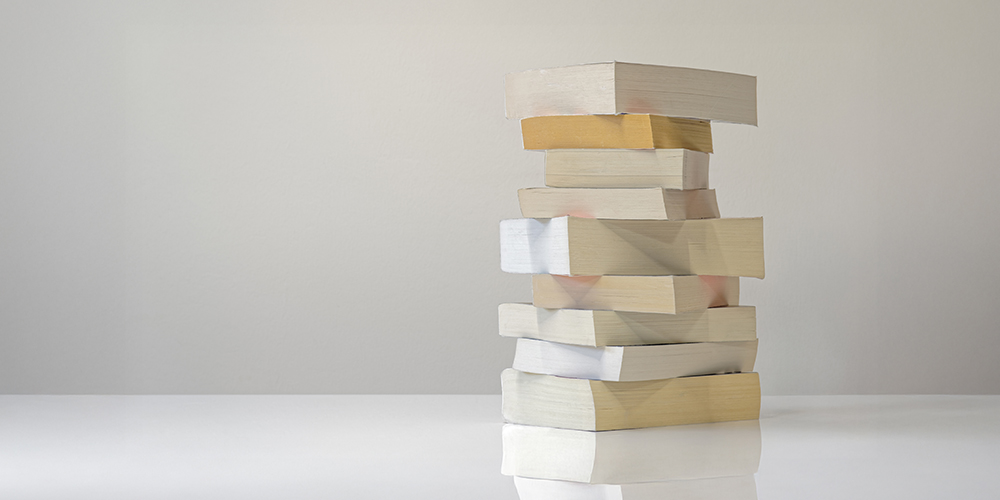
أتعرف أيها القارئ العزيز فيم سُمِّيَ أيُّ مجمع للبحث العلمي باسم (أكاديمي)؟ في التاريخ الأثيني داوم أفلاطون صاحب المدرسة (المثالية) على تدريسه بأرض كانت مرتبطةً بشخصية بطل إغريقي أسطوري (أكاديموس) فسُمِّيَت الأرض باسمه، وصار تدريس أفلاطون فيها تلاميذه، ومذاكرتهم إياه فيها موسومًا بالتعليم الأكاديمي؛ وإذ كان تعليم أفلاطون وتدريسُه قائمًا على منهجٍ علميٍّ محدَّدٍ لا على جدالاتٍ سفسطية، بل على منهج علمي، وإذ أولى الرياضيات اهتمامًا خاصًا مع تعليمه الفلسفةَ التي كانت في عصره أُمَّ العلوم؛ حتى قال لا يدخل علينا أكاديميتنا من لم يحسن الرياضيات -إذ هي علم تجريد للظواهر وتوصيف مجرد للمعاني- إذ كان ذلك كذلك فقد صارت الأكاديمية وصفًا لكل متعلِّمٍ أو باحثٍ على أسسٍ علميةٍ ومنهجية حتى تَخَرَّج من مدرسته أبو المنطق، والمعلِّم الأول (أرسطو)، ولذلك فالجامعات أو المجامع أو المجلاتُ أو أيُّ مركز (علمي) وسمه (الأكاديمية) يجب على القائمين عليه ومدرسيه ومُنظِّرُيه أن يعلموا أنهم يحملون عبئًا ثقيلًا ومسؤوليةً تُلزمهم أن يكون المنهج أولًا حاضرًا جليًا واضحًا في أذهانهم وأيديهم الكاتبة على دُربةٍ منه، لا يعتريها منه طمطمةٌ ولا اعوجاجٌ. فينبغي أن يتقن أهله علم المناهج “Methodology”. وهو العلم الذي سيضبط الباحث كبيرًا كان أو صغيرًا على أصول العلم الذي تخصص فيه وقواعده وأساليب بحثه المتناسبة معه.
ثم علم (فلسفة العلم) وهو علم مغبون في بلادنا، مع أنه: (نقد العلم) فهو الذي ينقد رؤية الباحث للدليل، ثم ينقد استدلاله من الـمُعطى، ثم ينقد ترتيبه للأدلة، ثم ينقد استنتاجه من الأدلة، ثم ينقد صياغتَه النظرية مما مضى. وفلسفة العلم تَضبط الباحث أن يقع في وهم الإطلاقات -مثلًا- كأنْ يقول باحثٌ: «إن المعادن تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة» فيقول له فيلسوف العلم -حسب بعض مناهجه-: هل أجريت تجاربك على جميع المعادن؟ وما كانت الظروف البيئية المحيطة بالتجربة التي بلا شك لها أثرُها في تغيير النتائج؟ وهل قمت بالرصد المتنوع أم ماذا؟ كل ذلك أيها القارئ لضبط العلم وليكون كلام الباحث دقيقًا غاية الدقة عند الوصف، فيصل به أن يقول -مثلًا- إن المعادن التي استطعت الوصول إليها في ظروفِ كذا وكذا على حسب رصدِي ومنظوري تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة.
أذكر لك هذا المثال لتعرف مدى قيمة معنى أن يقول إنسانٌ: أنا باحث أكاديميُّ، أو: إنّ بحثي منشورٌ في مركز أكاديمي.
نقد لواقعنا الأكاديمي: بين الخطابة والانفعال:
في إحدى المجلات المحكمة بالقاهرة صادرة من مجمع أكاديمي عريق، في أحد بحوثها العلمية، الذى يتناول قضية أثر تعليم لغة أجنبية خلال المرحلة الابتدائية في تعليم العربية، وهو عنوان يسرد إشكالية واضحة ينبغي أن يتناول بشكل مجرد، إحصائي مِن ناحية، ومن ناحية يمكن الاستعانة بدراسات خاصة بالعصبيات والذاكرة وتشكُّل اللغة في المخ من ناحية، ومن ناحية ثالثة عمل استقراء ميداني للقدرة التعبيرية لبعض طلاب المدارس الأجنبية على اختلاف مستوياتها ومستوياتهم، ثم الخروج باستنتاج استقرائي -وإن عابه بعضُ نقص- وتوصيات وخطة مقترحة لمعالجة الإشكال الذي وصل إليه الاستنتاج بمنهج علمي واضح وآليات دقيقة، هذا ما يظنه أي باحث حين يطالع العنوان؛ أن يكون البحث على ذلك المنوال، أو أن يكون على منوال آخر لكنه في إطار علمي كذلك؛ لكنك تقرأ فيه: «وعليه فإن هذه الدراسة تَعِي هذه الحقيقةَ، وهي تتحدث عن هذه اللغة العربية الفصحى، اللغة العربية التي يتكلم بها الآن أكثر من ثلث سكان العالم، التي صنفوها -ظلمًا- سادسة لغات العالم، وهي في الحقيقة أولى اللغات التي لا تزال تنتشر في الكون مع انتشار ضوء الشمس في كل مكان، وأنها اللغة الوحيدة -وأؤكد على هذا الوصف: الوحيدة- التي لا تزال حية ندية مشرقة متطورة على مر العصور والأزمان…» إلخ.
أنا لا أشكك في جماليات العربية أو قدراتها التعبيرية وسعة صوتياتها، لكن الإشكالية هنا هي لغة البحث وآلياته التي لا تتعدى كونها كلمةَ قصّاص أو واعظ أو خطيب لا أكثر، ولتحليل ذلك علميًا أشير إلى الآتي:
1 – استخدام مصطلح علمي ذي خطر كـ «الحقيقة» والحقيقة أو المسلَّمة أيها القارئ في لغة الأبحاث هي طور نهائي بعد الفرضية والتجريب المتفاوت، في ظروف ومناهج إحصائية مختلفة -مثلًا- أو غير ذلك، والتنظيرِ والاستقرار وانتهاءِ كافة سبل محاولاتِ النقض؛ فتكون حينئذ «الحقيقة»! فحين يهدر باحثٌ في مجلة محكَّمةٍ بقول «إنّ الحقيقة»! أن العربية هي أولى اللغات. فنقد العلم يتساءلُ: أُولى. مِن جهة ماذا؟ ثم ما قوالب ترتيب اللغات؟ هل عددُ ألفاظها أم سهولة حروفِها أم عدد متحدثيها أم.. أم… إلخ؟ وكقوله: «اللغة الوحيدة -وأؤكد على هذا الوصف: الوحيدة- التي لا تزال حية» فهل تتبعت كلَّ اللغات لترصدَ هذه الظاهرة؟ وما الدراسة التي استنتجت مثل هذا الكلام؟ وما دقتها؟ وقابليتها في الأوساط العلمية؟
2 – إدخال ألفاظ مشاعرية عاطفية للاستدلال، والاستدلال بإثارة العاطفة خطأٌ منهجيٌّ غير مقبول؛ «التي صنفوها ظلمًا». فالبحث العلمي لا يعرف ظُلمًا ولا عدلًا ولا رحمةً ولا قسوةً، هذه ألفاظٌ في إطارِ البحوث الفلسفيةِ الأخلاقية؛ فإنْ أردتَ أن تصفَ تصنيف اللغة بكونه ظُلما فعليك أنْ تُبين ما أسسُ الترتيب التي اختيرت من بين أسس عديدة ثم تبيِّن أنَّ ترتيب اللغة لم يكن كما ينبغي بناءً على هذه الأسس الموضحة!
3 – اللغة الأدبية واللغة العلمية؛ إنْ كان العلم مُضَمَّنًا في لغةٍ أدبية عالية فذلك هو الغاية، وأما أن تكون اللغةُ أدبيةً ولا تتضمَّنُ العلم في إطار كلامٍ موسومٍ بالبحث الأكاديمي فذلك يخرجه من كونه بحثًا علميًا؛ كقوله: «لا تزال تنتشر في الكون مع انتشار ضوء الشمس في كل مكان»، «التي لا تزال حية ندية مشرقة متطورة على مر العصور والأزمان»، فهذه لغة إنشائية مدرسية لا تتضمن أي معلومة مرصودة أو منقودة. فهو حشو كلام لا معنى له.
المفاهيم الغيبية: بين الإيمان والرصد:
نموذج آخر لتعريف المصطلحات في مجامعنا الأكاديمية؛ وهو تعريف القرآن الكريم، وقبل ذلك أوضح أنَّ الكلام العلمي شيءٌ، والوصفَ الإيمانيَّ أو غيرَ الإيماني شيءٌ آخر؛ فحدُّ التعريف العلمي يتوقَّفُ عند الرصد الإنسانيِّ، لا الموقف الذي يتخذه الإنسان من هذا الرصد؛ فالشيء المرصود هنا هو كلام عربيٌّ على هيئة نص ديني ظهر في القرن السابع الميلادي… وهكذا فكما أنه لو عرَّفه معرِّفٌ بقوله: إن القرآن كتاب مِن تأليف (محمد) -وحاشاه صلى الله عليه وسلم- يُقال له: إن هذا التعريف غيرُ علميٍّ؛ وذلك أنه مبنىٌّ على موقفٍ اتخذه، لاحقٍ بكونِه رصْد شيءٍ، فكان ينبغي أن يتوقفَ تعريفُك عند الرصْد فحسب. فذلك كذلك إنْ عرَّف إنسانٌ القرآنَ بقوله: كلام الله تعالى الموحى إلى نبيه -صلى الله عليه وسلم-….إلخ يقال له: إن هذا التعريف غير علمي؛ لأنه مبنىٌّ على موقفٍ اتخذته، لاحقٍ بكونك راصدًا فحسب، وكان ينبغي عليك التوقف عند الرصد لا التعبير عن موقفك؛ ولو سألتني أيها القارئ عن موقفي فإني أؤمن بأن القرآن كلام الله تعالى الموحى به إلى نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم- خاتم النبيين، ومع ذلك فإني حين لمحت في إحدى المجامع العلمية التي تسعى لإخراج موسوعة علمية عربية -وهذا محمود- حين لمحتُ تعريفهم للقرآن الكريم بأنه كلام تعالى الموحى… إلخ اعترضت واقترحت عليهم شيئًا آخر علميًا، لا تعريفًا إيمانيًا.
فهذا الحد -أي: التعريف بأنه كلام الله تعالى الموحى به- حدٌّ تاريخيٌّ منقول مِن تراثنا العربي بما يتوافق مع ثقافة هذه العصور العلمية، وأما في عصرنا الحالي فقد تطورت نظرية المعرفة، ونظرية المعرفة في زماننا على اختلاف توجهاتها تضع حدًّا بين تعريف الشيءِ مِن خلالِ موضوعِه من حيث هو، من غير انفعال الراصدِ له به، وبين انفعاله به وتصوُّره له مبنيًا على إيمانٍ أو شعور. وهي المختصة بنقد العلم [تحديد مصطلحاته وكيفية الوصول لأدلته وترتيبها واستنتاجها نظرياتٍ وقوانينَ سواء في العلوم الطبيعية البحتة أو الإنسانية على اختلاف مناهجها واختلاف رؤًى وتوجهاتٍ بين تجريبية مادية مغرِقة أو مثاليّةٍ أو عقليّةٍ أو غير ذلك]
والخلاصة المقصودة: إنّ تعريف القرآن الكريم -الذي بلا شك عندي هو كلام الله تعالى ووحيه لنبيه صلى الله عليه وسلم- إذا عُرِّف بأنه هو كلام الله تعالى…. لم يكن تعريفًا علميًا، بل هو تعريف إيماني منطلق مِن كلام عن غيبيات (لفظ: الوحي).
والكلام عن الغيبيات ليست موضوعَ العلم، ولا تدخل ضمن إطار البحث؛ لأنها غير قابلة للرصد هي ذاتها أو تأثيرها، وسُمِّيَتْ غيبًا؛ إذ لا علاقة لها في ذاتها بالمادة والعلوم -حسب التعريف الحديث للعلم-.
فحين تُثبت الموسوعةُ أن القرآن هو كلام الله تعالى الموحى به..، حين تثبت ذلك فإنها تعرف القرآن من جهةٍ إيمانية لا مِن جهةٍ إنسانية محايدة. وهذا خلطٌ بين الحدِّ العلمي والموضوع الإيمانِي. وكأنها كمن يقول -مثلًا-: إن سرعة الملائكة تتجاوز سرعةَ الضوء!! وهذا الكلام حسب فلسفة العلم لا معنى له؛ لأنه غير قابل للرصد أو النقض.
والذى أريدُ قولَه إنّ تعريف المصطلحات ينبغي أن يكون على قدر المسؤولية العلمية التي تسعى إليها الموسوعة وهي مسؤولية عالمية لا محلية؛ وعلى ذلك فإني أقترح مثلًا أن يُقال بعد إعادة الصياغة وغير ذلك وبعد نقل التعريف التراثي كما هو؛ القرآن: هو نص عربيٌّ ظهر متواليًا متقطعًا على مدار 23 عامًا على لسان (محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب) مِن بنى هاشمٍ من قبيلة قريش بالحجاز، خلال القرن السابع الميلادي، بداية مِن سنة 610م تقريبًا على أرجح أقوال المؤرخين المسلمين، بين موطنين رئيسين: مكة والمدينة، وهو نص دينيٌّ على لغة عرب الحجاز في ذلك العصر، وفيه من بعض لغات العرب المختلفة، وله قراءات أشهر أعدادها: أربع عشرة قراءةً؛ منها عشرة متواترة، وسبع قراءات مشهورة، وأقدم مخطوطاته كذا وكذا، ونقلُه شفهيٌّ، يرى المسلمون -على اختلاف مذاهبهم- أنه وحي من الإله للنبي محمد -الذي يؤمن المسلمون بنبوته- حوى 6236 جملة، كل جملة منفصلة تسمى آية، ونهايتها سجعٌ سُمِّيَ “فاصلةً” على قول أكثر البلاغيين المسلمين -تمييزًا للقرآن عن غيره من النصوص-، وهو مصدر أساسيٌّ للغة والتشريع، وله تفسيرات مختلفة متقابلة أحيانًا ومتنوعة أحيانًا.
والخلاصة: الألفاظ التي تدل على الغيبيات أو الإيمان لا يصح استخدامها بأي حال من الأحوال في التعريف العلمي والتحديد؛ لأنها لا تدخل ضمن إطار البحث العلمي بحال من الأحوال.
وكذلك الكلام عن (الإله) -ذاته سبحانه وتعالى- لا يدخل ضمن إطار العلم أبدا، لأنه تعالى أعلى من أن يُرصد، والعلم لا يَرصد إلا ما يُمكن أن يُستدل من خلاله استدلالاً عقليًا طبيعيًا على وجود نظام، ويُستدل من ذلك النظام استدلالاً عقليًا طبيعيًا على وجود خالق؛ كما في القرآن: (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنـزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون) [البقرة 164] فالقرآن يدل إلى ظواهر طبيعية يُعقل منها ويستدل مِن خلالها على وجود الخالق. فهذا الرصد يدخل ضمن إطار العلم، والاستدلال به على وجود الخالق -تعالى- هذا الاستدلال نفسه يدخل ضمن إطار العلم والبحث العلمي، وأما المستدل عليه وهو الإله فلا يدخل ضمن إطار البحث العلمي. وكذلك الكلام عن القرآن؛ فإنه إذا قيل: (هو كلام الله) لم يكن ضمن إطار البحث العلمي، بل ضمن إطار إيماني؛ ولذلك فالقرآن نفسه يستدل على نفسه بما يدخل ضمن إطار البحث العلمي؛ ضمن علم المنطق والكلام، حين ذكر أن الدليل عليه هو أنه لا يتناقض وأنه نص محكم متماسك وغير ذلك، فهذا الاستدلال على أنه من عند الله -هذا الاستدلال نفسُه فقط هو في إطار البحث العلمي، وأما المستدل عليه وهو كونه من عند الله فهو في إطار إيماني لا علمي.
فالكلام عن رصد الظواهر هو كلام علمي يقع بين مصطلحات نظرية ومصطلحات طبيعية -النظرية هي الكلام عن ما رُصد تأثيرُه دون رصد ذاته كتعريف البوزيترون أو الكوارك وما إلى ذلك من كينونات طبيعية دقيقة، والطبيعية المرصودة ذاتًا وتأثيرًا- ثم الكلام عن الاستدلال على النظام ونسبة وجود قوة خالقة هو عِلْمٌ، أما الكلام عن الخالق في ذاته فليس علميًا.
ولذلك فإن القرآن ذَكر مصطلحَ (العِلْمِ) في إطاريْن مختلفين؛ الأول: في إطار العلم الطبيعي كما في التعريف المعاصِر، وحينها فإنَّ القرآن الكريم يَذكر العِلم والعالِمين العلماء بعد ذِكْر آياتٍ دالّةً على مظاهرَ طبيعيةٍ مرصودة. والثاني: في إطار العلم الديني الإيماني، وحينها يَذكرُ الغيْبَ والإيمانَ بالله واليومِ الآخر. وعلى ذلك فلا يصح لمن أراد التعريف العلميَّ بالمعنى الأكاديمي المعاصر أنْ يذكر ما يدل على غيبٍ أو موقفٍ إيمانيٍّ بل يتوقفُ عند الرصد وقابلية النقض والبحث.
وهكذا فإن ذلك نهجي الذي أُوازن به بين العِلْمِ والدين فلا يطغى أحدُهما على الآخر، بل يعين أحدُهما الآخرَ ويزيده؛ والعلم إن وفيناه حقَّه وقرَّرنا مقرراتِه وحقائقَه كما ينبغي فإنه يَدُلُّ العقل دلالَةً صحيحةً إلى الإيمان بالغيبِ الأكبر، وأما ثقافتنا اليوم سواء في أبحاثنا العلمية أو تفسيرنا الديني فهي مخلّطةٌ، وجائرةٌ إحداهما على الأخرى حتى لم يعد لنا في أيِّهما نصيبٌ!
مشكلة التوثيق في التراث العربي:
نموذج ثالث: النقل من كتب التراجم والتاريخ العربية التراثية؛ كثير من أبحاثنا اليوم تنقل منها نقلًا غلفًا ساذجًا من غير تأن واعتبار تداخلات المذاهب السياسية والدينية والأغراض الشخصية الانحيازية، وعوادي الزمان على الكتب بضياعها أو تصحيفها أو تلفها بعض أوراقها أو أكثرها وما إلى ذلك؛ وللأسف لم يتنبه بعض الباحثين الذين هم في مراتب (أكاديمية) عالية وينقلون من التراث مع تغاضيهم عن اعتبارات آتية -مثلاً- فيما يخص ترجمة الأعلام -مثلاً-:
1 – قد يَتَحَيَّزُ كاتبُ الترجمة للعلم المترجم له أو ضدَّه لاختلاف المذهب أو الطريقة أو غير ذلك؛ فذلك يدعو الباحث إلى الحذر مِن نقل ما يقرؤه غُلْفًا هكذا مِن غير تحقيق وتدقيق. كمؤلِّف معروف أنه من أهل الحديث والضبط يترجم لصوفي واعظ قصاص معروف بسرد ألفاظ الصوفية الخاصة بعلومهم ومصطلحاتهم، والمؤلف المترجم لا معرفة له بهذه المصطلحات أو عمد تحيز مذهبيٌّ ضده.
2 – لا بد للباحث أن يراعىَ مصطلحات المؤلف المترجِم جيدا في ترجمته للعلم؛ كقوله «قيل» و«سمعتُ ممن حضره» و«بلغني أنه» أو غير ذلك مما يختلف عن قولٍ كـ«وقد حدثني أنه مولود سنة كذا» أو «حضرتُ إليه فرأيتُه يفعل كذا وكذا».
3 – ضرورة ملاحظة أن كاتب الترجمة قد لا يكون من أهل الضبط والتحقق بل قد يكون من أهل الجمع المطلق للمرويات.
4 – ضرورة ملاحظة الباحث أن كتب التراث التي وصلت أقل بكثير مما ضاعت أو ما زالت مخطوطة؛ فعليه توخى الحذر في صياغته الباتة القاطعة، ومع ذلك لا ينبغي عليه تقديم مادة يحتويها الشك من كل مكان. بل أن تكون مادتُه واضحةً لكن يعتريها فضولٌ ومساحةٌ للزيادة والنقص.
5 – بعض الكتب التراثية الكبيرة أصابها تدليسٌ متعمَّدٌ معروف في تاريخ مؤلِّف الكتاب؛ كالإمام الشعراني وما سيق مِن تدليسِ بعضِ النُّسَّاخ وأصحاب الأغراض والأحقاد في بعض النسخ المخطوطة لكتابه: (طبقات الأولياء)؛ فوُضع فيه ما لم يقلْه، ثم حقّقت بعض هذه النسخ وانتشرت بين الناس والباحثين على أنها من كُتُبِ الشعراني وعلى أن ما فيها هو قوله.
6 – كثرة المصادر المؤيدة لرأى ما لا تعنى بالضرورة صحةَ هذا الرأي؛ فقد تكون الكثرةُ كائنةً من ناقلٍ عن ناقِل، وعند النظر تجد أنّ هذه الكثرةَ تعود إلى قِلة قليلة، فلا القلةُ تعنى ركاكةَ الرأي، ولا الكثرةُ في نفسِها تعنى صحةَ الرأي. وعلى الباحث أن يقرن بالكتاب الكتاب ثم يوازن.
7 – إذا لم يجد الباحث أسماء مؤلفات للعلم المترجم له؛ فلا يصحُّ أن يكتبَ في ترجمته: «ليس له مؤلفاتٌ!»؛ إذ عدمُ وجودِ أسماء مؤلفاتِه فيما وصل إلينا لا يعني بالضرورة عدمَ الوجود مطلقًا.
وبعض الباحثين يلوكون قولَ الأول -مثلاً-: ابن حبان عن عبدالرزاق الصنعاني (ت 211 ه) « كَان مِمَّن جمع وصنف وحفظ وذاكر، وكان مِمَّن يخطئ إِذا حدث من حفظه، على تشيع فِيهِ» ولا يراعى الباحثُ الآتي:
أولاً: دلالة المصطلح في هذا العصر -مصطلح (تشيع)- غير الدلالة المعروفة اليوم. فلا بد من تحرير الدلالة التاريخية جيدًا.
ثانيًا: تجنب استخدام هذه الصياغة غير العلمية «أنه كذا وكذا على تشيع فيه» فهذه الصياغة هي رأي المترجِم الشخصي المبنىّ على طبيعة معتقدِه المخالِف للمترجَم له. والصياغة فيها ذم متوارٍ وهذا أسلوب غير موضوعي، ينقل كلامه على أنه تاريخٌ لا أنْ يَنقل الباحثُ ذلك المنهجَ كما هو.
ثالثًا: تجنُّب صياغاتِ المدح أو الذم؛ كالصياغة السابقة فمن الممكن أن يقال: اتهمه ابن حبان بالخطأ في الرواية إذا حدث مِن حفظه، وكان يشايع آل البيت بالمعنى المتعارف عليه في زمانه.
وبعد هذه النماذج فإن شعوري بالأسى على المستويات التي وصلت إليها أبحاثنا (الأكاديمية) -في حدود مطالعتي- شعور قاس؛ خاصة أن أكثر كاتبيها لا يقلون عن مستوى «الأستاذية»!
خاتمة: نحو وعي أكاديمي مسؤول:
إن الخلط بين الإيماني والعلمي، بين الحماسة والبرهان، وبين البلاغة والتحقيق، هو ما يجعل أبحاثنا (الأكاديمية) تعاني من أزمة مصداقية. المطلوب ليس تهميش الإيمان أو التراث، بل وضع كل عنصر في سياقه المناسب، واحترام المنهج العلمي بحدوده ومعاييره.
دعوة للتجديد:
علينا إعادة النظر جذريًا في ثقافتنا البحثية، ووضع «المنهج» لا الخطابة في مقدمة ما نُدرّس وننشر. فبهذا فقط، نرتقي ببحثنا، ونكون فعلاً «أكاديميين» لا مجرد حاملين للاسم.
عدد التحميلات: 2