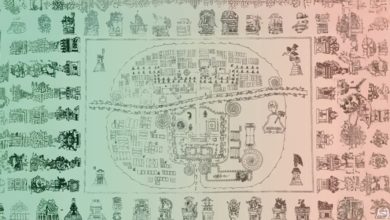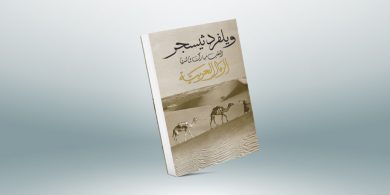شهدت السنوات العشر الأخيرة حُمّى من نوع آخر؛ ألا وهي حُمّى الشهادات العليا على وجه التحديد. ونتيجة لذلك، أصبح التنافس على أشدّه ليس فقط بين “طالبي الشهادات العليا” وحسب، بل بين مؤسسات التعليم العالي العام والخاصّ، وقد لا نبالغ إذا قلنا على مستوى العالم أجمع! ما الذي حدث حتى أصبح القاصي والداني، المؤهّل وغير المؤهّل، الذكر والأنثى، الغني والفقير، الكبير والأصغر سنًا يسعى وراء التحصيل الأكاديمي العالي من شهادة ماجستير ودكتوراه؟
لا شك أنّ الشهادة الجامعية ضرورية لكلّ من يرغب بمزاولة مهنة معينة يحصل عليها من خلال تحصيله الجامعي، كالتدريس والمحاماة والطب والهندسة والمحاسبة وغيرها من المهن الضرورية في الحياة والمجتمع. وهناك أيضًا المهن الحرفية التي تكون غالبًا موروثة من الجد إلى الأب فالابن، وهذه المهن الحرفية ضرورية أيضًا، ليس فقط من أجل استمرار الحياة وحسب، بل من أجل تحقيق التوازن الحيوي بين مختلف المهن ومجالات الحياة المتنوعة والضرورية لضمان استمرارية الحياة البشرية على هذا الكوكب الصغير. أمّا أن تتحول أنظار الناس كلّها إلى التعليم الجامعي، والتعليم العالي بشكل خاصّ، فهذا من شأنه أن يتسبب في خلل كبير جدًا يستحيل على إدارات التعليم الجامعي والتعليم العالي، وحتى سوق العمل، أن تحلّه أو تخفف من وطأته. ما أجمل من الاعتدال والتوازن في كلّ شيء! وقديمًا قالوا: خير الأمور أوساطها، ولعمري كم نحن بحاجة ماسّة لتطبيق هذا المثل الرائع في مختلف مناحي الحياة، النظرية والعملية!
لا أريد، بعد هذه المقدمة، أن أخوض في تفاصيل التعليم الجامعي فواقعه يتكلّم عنه أفضل منّي بكثير. لكنني سأخوض في موضوع التعليم العالي، أو الدراسات العليا من ماجستير ودكتوراه، كوني قد أمضيت أكثر من ربع قرن أدرّس في مجال التعليم الجامعي، وبضع سنين في التعليم ما فوق الجامعي. وأعتقد، كما يعتقد كثيرون في هذين القطّاعين، أنّ موضوع التضخّم الأكاديمي، أو التعليمي، برز في الفترة الأخيرة بقوّة كبيرة جدًا بحيث لا يمكن لعاقل ألا يلحظه، أو ألا يرى فيه مشكلةً كبيرة باتت تضرب أطنابها في أرجاء المعمورة قاطبةً وتقضّ مضاجع أصحاب القرار هنا وهناك! من المعلوم سابقًا أن عدد الطلاب الذين قد يرغبون في مواصلة التحصيل العلمي، بعد اجتياز المرحلة الجامعية الأولى، قليلٌ بالمقارنة مع باقي الطلاب؛ وذلك لأنّ المتفوقين في كل تخصص قلّة قليلة بالأصل، ومن خلال الخبرة الطويلة نسبيًا في هذا المجال أستطيع القول إنّ عدد المتفوقين دراسيًا في كل فصل دراسي لايتجاوز 5% من مجموع الطلاب في أفضل الحالات. سابقًا، وحسب معايير القبول في الدراسات العليا، لا يتم قبول إلا المتفوقين من ذوي المعدلات المرتفعة (جيد جدًا على أقل تقدير) بعد خضوعهم لاختبارات ومقابلات شخصية. أمّا الآن فإنّ هذه المعايير قد تغيّرت وتبدّلت وانخفضت وأصبح هناك استثناءات هنا وهناك، وأصبحت لكل مؤسسة تعليم عالي ضوابطها ومعاييرها وشروطها الخاصّة التي تسمح، للأسف، لغير المتفوقين ممن تقل معدّلات تخرّجهم في المرحلة الجامعية الأولى حتى عن “جيد” بالالتحاق ببرامج الدراسات العليا! بمعنى، أن باب القبول أصبح مفتوحًا على مصراعيه لكلّ من هبّ ودبّ للالتحاق ببرامج الدراسات العليا، شريطة أن يحقق الباءة والاستطاعة المادية ويدفع الرسوم المترتبة عليه! إنّ تخفيض معايير القبول في الدراسات العليا، ولاسيّما أهم معيار لها ألا وهو المعدّل، مؤشرٌ كبير على أنّ الهدف من الدراسات العليا، بالنسبة لتلك المؤسسات، ليس إعداد أساتذة جامعات مميزة، بل تحقيق عوائد مادية فقط، وهذا بدوره سينعكس على جودة التعليم الجامعي لأنّ بعضًا ممن يتخرّج من تلك المؤسسات، وكان بالأساس من أصحاب المعدلات المقبولة وغير مؤهّل للدراسات العليا، سيجد طريقه إلى التعليم الجامعي وفوق الجامعي من خلال المحسوبيات أو الواسطة أو المعارف والأٌقرباء. ولنا أن نتخيّل مخرجات التعليم على أيدي هؤلاء! وقد يصبح بعضهم أيضًا من صنّأع القرار في وزارات التعليم العالي، حسب نظام الترقية الوظيفي! ولنا أيضًا أن نتخيّل ماذا سيحلّ بالتعليم في كافة مراحله!!
لابدّ لأصحاب القرار، من الكفاءات العالية، في وزارات التعليم العالي من اتخاذ مايلزم لمكافحة هذه الظاهرة قبل فوات الأوان، علمًا أنّ أثرها أصبح كبيرًا وملحوظًا في المجتمع من خلال تزايد أعداد المؤهلات العالية تزايدًا كبيرًا جدًا لايمكن لسوق العمل أن يستوعبه، وهذا من شأنه أن يدفع أرباب العمل إلى رفع معايير التوظيف لديهم. وقد نرى موظفًا في شركة أو قطّاع ما يحمل شهادة ماجستير أو دكتوراه؛ مع أن الوظيفة ذاتها كان يقوم بها موظف يحمل شهادة دبلوم متوسّط في السابق! ومن شروط القبول في برامج الدراسات العليا أيضًا وجود خطابات تزكية للطالب يقوم بإعدادها بعضٌ من أساتذته في المرحلة الجامعية الأولى ممن درّسه بعض المقررات ذات الصلّة. فإذا كانت هذه الخطابات مهمّة ومصيرية في اتخاذ قرار قبول الطالب في برامج الدراسات العليا فلابدّ إذن من الاهتمام بها جيدًا، وهنا يبرز دور أساتذة الجامعات الأكفاء والنزيهين في كتابة خطابات تزكية أكاديمية وموضوعية ونزيهة تعكس مستوى الطالب الحقيقي وتحصيله العلمي الواقعي كما هو في كشف درجاته دون زيادة أو نقصان. أذكر ذات مرّة كان لديّ طالب مستواه دون الوسط وبالكاد يجتاز مقرراته التي يدرسها معي ومع غيري من الزملاء. جاءني بعد تخرّجه بمعدّل مقبول يطلب مني أن أعطيه خطاب تزكية، فرفضت ذلك وقلت له إن معدّله مقبول ولايؤهله للدراسات العليا فهي، أي الدراسات العليا، لأصحاب المعدلات العالية جدًا، وليست لمن دون ذلك. فسارعني بالقول إنّ المنهاج الذي درسه في الجامعة ليس جيدًا وإنّ مدرسيه، وأنا منهم بالطبع!، ليسوا أكفّاء لذلك تخرّج بمعدل مقبول!!! وإنّه سيتعلّم أفضل عندما يسافر إلى دولة غربية، حسب زعمه!! اعتذرت منه ولم أعطه خطاب تزكية، فعاتبني وخرج من مكتبي غاضبًا، وربّما ذهب إلى زميل آخر وطلب منه خطاب تزكية وأعطاه! علينا نحن، أساتذة الجامعات، مسؤولية أخلاقية ودينية وأكاديمية واجتماعية، ولا سيما فيما يتعلّق بخطابات التزكية. علينا أن نُعدّ خطابات موضوعية وواقعية مستندة إلى أداء الطالب وسجل درجاته في المقررات التي درسها معنا، وعلينا عدم التساهل في ذلك أبدًا، بغض النظر عن علاقتنا بالطالب ودرجة القرابة منه، وإلا فنحن شركاء في هذه الظاهرة ومسببون لها بطريقة مباشرة.
كي نحصل على تعليم جامعي نوعي علينا أن نساهم في قبول طلاب نوعيين في برامج الدراسات العليا، وهؤلاء الطلاب قليلون من حيث العدد، وهذا أمر عادي؛ لأنّ المتفوقين في أي تخصص هم النذر القليل، وهؤلاء من ينبغي استهدافهم في برامج الدراسات العليا وتشجيعهم من خلال تبنيهم ومنحهم منح دراسية مجانية نظير تفوقهم وتميّزهم وبذلك نعُدّهم ونؤهلهم لهذه المناصب فيحافظون على جودة التعليم وتميّزه، ونساهم أيضًا بمكافحة ظاهرة التضخم الأكاديمي التي أخذت بالانتشار مؤخرًا انتشار النار في الهشيم وتسببت بخلال جسيمة في مختلف مناحي الحياة ومجالاتها. أما ما يحدث، ولاسيما في السنوات العشر الأخيرة، من مرض عُضال أصاب المجتمع في مقتل نتيجة التضخّم الأكاديمي، فقد تجلّت أعراضه ودخل مرحلة سريرية حرجة، وإلا نفعل شيئًا حيال ذلك فإنّ المستقبل قاتمٌ لا محالة!
عدد التحميلات: 1