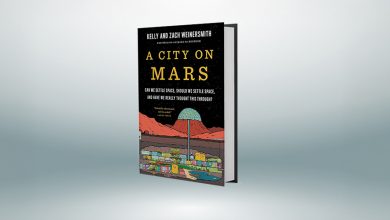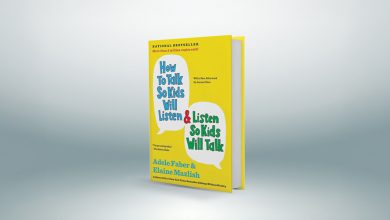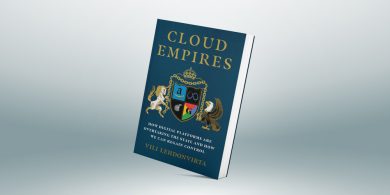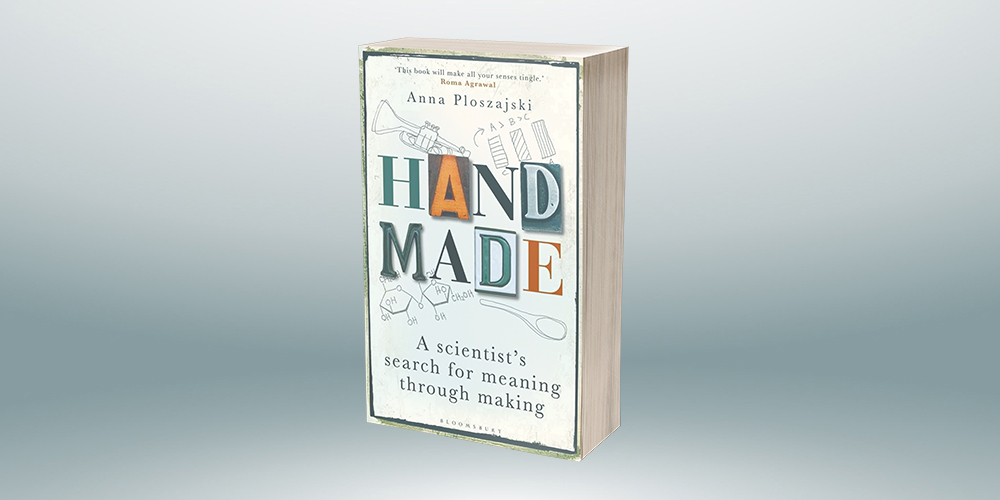
الكتاب: «صناعة يدوية: رحلة علمية للبحث عن معاني الأشياء من خلال تطبيقاتها»
المؤلف: آنا بلوجايسكي
الناشر: Bloomsbury Sigma
تاريخ النشر: 13 مايو 2021
اللغة: الإنجليزية
عدد الصفحات: 250 صفحة
عندما اختارت عالمة المواد آنا بلوجايسكي العمل في مجال توصيل العلوم، وجدت أنه كلما زادت مناقشاتها مع الآخرين حول أبحاثها، قلّت قدرتها على الإجابة عن أسئلتهم. وكانت تحيط علمًا بالتفاعلات الجزيئية التي تعطي المواد قوتها، أو مرونتها، أو صلابتها، لكنها عجزت عن الإجابة عن أسئلة أصدقائها وعائلتها حول البديل الأمثل للبلاستيك، أو لِم تُصنع شاشات الهواتف من الزجاج، رغم كونها عرضة للتحطم. ولعلاج تلك الثغرات في معرفتها للمواد، قررت أن تحظى بتدريب عملي، حيث سعت إلى استكشاف كيف يتفاعل الحرفيون مع المواد التي تقتصر معرفتها بها على الجانب النظري.
وفي كتاب «صناعة يدوية Handmade»، تستكشف بلوجايسكي عشر مواد. وتبدأ بالفئات الكلاسيكية من المواد في مجالها: الزجاج، والبلاستيك، والمعادن -مثل الصلب، والنحاس الأصفر- والخزف، ثم تنتقل إلى المواد الشائعة في الصناعة والحِرَف، التي تُدْرَس رغم ذلك بدرجة أقل في المختبرات، على غرار السكر، والصوف، والخشب، والورق، والحجر. وتجرِّب العمل على نفخ الزجاج، وصنع الفخار، وصب الفولاذ، وأشغال الإبرة، ونحت الملاعق الخشبية.
وتتعرف على الفنون التي تَستخدِم البلاستيك، والحِرف التي تستخدم الأحجار، وتلقي نظرة شاملة على مواد لم تكن لتعيرها اهتمامًا من قبل. وتمخضت تلك الجهود عن فهم لخواص المواد وتأثيرها الثقافي، ساعدها على توصيل العلوم على نحو أفضل.
وبوصفي كيميائية امتهنت الكتابة، وهاوية شغوفة بالحِرَف من أشغال الإبرة، إلى فن طيّ الورق (الأوريجامي)، تفهمت للغاية الأسباب التي دفعتها إلى مسعاها.
ويتخلل وصف بلوجايسكي لتجاربها عرض لمنظور علم المواد لهذه الوسائط المادية، بدءًا من التركيب الجزيئي غير منتظم الشكل للزجاج، إلى التفاعلات الكيميائية بين معادن الكالسيوم، والرطوبة، وثاني أكسيد الكربون، التي تُكسِب الملاط الجيري خواص الإصلاح الذاتي المذهلة التي يتميز بها. كما تصف تاريخ استخدام كل مادة بمقتطفات من التراث وعلم الآثار من جميع أنحاء العالم، تنوعت بدءًا من الإشارة إلى جوارب مغزولة من مصر القديمة، يزيد عمرها على ثلاثة آلاف عام، وصولاً إلى أفران تعمل بطاقة الرياح، استُخدمت في سريلانكا في أثناء العصر الحديدي. وتروي كذلك قصصًا طريفة حول ما أصبحت بعض المواد تعنيه بالنسبة إليها، فتسرد على سبيل المثال – قصة مصنع البلاستيك الذي أنشأه جدها، الذي وفد مهاجرًا إلى البلاد، والوجبات الخفيفة الغنية بالسكر، التي مكّنتها من السباحة عبر القنال الإنجليزي، والورق الذي حمل أفكارًا وقصصًا دوّنتها نساء مثليّات على مدار قرون مضت، وكانت عونًا لها على فهم طبيعتها الجنسية. وقد تمخض هذا كله عن سرد ساحر ومؤثر.
التأثير في عالم الواقع
وفي الفصل المعنون “صُلب” Steel تحكي بلوجايسكي عن نجاحها، في أثناء دراستها الجامعية، في الفوز بعضوية فريق يعمل على تصميم مركبة تتحدى الرقم القياسي في السرعة على اليابسة. وقد اكتشفت أن التروس في محرك السيارة تتحطم بفعل الضغط الناتج عن تكتل ذرات الكربون داخل معدن هذه التروس، لكنها عجزت عن توظيف هذا الاكتشاف عمليًّا على نحو يساعد الفريق على تحقيق هدفه، لأنها لم تملك الثقة اللازمة لعرض أفكارها على الميكانيكيين الذكور الأكبر سنًّا.
وقد بات الانفصال بين البحث العلمي الجيد وعرضه بالطريقة المناسبة للناس واضحًا بجلاء في أثناء جائحة “كوفيد- 19 “. ففي وسع الباحثين فهْم آليات العدوى بالفيروس، وإنتاج لقاحات فعالة مضادة له، وتقديم بيانات وبائية مثيرة للاهتمام عنه، بيد أنه دون فهْم الأسباب التي تعوق بعض الأفراد عن تلَقّي اللقاحات، أو تدفع بعضهم إلى الامتناع عن تلقيها، فإن تلك النتائج العلمية المكتشَفة قد لا تساعد الناس.
وتسلط تجارب بلوجايسكي الضوء كذلك على الكيفية التي يشكّل بها الأفراد البحث العلمي. فالعلماء يهدفون إلى تحقيق الموضوعية، لكنهم غالبًا ما ينسون أن تجاربهم وثقافاتهم تؤثر على كل جانب من جوانب عملهم. ومثلما تشكِّل ذَرّة في قطعة من الخشب شكل الملعقة التي تنحتها بلوجايسكي، تشكّل بِنْية المجتمع الأسئلة البحثية التي يسعى العلماء إ ليجاد إجابة عنها.
وهذا الوضع ليس سيئًا بالضرورة، بل تظهر المشكلات عندما ينسى الباحثون أن مقارباتهم تشكلها الظروف المحيطة بهم. ومثال على ذلك أن بلوجايسكي، التي تعزف آلة البوق منذ طفولتها، اكتشفت أن الأبواق لا تُصنع دائمًا من النحاس الأصفر، فبعض العازفين يفضلون الصوت الناتج عن أبواق مصنوعة من الفضة، أو النحاس الخالص. وتُذَكّرني هذه القصة بالاعتقاد الشائع بأن علم الفلك هو علم بصري، على الرغم من أن عددًا من الفلكيين المكفوفين كانوا روادًا في استكشاف الكون عبر الصوت.
وفي الحقيقة، تمنيت أن تقدم لنا بلوجايسكي مزيدًا من الأوصاف والقصص. فالشروح العلمية الموجهة إلى عموم القراء في كتابها انتهت فور ما أن بدأت تثير اهتمامي.
وهي تكتفي باستعراض نبذة سطحية عن تاريخ كل مادة، ودلالاتها الثقافية الضمنية، واستخداماتها المحتملة، بل كدت أتمنى أن تكتب مجلدًا كاملًا لمحتوى كل فصل، ليصبح لدينا موسوعة عن العلم والحِرَف.
والتأمل في تأثير التجربة الجسدية على أفكارنا كاشف حقًّا. والفصل بين الجانبين له تأثير ضار، حسبما تشير بلوجايسكي؛ فكل جانب بوسعه أن يحسِّن الآخر. وبوصفي حِرَفية، أتفهم جيدًا الارتياح الذي تجده بلوجايسكي في الإبداع الحرفي. فثمة شيء من السحر ينطوي عليه غزل مجموعة من الألياف الرقيقة المتنوعة، لتشكل خيطًا قويًّا يبعث في الناظر شعورًا بالدفء، أو استخلاص كتل الجبن الصلبة من اللبن السائل. وبعد الانغماس طوال اليوم في الأفكار والنظريات، من المبهج أن أحمل شيئًا حقيقيًّا بين يدي، وأقول: «أنا من صنع هذا».
عدد التحميلات: 0