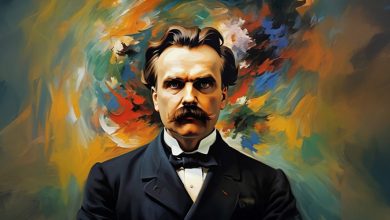في العام 1995م أطلق الطبيب النفسي الأمريكي إيفان جولدبيرج مصطلح اضطراب إدمان الانترنت والذي بات يشار له اختصارًا (IAD)، ولكن لم يكن الأمر موضع اهتمام فعلي. ثم في العام 1966م عرضت المتخصصة النفسية الأمريكية د. كيمبرلي يونج في مؤتمر متخصص دراسة جادة في تتبع الموضوع بعنوان (إدمان الانترنت): ظهور اضطراب عيادي جديد وعرضتها في المؤتمر السنوي للجمعية النفسية الأمريكية، والذي عقد في تورنتو، ونشرت الورقة بعد ذلك في أحد الدوريات النفسية المتخصصة، ولكن كيف استطاعت د. يونج دراسة هذه الظاهرة كإدمان مع أنها غير مصنفة مرضيًا في الدليل التشخيصي للاضطرابات النفسية (DSM) الذي اعتمدته الجمعية الأمريكية للطب النفسي (APA) والذي يعتبر المرجع الحاكم في هذا الحقل في الأمريكيتين؟ الحقيقة أن د.يونج أخذت من هذا الدليل بإصداره الرابع آنذاك (1994 DSM-IV APA) معيار اللعب المرضي للقمار وتوصلت الدراسة إلى أن عددًا من أفراد العينة من مستخدمي الانترنت يعاني من نفس الأعراض المصاحبة للعب المرضي للقمار.
من خلال دراسة الدكتورة يونغ Young حول الإدمان على الانترنت والهدف منه، حيث مست هذه الدراسة 396 متصل بالإنترنت تتوفر فيهم محكات الإدمان، توصلت إلى إيجاد 3 أفواج من الأشخاص المدمنين:
1 – فوج يهدف إلى الحصول على علاقات اجتماعية، وهم أشخاص يعيشون في مناطق معزولة جغرافيا ومهمشون اجتماعيًا.
2 – فوج الباحثين عن الاتصالات الجنسية الخيالية حيث تصبح المواقع الإباحية وسيلة للحصول على الإشباع بدون خطر.
3 – فوج المستعملين الذين يخترعون شخصية خيالية عنهم عبر الانترنت ويصبح بإمكانهم أن يفحصوا مظاهر شخصيتهم التي لم تظهر في الواقع.
اختلف العلماء في استخدام مفهوم الإدمان على شبكة الانترنت، حيث اعترض البعض على أن الشخص يعتبر مدمنًا إذا استخدم الانترنت بشكل زائد عن الحد فالشبكة ليست عادة، إنما هي ميزة للحياة الحديثة لا يمكن الاستغناء عنها، واعتبروا أن الانترنت عبارة عن بيئة ولا يمكن الإدمان على بيئة، غير أن الدراسات والبحوث الأخيرة، والتي قامت بها مراكز متخصصة، أكدت أن الإدمان على الانترنت أصبح واقعًا وحمى مرضية، عكف الأطباء النفسانيون البحث عنها وعن مخاوف الاستعمال المفرط والمبالغ للشبكة، وأصبحت تسميات تطلق على من يبالغ استعمالها مثل: الإدمان على الانترنت الاستخدام الباثولوجي للإنترنت، أو الاستخدام القسري للإنترنت، وحسب استطلاع أجري عام 2005 نظمته جامعة ستانفورد حددت من خلاله معدل قضاء الوقت في استخدام الانترنت بشكل عام 3 ساعات ونصف.
نبه الباحثون في هذا الحقل إلى أنه ليس المراد بالإدمان الشبكي إدمان الآلات المادية المحسوسة لهذه الأجهزة التقنية، وإنما مرادهم بطبيعة الحال إدمان المحتوى ذاته وإنما هذه الأجهزة وسائط وبشكل أكثر تحديدًا فإن المحتوى الذي يشار له في هذه الدراسات هو شبكات التواصل الاجتماعي وغرف الدردشة وألعاب الفيديو والقمار الإلكتروني والمواد الإباحية ونحوها، كما سيأتي الإشارة إليه ويحظى الإفراط في الانهماك في شبكات التواصل الاجتماعي بدراسات خاصة تسمى اختصارًا (SNS addiction)، وهو يعنينا في موضوع كتابنا هذا أكثر من غيره من صور الإدمان الشبكي لأنه وبحسب اطلاعي هو أكثر المحتويات الشبكية قدرة على اصطياد الشرائح الجادة المشغولة بالعلم والإصلاح.
ومن بين العوامل المسببة لذلك:
1 – الافتقاد للسند العاطفي عند المراهقين يجعلهم يلهثون وراء الإشباع الوهمي واللذة المؤقتة من خلال الدردشة مع الغرباء.
2 – إطلاق الرغبات الدفيئة والتعبير عنها عبر غرف الدردشة التي توفر للشباب فرصة ذهبية للتخلص من القيود المجتمعية الصارمة.
3 – توفر غرف الدردشة وسيلة للتفريغ الانفعالي وتفريغ شحنات الغضب والكبت والعدوانية لذلك تصبح تلك الغرف الملاذ الآمن والمنقذ الأكبر، لما يعتري النفس من مكبوتات اللاشعور وبكل ثقة، مما يؤدي إلى توهم الحميمية والألفة.
4 – يحاول الفرد من خلال الإنترنت التخلص من حالات القلق النفسي وضغوطات الحياة اليومية.
5 – انتشار مقاهي الانترنت وتوفر السيولة المالية للمراهقين.
6 – التأثر بثقافات أخرى خاصة في عصر التطور الهائل في الاتصالات.
7 – تأثير جماعة الأقران والأصدقاء خاصة إن كانوا مدمنين على الانترنت.
من مظاهر إدمان الانترنت:
التصفح القسري
ومن الملاحظ أن بعض الناس أثناء الأوقات الجادة المخصصة للمهام، كاجتماع عمل أو حضور درس أو مذاكرة لاختبار أو بحث علمي أو ساعة ذكر وتلاوة ونحو ذلك، تتسلل يده مرارًا إلى هاتفه الذكي ويفتح شبكات التواصل مثلاً، ويبدأ إبهامه في تمرير الصفحات، فهل هذه مجرد عادة (habit) أم هي إدمان (addiction)؟ المتخصصون في هذا الحقل يشيع بينهم التأكيد على أن الفارق بين العادة والإدمان هو «صفة القهرية» (compulsive)، فالعادة تظل محكومة بالقدرة على السيطرة على الإرادة، بخلاف الإدمان الذي يتحول إلى سلوك قهري.
المفاجئ عن المواد التي أدمن عليها، حيث يبدأ انسحاب السموم من الجسم، وهذه الأعراض المصاحبة مثل التوتر والقلق والغثيان ونحوها، ومن الملاحظات الطريفة التي تشير إليها دراسات هذا الموضوع، أن العينات محل الدراسة التي تم تشخيصها بأنها مدمنة على الانترنت، وهو إدمان سلوكي وليس كيميائي، ظهر عليها أيضًا «الأعراض الانسحابية» عند التوقف المفاجئ عن استخدام الانترنت، فيظهر عليها الغضب والقلق والتوتر والانزعاج.
وهذه الحالة التي تذكرها هذه الدراسات تؤكدها التجارب الشخصية أيضًا، وما زلت أتذكر أحد الأصدقاء تأخر كثيرًا في تسليم رسالته العلمية، ولاحظ أن شبكات التواصل تلتهم عليه وقته وتفترس تركيزه الذهني والنفسي، فقرر حذف حسابه، ويروي هذا الصديق كيف كان يشعر بتوتر في اليوم الأول، وكيف كانت تقرصه يده للدخول لما اعتاد عليه، بل حدثني شخصيًا وهو مندهش كيف لاحظ أبناؤه فظاظته في التعامل معهم في الساعات الأولى التي حرم نفسه فيها من الدخول لشبكات التواصل، وهذه الحالة هي عينها الأعراض الانسحابية (withdrawal symptoms) التي رصدتها الدراسات التجريبية الجادة في هذا الحقل.
مدمنو البيانات (Data holics)
من العقبات المعروفة في البحوث العلمية شح المعلومات في موضوع البحث التي تجعل الباحث يقلب الكتب وهو كاسف البال ويراسل المختصين فلا يعود بطائل ويصبح البحث كالجبل فوق رأسه، ولكن ليس هذا كل شيء، ليس شح المعلومات هو المشكلة فقط، فإن الكثرة المفرطة في المعلومات موضوع البحث هي أيضًا عقبة أخرى أكثر شيوعًا اليوم، فترى الباحث كلما ظن أنه استوعب منطقة البحث وحرثها جيدًا، انفتحت عليه أبواب ومساحات أخرى فيتشعب ويتفرع حتى تخور قواه، فلا يسعفه الوقت الدراسة هذه المعلومات المتدفقة المتناسلة، وبذات الوقت يعز عليه أن يختم البحث ويستخلص النتائج وما زالت بعض معطياته مجهولة له، وخصوصًا إذا كان الباحث من المصابين بشهوة الاستقصاء.
عدد التحميلات: 0