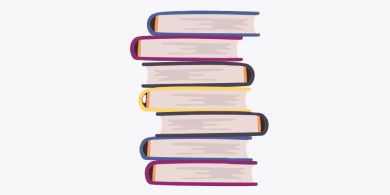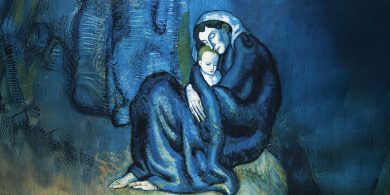نازك الملائكة والتأسيس الحداثي للفكر النقدي العربي
كان المشهد الأدبي في حدود الربع الأول من القرن العشرين ذا جذوة بما نشره الأدباء من قصائد وقصص ومقالات، مفيدين من التراث الأدبي العربي أو من الآداب الأوروبية الحديثة وأحيانًا من كليهما معًا. ولم يكن للنقد حضور مماثل به يواكب ما في هذا الأدب من جذوة، فظلّ دوره غير ملاحظ ولا مؤثر لأسباب متعددة، أهمها القطيعة الطويلة مع النقد القديم التي دامت لأكثر من أربعة قرون فكان الأدباء هم الممارسون للنقد بشكله الانطباعي، ولهم قراءاتهم في البلاغة العربية وكتب التاريخ والاجتماع، ومعتمدين أيضًا على حسهم الذوقي في تشكيل الرؤى وإصدار الأحكام. ومنذ أواخر العشرينيات وما بعدها ظهر نفر قليل من الدارسين، التحقوا بالجامعات الأوروبية وتخصصوا في النقد الأدبي وكان لإتقانهم اللغة الانجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أن جعلهم مترجمين لأمهات كتب النظرية الأدبية الغربية إلى جانب ممارستهم الكتابة النقدية في الصحف والمجلات أو في كتب متخصصة فضلًا عن دورهم كأساتذة جامعيين. وتشكل من النقاد الأدباء وهؤلاء الدارسين الأكاديميين الرعيل الأول من النقاد العرب المنهجيين الذين وضعوا أساسات النقد الأدبي التطبيقية في الأدب عامة والشعر خاصة، معتمدين نظريًا على ما في النقد الغربي من مدارس ومذاهب ومنهجيات وأولها المنهج التاريخي والمقارن وأحيانًا المنهج الاجتماعي، باستثناء عدد قليل من الكتب التأسيسية التي ضمت شكلا أوليا من أشكال التفكير في الفعل النقدي مثل كتب العقاد وكتاب ميخائيل نعيمة (الغربال) وفيه وضع رؤاه الأدبية معتمدًا على ذائقته الانطباعية وما تلقفه من قراءة الآداب اليونانية.
وأغلب هذه الرؤى تفتقر إلى الجدة نظرًا لغلبة روح السخرية والتهكم عليها مع اهتمام خاص أظهره نعيمة بمسالة تثبيت المقاييس الأدبية، رافضًا الخروج عليها سواء وهو يصدر الأحكام أو وهو يقدم النصائح والتوجيهات، مؤكدا أن (من حسنات المقاييس أنها ثابتة لا تتقلب بتقلب الفصول والعصور فهي وإن تنوعت بتنوع الأمم والأمصار، تتنوع من حيث شكلها الخارجي لا من حيث جوهرها)1 ومثاله على ذلك المزامير، إذ ما يزال (قسم كبير من العالم ينشدها كما كان ينشدها منذ ألوف من السنين شاعر عبراني اسمه داود ويستمد من إنشادها لذة روحية)2. ولكنه تهكم من عروض الخليل قائلًا: (منذ مات الخليل حتى اليوم ونحن منغمسون في درس الخبن والخبل والترفيل والتذييل والنقص والوقص.. إلى أن ملكنا بإذن الله ناصية علم العروض وأصبحنا بمنة الخليل نميز بين صحيح أوزان الشعر العربي وفاسدها.. فالمهم المهم أن نعرف إذا ما نظمنا بيتا أننا لم نجز لأنفسنا ما لم يجزه الخليل وأننا لم نهتك حرمة قاعدة ولم نخلّ بحرف من ناموس.. فاتكلنا على الله ورحنا ننظم القصائد)3.
وعلى الرغم من هذه السخرية، فإن نعيمة خشي من أن يُفهم كلامه فهما خاطئا لذلك استدرك، وبالروح الساخرة نفسها، منبها القارئ إلى أنه لا يعني مما قاله آنفًا رفضًا أو قلبًا: (تسألني ما إذا كنت أتهكم أو أعنى ما أقول؟ لا وتربة الخليل لست متهكما فلعروض الخليل فضل علي كبير.. لأن الخليل يوم جمع ما كان في زمانه من أوزان الشعر وبوبها وحدد ما يطرأ عليها من الزحافات والعلل لم يقصد سوى الخير.. أما الذين جاءوا بعد الخليل فتقيدوا بزحافاته وعلله ألف ومائتي سنة فإياهم أسدي جزيل شكري. لأنهم بمباراتهم في معرفة صحيح أوزان الشعر وفاسدها قد أتقنوا الأوزان وأهملوا الشعر. وبإهمالهم الشعر نبهوني إليه وقد ينبهنا عدم وجود الشيء إلى الشيء أسرع مما ينبهنا إليه وجوده)4 وبهذا الاستدراك يكون نعيمة قد أكّد ثباته على المقاييس المعتادة في نظم الشعر، وأنه لا يؤاخذ سوى الذين يحرصون في قول الشعر على مسألة خلوه من الزحافات والعلل حسب.
وأما تشبيهه الأوزان والقوافي بطقوس الصلاة وأن من الممكن للصلاة أن تكون من دون طقوس وأن (لا الأوزان ولا القوافي من ضرورة الشعر)5 فجاءت في معرض تمثيله الساخر على لا جدوى البحث عن الزحافات والعلل لأنها أساءت إلى الشعر بشكل عام.
وتبقى محاولة نعيمة في (الغربال) مميزة بالنسبة إلى محاولات نقاد آخرين من جماعة الديوان أو جماعة أبولو أو أدباء المهجر الذين كان نقدهم الأدبي بالعموم محافظًا ونمطيًا. واستمرت هذه النمطية طاغية على نقدنا الأدبي إلى منتصف القرن العشرين؛ فلم يعن بالفكر والتنظير إلا في حدود ما جادت به النظرية الأدبية الغربية، سواء في مصر وفيها اتخذ النقد شكلًا منهجيًا وكانت غالبية ممارسيه من أساتذة الجامعة أو في العراق وفيه اتخذ النقد شكلا انطباعيا لأن غالبية ممارسيه كانوا من الأدباء ثم أخذ يظهر معهم قلة من الجامعيين مثل عبدالقادر حسن أمين برسالته (القصص في الأدب العراقي الحديث) 1955 وحصل عليها من الجامعة الأمريكية ببيروت، وعلي جواد الطاهر وحصل على شهادته من السوربون6 كما عُرفت أسماء أخرى بممارسة النقد والترجمة الأدبية مثل نهاد التكرلي وعلي الشوك وجبرا إبراهيم جبرا. أما نازك الملائكة فمثلت حالة استثنائية بوصفها الشاعرة الثائرة على عمود الشعر، والناقدة التي قدمت لدواوينها بمقدمات فيها تنظير فكري ونقد تطبيقي أيضًا.
وتعد مقدمة ديوانها (شظايا ورماد) 1949 أول مانفستو شعري يبشر بحركة الشعر الحر وفيه وضعت رؤيتها الفلسفية في تحديث القصيدة العربية. وبهذا المانفستو اختلفت عن أقرانها كونها لم تكتفِ بنظم الشعر الحر وحده كما فعل السياب والبياتي، بل اهتمت أيضًا بالتنظير لهذا الشعر فقدمت رؤى نقدية اعتمدت فيها على ما تحصلته في دراستها للماجستير من مفاهيم وطروحات مدرسة النقد الجديد الأمريكية في وقت لم يكن عدد النقاد العراقيين الجامعيين يتجاوز أصابع اليد الواحدة.
وبجمع نازك الملائكة بين النقد النظري والنقد التطبيقي، تغدو حيازتها السبق مخصوصة بها كأول شاعرة تودع في مقدمات دواوينها أطروحة خاصة في الحداثة الشعرية. وهي أطروحة بطبيعة الحال فريدة لأنها بلا بواكير أو ممهدات، وإنما هو وعي الشاعرة العالي بالشعر والفاعلية الشعرية.
وأية عملية مسح للواقع النقدي في تلك المرحلة ستؤكد أن مانفستو (شظايا ورماد) محاولة رائدة في ممارسة الفكر النقدي استلهمت فيه الشاعرة قراءاتها المعمقة في التراث العربي ومعرفتها الواسعة بالشعر الغربي. فكانت صاحبة ثورة حداثية كلية؛ ولم تكن على مستوى إبداعي واحد، بل شملت الشعر ونقده معًا. وهو أمر كثيرًا ما يتغاضى النقاد عن تقدير كليته، فينظرون إلى منجز الملائكة الإبداعي بمنظار تجزيئي ليقرروا أنها في الشعر رائدة ولكن في النقد مرتدة وناكصة.
وإذ ابتدأت نازك الملائكة في مقدمة (شظايا ورماد) بطرح رؤاها في خرق القواعد الشعرية، فإنها لم تتوقف عن التنظير قط، بل كتبت مقدمات أخر وبروح مغايرة. ومرادها ليس إبدال قواعد بقواعد، بل الاستمرار في الانقلاب على القواعد، ولا فرق بالنسبة إليها إن كان في الانقلاب ما يعزز آراءها أو لا.
وكان لعلم النفس دور مهم في ما طرحته من تعليلات لرؤاها الحداثية. ومن المفاهيم التي اجترحتها، مفيدة من أدبيات مدرسة التحليل النفسي ما يأتي:
الاقتران: يعني استعمال الأديب – وهو نصف واع – الألفاظ بصورة رتيبة تعكس ما في نفسه من رتابة فتصبح من ثم تلك الألفاظ ظلا له.
الإبهام: (صورة من صور الحياة ولذلك يندر أن نجد شاعرا كل شعره معقد ملتو. أما الذين يتعمدون تعقيد شعرهم فقد يكون الدوس هكسلي التمس لهم بعض العذر حين قال إن المعاصرين يهربون إلى الإبهام خوفا من الوضوح الذي هو الصفة الأساسية في الأدب الشعبي)7.
الذات الباطنية واللاشعور: (هي حالات لم يقف عندها الشعر العربي إلا نادرا فهو وقف نفسه على معالجة السلوك الخارجي للإنسان)8 وطبقت الشاعرة هذا المفهوم على ثلاث من قصائدها فيها مشاعر الحزن والندم والخوف والنسيان والضعف والشرود. وأولاها هي «الخيط المشدود إلى شجرة السرو» ويتحدث موضوع القصيدة عن قصة عاطفية لشاب فوجئ بنبأ موت حبيبته، فرسمت الشاعرة انفعالاته في صورة شعرية تحكي هذيانه الداخلي الذي اعترى عقله المصدوم. والقصيدة الثانية «مر القطار» وفيها رسمت صورة للمشاعر التي يحسها مسافر الدرجة الثالثة في القطار ليلًا. والقصيدة الثالثة «الأفعوان» وفيها عبرت عن الإحساس الخفي الذي يعتري المرء ويشعره أن هناك قوة مجهولة جبارة تطارده مطاردة نفسية ملّحة (الأفعوان يطاردنا.. حتى لذنا باللابرنث وهو تيه معقد المسالك يدخله المرء فلا يملك مغادرته لالتواء طرقه وكثرة أبوابه)9.
الإيحاء الذاتي: هو الذي يجعل الجمادات تشعر بما يشعر به الإنسان (ألف قصة تقصها الأشياء الراكدة حولنا) ومثلت الشاعرة على هذا المفهوم بقصيدة «مر القطار» وفيها يبرز الشعور بالسكون (إنه لن يجيء/ لن يجيء وإن عبر المستحيل/ أبدا لن يجيء) وقصيدة «خرافات» وفيها السياج يتكلم ويستعيد ما لديه من ذكريات انطمست وماتت. وقصيدة «قصائص الورق الممزق في الخرائب» وتحكي أقاصيص مثيرة عن حوادث بعيدة منسية وقصيدة «الغبار» وتقص حكاية النسيان الذي تذره العصور على كل شيء10.
الحاجة إلى التجديد: ضرورة طبيعية من ضرورات الحياة، إذ لا يمكن للإنسان أن يلبس ما كان يلبسه أسلافه قبل قرون ومثل ذلك تقاليد الشعر العربي التي ستتغير حتما. واستقرأت الشاعرة واقع الشعر في عصرها، فوجدته (يقف على حافة تطور جارف عاصف لن يبقي من الأساليب القديمة شيئًا فالأوزان والقوافي والأساليب والمذاهب ستتزعزع قواعدها جميعًا والألفاظ ستتسع حتى تشمل آفاقًا جديدة واسعة من قوة التعبير والتجارب الشعرية ستتجه اتجاهًا سريعًا إلى داخل النفس بعد أن بقيت تحوم حولها من بعيد)11.
جدلية الخمود التطور: قانون حتمي ينطبق على ما هو مادي وغير مادي، وبه شرحت نازك الملائكة منطقية التلاقي الثقافي بين الأمم (فقد يحدث أن أمة معينة تخمد قابلياتها وتركد قرونًا كاملة بتأثير عوامل خاصة ثم يأتي عليها زمن متوثب يوقظها فتتململ وتتحرك وترنو إلى ما حولها وتبدأ باستيعاب ما فاتها من ثقافات فتستفيد من تجارب أمة مجاورة بقيت نشيطة فأضافت إلى الفكر الإنساني فصولا لامعة. فما يمضي نصف قرن حتى تنتهي الأمة التي كانت راكدة من مرحلة الاستيعاب وتبدأ حيث وقفت الأمة المجاورة.. لا نستطيع أن نعثر على مذهب أو اختراع أو نظرية توصلت إليها أمة بعينها دون أن تستفيد من تجارب الأمم الأخرى)12.
ولم تكتفِ نازك الملائكة بالتنظير للشعر الحر على مستوى كتابة المقدمات، بل على مستوى كتابة الدراسات أيضًا وفيها قدمت مزيدًا من التصورات الفكرية حول أطروحتها الحداثية في الشعر الحر، فنشرت على مدى عشر سنوات تقريبًا دراسات نقدية في مجلتي الأديب والآداب البيروتيتين ثم جمعت تلك الدراسات ونشرتها بعد إجراء بعض التغييرات عليها في كتابها (قضايا الشعر المعاصر) 1962 والذي أثار وما يزال يثير كثيرا من الاختلاف.
وسنخصص للمقدمات التي افتتحت بها نازك الملائكة دواوينها وقفة تحليلية، وهدفنا التدليل على تأسيس نازك الملائكة الحداثي للفكر النقدي العربي في وقت كانت النزعة الكلاسيكية مهيمنة عليه في الأعم الأغلب.
القاعدة/ اللاقاعدة
مهدت قصائد ديوان (عاشقة الليل) الطريق أمام نازك الملائكة لأن تضع أطروحتها في التحديث الشعري، وكانت أول بادرة في ذلك هو كتابتها مقدمة نقدية لديوانها الثاني (شظايا ورماد) 1949 بسبب ما اشتمل عليه من نصوص، اختلفت طريقة نظم تفعيلاتها عما هو معهود، فأظهرت نازك الملائكة في هذه المقدمة وعيًا عاليًا بأهمية تجديد القصيدة العربية على المستويين: الرؤيوي وفيه درست العملية الشعرية كفعل ذهني جمالي، والمستوى الإجرائي وفيه حللت بعض قصائد الديوان، موضحة بشكل عملي للقارئ جدوى ما تهدف إلى تحقيقه في الشعر من تغييرات جدية. بيد أن الأهمية الكبرى في هذه المقدمة تتجلى في انطلاق الشاعرة نازك الملائكة من ثنائية (القاعدة/ اللاقاعدة)؛ وعلى وفقها وضعت أطروحتها الجديدة والجريئة في الشعر الحر. ولا محصلة نهائية لهذه الثنائية، لأن خرق القاعدة سيؤدي بمرور الزمن إلى ثبوتها كقاعدة، ومن ثم يكون لزامًا خرقها بقاعدة أخرى.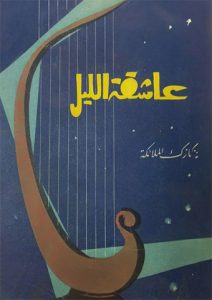
وهذا هو لب الأطروحة الشعرية التي نادت بها نازك الملائكة وهي بمثابة معادلة تتألف من طرفين متناقضين وفي حالة استمرار على الدوام، فيها يجد الشعر حياته؛ فأما الطرف الأول ففيه القاعدة لا تناسب الواقع الشعري، بل هي تحنط الشعر الذي هو في ماهية تكونه مثل الحياة، يتغير بتغيّر أحداثها. ومعلوم أن الشعر لا يكون حرًا، إلا إذا حلَّق الشاعر في أجواء الحلم والخيال على رحابتها بلا حدود أو موانع. وأما الطرف الآخر ففيه لا مناص للشعر من القواعد التي مهما خرقت فإنها ضرورية. ومن هنا عنونت الشاعرة ديوانها بـ(شظايا ورماد) حيث الشظايا تمنح الطاقة على الخرق والتجاوز أي (اللاقاعدة) وحيث الرماد رجوع إلى الأصل على نية استعادة (القاعدة).
ولقد طرحت الشاعرة رؤيتها هذه بشكل واضح وأعلنت – بلا تتردد ولا ارتكان إلى التهكم أو السخرية – أن الشعر العربي الحديث كسيح، وأنه (لم يقف بعد على قدميه بعد الرقدة الطويلة التي جثمت على صدره طيلة القرون المنصرمة الماضية)13 ومقصدها من وراء ذلك كله شرح العملية الشعرية، وفيها حجزت للقارئ موقعا مهما، بوصفه طرفًا، عليه تقع المراهنة في الاحتجاج للحداثة والمجادلة في خرق المعتاد والثورة عليه. وليس هذا التحديث محض صدفة أو مجرد تخمينات طارئة، بل هو مقصود. ولا عجب أن تدخر له نازك الملائكة كل طاقتها الإبداعية، موظفة ما لديها من أساليب بلاغية، منها:
1) استعمال ضمير جماعة المتكلمين (نا) في التعبير عن فكرها، كقولها: (نحن ما زلنا أسرى القواعد/ ما زلنا نلهث ونجر عواطفنا بسلاسل الأوزان/ سدى يحاول أفراد منا أن يخالفوا/ جمدنا على ما كان قبل ألف عام) فغايتها من وراء الحديث عن ماهية الشعر ليست خاصة بتجربتها وحدها وإنما هي عامة ومقصود منها الشعر العربي برمته.
2) توجيه الأسئلة باستعمال صيغة الاستفهام الاستنكاري، في قولها: (ألم تصدأ لطول ما لامستها الأقلام والشفاه منذ سنين وسنين؟ ألم تألفها أسماعنا وترددها شفاهنا وتعلكها أقلامنا حتى مجتها ؟)14 فهي تتوجه بأسئلتها هذه نحو القارئ، مبتغية تحفيزه على تأمل العروض الخليلي وتدبر ما فيه من تقييد وجمود.
3) التمثيل السردي باستعمال تقانة المحاكاة الساخرة، لما لها من دور بلاغي في إيصال الدلالات بأقل الألفاظ وأكثرها قوة، كقولها: (كأن الشعر لا يستطيع أن يكون شعرا إن خرجت تفعيلاته على طريقة الخليل.. سارت الحياة وتقلبت وما زال شعرنا صورة لقفا نبك وبانت سعاد) و(أن اللغة إن لم تركض مع الحياة ماتت) و(أجيال من الذين يجيدون وضع التماثيل) و(صنعوا من ألفاظها نسخًا جاهزة ووزعوها على كتّابهم وشعرائهم دون أن يدركوا أن شاعرًا واحدًا قد يصنع للغة ما لا يصنعه ألف نحوي ولغوي مجتمعين)15.
4) الشرح المنطقي المدعم بالتعليل، له فاعلية في تقريب الأفكار سواء في تشخيص سلبيات الشعر العربي أو في وضع حلول عملية تعالج تلك السلبيات. ولقد شخَّصت نازك الملائكة أربع ظواهر شعرية سلبية، هي:
- ظاهرة القافية الموحدة/ هي أول ظاهرة سلبية شخّصتها نازك الملائكة وبينت مساوئ الالتزام بها؛ فالقافية:
- أنزلت (خسائر فادحة بالشعر العربي طيلة العصور الماضية.. تضفي على القصيدة لونًا رتيبًا يمله السامع فضلًا عما يثير في نفسه من شعور بتكلف الشاعر وتصيده للقافية.. القافية خنقت أحاسيس كثيرة ووأدت المعاني. والشعر لا يكون إلا وليد الفورة الأولى من الإحساس في صدر الشاعر)16.
- (ذلك الحجر الذي تلقمه الطريقة القديمة كل بيت)17.
- (حالت دون وجود الملحمة في الأدب العربي مع أنها وجدت في آداب الأمم المجاورة كالفرس واليونان)18.
- جعلت من النادر أن نجد في الشعر القديم (قصائد موحدة الفكرة يسيطر عليها جو تعبيري واحد منذ مطلعها إلى ختامها)19.
ولذلك كله رأت نازك الملائكة أن من الممكن أن تتعدد القافية، خرقًا لقاعدة القافية الموحدة وليس إلغاء لها بشكل تام. وقصدت بـ(الآلهة المغرورة) القافية الموحدة التي لا تريد تعددًا، فدعت إلى الاستخفاف بسلطانها من خلال استعمال واحد من الأنظمة الآتية: نظام الرباعية أ ب ب أ / نظام التعاقب أ ب أ / نظام المقطوعة stanza أ أ ب ب أ ب.
- ظاهرة قلة الاهتمام بالجانب الإيحائي للغة وما فيه من قوى كامنة الأمر الذي تسبب في:
- جنوح الجمهور العربي إلى (استنكار مدارس شعرية تعتمد على القوة الإيحائية للألفاظ كالرمزية والسريالية)20.
- جعل في (اللغة أثقالا من الرموز والأحلام الباطنية والخلجات الغامضة واتجاهات اللاشعور ومثل ذلك مما لا تنهض به إلا لغة بلغت قمة نضجها)21.
- اليقظة التي تخرج الشاعر من عالم الأحلام فيضطر إلى مصانعتها وربما يختار القوافي أولًا وعلى وفقها يضع القصيدة. والحل في معالجة هذه السلبية هو أن (يطلق جناح الشاعر من ألف قيد).
- ظاهرة ترديد النقاد مقولة إن القارئ العربي يهرب من الشعر الرمزي والذات العربية تنفر من الإبهام والرموز فـ(لا تجد جمالًا في الدهاليز التي تتلوى وراء الحس)22 ورأت الشاعرة أن ذلك غير صحيح، إذ أن (النفس البشرية عمومًا ليست واضحة وإنما هي مغلقة بألف ستر وقد يحدث كثيرًا أن تعبِّر الذات عن نفسها بأساليب ملتوية، تثيرها آلاف الذكريات المنطمسة الراكدة في أعماق العقل الباطن منذ سنوات وسنوات ومئات الصور العابرة التي تمر فيحدق فيها العقل الباطن ويكنزها مع ملايين الصور التافهة ويغلق عليها الباب حتى إذا نسى في غفلة من العقل الواعي أطلقها صورًا غامضة لا لون لها ولا شكل.. الشاعر لا يستطيع أن يتهرب من هذه الصور فهي تلاحقه. والإبهام جزء أساس من حياة النفس البشرية لا مفر لنا من مواجهته أن نحن أردنا فنا يصف النفس ويلمس حياتها لمسًا دقيقًا)23.
- ظاهرة نظام الشطرين، قيّد هذا النظام الشعر من نواح عدة، ولم يسمح للشاعر أن يقف حيث يشاء الوقوف، وجنى بذلك جناية كبيرة على الصورة (فرقّعنا المعنى وخلقنا له عكازات) ويتضح الأمر أكثر مع البحر الطويل وفيه تكون البلية أعمق؛ فتطول العكازات ويتسع الرقع وينكمش المعنى ويشعر القارئ ببلادة التعبير وتقلص المعنى24.
ورأت الملائكة أن الحل يكمن في التلاعب بعدد التفعيلات في كل شطر وإعادة ترتيبها من جديد وضربت مثالًا على ذلك بقصائدها (لنكن أصدقاء/ جامعة الظلال/ جدران وظلال/ مرثية يوم تافه/ أغنية الهاوية). وفيها خروج على القواعد المألوفة في ترتيب تفاعيل البحرين الطويل والمتقارب. ولا يُفهم من هذا كله – كما تقول الملائكة – أي خروج (على طرقة الخليل وإنما هو تعديل لها يتطلبه تطور المعاني والأساليب خلال العصور التي تفصلنا عن الخليل)25.
- ظاهرة احتكام الشعراء إلى اللغويين والنحاة، وهذا ما يجعل الشعر جامدا لا يتطور، والحل يكمن في «الأديب المرهف» الذي يملك ثقافة عميقة الجذور في الأدب المحلي قديمه وحديثه مع اطلاع واسع على أدب أمة أجنبية واحدة على الأقل وأن يتهيأ له حس لغوي قوي يمكنه من استعمال ألفاظ لم تكن مستعملة (الشاعر بإحساسه المرهف وسمعه اللغوي الدقيق قد يخرق القاعدة مدفوعًا بحسه الفني)26. وبهذا يُدخل تغييرا على قاموس العصر حتى إذا خرق قاعدة أو أضاف لونًا، فإن خرقه أو إضافته ستعد قاعدة ذهبية، و(الشاعر أو الأديب هو الذي تتطور على يديه اللغة. أما اللغوي والنحوي فلا شأن لهما بها. النحوي واللغوي عليهما واجب واحد هام. واجب الملاحظة واستخلاص قواعد عامة من كلام المرهفين من الكتّاب والشعراء)27.
ولقد اختلف شعراء ونقاد العقد الخمسيني وما بعده في تقدير المنحى التحديثي في (شظايا ورماد)، وبعض منهم وقف موقفًا سلبيًا من هذا الديوان. ومن هؤلاء الدكتور إحسان عباس الذي كتب دراسة عن تطور اتجاه نازك الملائكة الفني فلم يجد أي تطور، لأن الديوان برأيه (جاء في أكثره حكاية واحدة تفترق فيها العناوين لتلتقي في الغالب عند موضوع واحد ذلك لأن نهاية التجربة المخفقة لا تتعدد في نظرنا إن لم نحاول أن نخدع أنفسنا بشيء من التبرير المختلف ومن ثم أعادت الشاعرة في كل قصيدة تقريبًا حديث الشكوى والكآبة والوحدة)28. وعلى الرغم من أن الشاعرة كانت وقتذاك معروفة لا بوصفها أحد رواد الشعر الحر حسب، بل أيضًا الناقدة العربية الأكثر إنتاجًا على قلة عدد الناقدات أصلًا، بيد أن هذا الناقد لم يأت – وهو يمثّل بقصيدة «الجسر» من ديوان (عاشقة الليل) وقصائد أخر- على أي ذكر لمنظورها في الشعر الحر. وأخذ على الشاعرة ما سماه خطأ نفسيًا لأنها لم تهتم بالصور وأن شعرها (لا يصور لنا شاعرة مجددة ذات مذهب فني واضح الحدود بادي الجدة بعيد العمق ومن الطبيعي أن تكون الصلة بين الديوانين منقطعة، بل إن الطاقة الشعرية التي أنتجت قصيدة مرثية يوم تافه هي نفسها التي وجدت في الأسماء الغامضة في سفر التكوين)29. وختم دراسته بالقول: (فإذا اتضحت كل هذه الجوانب التي عرضتُ لها، فذلك هو صورة ما أعنيه حين أتحدث عن تطور الاتجاه الفني في شعر نازك الملائكة)30. وعلى وفق هذا التحصيل، يكون عنوان هذه الدراسة منافيًا لمتنها فضلًا عن انه كشف من جانب آخر كلاسيكية هذا الناقد الذي تجاهل بشكل تام مانفستو الشاعرة في الحداثة والتحديث. وليس هذا هو شأنه وحده، بل شأن نقاد آخرين اخطأوا في تقدير شاعرية نازك الملائكة، وحاولوا بشتى السبل محو دورها التحديثي؛ أما بتجاهل هذا الدور أو بتغيير اسم الشعر الحر إلى الجديد أو المرسل أو التفعيلة. والسبب هو رؤاهم التقليدية التي لم تكن قادرة على مجاراة حداثة نازك الملائكة. الأمر الذي استفزهم استفزازًا كبيرًا فكان حجم حنقهم واضحًا. ولقد كانت مردودات ذلك كله ايجابية لأنها حركت مياه النقد العربي الراكدة، ولكنّها أيضا تركت بعض الآثار السلبية في نفس الشاعرة المجددة وولدت لها أسى، تجرعته على مضض.
الصعود/ الهبوط
بناء على ثنائية (القاعدة/ اللاقاعدة) شخّصت نازك الملائكة في مقدمة ديوان (قرارة الموجة) 1957 تطورها النفسي في نظم الشعر الحر، ولم ترد أن تتبع الصيغ الأسلوبية نفسها التي استعملتها في مقدمة (شظايا ورماد) فلجأت إلى استعمال أسلوب الحوار المسرحي من خلال عقد محاورة افتراضية بين شخصيتين مؤنثتين: الأولى ترمز إلى ذات الشاعرة والثانية ترمز إلى ذات أخرى هي ملهمة وشاعرة أيضًا، ومنها استلهمت الشخصية الأولى أفكارها، فبثت إليها شجونها والتمست لديها حلولًا لما تواجهه في الشعر من تحديات موضوعا وشكلًا. وكانت غاية نازك الملائكة من وراء هذا الحوار توعية القارئ عامة والناقد خاصة بحقيقة هذا الشعر، فألقت حزمة (أضواء كاشفة على هذا الشعر قد تساعد الناقد في فهم وجهة نظري الفلسفية وتطوري الذهني بين الفترتين)31.
واصطباغ الحوار المسرحي بوصف نفسي للحالة التي عليها كل شخصية، يجعل المقدمة أقرب إلى السيناريو منها إلى المونودراما. ومن الأوصاف والصور التي بها حددت نازك الملائكة الحالة النفسية للشخصية الأولى (في لهفة/ في ازدراء/ في ضيق/كأنها لا تصغي/ في لهجة حالمة/ ما زالت تحلم/ تنتفض في شبه خوف/ تبتسم/ في احتجاج/ في جهل مخلص/ لا ترد تختفي وراء الضباب) وحددت الحالة النفسية للشخصية الثانية بالأوصاف والصور الآتية: (دون مبالاة /ساخرة/ ما زالت تحلم/ في لهجة حالمة/ كأنها لا تصغي).
وإذا كانت الشاعرة قد بدأت في مقدمة (شظايا ورماد) بالتنظير ثم ألحقته بالتطبيق، فإنها في حوارية (قرارة الموجة) ابتدأت بالتطبيق، فوقفت من قصائدها موقف الناقد ثم انتهت إلى التنظير الذي فيه حاولت إثبات صحة فرضيتها في (القاعدة/ اللاقاعدة) حيث الشعر لا يرتكن إلى قاعدة إلا لكي يخرقها، والأسباب هي:
- أن الشعر فعل لا نهاية له، لأنه لا يركد على حالة واحدة، فهو مثل الموجة فيه نقطة عليا حارة كما له قرار هو نقطة سفلى باردة، تنطوي (على بذرة التحفز إلى الانبثاق الحار والصعود إلى القمة)32. وكذلك كانت قصائد (شظايا ورماد) فالشظايا هي القمة العالية، والرماد هو النهاية التي لا حياة بعدها.
- أن الشعر غواية في تغيره وهو كالمرآة في انعكاس الحياة الزاخرة التي عاشها الشاعر (ولا بد لكل فترة في حياة الشاعر الحق من اتجاه مميز)33.
- أن الآمال أجمل دائمًا من تحققها، ولهذا يظل الشاعر في حالة تحديق مستمر فيها وأن في هذا الاستمرار سعادة، وليست السعادة في بلوغ القمة والوصول إلى المنتهى.
- أن الخوف من الزمان والتشاؤم من مصاحبة الأفكار هو الذي يقيد الشاعر، فيغدو الشعر جامدًا وشبيهًا (بالسمكة الطافية على سطح النهر). أما ما يجدد الشعر فهو الشعور أن هناك إنسانًا جديدًا يولد داخل الشاعر على الدوام، ومثلت الشاعرة على ذلك من تجربتها الخاصة: (عندما عدتُ من الولايات المتحدة عام 1951 تخيلت ان إنسانا جديدا قد ولد وترعرع في داخل كل إنسان عرفته في ارض الوطن)34.
وتنتهي الحوارية واستمرارية النظر إلى الشعر متحققة بالصعود تارة كـ(موجة) والهبوط تارة أخرى كـ(قرارة) فثبتت الشخصية الثانية على صورتها المتفائلة والمتجددة، في حين تحولت الشخصية الأولى إلى ذات متجهمة متقوقعة ومتشائمة، لكن الأمل يحدوها إلى أن تجد نفسها من جديد، فتصعد كموجة(سأجدها في النهاية وأصافحها وداعا يا رفيقة)35.
الثورة/ اللاثورة
بعد عشر سنوات من كتابة مقدمة ديوان (قرارة الموجة) نشرت الشاعرة ديوانها الرابع (شجرة القمر) 1967 وفيه جمعت قصائدها غير المنشورة من عام 1952 حتى العام 1965 وقدمت لها بمقدمة سمتها (ملاحظات حول قصائد هذا الديوان) ولم تكن الظروف التي رافقت صدور ديوان (شجرة القمر) بالطبيعية من الناحيتين الأدبية والحياتية؛ فعلى صعيد الأدب، طرأت اتجاهات ونزعات فوضوية تقلد موضات الحداثة في فرنسا والولايات المتحدة. وعلى صعيد الحياة، عم الفتور والنكوص مختلف ميادين الحياة بسبب ما تركته نكسة حزيران 1967 في النفوس من قنوط وخذلان. ولم تكن نازك الملائكة بمنأى من التأثر بهذه الظروف، فظهر بوضوح نزوعها الواقعي في الشعر، وأخذت كتاباتها النقدية تهتم بمسائل ثقافية تدور حول القومية والمجتمع والأخلاق والتربية والمرأة والأغاني والتعليم والترجمة وغيرها.
وانطلاقًا من هذا كله جاءت مقدمة ديوان (شجرة القمر) حافلة بتشخيص عيوب الشعر الحر والظواهر السلبية التي رافقته، وأخذت الشاعرة منها مواقف معينة، وقدمت استشرافاتها. الأمر الذي جعل هذه المقدمة تنطوي على بعض التعقيد، وهو ما يتطلب نظرا معمقا فيها كي نتمكن من تقدير أبعادها والحكم عليها بموضوعية.
ولقد جاءت المقدمة في شكل ملاحظات ثلاث؛ اتخذت الملاحظة الأولى شكلاً تطبيقيًا، وفيه شرحت الشاعرة قصيدتها (شجرة القمر) المنشورة عام 1952 في حين جاءت الملاحظتان الثانية والثالثة في شكل نظري، ودارتا حول قصيدة (البعث) المنشورة عام 1962 وتحديد ماهية الشعر الحر، وسنفصل في أدناه القول في هذه الملاحظات، مناقشين كل واحدة منها على حدة:
- حددت الشاعرة في الملاحظة الأولى سبب كتابة قصيدة (شجرة القمر) وهو أن ابنة عمتها ميسون ـ وكان عمرها أحد عشر عامًا ـ طلبت منها أن تقص لها حكاية، فنظمت على إثر ذلك هذه القصيدة وتتألف من مئة وأربعة وأربعين بيتًا، واسترجعت فيها حكاية كانت قد قرأتها في مقطوعة شعرية إنجليزية لم تتذكر اسم شاعرها ولا عنوانها ولكن موضوعها ظل عالقًا في ذهنها. ووصفت الذكرى بأنها (هيكل الحكاية العاري.. فيها بذرة شعرية تصلح حكاية لطفلة)36. وموضوعها أن غلامًا اصطاد القمر وأراد أن يملكه لكنه وجد الناس كلها تريد امتلاكه أيضًا، فقام بخدعة وهي أن يدفن القمر ويستنبت منه شجرة سامقة لا مثيل لها ثمارها عبارة عن أقمار فضية متألقة، فحقق لنفسه سعادة. ومراد الشاعرة من هذه الحكاية هو أن الفنان في تناوله للطبيعة لا يقصد سوى الفن الذي فيه سعادته. وإذا عكسنا الأمر على الشاعرة فسنجد أنها بدعوتها إلى الشعر الحر لم تكن تريد من وراء ذلك سوى الشعر بكليته شكلًا ومضمونًا.
- في الملاحظة الثانية أكدت الشاعرة أن استعمال نظام الشطرين في كتابة قصيدة (البعث) هو نهجها في الأساس وأن لا غرابة في إدراج القصيدة على هذا النظام. وأنها ما تركت استعمال هذا النظام في ديوانيها السابقين إلا بسبب اهتمامها بالمعنى وحده فلم تراع الوقفات العروضية، مفترضة أن القارئ على دراية بمواضع هذه الوقفات، وأضافت سببًا آخر لا علاقة له بفنية الشعر وهو صغر حجم ذينك الديوانين فخافت أن يصبح البيت من البحر الخفيف أطول من عرض الصفحة فقررت أن تقسمه إلى قسمين. ولا ضير إذ (مهما كان الشكل الذي نختاره حتى لو كتبناه كما نكتب النثر فهو موزون على كل حال)37 فبدت بعض القصائد شعرًا حرًا أو شعرًا منثورًا في حين هي موزونة بنظام الشطرين، وضربت أمثلة على ذلك من شعرها. وتأسفت أن بعض الشعراء فهم الشعر الحر فهما مغايرا لما أرادته هي، فراح يتصور أن هذا الشعر ليس سوى كتابة سطرية لا حاجة فيها للأوزان ولا للقوافي، فقالت: (في سنة 1957 لم يكن يدور في خلدي إن أناسًا من الشعراء سيتخذون عملي الاضطراري سنة يحتذونها في منشوراتهم الشعرية ودواوينهم ولكم جزعت عندما صرت أرى في المجلات قصائد موزونة على الشكل العربي وزنًا تامًا ولكنها كتبت كتابة فوضوية وكأنها نثر لا شعر.. ثم يتحدثون عنها وكأنها شعر حر أو شعر منثور)38 ورأت نازك الملائكة أن هذا سيبلبل القارئ العربي ويزيده جهلًا. لذا قررت إدراج قصائد ديوانها (شجرة القمر) على الشكل العربي التقليدي (لأرفع صوت احتجاج على زملائي الشعراء الذين أصبحوا يكتبون شعرًا موزونًا على الأسلوب العربي ثم يدرجونه وكأنه شعر حر)39.
- في الملاحظة الثالثة، أكدت أن استعمال نظام الشطرين هو الأساس، وأن الشعر الحر هو الاستثناء، وأحصت الشاعرة عدد قصائد الشعر الحر في ديوانها (شجرة القمر) فوجدتها سبعًا، وفي ديوانها (شظايا ورماد) عشرا، وفي (قرارة الموجة) تسعًا. ولم تذكر ديوانها (عاشقة الليل) وعقبت بالقول: (.. ولا اذكر قط أنني اقتصرت على الشعر الحر في أية فترة من حياتي وسبب هذا أنني أولًا أحب الشعر العربي ولا أطيق أن يبتعد عصرنا عن أوزانه العذبة الجميلة ثم أن الشعر الحر كما بينت في كتابي قضايا الشعر المعاصر يملك عيوبًا واضحة أبرزها الرتابة والتدفق والمدى المحدود وقد ظهرت هذه العيوب في أغلب شعر شعراء هذا اللون وهذا حاصل أيضًا في الشطرين فإن له مزايا وله عيوب)40 ولأن بعض الشعراء تعصبوا للشعر الحر فتركوا الأوزان الشطرية تركًا قاطعًا، رأت الشاعرة أن مستقبل تيار الشعر الحر سيتوقف في يوم غير بعيد، وسيرجع الشعراء إلى الأوزان الشطرية ولكنها نفت موت الشعر الحر، بل سيبقى الشاعر يستعمله لأغراض ومقاصد ومن دون تعصب أو ترك (الأوزان العربية الجميلة).
إن هذه التعليلات والشروح تجعل مقدمة (شجرة القمر) مخالفة أو بالأحرى مناقضة لما أسست له مقدمتا (شظايا ورماد) و(قرارة الموجة). وهو ما جعل كثيرًا من النقاد يصفون هذه المخالفة بأنها نكوص وتراجع. فهل كانت نازك الملائكة في (شجرة القمر) هي غيرها في دواوينها السابقة؟ وما الدواعي الموضوعية التي أثّرت في حماستها للشعر للحر وجعلتها تكتب على الضد من أطروحتها في الشعر الحر؟ وما غايتها من وراء هذا التضاد والارتداد؟
بدءًا نقول لو كانت نازك الملائكة مرتدة حقًا لكانت امتنعت عن إيراد أية قصيدة من الشعر الحر في ديوانها (شجرة القمر) وأعلنت ارتدادها صراحة على الملأ وبالجرأة نفسها التي بها أعلنت ثورتها على نظام الشعر العربي. بيد أن الذي حصل هو أن مجموعة عوامل فنية وموضوعية شخّصتها نازك الملائكة في الشعر الحر، أثرت في تنظيرها له. ولا يمكن فهم تبعات هذا التأثير إلا في إطار الفرضية نفسها التي عملت الشاعرة على إثبات صحتها في ديوانيها السابقين وأعني بها (القاعدة/ اللاقاعدة)
بالطبع لم ترد نازك الملائكة من الثورة على نظام الشطرين سوى ما أرادته من العودة إلى هذا النظام. والمعادلة في كلا الحالين واحدة، إذ أنه متى ما صارت الثورة الشعرية معتادة، فلا بد من الثورة عليها شعريًا. وما بين الاعتياد والثورة تكون الشاعرة غير متناقضة مع نفسها ولا هي نهجت نهجًا مخالفًا لأطروحتها في الشعر الحر، بل هي ما زالت على ثوريتها مؤمنة بأن الشعر إذا ثبت مكانه فسيتحنط ومن ثم لا مناص له من التحديث ولا حياد فيه عن الخرق والتغيير. والثبات هو القاعدة، والخرق هو اللاقاعدة. وإذا كانت الشاعرة تعد الخرق قبل عشر سنوات قاعدة، فإنها الآن ترى أن الأوان حان لخرق هذه القاعدة.
وليس الخرق فعلًا مجانيًا، بل هو أمر تحتمه أسباب موضوعية لها علاقة جوهرية بالشعر وليس غير الشعر. وهو ما غاب عن نظر النقاد الذين اتهموا نازك الملائكة بالارتداد عما أرادته من شعر حر. ولقد كانت الشاعرة على دراية بأن آراءها في هذه المقدمة ستثير ردود أفعال سلبية وأن الشعراء والنقاد سيتصورون توجهها الجديد مخالفًا لآرائها التي طرحتها في مقدمة (شظايا ورماد) ولاسيما أنها وصفتها بـ(الدعوة المتحمسة) ولعل هذه الدراية هي التي جعلتها تُحجم عن الرد عليهم. ومن يتعمق في مقدمة ديوان (شجرة القمر) فسيجد أن هناك أسبابًا موضوعية أوجبت النظر إلى الشعر الحر قاعدة، ولا بد من خرقها كما يأتي:
- أن أطروحة نازك الملائكة في الشعر تنفر من كل تقعيد وتقنين. وما لاقاه الشعر الحر من صدى كبير خلال عقد واحد جعله مقننًا بمجموعة ضوابط مغلوطة، وهو أمر يتنافى مع حريته. لذا دعت إلى استعادة أصول الشعر التي بدت هي اللاقاعدة من شدة هجر الشعراء لها.
- أن تقنين الشعر الحر ما كان ليكون لولا مغلوطية فهمه؛ فبعض الشعراء تصور أن هذا الشعر عبارة عن شكل كتابي بأسطر غير منتظمة وبعضهم الآخر تصور أنه شعر يتخلى عن الأوزان والقوافي.
- أن أوزان البحر الخفيف لا تتغير بتغير طريقة كتابة القصيدة، وهذا ما يجعل استعمالها في الشعر الحر (نظام الأسطر) غير مختلف عن استعمالها في الشعر التقليدي (نظام الشطرين)، ومثلت الشاعرة على ذلك بقصيدة «حصاد المصادفات» فكتبتها بنظام الأسطر وأعادت كتابتها بنظام الشطرين من دون أن يؤثر ذلك في أوزانها وإنما اختلف ترتيب تلك الأوزان فقط. وبهذا لا يكون الفارق في النظم على البحر الخفيف جوهريا بين الشعرين الحر والتقليدي وإنما هو فارق تنظيمي.
- أن كثرة كتابة الشعر الحر جعلت الشعراء يهملون القوافي ولا يعنون بفنية تعددها، وإذا كانت نازك الملائكة قد رأت – قبل عشر سنوات – في القافية الموحدة قاعدة لا بد من خرقها من خلال العمل على تعددها داخل القصيدة، فإنها الآن ترى أن هذا الخرق صار قاعدة ولا بد من كسرها من خلال استعادة العمل بالقافية الموحدة بوصفها الآن هي اللاقاعدة. ومن هنا أعربت الشاعرة في ختام مقدمة ديوان (شجرة القمر) عن أسفها لأنها لم تعن بالقافية فكانت تغيرها سريعًا (وهذا يضعف من الشعر الحر لأنه يقوم على أبيات تتفاوت أطوال اشطرها وبذلك ينقص رنينها وموسيقاها فلو زاد الشاعر القافية غنى ولم يغيرها سريعًا لأضفى على الوزن موسيقى تمسكه وتمنعه من الانفلات ولهذا بت أدعو إلى أن يرتكن الشعر الحر إلى نوع من القافية الموحدة ولو توحيدًا جزيئًا فبذلك نزيده موسيقى وجمالًا ونحميه من ضعف الرنين وانفلات الشكل)41 ويبقى رأيها هذا مجرد رغبة؛ فأغلب قصائد ديوانها (شجرة القمر) متعددة القوافي كقصيدة «البعث» وتتألف من ستة وثلاثين بيتًا موزعة بين ثمانية مقاطع وقد يشتمل المقطع الواحد على قافيتين، ومطلعها:
أنا غنيت للظلال وأعطيـ ـت هواي المفتون للأشباح
- أن الغاية من الشعر الحر هي تحديث الشعر بقصد بلوغ حقيقته التي بها يساير الحياة في عصريتها. ولم تجد الشاعرة بحرًا مناسبًا لتأكيد ذلك التحديث مثل البحر الخفيف، لأن فيه يمكن للشاعر أن يورد جملًا طويلة من دون تقطع. وقد أفضى تجريبها في هذا البحر إلى أن تكتب مطولتها الشعرية (مأساة الحياة وأغنية الإنسان) وعدتها أثرًا شعريًا يقدم الحقيقة الشعرية، وعللت الأمر بالقول: (إنني رأيت هذا البحر أكثر ملاءمة للمطولات فهو يسمح بالعبارة الطويلة على صورة تريح الشاعر الحديث)42 وتتألف هذه المطولة من ثلاث صور موزعة بين خمسمئة وثمانية وستين بيتًا، وكتبتها على ثلاث مراحل زمنية: الأولى عام 1946 والثانية عام 1950 والثالثة عام 1965، وموضوعها فلسفي يدور حول الموت والحياة وما خلفهما من أسرار.
ختامًا.. تبنت نازك الملائكة أطروحة في تحديث الشعر الحر، ولم تحد عنها قيد أنملة شعرًا ونقدًا، وكانت موقنة أن التحديث يعني البحث عن اللاقاعدة في القاعدة صعودًا وانحدارًا. إذ ما أن يبلغ الشاعر المبتغى حتى تكون القاعدة حجر عثرة ولا بد له من إزاحتها وبلا أدنى تردد أو أسف، منحدرًا عنها باللاقاعدة.
وما بين الصعود والانحدار والتشظي والرماد والعلو والقرار والاندفاع والتراجع تكون أطروحة نازك الملائكة واحدة؛ فلا هي بالغت فيها ولا هي نكصت عنها، بل كانت دائمة المراجعة لها. والشعر ما أن تتقنن قواعده حتى يشيخ، وما أن تتجدد قواعده حتى يعود فتيًا مشاغبًا. وما حماسة نازك الملائكة ثم فتور هذه الحماسة، إلا بسبب ما رصدته من ظواهر سلبية في كتابة الشعر الحر، وما كانت تعنيه هذه الظواهر بالنسبة إليها من خطر. فسجلت على الشعراء أغلاطًا وآخذتهم على استسهالهم ومبالغاتهم في الشعر الحر. وبلغ الأمر بهم درجة عالية من الغلط في غضون بضع سنين، ولذلك تصدت لهم بكتابها (قضايا الشعر الحر) الذي هو حصيلة مراجعة أطروحتها في الحداثة الشعرية ثم كان ديوانها (شجرة القمر) حصيلة مراجعة ثانية لها. وفي كلتا المراجعتين كانت نازك الملائكة هي نفسها الشاعرة المجددة والناقدة المنظرة، مؤكدة بشكل قاطع فرادتها التي بها استطاعت أن تختط لنفسها موقعا خاصا على خريطة الشعر والنقد العربيين.
الهوامش:
1 – الغربال مجموعة مقالات نقدية، ميخائيل نعيمة (مصر: المطبعة العصرية،1923) ص67
2 – المصدر السابق، ص70.
3 – المصدر السابق، ص109- 110
4 – المصدر السابق، ص111ـ112
5 – المصدر السابق، ص117
6 – استمر النقاد الأدباء يتصدرون المشهد النقدي في العراق في العقود اللاحقة، ومنذ الستينيات أخذت بوادر اهتمامهم بالمنهجية الاجتماعية والتاريخية تتضح كما في دراسات عبد الجبار عباس وفاضل ثامر وعبدالرحمن طهمازي وعزيز السيد جاسم وغيرهم كما اخذ نقد القصة يحجز له مكانا في تطبيقات هؤلاء النقاد.
7 – ديوان نازك الملائكة، المجلد الثاني (بيروت: دار العودة، 1997)، ص23.
8 – المصدر السابق، ص24
9 – المصدر السابق، ص26
10 – ينظر: المصدر السابق، ص27
11 – المصدر السابق، ص28
12 – المصدر السابق، ص29
13 -المصدر السابق، ص7
14 – المصدر السابق، ص8
15 – المصدر نفسه
16 -المصدر السابق، ص18
17 – المصدر السابق، ص17
18 – المصدر السابق، ص17ـ18
19 – المصدر السابق، ص19
20 – المصدر السابق، ص21
21 – المصدر نفسه.
22 – المصدر نفسه.
23 – المصدر السابق، ص21ـ23
24 – ينظر: المصدر السابق، ص14ـ15
25 – المصدر السابق، ص15
26 – المصدر السابق، ص9
27 – المصدر السابق، ص10
28 – تطور الاتجاه الفني في شعر نازك الملائكة، إحسان عباس، مجلة الأديب، العدد الرابع 1953، ص40. ومن المفارقة ان هذا العدد ضم أيضا ما كتبته نازك الملائكة من نقد لقصائد الشعراء: صلاح لبكي وسليم حيدر وفدوى طوقان وتوفيق عواد وخالد الشواف.
29 – ديوان نازك الملائكة، المجلد الثاني (بيروت: دار العودة، 1997) ص41
30 – المصدر السابق، ص42
31 – المصدر السابق، ص206
32 – المصدر السابق، ص209
33 – المصدر السابق، ص211
34 – المصدر السابق، ص225
35 – المصدر السابق، ص226
36 – المصدر السابق، ص410
37 – المصدر السابق، ص145
38 – المصدر السابق، ص416
39 – المصدر السابق، ص416
40 – المصدر السابق، ص417 ـ 418
41 – المصدر السابق، ص419
42 – ديوان نازك الملائكة، المجلد الأول (بيروت: دار العودة، 1997) ص18.
عدد التحميلات: 2