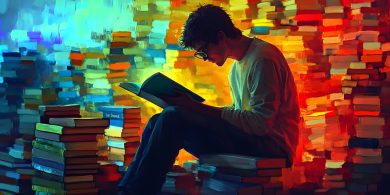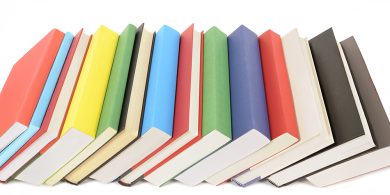التفاهة الرقمية: نقد فلسفي للسطحية المعولمة في زمن المنصات
مجلة فكر الثقافية
مقدمة نظرية: تعريف التفاهة وتحوّلاتها الرقمية
في زمنٍ يتسارع فيه كل شيء – من الاستهلاك إلى التواصل، ومن ردود الفعل إلى «صناعة الرأي العام»- برزت التفاهة كأحد أكثر تجليات ما بعد الحداثة راديكالية وخطورة. فهي لم تعد مجرد سلوك فردي أو انحراف ذوقي، بل غدت نظامًا ثقافيًا كاملاً، يُنتج ويُكرّس ويُعمَّم، حتى يغدو «اللا معنى» هو القاعدة، و«العمق» استثناءً معزولًا أو متهمًا بالتعقيد والنخبوية.
يكتب الروائي الكندي آلان دونو في كتابه (نظام التفاهة): «لم نعد في زمن يُكافأ فيه العارف أو العميق أو صاحب الرؤية؛ بل في زمن يُكافأ فيه من يتقن اللعب داخل النظام، من لا يزعج أحدًا، من لا يطرح أسئلة، من يُتقن لغة الإدارة لا لغة الفكر».
لكن هذا «النظام الرمزي» للتفاهة لم ينشأ من فراغ. فالمجتمعات الصناعية المتأخرة، كما أشار هربرت ماركوزه، أنتجت بشرًا «أُعيد تشكيل رغباتهم»، وأُقنعوا بأن الحرية تعني القدرة على الاختيار بين سلع استهلاكية، لا التحرر من الاستلاب. ومع الثورة الرقمية، اتخذت هذه الاستلابات طابعًا أكثر نعومةً، بل وأكثر جاذبية. إنها تفاهة «محبوبة»، لأنها مريحة، سهلة، سريعة، وشبه مجانية.
من التفاهة كتوصيف أخلاقي إلى التفاهة كنظام إنتاج رمزي
كلمة «تفاهة» (triviality) تحمل في تراثها الثقافي الغربي دلالات سلبية مرتبطة بالسخف والسطحية وعدم الجدارة. لكنها في السياق المعاصر لم تعد مجرد صفة، بل نسق إنتاجي متكامل، تُصاغ عبره المعايير، وتُضخ عبره الرموز، وتُعرّف من خلاله القيمة الاجتماعية والثقافية.
وقد لاحظ جان بودريار أن الإنسان المعاصر لم يعد يعيش في عالم «الواقع»، بل في عالم الصور والاستبدالات الرمزية. كتب في مجتمع الاستهلاك: «لم نعد نستهلك أشياء من أجل استخدامها، بل من أجل دلالتها. لقد صارت كل الأشياء علامات، والسلعة لا تُشترى بوصفها شيئًا بل بوصفها هوية».
هكذا، تصبح التفاهة ليست نتيجة لانعدام القيمة، بل نتيجة لانفجار فائض القيم المصنّعة، التي تُبثّ عبر منصات لا همّ لها إلا توليد المزيد من التفاعل اللحظي، ولو على حساب المعنى.
السياق الرقمي: ولادة التفاهة المؤتمتة
مع صعود الإنترنت، بدا للحظة أننا أمام عصر جديد من الحرية والتمكين المعرفي. لكن كما يُذكرنا جورج أورويل، فإن: «أكثر أنظمة السيطرة فاعلية هي تلك التي تجعل الناس يحبون عبوديتهم».
وقد ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في إعادة هندسة الذوق الجماهيري، لا عبر القمع، بل عبر الإغراق في السطحيات، وتشظية الانتباه، وتحفيز الذات النرجسية. هذه المنصات لم تُنشئ التفاهة، بل قامت بأتمتتها وتضخيمها وتدويرها بوتيرة غير مسبوقة.
النتيجة؟ أننا دخلنا عصرًا يُقاس فيه التأثير بعدد الإعجابات، والحقيقة بعدد المشاركات، والوجود الرقمي بالقدرة على الاستعراض لا على الفكر. وكما كتب فريدريك جيمسون في تحليله لثقافة ما بعد الحداثة: «لقد انهار الزمن العميق. كل شيء يحدث الآن. كل شيء سطحي، وكل شيء متاح، وبالتالي… لا شيء مهم حقًا».
التفاهة الرقمية كتحول أنطولوجي
ما نواجهه ليس مجرد ظاهرة ثقافية طارئة، بل تحول في بنية الوعي ذاته. التفاهة الرقمية ليست محتوى تافهًا فحسب، بل طريقة في التفكير، في الشعور، في بناء الذات والآخر. إنها شكل جديد من الوجود في العالم، قائم على: تمجيد اللحظة العابرة، واختزال المعنى إلى تفاعل، واستبدال الحقيقة بالشعبية، وتحويل الذات إلى منتج، وهنا، لا بد من مساءلة هذا النظام، تفكيكه، وتقديم أدوات نظرية لفهمه وتجاوزه.
من التفاهة كعرض اجتماعي إلى التفاهة كبنية إنتاجية
فيما مضى، كان يُنظر إلى «التفاهة» كظاهرة عرضية، ناتجة عن ضعف في الذوق العام أو نقص في العمق الفكري لدى بعض الأفراد أو الفئات. لكن مع تحوّلات الثقافة الرقمية، لم تعد التفاهة مجرّد حالة معزولة، بل غدت بنية إنتاج متكاملة. لم تعد عرضًا، بل أصبحت نسقًا يعمل بشكل منتظم، ويُعاد إنتاجه كل لحظة عبر أدوات السوق، وتقنيات الاتصال، ومؤسسات الترفيه، والخوارزميات.
أولًا: من الذوق إلى النظام – حين تصبح التفاهة معيارًا
يشرح بيير بورديو في كتابه (التمييز): نقد اجتماعي للحكم الذوقي كيف أن الذوق ليس مجرد تعبير فردي، بل هو نتاج لعلاقات قوى وهيمنة رمزية. وما يُعد «جميلًا» أو «قيّمًا» في نظر المجتمع هو انعكاس لسلطة طبقة معينة أو مؤسسة معينة فرضت رموزها بوصفها عالمية.
«الذوق ليس بريئًا، إنه يعيد إنتاج الفوارق الاجتماعية تحت قناع الجمال». تبعًا لهذا، حين يصبح الذوق العام محكومًا بأدوات السوق الرقمي (مقاطع قصيرة، محتوى تفاعلي، شعارات سهلة)، فإن ما يُنتج ويُروّج ليس ما هو أكثر عمقًا، بل ما هو أكثر قدرة على البقاء في الزمن القصير والانتباه السطحي.
إن التفاهة الرقمية لا تُقصي المعنى فقط، بل تعيد تعريف المعنى ذاته بما يتوافق مع إيقاع السوق. وهنا نصبح أمام ما يمكن تسميته بـ: «الاستبدال الرمزي للجوهر بالقشرة»، حيث يتم تصدير القيمة كأنها شكل لا مضمون.
ثانيًا: دور الرأسمالية الرقمية في هندسة التفاهة
منذ أن بيّن غي ديبور في كتابه (مجتمع الفرجة) أن الرأسمالية الحديثة تسعى إلى تحويل الحياة كلها إلى استعراض مرئي، صار من الواضح أن التفاهة ليست فقط انحدارًا ثقافيًا، بل هي وظيفة رأسمالية تهدف إلى ضبط الأفراد عبر الاستهلاك البصري.
«في مجتمع الفرجة، يصبح كل ما هو حقيقي صورة، وكل ما هو صورة يتحول إلى واقع استهلاكي».
الرأسمالية الرقمية – كما بلورها شبمونغ تشول هان – ليست رأسمالية القمع، بل رأسمالية الشفافية والإغراء، حيث يُطلب من الأفراد أن يكشفوا ذواتهم، ويعرضوا حياتهم، ويحولوا تجاربهم إلى منتجات تُستهلك رمزيًا.
يكتب هان في (مجتمع الشفافية): «نحن لم نعد نعيش تحت عين الأخ الأكبر، بل صرنا نحدّق في أنفسنا بإعجاب، ونُراقب ذواتنا بنرجسية مرضية».
هذه الرقابة الذاتية تحوّل كل فرد إلى منتج/مُنتِج للتفاهة، بدون وعي، عبر تغذية المنصات بالمحتوى، وتغذية ذاته بوهم القبول الجماهيري.
ثالثًا: التفاهة كآلية لإنتاج الرأي العام
عندما يصبح المحتوى التافه هو الأكثر رواجًا، فإن الرأي العام يُصاغ وفق معايير التفاهة. بمعنى أن ما يُتداول أكثر يُعتبر تلقائيًا «مهمًا»، وما يُشارك أكثر يُعتبر «صحيحًا». وهنا يظهر ما أسماه نعوم تشومسكي بـ«هندسة الموافقة» (Manufacturing Consent)، ولكن بأسلوب جديد: لا عن طريق الإعلام الرسمي، بل عبر إنتاج ذاتي تلقائي للمحتوى الاستهلاكي.
وهنا تصبح التفاهة أداة سياسية غير مباشرة، تساهم في:
– صرف انتباه الجماهير عن القضايا الجوهرية.
– تمييع الوعي الجمعي وإفراغه من السياقات التاريخية.
– تكريس الرداءة بوصفها «ديمقراطية إعلامية» مزيفة.
رابعًا: الخوارزميات كمصانع تفاهة
الخوارزميات لا تفهم العمق، بل تفهم الارتباط والإقبال. إنها تبحث عن أنماط التفاعل لا المعنى. ولهذا فهي تميل إلى ترشيح المحتويات التي:
– تثير انفعالًا سريعًا (غضب، ضحك، استغراب).
– تكون قابلة للمشاركة فورًا.
– لا تتطلب تفكيرًا طويلًا أو تركيزًا عميقًا.
يكتب إيف-سيتون: «الخوارزمية لا تسأل: ما الذي يجب أن يعرفه الناس؟ بل تسأل: ما الذي يريد الناس التفاعل معه؟».
وهكذا فإن ما يبدو كاختيار فردي حر، هو في الحقيقة نتيجة سلسلة طويلة من التوجيهات الخفية التي تعيد تشكيل رغباتنا وأنماط تفكيرنا.
التفاهة كأيديولوجيا سائلة
لم تعد التفاهة شيئًا نستهلكه من الخارج، بل غدت هيكلًا داخليًا في وعينا، نمطًا في التفكير، وطريقة في التواصل، وأداة في التفاعل. إنها ليست مجرد عرض اجتماعي، بل بنية إنتاج رمزي واقتصادي وأيديولوجي، ترعاه السوق وتعمّمه المنصات وتُعيد تشكيله الخوارزميات.
هذه التفاهة الحديثة لا تُفرض بالقوة، بل تُمنح على شكل حرية.
التفاهة بوصفها إستراتيجية للسلطة الرمزية
إذا كانت التفاهة، كما بينّا، بنية إنتاج رمزية واقتصادية، فإن أحد أخطر أوجهها يتمثل في كونها أداة للهيمنة الناعمة. لم تعد السلطة اليوم تُمارَس فقط من خلال العنف المباشر أو الإكراه السياسي، بل تُمارَس بشكل أكثر خفاءً، من خلال إعادة تشكيل الأذواق، وتوجيه الرغبات، والتحكم في الانتباه. هنا، تصبح التفاهة الرقمية ليست فقط «محتوى سطحيًّا»، بل آلية سيطرة رمزية دقيقة، تُنتج «متلقين مستهلكين»، و«رأيًا عامًا منزوع الدسم»، و«وعيًا اجتماعيًا متبلدًا».
أولًا: من السلطة القمعية إلى السلطة الرمزية
وَفقًا لـ «ميشيل فوكو»، لم تعد السلطة في العصر الحديث تُمارَس من خلال السجون والعقوبات فقط، بل صارت تعمل عبر الخطاب والمعرفة وإنتاج الحقيقة. أما في السياق الرقمي، فإن هذه السلطة الرمزية تتمثل في:
– تحديد ما يُرى وما لا يُرى (المرشَّح الخوارزمي).
– تضييق نطاق التفكير في قضايا سطحية.
– تسطيح اللغة وتشظية المعاني.
يكتب فوكو: «السلطة ليست ما يُنتَزع بل ما يُمارَس؛ إنها شبكة من العلاقات التي تُشكّل الأفراد أكثر مما تُقمعهم». وهكذا فإن التفاهة الرقمية لا تُقصي الفرد، بل تشغله وتُشركه في لعبة لا نهائية من الانفعال والتشتت. ما يجري ليس إقصاءً بل امتصاص كامل للوعي داخل نظام من الصور والمحتوى الزائف.
ثانيًا: اقتصاد الانتباه والتفاهة كأداة للهيمنة
يرى جوناثان بيتي أن السلطة في العصر الرقمي لا تسيطر على الأجساد، بل تسيطر على الانتباه. وكل ما يتطلبه الأمر هو إعادة توجيه هذا الانتباه دومًا نحو ما هو أسرع، أسهل، وأكثر إثارة.
ويُوضح تريستان هاريس (مهندس سابق في غوغل) أن الخوارزميات لا تستهدف عقولنا الواعية، بل مناطق اللاوعي والانفعال التلقائي. هذه المنصات تعرف بدقة:
– كيف تُحفّز الغضب اللحظي.
– كيف تُطلق رغبة الفضول السطحي.
– كيف تُشبع الإحساس بالانتماء عبر «الإعجاب» والردود.
في هذا السياق، يُصبح المستخدم مشاركًا طوعًا في صناعة التفاهة، لكنه لا يشعر بذلك، بل يتخيّل أنه يُمارس حريته واختياراته. إنها الحرية المؤطرة بإحكام، أو كما وصفها هان: «في مجتمع الشفافية، نختار ما هو مُعدّ لنا مسبقًا، ونقول إننا أحرار».
ثالثًا: تآكل الفضاء العام وتحويل المواطن إلى مُتفرّج
تُعرّف حنة آرنت الفضاء العام بأنه المكان الذي يلتقي فيه المواطنون بوصفهم فاعلين سياسيين يطرحون قضايا الشأن العام. لكن مع هيمنة التفاهة الرقمية، يتحوّل هذا الفضاء إلى ساحة للعرض الذاتي، والسجال العقيم، والانفعالات المؤقتة.
إن المواطن لم يعد يُشكّل رأيًا سياسيًا مستندًا إلى معرفة، بل يُعيد إنتاج ما تُمليه عليه الموجة الرقمية. يتحوّل من فاعل إلى مُتفرّج. ومن مواطن ناقد إلى مستهلك للرأي.
هذا التحوّل الخطير يُذكّرنا بنقد ديبور في (مجتمع الفرجة): «كل ما كان يُعاش مباشرة، صار يُمثّل عبر صورة. لقد أصبحت الحياة نفسها مشهدًا».
هكذا، تتكامل التفاهة مع مشروع سياسي ضمني يهدف إلى:
– إفراغ المجال العام من النقاش الجاد.
– إحلال النجومية محل الفكرة.
– تدمير التفكير الطويل لصالح ردود الفعل السريعة.
رابعًا: التفاهة كأداة لـ «إزالة السياسة»
إن التفاهة لا تسيطر فقط على ثقافة اليوم، بل تُساهم في إزالة الطابع السياسي عن السياسة نفسها. فلا يعود النقاش حول العدالة أو السلطة أو الحق، بل حول: مَن قال ماذا؟، مَن أساء إلى من؟، مَن كان ترند اليوم؟ وهنا، تندمج التفاهة مع ما سمّاه بيونغ تشول هان «عنف اللطافة»، أي أن كل شيء يصبح مقبولًا ما دام لا يُزعج أحدًا، ولا يُحرّض على التفكير، ولا يكسر التوافق اللحظي. وهذا شكل جديد من القمع الناعم، يُفضي إلى موت السياسة كفعل نقدي، وولادة «السياسة المؤثرة» كفرع من صناعة المحتوى.
التفاهة كسلطة سائلة
لم تعد السلطة الرقمية تُمارَس من خلال الإجبار، بل من خلال التوجيه، التصفية، التكرار، والتسويق. ولم تعد الهيمنة بحاجة إلى إيديولوجيا صارمة، بل تكفيها تفاهة جذابة، وواجهة بصرية مريحة، وتفاعل لا ينتهي.
وهكذا، فإن التفاهة ليست فقط نتيجة لسوء الذوق أو الاستهلاك، بل هي إستراتيجية سلطة تعمل بصمت على إعادة تشكيل الإدراك والوعي والانتماء.
التفاهة وصناعة الذات الرقمية
في العصر الرقمي، لم تعد الذات كينونة داخلية تتشكّل في صمت، بل أصبحت مشروعًا يُنتَج باستمرار أمام الكاميرا، في منشور، في «ستوري»، في بث مباشر. لقد تم تحويل الذات إلى منتج مرئي، قابل للتسويق والتعديل والمشاركة. وهذه الذات لا تُبنى عبر المعرفة أو التجربة، بل عبر الأداء المتكرر والتفاعل اللحظي.
هنا، تتحول التفاهة إلى أداة أساسية في بناء هذه «الهوية الجديدة» التي لا تُعرّف من خلال العمق، بل من خلال التفاعل السريع والتأثير اللحظي.
أولًا: الذات كواجهة – من العمق إلى التمثيل
يشير الفيلسوف الكوري الألماني بيونغ تشول هان إلى أننا نعيش في عصر «التمثيل الذاتي الدائم». لم يعد الناس يعبرون عن أنفسهم، بل يعرضون أنفسهم. وكلما زاد التفاعل، زادت قيمة هذه «الهوية الرقمية».
في كتابه (في مجتمع الأداء)، يقول: «لقد تخلّت الذات عن سردها الداخلي، وصارت تُنتِج نفسها كصورة قابلة للإعجاب، وجاهزة للاستهلاك». وهكذا، فإن التفاهة لا تُعتبر ضعفًا في الوعي، بل آلية إنتاج ذات. فالمستخدم لا يبحث عن معنى، بل عن «قابلية الانتشار»، و«جاذبية الأداء»، و«الترند التالي». وبدل أن يكون الإنسان «من يفكر»، يصبح «من يُشاهَد».
ثانيًا: نرجسية الشاشة وتحطيم التجربة الداخلية
يصف كريستوفر لاش في كتابه (ثقافة النرجسية) كيف تحوّلت المجتمعات الحديثة إلى مسارح نرجسية، حيث يسعى الأفراد إلى إثبات ذواتهم لا من خلال الإنجاز الفعلي، بل من خلال الظهور والانكشاف المستمر. وفي العصر الرقمي، تُغذّي المنصات هذه النزعة عبر:
– إشعار المستخدم بأنه «مهم» لأن له متابعين.
– مكافأته بعدد الإعجابات.
– ربط قيمته الذاتية بالتفاعل اللحظي.
«النرجسي الحديث لا يسعى إلى أن يكون محبوبًا لصفاته، بل لأنه مرئي». وهكذا، تتآكل التجربة الوجودية للإنسان، إذ لم يعد يُجري حوارًا داخليًا، بل يركض خلف صورة محسّنة لذاته، ويعيد إنتاجها كل يوم بشكل قابل للمشاهدة.
ثالثًا: رأسمالية الذات – حين تصبح الذات مشروعًا تسويقيًا
تُرغمنا المنصات على أن نُنتج أنفسنا باستمرار كعلامة تجارية شخصية. هذا ما يسميه جيل ليبوفيتسكي في كتابه (عصر الفراغ) بـ«الفرد السوقي»، أي الإنسان الذي يُسوّق ذاته كما تُسوَّق السلع. ولذلك:
– تُختصر الحياة إلى مقاطع قصيرة.
– تتحول العلاقات إلى محتوى.
– يُفكَّك الزمن الداخلي إلى «بوستات» عابرة.
هكذا، تنشأ ذاتٌ تافهة ليس لأنها فارغة، بل لأنها مصمّمة لتكون قابلة للتداول لا للتأمل. التفاهة تصبح بذلك صيغة دفاعية للبقاء في السوق الرمزي.
رابعًا: القلق الدائم والتفاهة كتعويض نفسي
التفاهة ليست فقط ناتجًا للفراغ، بل تعويضًا نفسيًا عنه. فمع تزايد الضغط الوجودي في العالم الرقمي – حيث يُطلب من كل فرد أن يكون جميلاً، ناجحًا، حاضرًا، مؤثرًا – تُصبح التفاهة مسكنًا نفسيًا وسيلة للهروب من الشعور بالنقص.
«أضحك، إذا أنا موجود». «انشر، إذًا فأنا لست وحيدًا». «تلقيت إعجابًا، إذًا أنا محبوب».
بهذا المعنى، تتحوّل التفاهة إلى طقس جماعي للتخفيف من وطأة العزلة، وفقدان المعنى، وانهيار القيم المشتركة. إنها ليست فقط بنية إنتاج، بل دواء عصري ضد القلق الوجودي.
التفاهة كهوية معاصرة
في العصر الرقمي، لم تعد التفاهة عيبًا يُخجل منه، بل صارت صيغة مقبولة لبناء الذات، وأحيانًا الوسيلة الوحيدة للظهور. وما كان يُعدّ سطحيًا بالأمس، أصبح معيارًا للنجاح اليوم. وهكذا، تُختزل الذات إلى حضور مرئي، ويتحوّل الإنسان إلى مشروع أداء دائم في مسرح مفتوح لا ينطفئ أبدًا.
التفاهة الرقمية وأزمة المعنى
ليست التفاهة مجرد عرض لمحتوى سطحي أو أداء نرجسي، بل هي مظهر من مظاهر أزمة المعنى الكبرى في العالم الرقمي. فالعالم الرقمي، على ضخامته، لا يوسّع آفاق الفهم، بل يضغطها؛ لا يعمّق التجربة، بل يذرّرها. ومن هنا، فإن التفاهة ليست عرضًا جانبيًا للمنصات، بل نتاج مباشر لفقدان القدرة على إنتاج معنى وجودي أو رمزي.
أولًا: تآكل البنية الرمزية للعالم
يرى بول ريكور أن الإنسان لا يعيش بالوقائع فقط، بل يحتاج إلى تأويل مستمر لتجربته في العالم. وهذا التأويل يُبنى عبر اللغة، والسرد، والرموز الثقافية. ولكن في العصر الرقمي، تُستبدل هذه الرمزية بتدفقات من الصور والشعارات.
«إننا نعيش في زمن سحبت فيه الصور قدرتها الرمزية، وباتت تحيل إلى لا شيء إلا إلى نفسها.» – بول فيريليو
فالتفاهة الرقمية لا تعني فقط «سوء المحتوى»، بل انهيار بنية التأويل نفسها. لا يعود هناك فرق بين الجد والهزل، بين الحقيقة والسخرية، بين الفعل والصورة، مما يؤدي إلى:
– تحلل السرديات الكبرى (مثل الحرية، العدالة، المصير، الله).
– انتشار نَسبية رخيصة (كل الآراء متساوية).
– ذوبان الحواس الرمزية لصالح «الترند».
ثانيًا: لحظة ما بعد الحقيقة والتفاهة كخداع معرفي
في عالم «ما بعد الحقيقة»، لم تعد الحقائق تُقاس بالبرهان، بل بمدى انتشارها. وهكذا، تكتسب التفاهة قوتها من آليات الخداع الناعم:
– الصورة أقوى من النص.
– الانفعال يتفوق على الدليل.
– سرعة النشر أهم من دقة المعنى.
وقد حذّر المفكر الإيطالي أمبرتو إيكو من هذه الظاهرة حين قال: «وسّعت الشبكات الاجتماعية دائرة التعبير، لكنها رفعت منابر للحمقى الذين كانوا يُقصَون من الفضاء العام، وأصبح لهم صوتٌ لا يقلّ عن صوت الفيلسوف أو العالم». وهكذا، يُستبدل النقاش العقلي بـ«رد الفعل»، والفكر بالـ«ميم»، والتأمل بـ«الفاينل كت».
ثالثًا: تفاهة المحتوى وتدمير العمق النفسي
يرى كارل غوستاف يونغ أن الإنسان بحاجة إلى رموز حية تغذّي لا وعيه وتمنحه المعنى. ولكن التفاهة الرقمية لا تنتج رموزًا، بل تفرغ المخيلة من أي مضمون رمزي. والنتيجة هي:
– عقل مشبع بالصور، لكن جائع للمعنى.
– مشاعر سريعة، لكن بلا عمق.
– تجربة مشظاة، بلا تماسك داخلي.
يكتب يونغ: «الإنسان الحديث فقد ارتباطه الرمزي، ولهذا يعاني من قلق داخلي لا تداويه المعرفة العلمية ولا رفاهية الحياة».
رابعًا: من القصص إلى القصاصات – اختزال الوجود في اختزالات لغوية
في الثقافات القديمة، كانت الأسطورة، والقصيدة، والحكاية أدوات لصياغة العالم، تمنح الإنسان موقعًا داخل الكون. أما اليوم، فقد حلت محلها «الستوري»، و«التويتة»، و«الفيديو القصير». هذه الأشكال لا تبني وعيًا بل: تُشتّت التركيز، وتُضعف اللغة، وتُفكك السرد.
وهكذا، يفقد الإنسان ليس فقط قدرته على الفهم، بل أيضًا على الشعور العميق، إذ لم يعد هناك وقت للتأمل، ولا مجال للبطء، ولا معنى للبقاء مع فكرة واحدة أكثر من 10 ثوانٍ.
التفاهة كأعراض حضارية لانهيار المعنى
التفاهة الرقمية ليست مسألة «محتوى تافه» فحسب، بل عرض مرضي لأزمة حضارية شاملة، تتمثل في:
فقدان الأفق الرمزي، واختفاء التأمل البطيء، وهيمنة السطح على العمق.
إنها حالة من اللا-معنى المعولم، حيث تتراكم المعلومات وتتناقص الحكمة، حيث تزداد الحوارات وتختفي المحادثة، حيث نعرف كل شيء عن كل شيء، لكننا لا نشعر بأي شيء على الإطلاق.
الجزء الخامس: في نقد التفاهة – إمكانات المقاومة الرمزية والمعرفية
رغم تغلغل التفاهة في الفضاء الرقمي، وسيطرتها على أنماط التواصل والتفكير، فإن السؤال الأهم لم يُطرح بعد: هل يمكن مقاومة التفاهة؟
وهل يمكن استعادة تجربة المعنى في عالم يفيض باللا-معنى؟
في هذا الجزء، نحاول رسم ملامح نقدية تُعيد فتح أفق التفكير، لا بإدانة التفاهة فقط، بل باقتراح أنماط للمقاومة المعرفية والرمزية والوجودية.
أولًا: مقاومة التفاهة
تبدأ من الوعي بها. كما يقول سلافوي جيجك: «الخطوة الأولى في النقد ليست تغيير الواقع، بل أن نُدرك كيف صِرنا جزءًا منه دون أن نشعر».
وهنا تكمن أولى إمكانات المقاومة: تفكيك التفاهة من الداخل، إدراك آلياتها، وتسمية استراتيجياتها.
فالتفاهة تتغذى من اللاوعي، من التكرار غير المفكر فيه، من العادة، من الاستسلام للنمط السائد. لذا، فإن كل ممارسة نقدية تبدأ بـ: كشف آليات إنتاج المحتوى التافه، وتحليل بنية الجذب اللحظي، ووعي العلاقات الخفية بين الرأسمالية الرقمية وتفاهة الخطاب.
بمعنى أن ننتقل من «الاستهلاك السلبي» إلى «الفهم النقدي».
ثانيًا: استعادة الفعل الثقافي كفعل مقاوم
المفكر الفرنسي ألان باديو يرى أن الثقافة لا تُختزل في الإنتاج الثقافي، بل في ما يسميه «الوفاء للحقيقة».
ويكتب في كتابه (الوجود والحدث): «الحقيقة ليست ما يُعرض في السوق، بل ما يُكتسب بالصبر والمثابرة، في مواجهة التفاهة التي تُغري وتُنسى».
لذا، فإن المقاومة تمر عبر:
– إعادة الاعتبار للقراءة الطويلة في زمن التمرير السريع.
– استعادة الحوار العميق في زمن ردود الفعل السريعة.
– بناء مشاريع فكرية بطيئة ضد منطق اللحظة.
– إحياء الكلاسيكيات ومفاهيم الزمن الطويل في الثقافة.
فالكتابة، والقراءة، والتأمل، ليست مجرد أنشطة ثقافية، بل مواقف سياسية وأخلاقية ضد منطق السوق الرمزي.
ثالثًا: الذكاء التأويلي ضد الذكاء الاصطناعي
في زمن تحكمه الخوارزميات، يزداد خطر استبدال الفهم الحقيقي بـ«التحليل الكمي».
فالذكاء الاصطناعي لا يفهم العالم، بل يُحلله من الخارج.
أما ما يُسميه بول ريكور بـ«الذكاء التأويلي»، فهو قدرة الإنسان على: قراءة الرموز، واستخلاص المعنى من التعدد، والربط بين التجربة واللغة.
وهذا الذكاء هو العدو الطبيعي للتفاهة، لأنه يبحث عن العمق حين تُفرض السطحية، ويعيد ربط الأجزاء ببعضها، حين يُفككها النظام الرقمي إلى «محتويات منفصلة».
رابعًا: بناء أخلاقيات رقمية جديدة
نحتاج إلى أخلاق جديدة للوجود الرقمي، أخلاق تنظم علاقتنا مع الشاشات، ومع الصورة، ومع الذات المتشظية. لا بمعايير دينية أو رقابية، بل بمعايير وجودية تحترم:
– الزمن البشري لا الزمن الخوارزمي.
– الحاجة للسكينة لا التحفيز الدائم.
– قيمة الغياب لا فقط الظهور.
وقد كتب إيف مينار: «أن تكون غير مرئي أحيانًا، هو شرط للحفاظ على وجودك».
فالانسحاب من التدفق المستمر ليس ترفًا، بل فعل مقاومة معرفي يحمي الذات من الذوبان.
خامسًا: نحو تربية على التفكير لا على التفاعل
المدرسة، والمناهج، والمؤسسات التربوية، يجب أن تتحرر من منطق التسليع الرقمي وتعيد مركزية:
الفلسفة، والقراءة النقدية، وتحليل الصور، ومقاومة «الأخبار السريعة».
التربية على «الانتباه الطويل» بدل «التنبيه اللحظي»، على «الصمت المخصب» بدل «الضجيج اللفظي»، على «الاستماع ببطء» بدل «الإجابة بسرعة».
خلاصة الجزء الخامس: مقاومة التفاهة كخيار وجودي
مقاومة التفاهة ليست مشروعًا ثقافيًا فحسب، بل خيارًا أنطولوجيًا: إما أن نعيش ككائنات سطحية لا تعرف من ذاتها إلا ما يُعجب الآخرين، أو أن نعيد بناء معنى العالم، بالقراءة، بالبطء، بالانتباه، وبالوعي بأن التفاهة لا تُحارَب بالصراخ، بل بالتفكير الطويل الصامت، العنيد، المستمر.
ضد التفاهة – من الضجيج إلى الحكمة
في ختام هذه الدراسة، يمكن القول إن التفاهة الرقمية ليست ظاهرة معزولة، بل مرآة لبنية حضارية أوسع:
حضارة الاستهلاك الرمزي.
– اقتصاد الانتباه.
– إعلام الإثارة.
– ثقافة النرجسية والتشظي.
والمطلوب اليوم ليس فقط تشخيص التفاهة، بل إنتاج بدائل ثقافية وفكرية وأخلاقية، تعيد للإنسان قدرته على الحضور العميق، والفهم الرمزي، والمعنى الوجودي.
وهذا عمل يتطلب فلاسفة، ومربين، وفنانين، ومفكرين، وقرّاء عنيدين.
كما يقول إدوارد سعيد: «في زمن الهيمنة، يكون المثقف هو من يرفض الصمت، ويصرّ على الحضور النقدي، حتى لو لم يسمعه أحد».
فلنُعد الاعتبار لهذا الحضور، ضد التفاهة، ومع الحكمة.
أهم المصادر والمراجع:
– ألان دونو – نظام التفاهة (La médiocratie) الكتاب الأساسي الذي ناقش تفشي الرداءة والتفاهة في المؤسسات والسياسة والثقافة.
– مصدر أساسي لفهم الخلفية النظرية لانتشار الرداءة بوصفها نظامًا.
– جان بودريار – مجتمع الاستهلاك، محاكاة ومحاكاة زائفة (Simulacres et simulation)
– حول هيمنة الصورة و«نسخ الواقع» التي لا تشير إلى شيء سوى ذاتها (Simulacrum).
تحليله لـ «الفراغ الرمزي» الناتج عن تغوّل الإعلام والصورة.
– بول ريكور – الزمان والسرد، الذات بوصفها آخر لأفكاره حول التأويل، والسرد كطريقة لبناء المعنى في العالم.
استُخدم لفهم كيف يؤدي غياب التأويل إلى تفاهة رقمية وجودية.
– سلافوي جيجك – مقالاته ومحاضراته حول الثقافة الشعبية والرأسمالية واللاوعي الإيديولوجي.
تحدث كثيرًا عن كيف «نمارس الأيديولوجيا ونحن نظن أننا نتهكم عليها».
يفكك التفاهة عبر خطاب ساخر – فلسفي – تحليلي.
– أمبرتو إيكو – النظرية السيميولوجية، مقالاته في الصحافة الإيطالية انتقد بشدة الفضاء الرقمي في أواخر حياته.
قوله الشهير حول وسائل التواصل الاجتماعي ومنحها منابر للحمقى.
بول فيريليو – سياسات السرعة (Dromology)
– حول تفكك المعنى بفعل التسارع الإعلامي والتقني.
يحلل كيف يُقصى المعنى حين يُستبدل الزمن البشري بزمن الخوارزمية.
– كارل غوستاف يونغ – الإنسان ورموزه
تحليله لأهمية الرمزية في تشكيل المعنى النفسي، وتأثير تلاشي الرموز في توليد القلق الوجودي.
– إريك فروم – الهروب من الحرية، الإنسان من أجل ذاته أهمية بناء الذات في مواجهة الفراغ الذي تخلقه المجتمعات الاستهلاكية السطحية.
– سيغموند فرويد – مستقبل وهم، القلق والحضارة عن العلاقة بين الغرائز، الثقافة، وتفريغ المعنى في المجتمعات الحداثية.
– شلومو زاند – حول تأثير الإعلام الجديد في اختزال الوعي التاريخي.
– غي ديبور – مجتمع المشهد (La Société du spectacle) مصدر كلاسيكي في نقد هيمنة الصورة على الواقع، وتحول الواقع إلى استعراض.
– تريستان هاريس – مبرمج سابق في غوغل، صاحب «مركز التكنولوجيا الإنسانية» انتقاده للبنية الإدمانية للمنصات الرقمية.
– زيغمونت باومان – الحداثة السائلة، الحياة السائلة
كيف تُفكك العلاقات والمفاهيم في العالم المعاصر بفعل السرعة والانسيابية واللااستقرار.
– نعوم تشومسكي – عن تلاعب الإعلام بالعقل الجماهيري، في كتبه مثل السيطرة على الإعلام.
– إدوارد سعيد – المثقف والسلطة، تأملات حول المنفى
أهمية دور المثقف في مقاومة البنى السائدة للهيمنة الثقافية والمعرفية.
– Baudrillard, Jean. 1998. The Consumer Society: Myths and Structures. London: SAGE Publications.
https://monoskop.org/images/d/de/Baudrillard_Jean_The_consumer_society_myths_and_structures_1970.pdf
– Baudrillard, Jean. 1994. Simulacra and Simulation. Translated by Sheila Glaser. Ann Arbor: University of Michigan Press.
https://press.umich.edu/Books/S/Simulacra-and-Simulation
– Debord, Guy. 1994. The Society of the Spectacle. Translated by Donald Nicholson-Smith. New York: Zone Books.
Eco, Umberto. 1984. Semiotics and the Philosophy of Language. Bloomington: Indiana University Press.
https://monoskop.org/images/b/b3/Eco_Umberto_Semiotics_and_the_Philosophy_of_Language_1986.pdf
عدد التحميلات: 18