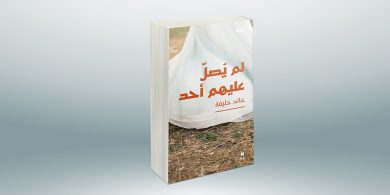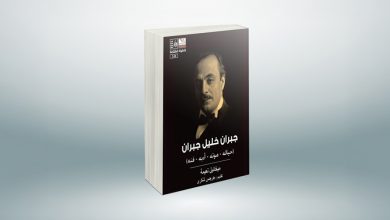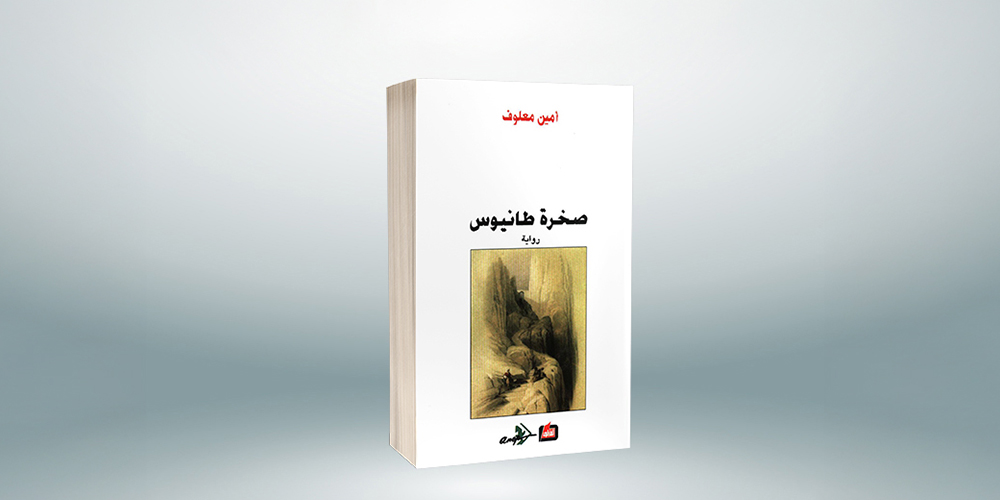
عُرف الأديب اللبناني أمين معلوف بميلة للرواية التاريخية إذ كان يلقي الضوء على حدث تاريخي معين بأسلوب روائي جذاب، وبالعادة لا تكون جميع الأحداث التي يذكرها أمين معلوف في رواياته حقيقية ولكن الإسقاط التاريخي وامتزاجه بالحس الروائي العالي يجعل المتلقي يعيش الحالة التاريخية بكافة تفاصيلها وكأنه فرد من مجتمع الرواية، هذا الأسلوب المميز جعل من معلوف يفرض نفسه على الساحة الأدبية العالمية كأديب بنكهة مؤرخ، عندما اتخذ لنفسه مسارًا وأسلوبًا ميزه عن باقي الروائيين العالميين من أبناء جيله، إذ يمكن اعتباره رائدًا في الأدب التاريخي قل أن يوجد له نظير.
أما فيما يتعلق برواية صخرة بطانيوس(1) فهي واحدة من أبدع روايات الأديب أمين معلوف والتي حازت على جائزة غونكور للأدب الفرنسي وهي أرفع جائزة أدبية تمنح في فرنسا عام 1993 م، ولذلك تم اختيار هذه الرواية لقراءة بعض المقتطفات التاريخية منها فيما يتعلق بتاريخ لبنان الحديث، وقد تجيب هذه الرواية عن شكل الحياة الريفية والاجتماعية في لبنان في مطلع القرن التاسع عشر، هذا البلد الذي عانى من الصراع الطائفي والاختلاف المذهبي منذ الأزل، ولفهم شكل الحياة الاجتماعية في الأرياف اللبنانية في مطلع القرن التاسع عشر لا بد من الاستعانة بالإضاءات التي ذكرها معلوف في روايته صخرة طانيوس، هذه الرواية التي اشتبك فيها الواقع مع الخيال، فيتبين للقارئ المؤرخ ورود أحداث تاريخية حقيقية يتخللها مجموعة من الأحداث الخيالية لخدمة النص الأدبي المترابط، وبالمحصلة فأن ما يهمنا في هذا المقال فهم الإشارات الواردة لأحداث تاريخية واقعية جمعها الكاتب من مذكرات كبار السن في قرية كفردبيان الواقعة في جبل لبنان، ومزجها بأحداث تاريخية أخرى موثقة وسبكها بأسلوب روائي لكي تعطينا تصورًا مبسطًا عن شكل الحياة في جبال لبنان في مطلع القرن التاسع عشر.
تدور أحداث الرواية حول الفتى طانيوس الذي يولد في قرية إقطاعية من قرى جبل لبنان، ثم تحوم الشكوك حول هوية هذا الفتى كونه قد يكون الابن غير الشرعي للشيخ الإقطاعي؟!، ثم تتوالى الأحداث لتنتهي باختفاء طانيوس، وبدأت الرواية بتناول مظاهر الحياة الريفية التي سيطر عليها الاستبداد المتمثلة بشخصية الشيخ الذي وصف بأنه حفيد سلالة عريقة من مشايخ جبل لبنان وأطلق على عصره في مطلع الرواية اسم “عصر الشيخ “، وهنا بدأ معلوف بذكر مجموعة من الصور الريفية التي تدل على شكل الحياة المتردية التي كان يعيشها أبناء القرى تحت سطوة المشايخ، فيصف المقاطعة التي تقع تحت حكم الشيخ بأنها مقاطعة صغيرة مقارنة بغيرها إذ لا تتجاوز مساحة هذه المقاطعة قرية كفر دبيان، والمزارع التي حولها وثلاثمئة بيت تعود ملكيتها للقرويين، فيما سيلاحظ القارئ وجهة نظر الكاتب التهكمية بأن هذا الشيخ الذي يتجبر في رقاب العباد ما هو إلا حلقة صغيرة من حلقة أكبر يخضع فيها الشيخ لأمير جبل لبنان هذه المنطقة التي تخضع لتجاذبات الولاة في مصر وبلاد الشام الذين يرزحون جميعًا تحت نير الدولة العثمانية إذ يقول “هذه المدن التي تخضع للسلطان الأكبر في الآستانة”، ويعني بذلك الحكم العثماني الذي خلف هذا الشكل من الإقطاع الجائر وحول حياة الناس البسطاء إلى عبودية دائمة بين تجبر الشيخ وتجبر السلطان، نتج عنها أجيال عديدة ترزح بين سندان الشيخ ومطرقة السلطان ليس لها سبيل إلى العيش إلا العمل في السخرة من أجل إرضاء المشايخ، ولذلك ذكر معلوف مجموعة من الصور التي تعطي نبذة عن حياة الفلاحين فيمكن الوقوف عند جملة “إن الفلاح يجب أن يعيش دائمًا في رهبة وخنوع”، هذه العبارة العميقة التي تدل على علاقة الفلاح بالشيخ الذي يأتمر بأمره، وهنا يظهر تهكمه مرة أخرى على مصطلح “كف”، وهو تعبير مجازي كان يستخدمه القرويين بكثرة وله مجموعة من المعاني المبطنة في حياة القرويين فيقول: “غالبًا ما كانت كلمة كف اختصارًا لكل من القيود والسوط والسخرة”، وهذا يدل على مدى الإرهاب النفسي الذي كان يمارس على الفلاحين فبالإضافة للعقاب الجسدي كان الإقطاعيين يمارسون الضغوط النفسية على رعاياهم فكان مجرد الحديث عن الشيخ وحياته يثير قلق السكان، وبذلك يعود معلوف ليقول: “لم يكن الإقطاعي يعاقب على تنكيله برعيته”، وجاء هذا التصوير العميق ليبين شكل الحكم الاستبدادي الذي يمارسه الحاكم الديكتاتوري على رعاياه البسطاء الذين هم دائمي الحاجة له في إدارة شؤونهم.
فقد كان الشيخ هو المسؤول عن حل القضايا الاجتماعية بين القرويين، وكان القرويون يقبلون بأحكامه على مضد إذ لم يكن أي منهم يجرؤ على رفض أحكامه فيقول: “لو تعنت أحدهم تأتي صفعة السيد لتحسم الأمر نهائيًا”، وهذا نوع من التأطير للنظرية الاستبدادية التي يحاول معلوف مناقشتها في هذه الرواية، ومن جانب آخر فأن الشيخ الإقطاعي كان يقاسم الفلاحين مواسمهم الزراعية، في الوقت الذي كان يتعهد بأنه لن يجوع أحد من رعاياه ما دام في بيته كسرة خبز وحبة زيتون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تفسير هذه الجملة بأنها نابعة من محبة يكنها الشيخ لرعاياه، بل على العكس هي دلالة على أن حاجة الشيخ للفلاحين أكثر بكثير من حاجتهم إليه ولكن السطوة التي يتمتع بها هي ما جعلته يتحكم في أرزاقهم إذ كان بإمكانهم التخلص من تجبره بمجرد رفض مقاسمته لهم في أرزاقهم، ولكن عدم التحرر من فكرة الخنوع والخوف الغير مبرر من شخصيات ذات سلطة محدودة نوعًا ما، هي من خلقت هذا الشكل الاستبدادي في المجتمعات العربية في عهد الدولة العثمانية.
وبالانتقال إلى الإشارات التاريخية التي نقشها معلوف في الرواية نجد أن هناك أكثر من حادثة تاريخية حقيقية حصلت بالفعل في تاريخ لبنان الحديث، وتناقش الرواية الفترة التي كانت لبنان تحكم من قبل الأمير بشير الثاني أمير إمارة الجبل لبنان والجدير بالذكر أن عهد الأمير بشير الثاني يعتبر من أطول فترات الحكم في العالم، حيث واستمر عهده لأكثر من اثنين وستين عامًا (1788 – 1840م)(2)، وقد كانت الدولة العثمانية تعاني في هذه الفترة من ضعف واضح شهدت خلاله بلاد الشام مجموعة من الاضطرابات لعل أبرزها قدوم الحملة الفرنسية على مصر وبلاد الشام كما أن الأمير بشير عاصر الوالي محمد علي باشا في مصر، وأدى التحالف بين الأمير بشير والوالي محمد علي باشا ضد الدولة العثمانية في الفترة الممتدة بين عامي (1831 – 1840م) إلى انهيار حكمه ثم نفيه بعد انسحاب القوات المصرية من بلاد الشام، بعدها قامت القوات العثمانية بأسره ثم نقله إلى المنفى الذي توفي فيه عام 1850(3).
ولكن معلوف لم يورد هذه المعلومات بهذه الدقة بل حاول أن يخفي المعالم الرئيسية لشخصية الأمير بشير متذرعًا بالأسلوب الأدبي الروائي إذ أشار إلى أنه لا يتوجب أن تكون هذه الشخصيات حقيقية، ولكن مع التطابق التام بين قصة الأمير بشير الثاني الحقيقية، وقصة الأمير الوارد في الرواية اكتفى معلوف باستخدام كلمة “الأمير” للحديث عن التحالف بين الأمير بشير الثاني ومحمد علي باشا والي مصر، وهنا تظهر وجهة نظر الكاتب بقوله: “خيانة المصريين” للتعبير عن السبب الذي أدى إلى وقوع الأمير في الأسر العثماني ثم نقله إلى منفاه في الأستانة فيقول: “فضل الأمير المنفى على خيانة المصري له في اللحظة الأخيرة فأبحر هذا الأسبوع إلى مالطة” ويمكن الحديث عن أن هذه الفترة بأنها من أكثر الفترات اضطرابًا بالأحداث التاريخية المتوالية والمتواترة في التاريخ العربي الحديث، إذ كان وجود محمد علي باشا في البلاد العربية محورًا للعديد من الأحداث الموزعة جغرافيًا على العديد من الجبهات إذ لم تقتصر تدخلات محمد علي باشا على إمارة بشير الثاني في جبل لبنان فحسب بل كان محمد علي باشا ذو تحركات توسعية في عدة اتجاهات فبعد إحكامه السيطرة على الحكم في مصر عام 1805م، تخلص من خصومه المماليك بما عرف بمذبحة القلعة عام 1811م(4)، بعد ذلك تطور الفكر التوسعي لدى محمد علي باشا إذ قام بإرسال حملة على الجزيرة العربية من أجل القضاء على دولة آل سعود الأولى في الدرعية الواقعة في هضبة نجد(5) وسقطت الدولة السعودية الأولى بواسطة ابنه إبراهيم باشا عام 1818م(6)، وفي عام 1820 م استطاع التوسع إلى السودان وتأسيس مدينة الخرطوم بقيادة ابنه اسماعيل باشا وضم السودان إلى حكمه(7)، ثم زادت اطماعه التوسعية بعد أن لمس الضعف الحقيقي في الدولة العثمانية في عهد السلطان محمود الثاني (1808-1839م) فقرر التوسع على حسابها في بلاد الشام عام 1831م(8).
ويمكن القول بأن القوة التي ظهر بها محمد علي باشا هي السبب الرئيسي الذي دعى الأمير بشير الثاني للتحالف مع محمد علي باشا خاصة في فترة ضعف سلاطين الدولة العثمانية، وفي هذا الصدد يرى معلوف أن الوجود المصري في لبنان كان مرفوض من الأهالي إذ كان يعتبر وجود المصريين هو عمل ضايق اللبنانيين لأنه رأى أن هذا التحالف ما هو إلا خضوع للحكم المصري وهو بطبيعة الحال احتلال غير مباشر لإمارة جبل لبنان، فكان من الأحرى بالأمير بشير الثاني رد على القوات المصرية ومنعها من التحكم بسيادة جبل لبنان.
كذلك من الأحداث المهمة التي نقشها معلوف التواجد البريطاني على الأراضي اللبنانية في مطلع القرن التاسع عشر والذي رمز لها بمدرسة القس الإنجليزي هذا الوجود المزعج بالنسبة للسكان ذوي الأغلبية المارونية الذين يتبعون بولائهم لفرنسا بالدرجة الأولى، فيلاحظ من خلال نص الرواية أن السكان اعتبروا الوجود الإنجليزي على أراضيهم محاولة لنشر “الهرطقات” حسب تعبير إحدى شخصيات الرواية، وبالرجوع للواقع كان العديد من مسيحيي الشرق ينظرون بالفعل إلى المذهب الأنجليكاني الذي كانت تبشر به بريطانيا خلال إرسال البعثات التبشيرية إلى الشرق بأنه هرطقة وخروج عن التعاليم الدينية التي يؤمن بها أغلبية المسيحين في الشرق(9).
وبالعودة للحديث عن مدرسة القس الإنجليزي فقد كانت مثار للريبة لدى أهالي جبل لبنان ذو الأغلبية المارونية حيث بدأت هذه المدرسة باجتذاب أبناء القرى، وهذا الغطاء التبشيري ما هو إلا شكل من أشكال التمهيد لاستعمار بلاد الشام في خضم الصراعات الداخلية بين الدولة العثمانية وولاة الولايات العثمانية، وهنا بدأ يظهر استغلال الانجليز والفرنسيين لحالة الصراع الدائم في بلاد الشام من أجل التسلل للبلاد العربية تحت غطاء المؤسسات التربوية.
كما ناقش أمين معلوف خلال سرد أحداث الرواية حادثة مشهورة في تاريخ لبنان الحديث تمثلت باغتيال البطريرك يوسف بطرس حبيش عام 1845م، فيذكر تاريخيًا أنه في عهد هذا البطريرك وقعت حرب أهلية في جبل لبنان بين الموارنة والدروز بعد نفي الأمير بشير الثاني عام 1840م، واستمرت حتى اغتيال البطريرك فكانت هذه الحرب عبارة عن مناوشات متقطعة تتجدد بين الحين والآخر فبالرغم من الحركة الإصلاحية التي حاول البطريرك حبيش أن يقوم بها في جبل لبنان من خلال فتح المدارس والكنائس والجمعيات الخيرية إلا أن رحى الحرب كانت أقوى منه، إذ يعتقد بعض المؤرخين أن السبب الرئيسي لاغتيال البطريرك حبيش هو علاقته الجيدة مع الدولة العثمانية(10).
وجاء السرد التاريخي لدى أمين معلوف فيما يتعلق بحادثة اغتيال البطريرك منسجمًا مع أحداث الرواية بالأخص مع تطرقه لبعض أحداث الحرب الأهلية بين طوائف جبل لبنان خاصة الموارنة والدروز إذ كانت هذه الحرب على أشدها في تلك الفترة.
ومن خلال هذه القراءة التاريخية السريعة لرواية صخرة طانيوس، يتضح أن قناع الفتى طانيوس الذي استخدمه معلوف لمناقشة فترة تاريخية معقدة في تاريخ لبنان الحديث في الكواليس ساعد على استخدام هذه الشخصية لتكون غطاء لسرد أحداث تاريخية عميقة أكبر بكثير من قصة طفل صغير ولد في قرية نائية تحوم الشكوك حول نسبة، كما أننا لا نستطيع الجزم إن كانت شخصية طانيوس هي شخصية حقيقية أم من نسج خيال الكاتب، هذه الشخصية التي ظهرت على مسرح الأحداث المضطربة ثم اختفت فجأة، ولكن ما نستطيع استقراءه في ثنايا رواية صخرة طانيوس هو الاسقاط الأدبي المحترف الذي برع به أمين معلوف من خلال استخدام شخصية شاب قروي يولد في حقبة دموية في منطقة ملتهبة ويكون بطلًا تدور حوله أحداث تاريخية حقيقية بأسلوب روائي جذاب يجعل المتلقي يفهم هذا اللغط الشائك في تاريخ لبنان الحديث خلال تسلسل الأحداث التي جرت ضمن اندماجه في ثنايا قصة نسجت من خيال الراوي لكن وضحت حقائق غفل عنها الكثير دون التمعن في ما وراء هذا النص الأدبي الجذاب من أحداث تاريخية حقيقية سوداء.
الهوامش:
(1) معلوف، أمين، صخرة طانيوس، ترجمة نهلة بيضون، ط1، دار الفارابي، لبنان، 2001م.
(2) زيدان، جرجي، تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر، ج1، مؤسسة هنداوي، بريطانيا، 2017م.
(3) زيدان، تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر.
(4) كفافي، حسين، محمد علي رؤية لحادثة القلعة، الهيئة العامة المصرية للكتاب، مصر، 1992م.
(5) بركات، داود جرجس خوري (ت 1351هـ/ 1933م)، البطل الفاتح إبراهيم وفتحه الشام 1832م، مؤسسه الهنداوي، وندسور، المملكة المتحدة، 2017م.
(6) الترك، صالح أحمد، حكم محمد علي في الحجاز 1819-1840م، رسالة ماجستير غير منشورة، إشراف د. حسين القهواتي، المفرق، الأردن، 1999م.
(7) الأرمني، إسكندر بن يعقوب آغا ابكاريوس (ت1303هــ /1885م)، تاريخ محمد علي باشا، تحقيق أحمد العدوي، مركز الدراسات الأرمنية في جامعة القاهرة، القاهرة، ط1، 2009م.
(8) ديفن، بريس، مذكرات بريس ديفن في مصر (1807 – 1879م)، ترجمة جمال الضيطاني، ط1، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 1991م.
(9) دياب، عيسى، مدخل الى تاريخ الكنائس الانجيلية ولاهوتها، دار منهل الحياة، 2009م.
(10) بهير، ماجد حمدان، الحروب المسيحية/الدرزية في جبل لبنان 1841-1861م ن كلية التربية، جامعة المستنصرية، العراق، 2018 م.
عدد التحميلات: 0