
“إن الكاتب الإفريقي الخلاّق الذي يحاول تجنب القضايا الاجتماعية والسياسية الكبيرة في
إفريقيا المعاصرة، سينتهي بـه الأمر إلى أن تكون كتاباته أشبه بدخان في الهواء”.
أتشينو إتشيبي
يُعد نجوجي واثيونجو Ngugi Wa Thiongo من أبرز ورائيي كينيا الواقعة شرق أفريقيا، وأحد عمالقة الأدب الأفريقي الحديث، وأهم كتّاب ما بعد الكوليونيالية في الأدب الأفريقي المعاصر، فقد كانت حياته في حد ذاتها رواية ملحمية تستقى أحداثها من وطنه ومن معاناة بنى وطنه في كينيا التي كانت الكولونيالية الإنجليزية متأصلة في كافة ربوعها، وكانت حياته بكل أبعادها الإنسانية والإبداعية مرحلة نضالية تمرد فيها واثيونجو على كل المصاعب الحادثة في الحياة الإنسانية والثقافية الأفريقية والعالمية وشارك بتمرده على المؤامرة الكولونيالية التي تعّود على مواجهتها بكل قوة، وكان دائمًا ما يقول: «أنا أصف نفسي كمحارب شرس من أجل اللغات المهمشة وأتوق إلى الفانفونية كمعلم مهم من أجل تحرير إفريقيا بؤرة العالم الثالث».
رحل الكاتب الكيني الكبير «نجوجي أثيونجو» يوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025 عن عمر ناهز الـ 88 عامًا بعد حياة حافلة بالنضال والإبداع، وكان تأثره بمجايليه من الكتّاب الأفارقة النشطاء في مجالات الفكر والإبداع خاصة بـ«وول سونيكا، وأشينو أتشيبي» وغيرهم من صفوة كتاب أفريقيا الكبار، خاصة وقد كان الأثر الواسع لأعمال الكاتب النيجيري الكبير (أتشينو أتشيبي) عليه وعلى رفاقه من الأدباء الأفارقة حول قيمة تمجيد الماضي كبيرًا كما كان له أثره الفعال في إبداعات الكثير من روائيي القارة، ويجب الإشارة هنا إلى أن هذا الأثر الفعال قد شغل اثيونجو كثيرًا خاصة بعد قراءته أعمال أتشيبي وتأثره بالكثير منها، ويعتبر نجوجي أثيونجو من أوائل كتّاب شرق أفريقيا الذين نشروا أعمالهم خارج وطنهم، وتوضح أعماله كيف أن الرغبة في تسجيل الحقيقة حول الماضي من الأنثروبولوجي المرتبط بالحياة في كينيا، وتأثير الاستعمار المدمر على كرامة الحياة الموروثة عند الأفارقة أصبحت دافعًا قويًا خاصة لكل كتّاب الموجة الأولى من الروائيين، وعلى رأسهم نجوجي على الرغم من الفروق الثقافية والتاريخية بين الأجيال الكاتبة من الأدباء، وقد اعترف نجوجي منذ البداية بأثر (أتشيبي) وغيره من كتّاب غرب أفريقيا على جيله من الكتّاب، كما أنه حدد بوضوح تام أهمية أعمال هؤلاء الكتّاب بالنسبة للكتاب الشباب في مناطق أخرى من أفريقيا ممن استلهموهم في تسجيل تجاربهم الذاتية وتجارب شعوبهم وقد قال في هذا الصدد: لقد قرأت لـ«أشينوا أتشيبي» و«لاكوتسي»، كما أعتقد أن بعض كتّاب جزر الهند الغربية وشعوبها قد شحذوا خيالي، إن ما فعله الكتّاب الأفارقة ولم يستطع أن يفعله أي كاتب إنجليزي آخر هو أنهم جعلوني أشعر أنهم يتحدثون إليّ فعلاً: «فالوضع الذى يكتبون عنه كان مألوفًا لديّ، كما وجدت للمرة الأولى أنني أتحدث مع شعبي، أتحدث مع شخصيات أعرفها، بطريقة ما، لها آلامها التي شهدتها مع شعبي في كينيا، وعندها أدركت أنني أستطيع أن أمارس الكتابة أيضًا».(1)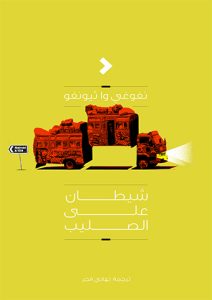
ولد نجوجي واثيونجو في الخامس من يناير عام 1938 في قرية «كاميريثو» قرب مدينة «ليمورو» الواقعة على مقربة من العاصمة نيروبي وسط كينيا، وعمّد باسم (جيمس نجوجي) جريًا على عادة وتقاليد الكنيسة التي تخلع أسماء قديسيها على أسماء المواليد تيمنًا بهم؛ وطلبًا لبركة مرجوة. نشأ نجوجي في أسرة تضم العديد من الأخوة والأخوات لأب مزواج يهوى تعدد الزوجات. في السادسة من عمره أرسلته أمه إلى إحدى إرساليات التبشير، وفي العام التالي أدخل مدرسة «كيكويو» في مدينة «كارينجا» حيث انتظم في الدراسة والتعليم حتى عام 1955، إلا أنه انقطع عن الدراسة بين عامي 1948-1950 عندما توقفت الدراسة في أنحاء كينيا مع اندلاع ثورة «الماو ماو» التي قادها الزعيم الكيني «جومو كينياتا»، ثم ما لبث أن تابع دراسته العليا في مدرسة «الأليانس» حيث قام بأولى محاولاته الأدبية والتي تمثلت في مسرحية اقتبسها عن رواية للكاتب الأمريكي «أدجار والاس» صاحب رواية «بن هور». التحق نجوجي بجامعة «ماكيريرى» في كمبالا بأوغندا وحصل منها على شهادة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي عام 1963، وأثناء المرحلة الجامعية أشترك مع زملائه في تحرير مجلة «رأس القلم الطلابية» التي كانت تمثل منبرًا ثقافيًا وأدبيًا للأصوات الشابة خلال تلك المرحلة. بعد تخرجه من الجامعة عمل في صحيفة «الأمة» اليومية في نيروبي لأشهر قليلة، سافر بعدها إلى «ليدز» في إنجلترا لمواصلة دراسته، عاد إلى بلاده عام 1967 ليعمل محاضرًا في اللغة الإنجليزية في جامعة نيروبي بكينيا، إلا أنه استقال من منصبه الجامعي عام 1969 احتجاجًا على الطريقة التي واجهت بها السلطات الاضطرابات الطلابية أنداك. سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1970 حيث شغل منصب أستاذ زائر في الأدب في جامعة «نورثوسترن» في ولاية «أيلينوى»، ثم عاد إلى كينيا حيث استأنف نشاطه الأكاديمي في تدريس الأدب في كلية نيروبي، في ذلك الوقت لم تكن علاقته بالسلطة طيبة بسبب ارتباطه بحركات العمال والفلاحين، ففقد وظيفته الجامعية عام 1978، واعتقل بدون محاكمة لمدة سنة، سافر بعدها إلى لندن عام 1982 للإشراف على نشر الترجمة الإنجليزية لروايته (الشيطان فوق الصليب) التي كتبها أثناء فترة اعتقاله، وأثناء وجوده في لندن علم بأن السلطات الكينية تعتزم اعتقاله فور عودته إلى بلاده فقرر البقاء في لندن واتخذها قاعدة لحياته الاجتماعية والأدبية.
نجوجي واثيونجو ولغة الكيكويو الكينية
كتب نجوجي في حقول السرد المختلفة القصة القصيرة والرواية والمقالة النقدية والكتابة للمسرح، وتتناول أعماله الإبداعية المتنوعة مساحة واسعة من الاشتغالان المرتبطة بالهم القومي والوطني والإنساني، تمتد من النقد الاجتماعي والسياسي، والأنثروبولوجي الثقافي وحتى أدب الأطفال. كما كتب باللغة الإنجليزية العديد من الأعمال الإبداعية، ولكنه أحجم عنها بعد ذلك، وانبرى يكتب بلغته المحلية لغة (الكيكويو Gikuyu) وحول موقفه من مسألة اللغات، يقول نجوجي: هل أكتب بلغتي الأم أم بلغة المستعمر؟ هل أترجم النص إلى لغتي أم إلى لغة الآخر؟، لقد ارتبط نجوجي بلغة قومه كما قال إدوارد سعيد «يالغتي أكون كما تكونين»(2) وهكذا جسدّت علاقة نجوجي بلغته القومية بحيث أصبحت علاقة تشابك لا انفصام لها، وبدأ حالة من التمرد على الأوضاع من خلال تفاوت اجتماعي ناصر فيه علانية قضايا الوطن المطحون مما أدى إلى القبض عليه وحبسه دون توجيه تهمة له عام 1977.
وفى سجن كاميتي مشدّد الحراسة اتخذ نجوجي القرار، وأعلن المقاومة من رحم الإبداع، معتبرًا أن اللغة هي ساحة المعركة الأولى للتحرر، ومؤكدًا أن «اللغة ليست مجرد وسيلة تواصل فحسب، بل هي وسيلة تفكير وتصّور للعالم، فحين نبتعد عن لغتنا، نبتعد عن ذواتنا». وهجر واثيونجو اللغة الإنجليزية كوسيلة للتعبير وبدأ الكتابة بلغة وطنه «الكيكويو» معتزًا بها، ومبرهنًا على قدرتها على حمل الأفكار والرؤى والتعبير، ومصرًا على أن تترجم أعماله منها لا إليها. كما ألف العديد من المسرحيات، وأنشأ مسرح «كمريثو» وسط القرى الكينية النائية ليشعل شموع الوعي في مناطق التهميش والنسيان، لكن ذلك لم يكن بلا ثمن، فقد اعتقل عام 1977 على أثر مشاركته مع عمال مزارعين من قريته، في عرض مسرحية «سأتزوج عندما أريد» التي كانت دفاعًا عن حقوق المزارعين والعمال والنساء في مواجهة السلطة والكنيسة. وفى المعتقل لم تخفت إرادته بل اشتعلت أكثر عن ذي قبل حتى إنه عندما أراد كتابة رواية (الشيطان على الصليب) بلغة «الكيكويو» لم يجد سوى لفافات مناديل الحمام ليكتب عليها روايته.
يسلط واثيونجو في معظم رواياته عينًا كاشفة على ما رافق الاستعمار من انسلاخ قومي ولغوي مضطلعًا بدور المتحدث الصارخ المحتد دائمًا نيابة عن القارة الأفريقية جمعاء. حتى اسمه قرر أن يغيّره حينما حضر مؤتمرًا كنسيًا عام 1970، وقال فيه على الملأ: إنني لست مسيحيًا!!، فاعترض أحد القساوسة مدللاً على هويته الدينية باسمه المعمّد به. وهو جيمس، وقرر في هذه اللحظة إخفاء أسم جيمس واستبداله باسم نجوجي.
وفي إحدى الحوارات مع نجوجي واثيونجو حول ذكرياته مع صور الأعمال والممارسات الوحشية التي اقترفها نظام الحكم الاستيطاني الأبيض في كينيا، والذي قال عنها نجوجي إنه كان ضحية محاولات اغتيال، واعتقال، وقمع وإدراج على القوائم السوداء، وما إذا كان كل هذه المحاولات الاستفزازية قد غيرت طريقته في الكتابة؟ وقد أجاب واثيونجو: «أن ذكريات العنف الكولونيالي لا تزال حاضرة معي، وكذلك العنف الذي مُورس على أسرتي. لذلك فإنني حينما أرى المذابح في الشرق الأوسط، أو عنف الشرطة العبثي مع السود في شوارع الولايات المتحدة، تحضرني تلك الصور التي كانت تمارس معي. فأزداد جدية في العمل. أريد أن أرى عالمًا بلا تشرد أو جوع. أريد أن أرى نهاية للمنطق الذي تقوم عليه التنمية الحديثة الذي من أجل أن يكون فيه واحد، لا بد أن لا يكون آخر. أريد أن أشهد نهاية لمنطق أنه لكي يوجد ألف مليونير أو بليونير، لا بد أن يوجد بليون فقير. علينا أن ننهي هذا العته في التفكير الذي يقيس التنمية في بلد بقدر ما فيه من بليونيرات. ماذا عن البليون فقير الذي تسبب فيها البليونيرات؟(3)
منجز واثيونجو الروائي
تُعد رواية (لا تبك يا ولدي) 1964 هي الرواية الأولى في منجز واثيونجو الروائي، كتبها أثناء دراسته بجامعة «ماكيرير» في كمبالا، وهي تعتبر أول رواية تصدر باللغة الإنجليزية لكاتب من شرق أفريقيا، وتدور أحداثها في فترة ثورة «الماو ماو» وتقوم على صورة الإقطاعي الكولونيالى ودوره في دحر الإنسان في عقر داره وسلبه حقه في العيش الكريم عن طريق استباحة الاستيلاء على أرضه والتمثيل بواقعه، خاصة عندما يكون الفعل الحاصل جراء هذا الإجراء هو شرعية الدفاع عن النفس بكل الوسائل ومنها الانخراط في المظاهرات مع أصحاب الحق المسلوب، وتمس الرواية جوانب عدة من الحياة الإفريقية المعاصرة في كينيا وفي دول أفريقية أخرى، على الأخص الوعى القبلي أو المذهبي الذى يؤثر على التفاصيل الدقيقة للسلوك اليومي للإنسان الأفريقي والذي يضعه في مواجهة الصدام الحاصل بين كل ما هو محلي وأوروبي، وبين كل ما هو وثني ومسيحي، وبين البدائية والعصرية، وقد عبّر نجوجي عن إيمانه بأن صراع الإنسان الأفريقي هو أيضًا بين تقاليد القبيلة وبين متطلبات المجتمع في العصر الحديث: «وقد ارتكزت الرواية على شخصيات مركزية وثانوية أدت أدوارًا مهمة في تصاعد نسغ الفعل والحركة. فكان وجودها إيذانًا لحراك تاريخي واجتماعي يرى في نيل الحرية والحقوق والدفاع عنها منبرًا ينطلق منه العمل الفني الذي يبني في الرواية مجمل المسار الحدثي. فصائل «نجوذو» الشخصية القوية الفاعلة ضمت الزوجة والابن «نجوروجي» الذي يعد محور العمل والشخصية المركزية، والتي أدت دورًا فنيًا عاليًا في صياغة الحدث وتطوره. «نجوروجي» طفل لم يعرف المدرسة بعد. يشارك عائلته كوخا يجاور مسكن الإقطاعي الأسود «جاكوبو» وهو رجل يملك أراضٍ شاسعة، ويسكن منزلًا فخمًا. كان يمارس اضطهاد الفلاحين السود ويترفع عن مشاركتهم أي احتفال أو تجمع لهم. عائلة «نجوروجي» تسكن في أرضه بعدما اغتصب المستوطن الأبيض أرضها. فقد أبوه «نجوذو» أرضه وولده حين سيطر المستوطن «هولاندز» عليها وجعله مزارعًا فيها. فكان السؤال. هل ارتضى هذا الرجل العجوز بأن تصادر أرضه ويكون مزارعًا في نفس أرضه؟! عالج المؤلف موقف هذه الشخصية من خلال منحه وعيًا بسيطًا جسّده برفض السرقة والاستحواذ، فكان لوعيه دور كبير في حشد الآخرين واشتراكهم في التظاهرة التي تدعو لرفض الظلم والسرقة وعودة الأرض لأصحابها، برغم علمه أنه سوف يسجن ويطرد من مسكنه. وبالفعل تم طرده من العمل وصودرت داره، وفشلت أحلامه وأماله في الوصول إلى حقه المسلوب، فظل يعيش تجربة الألم وذكريات الماضي البغيض. ولعبت الصدفة دورها في لقاء الابن «نجوروجى»، مع «موبهاكي» ابنة الإقطاعي الأسود «جاكوبو»، وبدأت علاقة بريئة بين الطفلين تتنامى وتتصاعد وتيرتها على مر الأيام أدخلت الرواية في حالة جديدة، وفتحت آفاقا حوارية صريحة، مفعمة بالكشف والمواجهة بعيدًا عن أجواء العائلتين الفقيرة والغنية. كان للزمان والمكان في الرواية بعدان لم يتغيّرا، لكن الذي تغيرّ هو إحساس «نجوروجي» الطفل الذي كبر مع الأحداث، والوعي الذي نما معه، نتيجة طرد والده من أرضه وسلبه داره، الحدث في الرواية اشتمل على أبعاد اجتماعية وسياسية تمثلت بالصراع ضد السلب والاستغلال والتمييز العنصري بحيث أفاد في توظيف الموضوع تمامًا.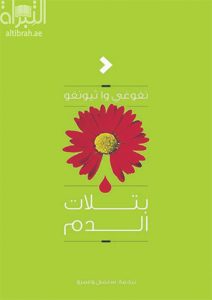
أما رواية (النهر الفاصل) 1967 فقد أستخدم واثيونجو فيها الرمز وارتباطه بخلفيات المعتقدات الدينية والصوفية، كعنصر فاعلاً لحقيقة واقعة مضافة إلى مرتكزات أحداث النص يحاول فيها القارئ فك أبعاده، ومدلولات مضامينه ليصل إلى المعنى المجرد لطبيعة الأحداث. فالنهر الفاصل هو النهر الذي يجري بين سلسلتين من التلال «كامينو»، و«ماكوبو» يفصلهما نهر «هونيا» أي الكلمة التي تعني الشافي أو نهر الحياة الذي يوحد الرجال والطبيعة، في هذه المنطقة كان يعيش رجال منذ القدم شكلوا رموزًا حقيقية للحياة، وأسسوا حياتهم على طقوس ومعتقدات دينية قديمة في تلك الهضاب الموغلة في القدم، أهمها عملية الختان التي تفرضها القبيلة على شباب القبيلة بنوعيهما حتى يصبحوا رجالًا ونساء، وتستلزم هذه العملية حفلات رقص وغناء تقيمها القبيلة. وتسير الرواية في قصة حب وتبشير بطبيعة الحياة ما بين الجديد والقديم، وتمثل نقطة التقاء اجتماعية وفكرية: «وقد إسر “واياكى” بمواطن الضعف في نفسه، وكذلك بالمتناقضات الموجودة في المواقف العاطفية العامة التي يسيطر عليها الزعيم الديماجوجي التقليدي بخداعهم، وكما هو أيضًا صوت “سيريانا” السفسطي أو إغراءات المدينة الكبيرة، ولكن هذه الفترة الزمنية بكل ما فيها من جوانب “واياكي” وبعيدًا عن كونها حاسمة ومقنعة تتضمن بذور الأمل».(4)
كما يستخدم واثيونجو أيضًا اللعب بالزمن والسفر إلى الماضي في رواية رواية (تويجات الدم) 1975، وكيف تتشابك حياة الشخصيات، وما تواجهه كينيا في مرحلة ما بعد الاستعمار الكولونيالي. وفيها يحكي قصة أربع شخصيات يتم استجوابهم في قرية كينية بتهمة قتل المديرين الأفارقة لشركة تقطير التنجيتا التي يملكها أجانب؟، وبدأت الشرطة في التحقيق مع أربعة أشخاص من بلدة الموروج الجديدة الواقعة على الطريق العابر أفريقيا. وكانت حياة شخصية «منيرا» مدير المدرسة، مشتبكة مع حياة المشكوك فيهم الثلاثة.. «وانحا» فتاة المشرب الجذابة، «كاريجا» المتمرد دائمًا والذي تحوّل من معلم إلى نقابي، و«عبدالله» صاحب الدكان ذو الماضي البطولي باعتباره مقاتلاً فدائيًا في النضال من أجل استقلال كينيا. تتكشف علاقات هؤلاء الشخصيات على أرضية الموضوع من خلال تغير القوى الاجتماعية. تحمل الرواية تاريخ النضال السابق ضد الحكم الكولونيالي والاضطهاد الحاصل للشعب الكيني، وكذلك نضال الشعب المستمر ضد استغلال أشد وأبشع قائم على تحالف الأجانب والطبقة المالكة الجديدة من الأفارقة. ترى الرواية أمل أفريقيا الوحيد في استمرار نضال الجماهير ضد هذا التحالف بغية التغلب على الاستحواذ المستمر والمدمر لاستنزاف أموال الشعب الذي يتم في المناطق الريفية بصفة خاصة، ومن المدن، ومن الأمة بأسرها وتحويله إلى بلاد المستعمر، وحين يهطل المطر، لينبت ازدهار ذات تويجات الدم.. فأي ثمار تنتظر؟ هذا هو كل ما قالته هذه الرواية التي جسدت الكفاح الكيني ضد المستعمر بشتى صوره وأشكاله وقد صدرت عام 1977 واستغرقت كتابتها خمس سنوات.
وحول رؤيته تجاه تمييز العلاقات بين حادثة وأخرى كتب نجوجي روايته رواية (حبة قمح A Graint of Wheat) وتدور أحداثها في الفترة التي أدت إلى استقلال كينيا وتجمع معاني الماضي وتراجعها في ضوء المستقبل الذى حققه أخيرًا الصراع السياسي للشعب الكيني، وقد جعل نيجوجي من قرية «ثاياي» عالمًا مصغرًا لعموم كينيا كلها، مصورًا لها على أنها كومونة اجتماعية دارت في أرجائها التفاعلات السياسية، والاجتماعية وتشابكت فيها مشاعر الناس، وانتهت بحمل فكرة أن الاستقلال لا يأتي نيله إلا بالنضال، فيما آثر البعض الحياد، والعيش بمنأى عن خطورة الأحداث. كما وجد بعضهم في المستعمر القادم ملاذًا وقوة يجني من خلالها التعاون معه للحصول على أيسر السبل وأسرعها وأكبر قدر من المكاسب على حساب وطنه وأهله، كما أعطى لشرائح كبيرة تعيش الحياة البسيطة المهمشة في المناطق العشوائية اللامبالاة واللاهتمام لما يدور حولها، فلم يمنح لحركة المجتمع الواسعة صفة المشاركة فى سردية الخطاب، ولعله اكتفى بعالم القرية كشريحة حياتية تفي بالغرض الذي من أجله كتب هذا الخطاب السردي. في «ثاباي» نشر الروائي شخوصه ليجعل منها نقوشًا ديباجية تتوزع في أدائها، وأدوارها، وتعبيرها عن مشاعرها. وتنامت الشخصيات في حيز الأحداث فأخذت «مومبي» حيزًا من تنامي الأحداث، وهي أخت «كيهيكا» ومحط أنظار واهتمام «موجو» و«جيكونيو» و«جرانكا»، وقد فاز «جيوكونو» بالزواج منها. «جرانكا» هو الوجه القبيح للرجل الأفريقى المنافق الذي فضل النظر إلى مصالحه ومكاسبه الشخصية إلى التعاون مع المستعمر لكي يكسب شارة مختار القرية ومن خلالها يحقق مآربه التي كانت واحدة منها الاستحواذ على «مومبي» وقد تحقق له ذلك.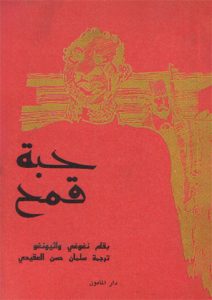
يجسد الكاتب في ثيمة الخطاب الروائي تكريس حالات كثيرة من الخيانات التى تأتي من المقربين، والذين يعتقد المرء أنهم ثوريون، وشخصية «موجو» تكاد تفصح عن نفسها في بعض مشاهد النص، تمامًا كما فعل «بروتس» مع قيصر يوم وضع يده مع أيدي الغادرين وغرز خنجره في ظهر القيصر بينما كان الأخير يوليه ثقته ويضعه في خانة المقربين، من الشخصيات التي أخذت مساحة كبيرة داخل نسيج الرواية «جيكونيو» وهو من الشخصيات المهمة في حركية الأحداث وتناميها، فهو عامل نجار ويبتدي في النص كرمز لطاقة التقنية التى تؤسس أحد أعمدة الكفاح ومحفز قوى لعملية النضال ضد المستعمر. ولعل العلاقة التي كانت تربط «موجو» بـرفيق صباه وأبن قريته «كيهيكا» هي علاقة ملتبسة، وقد ظهرت هذه العلاقة التي توضح علاقة «موجو» بأبناء وطنه حين طلب منه «كيهيكا» أن ينضم إلى جماعات «الماو ماو» المناهضة للمستعمر، ولكن «موجو» يسدد ضربة قوية لصديقه «كيهيكا» بأن يبلغ عنه مدير الشرطة «تومبسون» ويعلمه بحادثة الاغتيال المسجلة بأسم مجهول، ويدلي باسم «كيهيكا» كفاعل للحدث.
في الجانب الآخر من تاريخ الوطن وحركية النشاط السياسي والاجتماعي ثمة من خسروا شيئًا ثمينًا جراء الاستقلال، وندموا كثيرًا عما حصل لهم وتحسروا على أيامهم الماضية التي كانوا فيها أصحاب اليد العليا، والقابضين على السلطة في البلاد، فإذا هم الآن يعيشون على حسرة الفقد، من هؤلاء مفتش الشرطة «توماس تومبسون» الصورة الأخرى المثلى التي رسمها الروائي للغازي وهو يمارس ساديته. وكان يعرف بـ«توم المرعب»: «اتبع الكاتب تكنيكا يخلو من الانسيابية في تسلسل الأحداث والزمان، ففي الوقت الذي يأخذ السرد طريقه في قص حدث أو تسليط ضوء على موقف ينتقل الكاتب بأسلوب منعطف إلى حدث آخر جديد يأخذ حيزًا أكبر من مساحة السرد. ثم يعود متراجعًا إلى الحدث الأول فيتمه، مما يترك انطباعًا لدى المتلقي أن صانع الخطاب السردي إنما أغواه في جره إلى موقف لم يخطر على باله. هذا الانتقال السردي في الأحداث يتكرر مرارًا، ويسير في إيقاع هادئ لا توجد فيه انعطافة خارقة أو انتقال صادم. الرواية بسعتها الخطابية تتيحل مثل هكذا انتقالات على عكس القصة القصيرة التي هي جنس سردي أيضًا حيث فيها الانتقال إلى حدث آخر بطريقة صادمة، وتقطيع حاد بحيث يمكن استشفاف التحول من أول عبارة أو استهلال كمدخل».(5)
وكما عبرت رواية (تويجات الدم) عن استغلال النفوذ وسرقة الثروات في كينيا قبل الاستقلال، جسد واثيونجو في روايته (شيطان على الصليب) نفس التيمة الخاصة بمحاولة سرقة ثروات كينيا بعد الاستقلال، وكيف تحولت إلى مطمح للرأسمالية العالمية، وأرضًا خصبة لمجموعة من اللصوص المحليين، انتقدت فيها الرواية الرأسمالية، والاستعمار القديم الذي خلّف نظامًا استثماريًا فاسدًا انسحب فساده على الناحية الاجتماعية في كينيا. وتعتبر (الشيطان على الصليب) أحد أهم الروايات في الأدب الأفريقي التي تنتقد الرأسمالية بشكل مباشر، وتهاجم الاستعمار القديم، وتدين عملاء الرأسمالية من أبناء الوطن، وقد كتبها واثيونجو على ورق التواليت أثناء اعتقاله في نهاية عام 1977، بعد عرض مسرحيته المثيرة للجدل (سأتزوج عندما أريد) وسجنه بسببها. والمتابع لأعمال نجوجي واثيونجو يجد في جميع أعماله، إنه يمكن استخدام الأدب لتفكيك الاضطهاد، يجب أن يكتب الأعمال الإبداعية التي تمس إشكاليات الواقع المستهدف، ولهذا كتب (شيطان على الصليب) وجميع أعماله اللاحقة بلغة وطنه العامية التي يريد بها الوصول إليهم وهي لغة (كيوكيو)، ويشكل الرمز في هذه الرواية بعدًا فاعلاً في أحداثها من خلال “وارينجا” الفتاة الكينية الشابة التي كانت تعيش في قرية بسيطة لها طموحاتها الخاصة أن تكمل تعليمها الجامعي وتصبح مهندسة، لكن تعرض والدها للسجن بسبب انضمامه للمقاومة، وتضطر “وارينجا” أن تعيش مع عمتها، وكان زوج عمتها من الوصوليين المنضمين إلى طغمة المستعمر، فيتوطأ لتعمل عند أحد الأغنياء ليتكسب من خلالها، وتقيم مع الغنى علاقة غير شرعية تنتهى بالحمل، ويتنكر لها هذا الغني العجوز، وتترك طفلها مع والديها، وتستقل السيارة للذهاب إلى نيروبي بعد أن تخلى عنها الجميع حتى الرجل الذى كانت تأمل في حياتها معه، وفى السيارة تتعرف على بعض النماذج من الشباب، منهم أحد العمال المقهورين، وأستاذ جامعي تعلم في أمريكا ولكنه متشبث بثقافته الكينية وتراث بلده ويرتبط بالفتاة “وارينجا” ويخوض معها بعض التجارب ليكتشف القارئ في النهاية أنه ابن ذلك العجوز الذي تخلى عنها. الرواية في أحداثها رغم أنها مباشرة إلا أنها تحرض على نبذ الاستغلال والطبقية وعلى رفض الظلم الاجتماعي والاقتصادي الذي لحق بكينيا وبكثير من بلدان إفريقيا والعالم الثالث، تتسم الرواية بالشاعرية في أحداثها وحواراتها ويستعين الكاتب بأمثال كثيرة من البيئة الكينية والأنثروبولوجي المرتبط بالحياة فيها.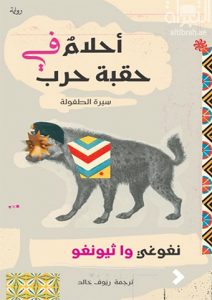
(تصفية استعمار العقل) والفافونية
في كتابه (تصفية استعمار العقل) حقق جونجي واثيونجو خلاصة ما كان يريد إنجازه على مستوى مسيرته الإبداعية فقد أورد في هذا الكتّاب الذي قام بترجمته الشاعر العراقي سعدي يوسف وصدر عن دار التكوين عام 2011 ملامح عالمه ومسيرته التي عانى من أجلها كثيرًا: «لقد كانت معظم الإشكالات الراهنة لأفريقيا لم تأت في الغالب بسبب اختيار شخصي، بل هي نتيجة وضع تاريخي، كما أن الحلول التي كانت مرتبطة بها أيضًا ليست مسألة قرار شخصي بل هو تحّول اجتماعي أساسي لبني مجتمعاتنا يبدأ من قطيعة حقيقية مع الاستعمار وحلفائه من الحكام المحليين. إن الإمبريالية وحلفاءها الكومبرادوريين لن يستطيعوا، تطوير أفريقيا، أبدًا، أنا أنتقد في هذه المقالات، الخيار الأفرو- أوروبي، أو (الأرور- أفريقي) لممارستنا اللغوية، ولا أنتقص من موهبة وعبقرية أولئك الذين كتبوا بالإنجليزية، أو الفرنسية أو البرتغالية.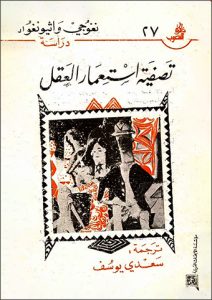
وعلى الضد من هذا أنا أرثو وضعا نيو- كولونياليا، معناه أن البورجوازية الأوروبية، تسرق، من جديد، مواهبنا وعبقرياتنا، كما سرقوا اقتصادنا. في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، سرقت أوروبا الكنوز الفنية من أفريقيا لتزيّن بيوتهم ومتاحفهم، وفي القرن العشرين استحوذت على الثروات العقلية الأفريقية لتثرى لغتها وثقافتها. إن أفريقيا تريد أن تسترد اقتصادها، سياستها، ثقافتها، لغاتها، وكتّابها الوطنيين جميعًا»(6) وفى بيان له: «في سنة 1977 نشرت (تويجات الدم) وقلت وداعًا للغة الإنجليزية، واسطة لكتابة مسرحياتي، ورواياتي، وقصصي القصيرة. فكل كتاباتي اللاحقة كتبت مباشرة بلغة الـ (كيكويو): روايتاي: (شيطان على الصليب)، و(ماتيغارى ما نيجرونغي)، ومسرحيتاي: (نغاهيكا ندندا) (سأتزوج حين أشاء)، و(مايتو نجوغيرا) (غني لي يا أمي)، وكتب الأطفال: (نجامبا نيني نامباتي أي ماتاجو)، و(باثيتورا يا جامبا نيني)، و(نجامبا نيني نا سيبو كنغانجي)، مع هذا، استمررت في كتابة نثر تفسيري بالإنجليزية. وهكذا أصدر بالإنجليزية: (يوميات كاتب في السجن)، (الكتّاب في السياسة)، (ماسورة قلم)، أما هذا الكتاب (تصفية استعمار العقل) فهو وداعي الأخير للإنجليزية بوصفها واسطة لأي من كتاباتي».
ومنذ الآن سأستخدم (الكيوكويو والكى- سواحلية) دوما. إلا أني آمل، من خلال أداة الترجمة العتيقة، في أن أتمكن من متابعة الحوار مع الجميع.(7)
ويستطرد واثيونجو في مقدمة الكتاب فيقول: «ظلت دراسة الحقائق الأفريقية، لوقت طويل، ينظر إليها من خلال شروط القبائل. مهما حدث في كينيا، أوغندا، مالاوي، إن مردّه أن القبيلة (أ) ضد القبيلة (ب). وكلما اندلع مندلع في زائير، نيجيريا، ليبّريا، زامبيا، كان السبب العداء التقليدي بين القبيلة (ج) والقبيلة (د). والتنويع في التفسير المبتذل يتم أيضًا بأن يوضع المسلم ضد المسيحي، أو الكاثوليكي ضد البروتستانتي، حيث يصعب تصنيف الناس في «قبائل». حتى الأدب نفسه يجري تقويمه، أحيانًا، بموجب الأصول «القبليين» لشخصيات هذه الرواية أو تلك المسرحية». هذا التفسير المبتذل للحقائق الإفريقية شجعّه الغربي الذي يريد أن يزيغ الناس عن رؤية أن الاستعمار ما يزال السبب الأساسي للعديد من معضلات أفريقيا. وقد وقع، لسوء الحظ، عدد من المثقفين الأفارقة ضحايا لهذه الخطة، وإلى الحد لم يعد فيه بعضهم قادرًا على الشفاء، ولا على معرفة الأصول الاستعمارية ذات قاعدة «فرق تسد» في تفسير الاختلافات الثقافية والصدامات السياسية تفسيرًا يستند إلى الأصول الإثنية للمختلفين. لا رجل أو امرأة بمقدورهما اختيار قوميتهما البيولوجية، ولا يمكن تفسير الصراعات بين الشعوب على أساس الثوابت. وإلا فإن المشكلات التي تنشأ بين أي شعبين، ستظل هي هي، في كل مكان وزمان، والأكثر من ذلك أنه لا يمكن التوصل إلى أي حل للصراعات الاجتماعية إلا من خلال تغيير في ما هو ثابت، مثلاً: من خلال تحّول ورائي أو بيولوجي للمتصارعين».(8)
وحول الحقائق الثابتة يستكمل واثيونجو رؤيته تجاه الكولونيالية الثقافية السائدة فيقول: «سأنظر إلى الحقائق الأفريقية، كما هي، المتأثرة بالصراع الكبير بين قوتين متضادتين في أفريقيا اليوم: تراث استعماري من ناحية، وتراث مقاوم من الناحية الأخرى. التراث الاستعماري في أفريقيا اليوم تحافظ عليه البورجوازية العالمية مستخدمة الشركات متعددة الجنسيات، وبالطبع الطبقات الحاكمة الملوّحة بالعلم الوطني، وتنعكس التبعية الاقتصادية والسياسية لهذه البورجوازية الإفريقية النيو- كولونيالية، في ثقافتها، ثقافة القردية والببغاوية، المفروضة على شعب متململ، بجزمات الشرطة، والأسلاك الشائكة، ورجال الدين والقضاة ذوي العباءات الفضفاضة، أما نشر أفكارهم فيقوم به جهاز من مثقفي الدولة، وكذلك الأكاديميون والصحافيون المقربون من المؤسسة النيو- كولونياية. أما (التراث المقاوم) فينهض به الشغيلة (الفلاحون والبلوريتاريا) بمساعدة الطلبة الوطنيين، والمثقفين (أكاديميين وغير أكاديميين)، والجنود، والعناصر التقديمة الأخرى من الطبقة المتوسطة الصغيرة. هذه المقاومة تتجلى في دفاعهم الوطني عن الجذور الفلاحية – العمالية للثقافات الوطنية، وفى دفاعهم عن النضال الديموقراطي لكل القوميات التي تسكن المنطقة ذاتها، وكل ضربة توجه إلى الاستعمار، مهما كانت الأصول الأثنية والمحلية للضربة، فإنها انتصار لكل العناصر المناهضة للاستعمار في القوميات كلها. وتكون الحصيلة النهائية لكل هذه الضربات، مهما كان وزنها وحجمها ونطاقها ومكانها وزمانها، هي التي تشكل التراث الوطني».(9)
الإحالات:
1 – المنفى المزدوج.. الكتابة في إفريقيا والهند الغربية بين ثقافتين، كاريث كريفتس، ت محمد درويش، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 1987 ص33
2 – الخيارات اللغوية كبداية لثورة فكرية، خالد كساب محايد، العرب، لندن، 9/12/2006
3 – حوار مع جوجي واثيونجو ملحق جريدة عمان.. شرفات، ع 590/591، 9/10 مايو 2017
4 – ما الأدب الأفريقي..؟! دراسة تحليلية، دافيد كوك، ترجمة هدى كيلاني، منشورات وزارة الثقافة السورية، دمشق، 1985 ص156
5 – المنفى المزدوج.. الكتابة في أفريقيا والهند الغربية بين ثقافتين، مصدر سابق ص 27
6 – تصفية استعمار العقل، نغوجي واثيونجو، ت سعدى يوسف، دار التكوي، بغداد، 2011 ص12
7 – المصدر السابق ص 13/14
8 – المصدر السابق ص 15/16
9 – المصدر السابق ص 16/17
عدد التحميلات: 2





