
ملامح من متخيّل الهجرة في الرّواية العربيّة والإفريقيّة من مبدأ المثاقفة إلى مبدأ المناكفة
«نحن جميعا مهاجرون بكيفية ما، والذي يتغيّر بيننا هو فقط مسقط الرّأس»
حكمة فرنسيّة
ما من شكّ في أنّ موضوع الهجرة قد شرع في الآونة الأخيرة، في استقطاب المزيد من الانتباه والاهتمام من لدُن الدّارسين المنشغلين بمختلف مجالات الفكر والمعرفة الإنسانيّين، بالنّظر إلى ما صار يهيمن على المشهد الإعلاميّ العامّ من وقائع وأحداث دراميّة، يكون ضحيتها في العادة بعض المهاجرين، هنا وهناك. لكنّ المتأمّل في موضوعة الهجرة، بوصفها حركةَ انفصال قد تأتي على نحو إمّا تلقائيّ وطوعيّ، أو ربّما تفرضها ثلّة متكاملة من الظّروف الاضطراريّة، من قبيل ما يُكره البعض على الابتعاد عن الأهل قسرًا، والنّزوح خارج الرّبع ومرتع الصّبا والشّباب، سيلفي بأنّ الهجرة ظلّت وما تزال أحد البواعث التي هي بقدر ما تثري تجارب المرء، تخصب فكره ووجدانه وسعة رؤيته، بحكم ما تتيحه من فرص متنوّعة للاحتكاك بالغير، قصد تثوير المقدّرات وتطوير التّجارب. فكيف تعامل الأدب الحديث يا ترى، مع موضوع الهجرة؟ وما هي أهمّ سمات وملامح التّخييل الأدبي في الرّواية المعاصرة، التي اشتغلت على موضوع الهجرة السّرية واللاّشرعية بالذات؟ كلّ هذا أساسا وغيره هو ما تسعى هذه المقالة إلى ملامسته، من خلال مقاربة نموذجيْن روائيّين من ريبرتوار الرّواية المغاربيّة والأفريقية.
1) من نافل القول أنّ الهجرة قد بقيت، بصرف النّظر عن معضلاتها السّياسية والاجتماعيّة والثّقافية والنّفسية المركّبة، وما يعانيه المهاجرون ضمن شرطها القاسي باستمرار(1)، أحدَ المحفّزات التي ما فتئت تعمل على تحفيز آلية الخلق بمختلف تجلّياتها، لا سيما أنّ كلّ حركة ارتحال تنجرّ إلى الانفصال عن دائرة الألفة والأليف، عادة ما تردفها آليات ذهنيّة ونفسيّة مركّبة، تدفع المرء دفعًا إلى محاولة التقاط كافّة ما يقع له ومن حوله، وإلى تتبّع مستجدّ وضعه الأنطولوجيّ وسط فضاء لم يعد مألوفًا بالنّسبة إليه، بقدر ما صار غريبًا عنه غرابة تشحذ البصيرة، وتسهم في فتح الحواس على كلّ ما هو مستطرف يستحقّ ربّما أن يلتقط، وأن ويتمّ توثيقه وتدوينه. ولذلك، عادة ما تتحفّز الذّوات إلى تسجيل ما تعيشه/تعايشه، وربّما تنتابها الحاجة بعد ذلك إلى البوح بما يعتمل بقرارها، كلما اتّقدت بداخلها جذوة اللّوعة، والتهبت مشاعر الحنين والنّوستالجيا المتأصّلة في الكائن الإنساني(2)، الذي ما إن يغترب عن أهله وذويه، حتّى يذبّ إلى أعماقه شعور بالفقد، يجعله يعيش على الأقلّ في الفترة الأولى من اغترابه، موجة عارمة من التّصدع التي يختلّ فيها بعض توازنه النّفسي والوجدانيّ، فيسهم هذا في انسكان الدّواخل بشتّى الأحاسيس، التي تظلّ من أبرزها الرّغبة الملحّة في تجديد العهد بالرّبع المفتقد، لمحاولة الإقامة مجدّدًا بين حضنه، ولو تمّت هذه الإقامة بكيفية لغويّة/رمزيّة، مثلما تكشف لنا عن ذلك القصائد الشّعرية الكلاسيكيّة عامّة.
والملاحظ في هذا السّياق هو أنّ نوازع الشّوق والحنين، لم تقصر على الشّعراء القدامى وحسب، وإنّما انتابت رعيلًا كاملًا من الأدباء العرب المحدثين، خاصّة منهم الجيل الأول مثقّفي القرن العشرين، الذين اضطرّوا اضطرارًا إلى الابتعاد عن الأوطان، لاستكمال دراستهم في بلدان الغرب المختلفة، وهو الأمر الذي أخضعهم إلى تجرّع إكراه مثاقفة عنيفة، نجمتْ عن لقاء هؤلاء بالغرب المختلف ثقافةً وجغرافيًا؛ وهو اللّقاء الذي بقدر ما أثار في النّفوس والأذهان الدّهشة والإغراء، حرّك بعض مشاعر النّفور والازورار أيضًا، علاوة على أنّه أيقظ الإحساس الشّديد بالغربة، التي تأجّجت نيرانها بقوة، متّخذة هيئة إدراك حادّ بالفقد والنّقص، بفعل اختلاط مشاعر الأنفة الجريحة بمشاعر أخرى ترفع لواء التّحدي والتّصدي، التي لا يسعف في تسكين احتدادها سوى بلسم الكتابة، بوصفه استعادة رمزيّة لمسكن أنطولوجيّ، يُسكّن أوار الصّدمة. وفي هذا الصّدد، يقول محمد حسنين هيكل ضمن التّقديم، الذي وطّأ به روايته الشّهيرة (زينب)، التي تعدّ النّص الرّوائيّ الأول الفاتق لمسار هذا الجنس الأدبيّ، في الثّقافة العربيّة الحديثة: «… لقد بدأتُ كتابتها في أبريل سنة 1910، وفرغت منها في مارس سنة 1911، وكان حظُّ قسمٍ منها أنْ كُتِب بِلُنْدَره، كما كُتب قسمٌ آخر بجنيف… فأردت أن أستظهر على غلاف الرواية التي قدّمتها للجمهور، يومئذ… أنّ المصري الفلاح يشعر في أعماق نفسه بمكانته، وبما هو أهلٌ له… ولعلّ الحنينَ وحدَه هو الذي دفع بي لكتابة هذه القصّة. ولولا هذا الحنين ما خطّ قلمي فيها حرفًا، ولا رأتْ هي نور الوجود. فقد كنتُ في باريس طالب علمٍ، يومَ بدأتُ أكتبها”(3).
وهكذا نجد بأنّ الرّواية العربيّة قد تعاملت مع ثيمة الهجرة منذ لحظة تأسيسها، وإلى ما بعد مرحلة التّأصيل والتّجنيس المواليّة، بوصف موضوع النّزوح عن الوطن حافزًا يستحث الهمم على التّعبير، بدافع حنين النّازح واشتياقه تارة، ولباعث التّصدي والمنافحة على كلّ ما قد يلحقه في بلاد المهجر تارة أخرى، من أشكال التّحامل التي تقلّل من أصوله وامتداده الاجتماعيّ والحضاريّ؛ وهو ما وقع التّصدي له إبداعيًّا بالفعل، والاعتراض عليه وعلى كافّة أنماط السّحق والإقصاء المهدّدة لهوية الأديب العربيّ الأصيلة(4). وإلى جانب هذا، لا يفوتنا التّذكير بأنّ ثيمة الهجرة قد ظلّت تعكس كذلك، بوصفها اختيارًا إبداعيًّا، ذائقة فنّية تترجم ما حصل ضمن مرحلة ثقافيّة معينة من التّحولات السّوسيوثقافيّة، التي نجمت عن أشكال المثاقفة العنيفة بالغرب، سواء بعد حملة نابليون على مصر وعكّا مباشرة، أو من خلال فترات الاستعمار التي حصلت بعد ذلك؛ مثلما يتّضح ذلك من خلال النّصوص السّردية المتميّزة، التي احتفظت عليها مدونة السّرد العربيّ الحديث(5).
2) ورغم استثمار بعض الكُتّاب المغاربة لموضوع الهجرة، واعتمادهم لها كآليّة تخييليّة لتصفية الحساب مع جيل كامل من المثقّفين السّلفيين، بطموحاته وخيباته(6)، فإنّ الرّواية المغربيّة المكتوبة بالعربيّة لم تتعاط مع الهجرة، بنفس الإلحاح الأدبيّ والانشغال الثّقافي الّلذين بصما رديفتها في المشرق العربيّ، ووفق البرنامج السّردي خاصّة الذي طالما تشبّع بتحدّي المثاقفة. إلّا أنّ هذا لا يعني بأنّ ثيمة الهجرة ظلّت متغيّبة في النّصوص الرّوائية المغربيّة الأولى، وأنّ متخيّلها انعدم في مدونتها بصفة تامّة، وإنمّا المقصود من وراء هذه الإشارة التأكيد على أنّ لغة التّناول تغيّرت، كما تغيّرت زاوية النّظر معها أيضًا، ضمن هذه المدونة السّردية. لذلك، نجد بأنّ الرّواية المغربيّة المكتوبة بالفرنسيّة استطاعت منذ وقت سابق، أن تتعامل مع الهجرة بوصفها برنامجًا سرديًّا متكاملًا؛ وهو ما دعاها إلى الاستثمار في بعض الأوضاع السّوسيوثقافيّة التي يلقاها المهاجر في معيشه اليوميّ، سواء أكان متعلّمًا أم غير متعلّم، باعتبارها أوضاعًا تظلّ مسكونة بلوعة الاغتراب وآلام الابتعاد والفقد، على غرار ما سجّلته النّماذج المؤسّسة لرواية الهجرة في الثقافة الأفريقيّة(7).
وقد أسهم هذا في خلق تراكم لا يستهان به على النّحو الكمّي والنّوعي، طال نصوصًا سرديّة مغاربيّة، تصدّى أصحابها لموضوعة الهجرة، بإغراءاتها ومحنها المتنوّعة. ومن ثمّ، أسهم هذا التّراكم في خلق تيّار سرديّ، ظهر للوجود منذ العقد الثّامن من القرن الماضي، أطلقتْ عليه الأدبيّات النّقدية اسم أدب الضّاحية المهجّنla littérature de Beur. والأمر هنا يتعلّق بتيار أدبيّ سرعان ما شبّ عن الطّوق، وانتشر بين ممثلي الرّعيل الثّاني والثّالث من المهاجرين المغاربيّين، سواء أولئك الذين يتواجدون بفرنسا، أو الذين نشأوا ببلجيكا وهولاندا وغيرهما. وما يميّز هذا الأدب الرّوائي كونه يتناول واقع الهجرة ومعيشها من الدّاخل، تناولًا يكاد يتشابه في مقاربته السّردية بين مختلف صوره، على الرّغم من أنّ الكتابة بالفرنسيّة هي ما يغلب عليه(8).
لكن مع توالي العِقد التّاسع وما بعده، وهي الفترة الزّمنية التي عرفت فيها بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسّط تعقّد الأحوال عامّة، نجم عن امتداد فترات الجفاف لأكثر من فصل، تسبّب في ذيوع أنماط البطالة والبؤس في البوادي والمدن، إلى جانب الحروب الأهليّة التي استعرّ أوارها في العديد من الأقطار الإفريقيّة، وما ترافق معها من ترحيل اضطراريّ، وإغراء بالهجرة إلى أبعد من دوائر الموت والمجاعة، وعلى الأخصّ إلى أوروبّا التي شجّع على اختراق حدودها سقوط جدار برلين، وإغراءات العولمة التي عمّمت أشكال الرّفاهية والرّخاء؛ فإنّ موضوعة الهجرة قد تحوّلت مع كلّ هذا، من مجرد ذريعة لرسم تخطيطات الآلام النّاجمة عن ضغط الغربة، مثلما عهدناها في أعمال الرّوائيين البارزين في المشرق العربيّ، ومن مجرد تعلّة أدبيّة لسرد وقائع الضّيم والانسحاق التي يكابدها المغترب، أو حتّى مجرد باعث نفسيّ للتّعبير عن لوعة التّعلق بأرض الأجداد، مع ما يقتضيه ذلك من تحقيق عودة رمزيّة للاتّصال بالأصل، وإنّما غدت هذه الموضوعة ـ مع تطوّر المستوى التّعليمي للمهاجرين، وتوسيع عملية النّشر على أكبر نطاق بين الأقلام الشّابة في البلدان المغاربيّة، أو البلدان الأفريقيّة ـ إلى مادّة مغرية للكتابة، يرصد فيها الرّوائي الوقائع الحقيقيّة أو المتخيّلة، التي أغرت بعض الحالمين بالإقدام علة مغامرة النّزوح لتحقيق حياة أفضل، في لحظة تعمّمت فيها المشاهد والاستعارات المُسْقِطة للحدود والجدران، حتى ولو كان ذلك النّزوح شأنًا يخرق كافّة القوانين والشّرائع التي تحمي بها بلدان الشّمال مجالها الخاصّ. وقد حذا هذا بثلّة من معذّبي الأرض في الجنوب، إلى ركوب صهوة المجاسرة الخطرة عن سبق إصرار، والخروج في رحلات سريّة غير مأمونة، تنشدّ بوصلتها صوب إيلدورادور eldorador جديد: بلدان شمال البحر الأبيض المتوسط.
ولهذا، نشأت في هذه المرحلة بالذات، كتابة سرديّة جديدة راوحت محكياتها بين التّخييل الرّوائيّ وعمليات التّوثيق والتّسجيل، التي تحاكي تارة شكل الرّيبورتاج، وتارة أخرى أنماط الرّحلة وكتابة اليوميات. وقد اتّسمت هذه الكتابة بهيمنة محكي الهجرة، خاصّة ما سُمّي بالهجرة السّرية التي يسلك أصحابها طريق البحر، للعبور بشكل مخاتل ومحفوف دومًا بالمخاطر، بغية الانفصال عن جغرافية الفقر والجفاف والضّياع والحروب الأهليّة، والإتّصال بموطن الآمال التي تحرّكها صور الأمن والأمان والوفرة، مثلما تتمثّلها الأذهان والمخيلات، ويتمّ التّعبير عنها في الكتابات السّردية، التي ذاع صيتها بالمغرب مع حلول الألفية الجديدة(9). فكيف يتمّ التّعبير عن كلّ هذا في الرّواية المغربيّة والأفريقيّة؟ وما دلالات ذلك والمرامي المرجوة من ورائه؟
3) وحتى تتمّ لنا مقاربة ثيمة الهجرة ضمن بعض النّماذج التمثيليّة، التي تنتمي إلى متخيّل الضّفة الجنوبيّة من البحر الأبيض المتوسّط، وقع اختيارنا على عملين رائديّن، صدرا معًا في بداية هذه الألفية الثالثة، وكلّ منهما يدخل ضمن صنف الكتابة السّرديّة المعاصرة. ويتعلّق الأمر هنا برواية الكاتب المغربي يوسف فاضل: (حشيش)(10)، ورواية الكاتبة السّينغالية فاتو ادْيوم Fatou Diome، التي تحمل عنوان: (بطن الأطلنتيك)11). ينتمي النّص الأول إلى حقل الأدب المغربيّ المكتوب بالعربيّة، بينما الثاني فيتّصل بالأدب الأفريقي المكتوب بالفرنسيّة. وإذا كان العملان يختلفان فيما بينهما في بعض التّفاصيل والجزئيات الفارقة(12)، فإنّهما يشتركان على الرّغم من ذلك في قواسم وتفاصيل متنوّعة، بمستطاعنا أن نذكر منها إلى جانب الانتماء إلى نفس الجنس الأدبيّ (= الرّواية)، ارتباط المؤلّفَيْن معا بمتخيّل قارّي واحد (= أفريقيا)، إلى جانب انتسابهما إلى إطار سوسيوثقافيّ تؤثّث مرجعيته بشكل عامّ، همومُ وشجون المستعمرتين الفرنسيتين السّابقتين اللّتين تؤطّران فضاء النّص التّخييلي، وأقصد المغرب والسّينغال. وعلاوة على ذلك، يتفرّد هذان النّصان بإسنادهما لدور البطولة الرّئيسي للأنثى: شخصية مريم في (حشيش)، وسالي Salie في (بطن الأطلنتيك). كما أنّ هاتين الرّوايتين تشتغلان كذلك على ثيمة مشتركة، وهي الهجرة السّرية بمجموع تداعياتها الذّهنية والنّفسية والاجتماعيّة. فماذا يحكيه هذان المؤلفان؟ وكيف يتمّ تقديم ذلك، إذن؟
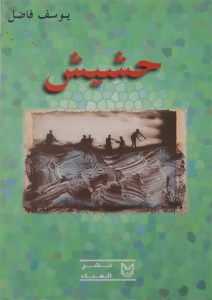
4) تروي حشيش كما رواية بطن الأطلنتيك، حكاية رغبة مستعرة تنشدّ بجموحها المندفع إلى إيلدورادو جديد، يقع هذه المرّة في القارة الأوروبيّة (= اسبانيا/فرنسا)؛ وهي رغبة تعلن عن نفسها ضمن مسار الحكاية في الروايتين، فتتّخذ شكل حُمى عارمة، تدفع بالشّخصيتين الرّئيسيتين إلى رفع التحدي، وتجريب بعض سبل المغامرة المحفوفة بالمخاطر، للالتحاق بالأرض المأمولة. وإذا كانت هذه الرغبة هي القاسم المؤطّر للعملين معًا، فإن اشتراكهما في ذلك لا يلغي تواجد بعض اختلافات الجوهريّة التي تفصل بينهما، خاصّةً في النّهاية المقترحة من لدن كل كاتب. فبينما يُصوّر يوسف فاضل الاندفاع المحموم الذي يسكن البطلة مريم، وإصرارها الثابت على خوض غمار الهجرة للمرّة الثالثة بطريقة سرّية ومخاتلة، وهو الإصرار الذي يبرّر اختيارها للإقامة بشمال المغرب، وربط شبكة علاقات موسعة مع ثلّة من الأهالي ورجال السّلطة، في أفق التّمكن من تجريب الحظ في ركوب البحر من جديد، رفقة فيلق هجين من المهاجرين السرّيين؛ فإنّ فاتو ادْيوم تكتفي باستثمار الرّغبة التي يعلن عنها أخو البطلة سالي (المثقفة المقيمة بمفردها في الديار الفرنسية)، وهو المدعو ماديكي Madické المغرم بلعبة كرة القدم حدّ الجنون، والمتولّه بشخصية اللاعب الايطالي مالديني Maldini، والذي يحلم بأن يحتضنه نادٍ من الأندية الرّياضية الفرنسيّة، كما حصل مع باقي اللّاعبين الأفارقة الكبار، الذين تمكّنوا من الاستقرار النّهائي في الضّفة الشّمالية للبحر الأبيض المتوسّط. لكن هذه الرغبة ـ على الرّغم من كونها تبدو ملحة ومستعرة في مسار الرواية ـ سرعان ما تخبو شيئًا فشيئًا، وتتقلّص بفعل بعض التنويعات الحكائية المتضمنة في النّص. ومن ثمّ، تخفّ جذوتها بصفة نهائية، في الوضعية التي يختتم بها النص محكيه.
ورغم هذا الفارق الجوهري، فإن كلا العملين الأدبيين يشترك مع غيره في عناصر ثيميّة، تندغم جميعها في ما يمكن وسمه بمتخيل الهجرة الرّوائي في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسّط. ومن هذه العناصر، نذكر ما يلي:
أ ـ أنّ المهاجر (سواء أكان مهاجرًا بالقوة أو الفعل)، يصوّر شرطَه الإنسانيّ العامّ في وطنه على أنه وضع ضحية، تتكالب عليها شتّى الظروف والصروف القاسية، وتكبّلها آثام أصلية لا يد للضّحية فيها ولا رِجل. ومع ذلك، فإنّها تضطر إلى مكابدة تبعات تلك الشّروط المجحفة، وتجرّع آلامها الموجعة. وبذلك، تصبح هذه الصورة دراميّة أكثر، حين يكون المقبل على الهجرة أنثى، حاقت بها الخطيئة الآثمة فوق أرض لا تتسامح مع الآثمين، ولا تتوسّل الأعذار لتبرئة ساحة المخطئين، حتى ولو كانوا مجرد صبايا وصبيان، فتحوا أعينهم على هذا العالم وهو يردّدون مع الأعمى الحكيم أبي العلاء المعري: هذا جناه أبي عليّ! ولا يهم أن يكون هذا الأب والدًا حقيقيًّا في أسرة صغيرة محدودة الأفراد، أو مجرد سيّد مشغّل في ورشة أو ببيت، أو أبًا رمزيًا لأمّة كبرى يفرض عليها استبداده وأنانيته المتغطرسة، بينما الجميع يعمه في البؤس والجهل والشقاء. وتظل صورة هؤلاء الآباء المتنوعة ثابتة، تتكرّر ضمن كثير من المحطات والمواقف الرّوائية، سواء في نصّ (حشيش) أو (بطن الأطلنتيك). فسالي الابنة اللّقيطة تقول مثلًا، وهي تستعرض الأسبابَ التي أفضت بها إلى الخروج، مبتعدة عن أسرتها وعشيرتها في نيوديور Niodior: «لقد كبرتُ، وأنا أشعر دومًا بعقدة ذنب متأصلة في كياني. كما كنت ألحّ كذلك، وبوعي منّي، على ضرورة التّكفير عن هذه الخطيئة، التي هي حياتي، أنا بالذات. ذلك أنّي حين منتُ أغضّ الطرف أمام العابرين من حولي، فإنّي ما كنت أحاول سوى البحث بالضّبط، عن كيفية من الكيفيات لإخفاء كامل كياني عنهم… إنّ البلاد البعيدة لتجتذبني، ما دام أنّ أهلُها لا يحاكمونني ـ أنا هذه العذراء بتاريخها ـ عن تلك الخطايا، التي قضى بها عليّ القدر..»(ص226).

وإذا كان هذا حال سالي، الذي يشبه تقريبًا حال مولود سانكيل Sankéle، الفتاة العذراء التي أغوى بها المعلم النّقابي نديتار Ndétare، وملأ أشاءها بمضغة بريئة، سرعان ما وئدتْ حالما ولدتْ، لخوف والد سانكيل من امتداد رائحة الفضيحة بين أهالي نيوديور، ممّا اضطرها إلى هجر الكلّ، والضرب بعيدًا في أرض التيه والضياع والتشرد، هروباً من بلاد الهتك والهتيكة والفتك؛ فإن مريم في رواية (حشيش) ليوسف فاضل، لتلمّح من ضمن ما تلوّح به، بخصوص الدّواعي التي جعلتها أكثر تمسّكا بالهجرة، إلى اعتداء زوج مشغّلتها ذات الأساور الذهبية (كما تلقبها الرواية!) على عرضها، وهو ما حدا بها إلى ترك الأرض، التي عاشت فيها مأساة الافتضاض وراءها، والانخراط في رحلة سرّية محفوفة بالمجازفة فوق شفير البحر.
ب ـ وإلى جانب هذا العنصر التّخييلي في الرّوايتين، نلاحظ كذلك بأنّ دالّ البحر يحاط من زاوية متخيل الهجرة، بكوكبة متنوعة من التمثلات والتصورات القيمية التي يعارض بعضُها بعضًا، سواء لحظة اقتراب موعد مغامرة الإبحار، أو أثناء اللحظة التي تأتي بعدها. ولا يفوتني أن أنوه إلى أنّ الباحث المغربي الكبير الأستاذ عبدالله مدغري علوي، قد سبق له الكشف عن عناصر من هذا الدّال المراوغ، في دراسة شيّقة له حول موضوع البحر والمهاجر السّري، سنحاول ألّا نكرّر معطياتها في هذه الورقة، على الرّغم من استفادتنا النّسبية منها(13).
ففضاء البحر من زاوية الهجرة، يقترن دوما بمدلول العبور والاجتياز. لكنّه من زاوية الهجرة السّرية يبقى فضاءً متمنّعا ومتأبّها لا يطاوع رغبة المهاجر، بل ويتحدّاها بالموت. ولذلك، فهو فضاء البين بين، لأنه بقدر ما يستجمع حوله من مشاعر وآمال فياضة، بقدر ما تنقلب شحنة الوجدانيات التّواقة والمتطلّعة إلى الانعتاق، إلى مشاعر القنوط واليأس والخيبة، فيشبه انقلاب حالها المتموج والمتلاطم انقلاب موج البحر تمامًا. ويظهر تباين هذه المشاعر والوجدانات بحدّة لدى شخصيات الرّواية، كلما فكرت هذه في جغرافية توقها أو إحباطها المحدّدين بمرجعية البحر الأبيض الأبيض المتوسّط وحسب: جنوبه أو شماله. فخلف هذا البحر، تمتدّ من جهة الجنوب صحراء موبوءة، كلّ مَن دخلها موءود/مفقود، وكلّ مَن خرج منها منبعث/مولود. إنها جهة من العالم المنذورة للشقاء والتعاسة، حيث لا يطبع أبناءها غير الضياع والموت المادي والرّمزي. أما الجهة الشمال لضفّة البحر، فثمّة جنّةُ عدنٍ تجري من فوقها أنهار الحياة الخالدة. إنها قطعة من الأرض التي تنبعث لها الآمال، وينشدّ إليها الرجاء. عالم حيّ وحفيّ بشتى الاستيهامات التي تدور حول محور السّعادة والولادة المتجدّدة، التي لا تعرف الشّقاء ولا الضّياع. تقول مريم في رواية (حشيش)، وهي تستشعر حِراكها فوق هذا الصراط الحادِّ، حيث الهنا والهناك موزعيْن على رحلة الموت والانسحاق أو الولادة والانبعاث: «لم أتجاوز العشرين عاماً، ولم أعرف خلالها ولو قسطًا ممّا يجعل الحياة هنية. أسير الآن على هذا الشفير ما بين الحياة والموت، موت أعانيه، أحبل به، وما بين حياة أنتظرها، كما يُنتظر البعث».
إن هذه الحياة التي ينتظَر تحقُّقُها في صورة بعثٍ مستحقّ هناك، في البلاد التي تقع في الجهة الشّمالية من البحر الأبيض المتوسّط، كما تعلّل بها مريم ذاتها، وهي تنتظر، وتُحتَضر شيئًا فشيئاً، تعيشها سالي نفسها في رواية فاتو ادْيوم من خلف البحر كذلك، وهي تكيل المديح والقريظ للبلاد البعيدة التي اجتذبتها. تقول: «… إنها (= فرنسا) بالنسبة لي ضمانةُ الحريةِ والاستقلال الذاتي. فأن تقدم على الذهاب إلى هناك، معناه أن تملك كل مظاهر الشجاعة الممكنة، لتساعد نفسك على أن تولد من داخلك، وعلى أن يخرج منك الفرد تلقائيّا لمواجهة الحياة، وبالطريقة الأكثر شرعية ممكنة لدى كافة الولادات الممكنة” (ص226).
لكن ينبغي لنا أن نسجّل في هذا السياق، بأن قارئ رواية (بطن الأطلنتيك) سيلفي ولا شك، تنويعًا مميزًا على خلفية هذه الصورة المتمثلة لصراط البحر، حيث لا يُحقّق البحر ها هنا أي ربط يذكر بين جنوب مؤلم وشمال مأمول، وإنما يغدو بطنًا أموميًا يمتد ويتمدّد إلى ما لانهاية، ليضم إليه ـ بحنو ورأفة بالغين ـ كلّ اليائسين والبائسين والمحبطين في عالم بطريركي قاس، لينقلهم برغبة منهم وطواعية إلى كينونة أمومية أخرى، يمكنها أن تكون بديلًا عن عالم الظلم والجور والقسوة. فموسى الذي ولد فقيرًا في أسرة متعددة الأفراد، جرّب الهجرة من خلال الالتحاق بأندية فرنسية، لكنه لم يجد هناك أيّ مخرج لأزمته، كما أنّه لم يعثر على أيّ خلاص لانتكاسته وخيبته، فخاض رحلة البحث عن بطن أوسع من بطن أمه وعشيرته وذويه، وأفسح من نيوديور والسينغال وفرنسا برمّها، متّبعا صوت البحر الذي نراه يبوح له، بما يعتور في قراره قائلًا: «أيها المحيط الأطلنتي، خذني إليك. بطنك الموّار سيغدو وديعًا ولطيفًا لأجلي. فقد سمعت من الحكايات القديمة بأنّك تأوي كلَّ من التمس أن يلوذ بك» (ص111).
ج ـ ولأن البحر هو هذا الصراط الممكن، الذي لا صراط غيره، والرّابط بين ضفة الموت الرّمزي وضفة الانبعاث، فهو بهذا يعدي كلّ مَن سوّلت له نفسه تجريب مغامرة السّير فوقه، بحيث لا يقوى كل من أصابته العدوى، أن يُعدّيَ عنه بعدها. إنه يصبح بمثابة البلوى والابتلاء. إنه حشيش مخدّر أخْدَر، مثلما يومئ إلى ذلك عنوان رواية يوسف فاضل، كل من شرب من دخانه، سرت في دمائه العدوى العُدَواء، فلا يجد عن ذلك فيما بعدُ، محيدًا أو حيادًا. تقول مريم التي جربت في الرواية مغامرة «الحريك» للمرة الثالثة: «واشْ نقدرْ نكونْ حتى أنا فرحانة شي نهارْ؟ أدرك فقط أنّ عصفورًا في حجم الإبهام، أفرد في دمي جناحيه. ومنذئذ لم أقو على الاستمرار جالسة أو واقفة أو ماشية. ومنذها لا يسعني وضع: ما أريد هو أن أجدني في إسبانيا» (ص36).
ي ـ إذا كانت أرض الهتك والشعور بالذنب تضيق بأبنائها، ما يدفع بهم إلى ركوب رؤوسهم وصراط البحر، قصد بلوغ أرض الآمال السّعيدة، فإن الوصول إلى ضفة الشمال الآمنة غير مضمون، ولا هو مأمون دومًا. إن صراط البحر لا يفضي بالضرورة إلى تحقيق تخلّق الفرد وولادته من جديد، حتى ولو أفنى سيئو الحظ أعمارهم في تجريب السير فوقه. فمريم مثلاً، التي تحاول الهجرة لثالث مرة بطريقة سرّية، لا يتضامن معها البحر أبدًا، ويعمل على ترجمة حلمها إلى واقع، وتوصيلها إلى البرّ العدَني سالمة غانمة، وإنما تتسلط عليها زبانية البحر الغلاظ الشداد، فيتصدون لها، ويمنعون عنها الاستمتاع بالنائلة المأمولة، بعد أن يغصِنون لذّاتِهم من جسدها، ويغتصبونها بشكل جماعيّ، ليقذفوا بها إلى الضفة التي جاءت منها، وقد صارد مجرد عصف مأكول وجسد مذلول.
ثم حتى هؤلاء الذين فازوا بظفر الوصول بكيفية قانونية إلى الضّفة الأخرى، واستقروا هناك بحرية وتلقائية، فإنّهم لم يحسّوا بالطمأنينة ولا بالسعادة الأسطوريتين أبدًا، وإنما ظلوا يشعرون بغربتهم وفقدهم، وأنّ حاجتهم الأنطولوجية ليست شأنًا مقضيًا. تقول سالي في إطار مونولوغ مشبع باللوعة الحزينة، بعد أن آلمتها أشكال العنصرية الصّادرة عن البوليس الفرنسي، على خلفية مشاعر الفرح التي أفصح عنها المواطنون السينغاليون في شوارع باريس، بعد فوز فريقهم الوطني في إحدى مباريات البطولة الأفريقية لسنة 2002: «اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، يتحتّم على هؤلاء المهاجرين، [الذين يحترفون كرة القدم بفرنسا]، ضرورة الصّدح بكل ما يعتور بدواخلهم، بكيفية واضحة وضوحًا تامًا… إني أحلم باجتماعات كبرى نعقدها نحن السنغاليين، لنحكي فيها عن ذلك الجزء المُرّ من حياتنا في فرنسا، بطريقة ليست فيها مراوغة ولا مخاتلة. لكم أرغب في أن يصف هؤلاء وأولئك لإخوانهم في الوطن/الأم، حقيقة السّراب الخُلابي الماكر الذي يلوح في أفق المهجر، ويوهم الناظرين إليه من بعيد بالانتصار! إني أرغب في أن يحكي هؤلاء وأولئك، كيف أنهم في غينغامب، ولينس، ولوريون، وموناكو، ومونبوليي، وسيدان، أو سوشو، حيث يحترفون كرة القدم، حيث نفس الجمهور الذي يصفق عليهم بعد ما يحرزون هدفًا من الأهداف، سرعان ما ينقلب عليهم ويصوّت عليهم كالقردة، ويقذفهم بأصابع الموز، ويسبّهم السّباب المقذع بوصفهم مجرد زنوج حقراء، حين يضيّعون فرصة ما، أو يسقطون أمام مرمى الخصم!» (ص247).
5) لماذا لا تَتَحقق آمال مريم وغيرها في (حشيش) إذن، ولا أحلام موسى الذي لم ينشق له البحر هذه المرة، كي يلطف به ويحميه من جور الحاكم الظالم، ولا أحلام سالي وغيرها في (بطن الأطلنتيك) من أبناء ضفة الجنوب، التي يسكنها الهتك والجوع والضّياع، سواء حين يقطعون صراط البحر بكيفية مشروعة، أو حين لا يُتاح لهم ذلك إلا في سرّية وبطريقة مخاتلة؟ ثم أين تكمن أسباب بلواهم وعلل شقائهم؟ أفي أسمائهم الغريبة، أم في سحنة وجوههم ولون بشرتهم وجلدتهم، أم في لغاتهم البربرية ذات النّبرة الانفجارية، أم في معتقداتهم وطقوسهم الدينية وعاداتهم الثقافية، أم في أحلامهم المغرقة في الأوهام؟
من غير المهم أن تمنحنا الرواية إجابات ضافية وشافية عن هذه الأسئلة، إذ ليس دور الروائي هو تقديم الإجابات، وإنّما يتوقف دوره عند حدّ إنتاج ما يسميه الرّوائي المكسيكي كارلوس فوينتيس بالمعرفة التّخييلية، وحسب. ومن ثمّ، لا ينبغي له أن يتعدّى ذلك الحدّ إلى تقديم أطاريح جاهزة، أو تسويغ مواقف ومشاريع فكرية ناجزة. وعليه، يمكننا القول بعد هذه السباحة العابرة لمتن الرّوايتين المذكورتين، بأنّ وضع المهاجر هو وضع البين بين، كما ما هو وضع البحر تمامًا. إنّه كائن يبقى مربوطًا إلى ضفتين: فلا هو ينتمي إلى موطنه الأصليّ، ولا هو يحتفي بالوطن الذي يختاره، ويصطفي الانتماء إليه بعد أن يجحد به الموطن الأصلي. إذ إن وطنه يدفعه دفع الموج نحو مشارف الانعتاق، ويلقي به على رصيف البحث عن معنى، يعتبره أحقّ لوجوده الناقص، لا يجده سوى بين تضاريس أرض الغرب الهلامية، التي يظل يتمثلها في خياله، ويتصورّها بكيفية أسطوريّة. بينما تدفعه عنها هذه الضّفة بالذات دفعًا غاشمًا عنها، بعد أن تغتصب شبابه، وتنزف ماءه وتستنزفه، لتطوّح به بعدها وكأنّه مجرد دالٍّ أنطلوجي أجوف، لا شيء يسعه سوى الموت والتوحّد مع الماء المالح في بطن المحيط الأطلنطي.
إن الكائنات الروائية في متخيل الهجرة تتوحّد، مثلما رأينا في هذه الورقة، ضمن وضع البين بين l’entre les deux مشبع بالقلق والتوتر حدّ التّهَجس. فلا هي ترتاح بضفّة البحر الجنوبيّة، ليزول عنها الهمّ منزاحًا إلى الأبد، ولا هي تذوب في ضفّة الشّمال ذوبان السّكر بالمشروب المرّ، بطواعية وتلقائية سلسة في الموطن الجديد. وإنّما هي تظلّ رافضة المكوث بالجنوب، مفضلة عليه الالتحاق بجنّة الشّمال الأسطورية، لكنها ما إن تصل إلى مبتغاها، حتى تحس بأن شيئًا ما يشبه التّيار البحري ما يزال يجرّها إلى الضّفة الأولى. إنّها كائنات لا تسكن غير البحر، إلى حدّ أنها تتشبّه به؛ فهي كالبحر الأبيض المتوسط الفاصل بين أرض الآلام وأرض الآمال، كائناتٌ موجية موزعة بين ضفة تدقّ على صخر الشّمال، وأخرى ترابض قلقة بشواطئ الجنوب. وضمن الوضعين أعلاه، نجدها لا تكف عن الحِراك والاحتراق، وكلا المعنييْن مركوز في لفظة «لحْريك»، التي تستعمل في الدّارجة المغربية! وبهذا، لا تكف عن مساءلة نفسها وأهل الشمال والجنوب جميعًا، سؤالها الأنطولوجيّ المربك والمحيّر: ترى، متى يصير لنا وطن آخر غير البحر، يا أيتها الأرض الفسيحة؟!
الهوامش:
1 – أنظر في هذا الصّدد كتاب: مذكّرات عابر حدود، للكاتب الألباني غازميند كابلاني، ترجمة أحمد الويزي، منشورات دار أثر السّعوديّة، الطبعة الأولى، 2021.
2 – يحمل لفظ نوستالجيا nostalgie، بحسب المعنى الذي خصّه به الرّوائي ميلان كونديرا، معنى مميّزًا جدًّا في اللّغات الغربيّة، بناء على ما تسرّب من الموروث الإغريقيّ. فهو يقسّم اللّفظة إلى قسمين، بحسب الجذر الإغريقيّ: نوستوس nostos الذي يعني العودة إلى الوطن، وألغوس Algos الذي يفيد الألم. ومن ثمّ، يستفاد بأن النّوستالجيا تعني «الآلام والمعاناة التي تتسبب فيها الرغبة غير المشبعة، في العودة إلى الوطن». أنظر المزيد في رواية (الجهل) L’ignorance، لميلان كونديرا Milan Kundera، ص 9 /11، منشورات غاليمار Gallimard، باريس، 2000، (بالفرنسية).
3 – محمد حسنين هيكل: زينب، ص: 7/10، الطبعة السادسة، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1967 (التشديد منّا!).
4 – لا ينبغي أن يغرب عن بالنا بأنّ اختيار محمد حسنين هيكل لصفة الفلّاح المصري، كهوية خاصّة وقّع بها روايته) زينب)، هو يمثابة ردّ فعل على أشكال التّمييز والإقصاء والازدراء، التي ظلّ المصريّ يعاني منها، في ظلّ الاستبداد العثماني. ولذلك، فتأكيده على هذه الهوية المقصيّة والمنسيّة، هو بمثابة تحدٍّ رمزيّ مرفوع في وجه المؤسّسة الرّسمية، التي ظلّ يعاني من عسفها المواطن المصريّ، سواء على المستوى الاجتماعيّ أو الثّقافي أو الاقتصاديّ أو السّياسي. ومن ثمّة، فتبنّي محمد حسنين هيكل لهذه الهوية المقصيّة، التي تنحدر من أقصى الرّيف المصريّ المهمّش، هو تعبير عن مدى الاعتزاز بهذه الهوية المقصية من جهة، وتأكيد من جهة أخرى على انتمائه إلى أنا جمعيّ، بدأت بوادره في التّخلق خلال عشرينيات القرن الماضي بمصر، مع بروز شريحة اجتماعية وسطى متنوّرة، أسهمت المثاقفة في صقل موهبتها وهويتها!
5 – لنفكّر هنا خاصّة في هذه النّصوص: (الأيام) لطه حسين (1929)، (عصفور من الشرق) لتوفيق الحكيم (1938)، و(الحيّ اللّاتيني) لسهيل إدريس (1953)، و(موسم الهجرة إلى الشمال) للطيب صالح (1966)،،، الخ.
6 – أفكّر هنا بشكل خاصّ، في روايتي (الغربة) و(أوراق) لعبدالله العروي!
7 – أحيل هنا على بعض الرّوايات المؤسّسة، أهمّها رواية عثمان سوسي Ousmane Socé: (سراب باريز) Les mirages de Paris (سنة 1937)، ورواية بيرنار دادييه Bernard Dadié: (زنجيّ في باريز) Un Nègre à Paris (سنة 1959).
8 – لا نعثر للأسف سوى على نزر قليل ممّا يُكتب من هذا الأدب السّردي بالعربيّة، على الرّغم من أنّ ثمّة كُتّابًا مغاربة معرّبو التّكوين والتّعبير في المهجر، منهم على سبيل التّمثيل لا الحصر الأستاذ علي أفيلال ومحمد المزديوي وهشام ناجح، وغيرهم.
9 – نذكر على سبيل التّمثيل لا الحصر، العناوين التّالية: (من البحر إلى البحر)، رواية، أحمد أبابري، (1995)، (أمواج الروح، سيرة مهاجر سري في باريس)، مصطفى شعبان، (1998)، (يوميات مهاجر سري)، رشيد نيني، (1999)، (زهرة الموريلا الصفراء، رحلة مغربية في قوارب الموت)، عبدالكريم الجويطي، (2003)، (أكلة اللحوم)، رواية بالفرنسية، الماحي بينبين، (1999)، (المهاجرون السّريون)، رواية بالفرنسيّة، يوسف أمين العلوي، (2000)،… الخ.
10 – يوسف فاضل: (حشيش)، منشورات الفنك، الطّبعة الأولى، الدار البيضاء، 2000.
11 – فاتو ادْيوم: (بطن الأطلنطي) Le ventre de l’Atlantique، منشورات آنْ كاريير éditions Anne Carrière، الطبعة الأولى، باريس، 2003.
12 – يختلف العملان عن بعضهما من مجموعة من النّواحي، التي يمكن أن نذكر بعضها على سبيل التمثيل لا الحصر، مثل الفروق المميّزة لجنس المؤلِّف: يوسف فاضل ذكر/فاتو ديوم أنثى، ولجنسيته: يوسف فاضل مغربي/وفاتو ديوم سنغاليّة، ولمقرّ إقامة كلّ روائيّ منهما الدائمة: الأول يعيش في المغرب/والثانية تقيم دائمًا بفرنسا. أمّا اللغةُ المستعملة في (حشيش) فهي العربية، بينما هي في (بطن الأطلنتيك) فرنسية. وإلى جانب ذلك، ثمّة اختلاف في طبيعة الضّمير السّردي المعتمد في الحكي: (حشيش) تعتمد ضمير المفرد الغائب/و(بطن الأطلنتيك) ضمير المتكلم المفرد. كما يختلف العملان أيضًا، من حيث الجغرافيّة البيّنة لطبيعة المتخيل المعتمد في كلّ نصّ منهما: إذ يحضر البحر الأبيض المتوسط في (حشيش)/بينما تشتغل فاتو ديوم على جغرافية المحيط الأطلسي. أما المرجعية الأوروبية المستهام بها فمتباينة أيضًا، إذ يتمّ الحلم بإسبانيا مع يوسف فاضل/ويقع الاستيهام بفرنسا مع فاتو ديوم. وإلى جانب ذلك كلّه، نلاحظ اختلافًا آخر في المقاربة المستعان بها في تناول موضوعة الهجرة: هجرة سرية في (حشيش)/وهجرة شرعية في (بطن الأطلنتيك).
13 – أنظر مقالة عبدالله مدغري علوي الموسومة بعنوان: «البحر الأبيض المتوسط والمهاجر السري، في الأدب المغاربي اليوم»، ترجمة مصطفى النحال؛ وهي منشورة ضمن كتاب جماعي بعنوان: الأدب المغاربي اليوم، قراءة مغربية، منشورات اتحاد كُتّاب المغرب، الطبعة الأولى، الرباط، 2006.
عدد التحميلات: 0





