
أبو الحسن الندوي العالم الرباني والداعية الأديب
اشتهر هذا العالم الهندي في العالم العربي والإسلامي بمصنفه القيم: (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟).
وذاع صيته في الشرق والعرب بسبب هذا الكتاب، وانتشر انتشارًا عظيمًا، ولقي قبولًا عجيبًا في أوساط طلبة العلم والعلماء.
تعلم في دار العلوم بالهند (ندوة العلماء)، حيث تخصص في التفسير، وأصبح شعلة نشاط في الهند وخارجها، وشارك في مؤسسات وجمعيات إسلامية، مثل المجمع العلمي بالهند، ورابطة الأدب الإسلامي، وكان عضوًا في مجمع اللغة العربية بدمشق، وعضوًا في المجلس التنفيذي لمعهد ديوبند، ورئيس مجلس أبناء مركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية.
وله إسهامات عديدة متنوعة في الفكر الإسلامي، فمن كتبه: (موقف الإسلام من الحضارة الغربية)، و(السيرة النبوية)، و(من روائع إقبال)، و(نظرات في الأدب)، و(من رجالات الدعوة)، و(قصص النبيين) للأطفال، وبلغ مجموع مؤلفاته وترجماته المئات وبلغات مختلفة: الإنجليزية والفرنسية والتركية والبنغالية والإندونيسية وغيرها من اللغات الأخرى. فضلًا عن 177 كتابًا بالعربية.
وكان رحمه الله رحالة يكثر السفر إلى مختلف أنحاء العالم لنصرة قضايا المسلمين والدعوة الإسلامية في الجامعات والهيئات العلمية والمؤتمرات. وتولى منصب رئيس ندوة العلماء منذ عام 1961م وظل فيه حتى وفاته، وقد حاز عددًا من الجوائز العالمية، منها جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام.
ثناء العلماء عليه
والشيخ الندوي يتميز بلغة أدبية شاعرية، يحلق بها في سماء الكتابة والتأليف، حتى نال الدرجات العلى في الأدب والبيان، وكان يتمتع بروح وثابة لا تقبل القعود والارتباط بالأرض، فكان يجوب البلاد لخدمة الدين ونشر العقيدة السلفية الصافية، ونال كل ما أمله ورجاه. وكان يغوص في أمَّات كتب التراث ويفتش في أعماقها فيخرج لنا الدرر الكامنة والفوائد والفرائد التي ظلت ردحًا من الزمن مخبئة، فهو أول من نفض التراب عن هذه المقولة التي تشع عزة وكرامة ومجدًا وفخرًا. التي قالها ربعي بن عامر رضي الله عنه وهو يخاطب بها رستم قائد الفرس بأنفة وعزة، حين دخل عليه وقد زيَّنوا مجلسَهُ بالنمارق المذهَّبة والزرابي الحرير، وأظهر اليواقيت واللآلئ الثمينة، والزينة العظيمة، وعليه تاجه، وغير ذلك من الأمتعة الثمينة. وقد جلس على سرير من ذهب. فدخل رِبْعي بثياب صفيقة وسيف وترس وفرس قصيرة، ولم يزل راكبها حتى داس بها على طرف البساط، ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد، وأقبل وعليه سلاحه ودرعه وبيضته على رأسه. فقالوا له: ضع سلاحك. فقال: إني لم آتكم، وإنما جئتكم حين دعوتموني، فإن تركتموني هكذا وإلَّا رجعت. فقال رستم: ائذنوا له، فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق، فخرق عامتها، فقالوا له: ما جاء بكم؟ فقال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جَور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قَبِلَ ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه أبدًا حتى نفضي إلى موعود الله. قالوا: وما موعود الله؟ قال: الجنةُ لمن ماتَ على قتال منْ أبى، والظفرُ لمن بقي.
سالت كلمات العزة والكرامة من فم ربعي كالسيل الجارف الذي يشق في الجلمود نهر الحياة والكرامة، بكلمات بليغة وإيجاز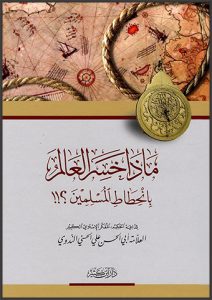 رائع وألفاظ تفعل الأفاعيل فيمن يسمعها. فما كان من رستم إلا أن قال: قد سمعتُ مقالتكم فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظرَ فيه وتنظروا؟ فاجتمع رستم برؤساء قومه فقال: هل رأيتم قط أعزَّ وأرجحَ من كلام هذا الرجل؟ فقالوا: معاذَ الله أن تميل إلى شيء من هذا، وتدعَ دينك إلى هذا الكلب، أما ترى إلى ثيابه، فقال: ويلكم لا تنظروا إلى الثياب، وانظروا إلى الرأي والكلام والسيرة. إن العربَ يستخفّون بالثياب والمأكل، ويصونون الأحساب.
رائع وألفاظ تفعل الأفاعيل فيمن يسمعها. فما كان من رستم إلا أن قال: قد سمعتُ مقالتكم فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظرَ فيه وتنظروا؟ فاجتمع رستم برؤساء قومه فقال: هل رأيتم قط أعزَّ وأرجحَ من كلام هذا الرجل؟ فقالوا: معاذَ الله أن تميل إلى شيء من هذا، وتدعَ دينك إلى هذا الكلب، أما ترى إلى ثيابه، فقال: ويلكم لا تنظروا إلى الثياب، وانظروا إلى الرأي والكلام والسيرة. إن العربَ يستخفّون بالثياب والمأكل، ويصونون الأحساب.
هذا هو ميراث الأجداد المخبئ الذي لا يريد أعداء الدين إظهاره وبثه وإحياءه. فهيأ الله له هذا الأديب الأريب سماحة الشيخ الندوي، فأخرج لأجيال الأمة هذه اللآلئ، فانتشرت بحمد الله بين شباب الأمة ورجالاتها وتمثلوها وصبغوا بها حياتهم ورددوها في المحافل وتناقلوها في كتبهم ورسائلهم الأكاديمية، وصارت بحمد تتردد على ألسنة الوعاظ والخطباء. حتى إن كثيرًا من شباب الأمة وفتيانها يتباهون بها في رحلاتهم وأمام أصدقائهم ومخالفيهم، ويفتخرون بإشاعة هذا الحوار.
فكان أبو الحسن الندوي هو أول من نبه إلى قيمة هذا الموقف وهذه الكلمات، ثم تناقلها الكُتَّاب والمؤلفون من بعده وانتشرت.
عاش أبو الحسن يتعلم ويعمل ويُعلم ويدعو، فكان الإسلام محور حياته ومرجعه في كل القضايا والدافع الذي يدفعه إلى الحركة والعمل والسفر والكتابة والجهاد، ساعيا لأن يقوي الجبهة الداخلية الإسلامية في مواجهة الغزوة الخارجية عن طريق تربية الفرد بوصفه اللبنة الأساسية في بناء الجماعة المسلمة، وكان عفيف النفس لا يمد يده لأحد مهما اشتدت الأزمات وضاقت السبل، فقد مرت أوقات صعاب على (دار العلوم) بندوة العلماء، فاقترح عليه بعض الأفاضل أن يزوروا الشيوخ وكبار التجار، ويشرحوا لهم أوضاع الدار واحتياجاتها للمال، فرفض بشدة ولم يسلك هذا المسلك.
مآثر الشيخ الشخصية والأخلاقية
الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي أحد أعلام الدعاة إلى الإسلام في عصرنا، بلا ريب ولا جدال، عبَّرت عن ذلك: كتبه ورسائله ومحاضراته التي شرقت وغربت، وقرأها العرب والعجم، وانتفع بها الخاص والعام.
كما شهدت بذلك رحلاته وأنشطته المتعددة المتنوعة في مختلف المجالس والمؤسسات، وبعض كتبه قد رزقها الله القبول، فطبعت طبعات عدة، وترجمت إلى لغات كثيرة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والحق أن الشيخ رحمه الله قد آتاه الله مواهب وقدرات، ومنحه مؤهلات وأدوات مكنته من إحراز مكانة رفيعة في عالم الدعوة والدعاة.
فكان يقول الكلمة الملائمة في الموضع الملائم والزمن الملائم، فتجده يشتد إذا لزم الأمر الشدة، ويلين إذا كان اللين هو الأفضل والأنسب، حتى يصير كالنسمة التي مرت فأفضت على المكان هدوءًا وراحة واطمئنانًا. وهذا ما عرف عنه منذ شبابه الباكر إلى أن توفاه الله.
وقد آتاه الله ثقافة عالية كانت زادًا له في دعوته وإبلاغ رسالته، وسلاحه في مواجهة خصومه، ونتج عن هذه الثقافة أن ألف كتابه الشهير الذي احتل مكانة مرموقة عند القارئ المسلم، وهو كتابه الأول إلى العالم العربي قبل أن يزوره ويتعرف عليه، (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟) الذي نفع الله به كثيرًا من عامة المسلمين وطلبة العلم، واستفاد منه كل من اطلع عليه.
وقد ساعده على ذلك: تكوينه العلمي المتين، الذي جمع بين القديم والحديث، ومعرفته باللغة الإنجليزية إلى جوار العربية والأردية والهندية والفارسية، ونشأته في بيئة علمية أصيلة، خاصة وعامة، فوالده العلامة عبدالحي الحسني صاحب موسوعة (نزهة الخواطر) في تراجم رجال الهند وعلمائها، كما نشأ في رحاب (ندوة العلماء) ودار علومها، التي كانت جسرًا بين التراث القديم والواقع المعاصر، فأخذ من القديم أنفعه ومن الجديد أصلحه، ووفق بين العقل والنقل، وبين الدين والدنيا، وبين العلم والإيمان، وبين الثبات والتطور، وبين الأصالة والمعاصرة.
الملكة الأدبية
وهب الله للشيخ الندوي البيان الناصع والأدب الرفيع، كما يشهد بذلك كل من قرأ كتبه ورسائله، وكان له ذوق أدبي جميل، وحس بلاغي رائع، فقد تربي في حجر لغة العرب وآدابها منذ نعومه أظفاره، فبلغ أسمى المراتب وأعلى الدرجات، حتى صار همزة وصل بين القارة الهندية والأمة العربية، فخاطبهم بلسانهم، كأنه واحد منهم، بل قد يفوق بعض العرب الناشئين في قلب بلاد العرب. فكتب رسائل وكتابات نثرًا لكنها تملؤها روح الشعر، وعبق الشعر. فكانت قطرات من الأدب المُصفى.
أما ما يتعلق بالدعوة فقد آتاه الله قلبًا حيًّا، وعاطفة جياشة لله ولرسوله ولدينه ولعباده المؤمنين، فهو يحمل بين جنبيه قلبًا مليئًا بالحب والحرص والخير، ولديه نبع لا يغيض، وشعلة لا تخبو، وجمرة لا تتحول إلى رماد. وهكذا الداعية إلى الله لا بد أن يكون له قلب مثل هذا القلب الحي، ولديه عاطفة مثل هذه العاطفة الدافقة بالحب والحنان والدفء والحرارة، فيفيض منها على من حوله، فيحرك ساكنهم، ويوقظ نائمهم.
فكلام أصحاب القلوب الحية له تأثيرات جليلة فيمن يسمعه أو يقرأ له، فإن الكلام الصادق إذا خرج من قلب حي دخل بلا استئذان قلوب مستمعيه، وقد صدق من قال: ليست النائحة كالثكلى!
فهذا القلب الحي، يعيش مع الله في حب وشوق، راجيًا خائفًا، راغبًا راهبًا، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، كما يعيش في هموم الأمة على اتساعها، ويحيا في آلامها وآمالها، لا يشغله هم عن هم، ولا بلد عن آخر، ولا فئة من المسلمين عن الفئات الأخرى.
وقد آتاه الله خلقًا كريمًا وسلوكًا قويمًا، ممتثلًا أخلاق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا غرو أن وصف الله خلق نبيه بالعظمة، حيث قال تعالى: (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) [القلم:4] ، وترجم هذا الرسول هذا العطاء في قوله: (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق).
فقد كان أبو الحسن صاحب خلق رضي، باطنه مثل ظاهره، وسريرته مثل علانيته، يطبق ما تعلمه ودعا إليه في حياته الخاصة والعامة، ومع محبيه وشانئيه، فكان رحمه الله ذا رقة وسماحة وسخاء وشجاعة ورفق وحلم وصبر واعتدال وتواضع وزهد والجد وصدق مع الله ومع الناس، وكان ذا إخلاص وبعد عن الغرور والعجب، وعنده وأمل وثقة وتوكل ويقين وخشية ومراقبة، وغيرها من الفضائل والأخلاق الربانية والإنسانية.
وهذا كله من بركات نشأته الصالحة في بيئة طيبة في أسرة ذات حسب ونسب.
أما عقيدته فهي عقيدة أهل السنة والجماعة، سليمة من الشركيات والخرافات والأباطيل التي كانت منتشرة في الهند، حيث تأثر كثير من المسلمين بالهندوس ومعتقداتهم وأباطيلهم، كما هو الحال عند جماعة “البريليوين” الذين انتسبوا إلى التصوف اسمًا ورسمًا، والتصوف الحق براء منهم، وقد حفلت عقائدهم بالخرافات، وعباداتهم بالمبتدعات، وأفكارهم بالترهات، وأخلاقهم بالسلبيات.
أما الشيخ أبو الحسن فقد تربى على عقائد سليمة قام عليها منذ نشأتها علماء ربانيون، طاردوا الشرك بالتوحيد، والأباطيل بالحقائق، والبدع بالسنن، والسلبيات بالإيجابيات. وأكدت ذلك مدرسة الندوة -ندوة العلماء- وأضافت إليها روحًا جديدة، وسلفية حية حقيقية، لا سلفية شكلية جدلية، كالتي نراها عند بعض من ينتسبون إلى السلف، ويحصرون السلفية في المظاهر والشكليات.
إن العقيدة السلفية عند الشيخ هي: توحيد خالص لله تعالى، لا يشوبه شرك، ولا يعكر صفاءه بدع، وكان على يقين عميق بالآخرة، فلا يعتريه ريب، ولا يزحزحه شبهات، فإيمانه جازم بالنبوة، لا يداخله تردد ولا أوهام، ولديه ثقة مطلقة في القرآن والسنة، وأنهما أساس العقائد السليمة والشرائع المحكمة والأخلاق العالية الرفيعة والسلوك المهذب الراقي.
(كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ) آل عمران: 185.
هكذا تنتهي حياة الخلائق عندما يأتيها أجلها، فلا تتقدم ولا تتأخر، بلغ الشيخ أبو الحسن الندوي ستة وثمانين عامًا قضاها في خدمة دينه وتبليغ رسالة ربه، فوفّى وأوفى، ونرجو له الدرجات العلى عند رب رحيم عفو كريم يجازي بالحسنات عفوا وغفرانًا، ويتجاوز عن سيئات عباده، فنسأل الله تعالى أن يعفو عنه ويغفر له، ويدخله في رحمته ويشمله بكرمه ويدخله جنته، فقد مات الشيخ كما مات غيره، وحزن عليه أهله وتلامذته ومحبوه، ونعوه في أرجاء المعمورة، وأقيمت عليه صلاة الغائب في كثير من بقاع الأرض.
عدد التحميلات: 0





