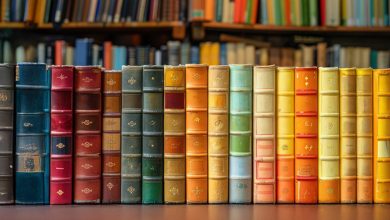في جمهورية ألمانيا الديمقراطية التي كانت خاضعة للنظام الشيوعي، كان الأمر الأشد مرارة من “خلطة البن”، التي ابتدعتها القيادة السياسية وقتذاك ورفضتها جموع المواطنين، هو النكات التي أطلقت حول هذه الخلطة.
وتقول نكتة منها “ما الفرق بين خلطة البن والقنبلة النترونية؟ ليس هناك فرق، فالفنجان سيظل ممتلئًا بينما سيتمزق الشخص إربًا”، وأطلق البعض عليها وصف “سم الفئران النقي”.
وهذه الخلطة كان نصفها من البن والنصف الآخر من منتجات أخرى، وابتُكرت عندما حدث نقص حاد في البن الذي أطلق عليه وصف الذهب الأسود، في أواخر السبعينيات من القرن الـ20، نتيجة سوء أحوال المحصول العالمي وعدم استقرار أسعاره.
وارتفعت أسعار البن بسرعة، بينما كانت ألمانيا الشرقية الشيوعية تعاني من عجز في النقد الأجنبي، منع الحكومة من استيراد البن.
أزمة البن
وبحلول عام 1977 تفاقمت أزمة البن، لدرجة أنها أدت إلى تصاعد مشاعر الاستياء، مما جعل وزارة الأمن الداخلي في ألمانيا الشرقية، التي اشتهرت بقبضتها الأمنية الغليظة، تدق جرس الإنذار.
ومن هنا طرحت القيادة في ألمانيا الشرقية خطة للتغلب على الأزمة، تتمثل في ابتكار ما عرف “بخلطة البن” التي تحتوي على ما نسبته 51% فقط من البن المحمص.
ولكن مشاعر الاستياء ظهرت حيث شعر محبو تناول القهوة بالغضب، كما أن هذه الخلطة الجديدة أدت إلى تعطيل آلات إعداد القهوة وجعل بعضها ينفجر، لتندلع أزمة سياسية شغلت بال دارسي التاريخ حتى يومنا هذا.
ومن المعروف أن القهوة تتمتع بمكانة مهمة في المجتمع الألماني، وتلقى إقبالاً كبيرًا حيث يشرب الفرد في المتوسط 169 لترًا منها في العام.
وهي ليست مجرد مشروب ساخن، بل تمثل نوعًا من الرخاء، ويقول المؤرخ فولكر فوندريتش إن كثيرين من الألمان يتذكرون أنهم أصبحوا قادرين على تناول القهوة العادية، فقط بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.
ويضيف فوندريتش أن القهوة تساعد أيضًا على تنشيط الحياة الاجتماعية، مشيرًا إلى التقليد الألماني بعقد لقاءات لتناول القهوة وتبادل الأحاديث.
ورغم ارتفاع أسعار البن، استمر سكان ألمانيا الشرقية في تناول القهوة، باعتبارها نوعًا من الترفيه أو المتعة، حتى لو كان ذلك على حساب استقطاع النقود التي تنفق على الخبز والزبد والنقانق والجبن، والتي كانت رخيصة على أي حال بفضل الدعم.
ولم تكن القهوة مجرد مشروب يضفي البهجة، ولكنها تحمل رمزًا، وكانت قيادة ألمانيا الشرقية تدرك أهميتها.
وحاولت هذه القيادة وقتذاك عقد صفقات مقايضة لشراء البن من الدول المنتجة مقابل سلع أخرى.
وعلى سبيل المثال، سعت القيادة في ألمانيا الشرقية إلى الحصول على هذه السلعة النفيسة من إثيوبيا مقابل صفقة أسلحة عام 1977.
وللتدليل على أزمة البن في تلك الأيام مع ارتفاع أسعاره، وتراجع احتياطيات ألمانيا الشرقية من النقد الأجنبي، ذكرت صحيفة “دي زيت” أن رئيس ألمانيا الشرقية إريك هونيكر شكا من صعوبة استيراد البن، إذ قال “أود أن أقول مرة أخرى إن استيراد حبوب البن الخضراء وحدها يكلفنا نحو 300 مليون دولار سنويًا، وإنفاق مثل هذا المبلغ ليس سهلاً علينا”.
وزاد الطين بلة طرح خلطة البن، وهي مزيج نصفه من البن المحمص، ونصفه بدائل تكميلية من البازلاء المحمصة ونبات الشيلم والشعير ولب البنجر.
وكان هناك شيء يتشكل ويتخمر، ولكنه لم يكن القهوة.
القهوة المرفوضة
اضطرت الشرطة السرية المخيفة المعروفة باسم “ستاسي” إلى الاعتراف بأن القهوة الجديدة المركبة “مرفوضة من قطاعات واسعة من السكان”، وجاء ذلك في تقرير يرجع تاريخه إلى الأول من سبتمبر/أيلول 1977.
وأشارت “ستاسي” في تقريرها إلى أن مواطني ألمانيا الشرقية يرفضون شراء الخلطة.
ولم يتوقف المواطنون عند تقديم الشكاوى بشأن سوء مذاق الخلطة الجديدة فحسب، بل شعروا بالاستياء لأن نصف المنتج فقط كان من البن، إلى جانب أن السعر ظل كما هو بدلاً من أن ينخفض بسبب رداءة المنتج، ولم تقدم وسائل الإعلام المملوكة للدولة أي ردود.
وفي النهاية اضطرت السلطات إلى إعدام أطنان من خلطة البن غير المبيعة، وإلغاء التجربة.
وترى عالمة الاجتماع آن ديتريتش المقيمة في مدينة ليبزج، التي كانت تقع في السابق ضمن حدود ألمانيا الديمقراطية الشيوعية، أن هذه اللحظة كانت نقطة تحول.
وقالت في مقال لها عن هذه الفترة إنها كانت اللحظة التي تراكم فيها معا افتقار الحكومة إلى المصداقية والشفافية، وسوء نوعية السلع وفرض زيادات في الأسعار بطريقة خفية، مما خلق “أزمة في الشرعية” للدولة الشيوعية.
وأضافت أن الامتناع عن شراء خلطة البن لم يكن نوعًا من الاحتجاج السياسي، ولكنه كان ثورة للمستهلكين، وأكدت أن “الأمر برمته كان يمثل كارثة اقتصادية”.
غير أن الحظ حالف القيادة الشيوعية بألمانيا الشرقية في نهاية المطاف، حيث بدأت أسعار البن في الانخفاض في الأسواق العالمية.
كما نجحت ألمانيا الشرقية في عقد صفقة مع جمهورية فيتنام الاشتراكية، لزيادة إنتاجها من البن، في مسعى للحصول على إمدادات رخيصة من هذه السلعة المحببة في البلاد.
المصدر:
عدد التحميلات: 0