متى تجد علوم الحكمة طريقها إلى جامعات المملكة؟الباب: مقالات الكتاب
 | أ.د. بدر الدين مصطفى أستاذ علم الجمال- آداب القاهرة |

كان قرارًا حكيمًا من إدارة لديها قدر وافر من الانفتاح والوعي بمتطلبات عصر تتبوأ فيه الصورة، لا سيما المتحركة منها، مكان الصدارة في مشهده الثقافي. وأعني هنا قرار إدخال السينما إلى المجال الثقافي العام للمملكة من خلال عروض جماهيرية. أهمية هذا القرار تتجاوز فكرة تواصل المتلقي مع الأفلام، لأن هذا التواصل كان متحققًا بالفعل من خلال شاشات التلفاز وأجهزة العرض المنزلية. ولاشك أن قطاعات عريضة من الجماهير داخل كافة المجتمعات على اختلاف أيديولوجيتها وعاداتها وتقاليدها لديها تواصل ما مع فن السينما يتنوع من حيث أهدافه وغاياته، لكنه موجود في كل الأحوال. وقد حققت السينما تقدمًا ثوريًا في مجال الصورة المتحركة جعلت المفكر الألماني فالتر بنيامين يصفها بأنها "الفن الوحيد الممكن في المستقبل". وأهمية السينما تتجاوز حدود الأهمية التقليدية للفنون الأخرى. ويكفي أن نقارن مقدار التفاعل الجماهيري معها لندرك تلك الحقيقة. كما أن للسينما دور معرفي شديد الأهمية بالإضافة إلى إمكانية استخدام الأفلام كوسيط مساعد للتدريس في العديد من المجالات، خاصة في حقل الإنسانيات. وبالإضافة لذلك من الممكن توظيف السينما والاستفادة من إمكاناتها في ترسيخ نموذج حضاري معين تتبناه الدولة. وقدرة السينما على أن تجمع معًا صورًا متباينة إلى أبعد الحدود، كيما يرى المشاهدون تقابل حيواتهم اليومية هي، بحسب بنيامين، قدرة تثبت تلك الحيوات وتمارس تأثيرًا محررًا جوهريًا. من هنا كان ضروريًا انفتاح ثقافة المملكة على عوالم السينما ومحاولة الاستفادة من قدراتها وإمكاناتها وإفساح المجال لها لتصبح مكونًا من مكونات المشهد الثقافي العام.
في كتاب الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز (1925 - 1995) الصورة- الحركة توجد مقارنة بين وظيفة الفلسفة ووظيفة السينما فكلاهما يطرحان أسئلة، يقدمان عالمًا، يثيران إشكالات تتعلق بوجودنا. والسينمائي كالفيلسوف يقدم وجهة نظره للعالم من خلال صوره المتحركة. وكل فيلم في النهاية يحمل فلسفة للعالم، سؤال ومحاولة من المخرج للإجابة عنه.
ربما هذا التقاطع بين الفلسفة والسينما، الذي استدعاه القرار الحكيم بإدخال السينما إلى الفضاء الثقافي للمملكة، يستدعي معه أيضًا النظر إلى علوم الحكمة نظرة أخرى غير التي سادت طوال العقود الماضية. فإضافة إلى الامتداد التاريخي لتلك العلوم داخل ثقافتنا العربية-الإسلامية، والذي يجعلها جزء من هويتنا الفكرية والحضارية، توجد ضرورة راهنة ملحة تستدعي إفساح المجال أمامها لتتخذ موقعها داخل السياق الثقافي الراهن، ولن يتأتى ذلك إلا إذا تم الاعتراف بها داخل المؤسسات الأكاديمية كحقل معرفي لا يقل أهمية عن الحقول المعرفية ا لأخرى إن لم يكن أساسًا للكثير منها.

ما الفلسفة ولمَ؟
ربما كان التساؤل عن معنى الفلسفة قديم قدم الفلسفة ذاتها، وقد يبدو الأمر مثيرًا للدهشة أن نتساءل عن معناها الآن مع توافر العديد من التعريفات الاصطلاحية لها. لكن بالتأكيد ما نقصده بالتساؤل عن ماهية الفلسفة يتجاوز حدود التعريف الاصطلاحي لها، فالمغزى من طرح التساؤل هنا تحديد طبيعة الفلسفة ودورها في الوقت الراهن. لذا فإن أي محاولة لتحديد تعريف للفلسفة ستقابلها صعوبة كبيرة، لأنه لا توجد صورة ثابتة للفلسفة تمكننا من تقديم مثل هذا التعريف. ولعل إعادة طرح الفلسفة لسؤالها، هو وعي بتلك الصيرورة التي لا تعرف معنى الثبات.
لكن بصفة عامة هناك شكلان أو طريقان للإجابة عن سؤال "ما الفلسفة؟" الأول؛ يركز على "ماهية الفلسفة"- والثاني يركز على وظيفتها. وقد ارتبط البحث عن ماهية الفلسفة في التراث الفلسفي بالبحث عن ارتباطات الفلسفة بالتاريخ أو بالأصول أو المعنى الأصلي أو بجذور ما للتفلسف اعتبرت حدثًا أساسيًا في تاريخ الفكر... إلخ. وقد حاول هذا الشكل الأول أن يفكر في الفلسفة من زاوية الفلسفة ذاتها، أي من منطلق كينونتها كفلسفة، منذ انبثاقها كحدث فكري وتجربة داخل لغة ما خاصة (هي لغة الإغريق) طرحت بشكل أصيل مسألة الوجود الإنساني في العالم. لكن الشكل الثاني المقابل يبحث عن وظيفة الفلسفة، فما يهمه، ليس الوصول إلى أصل ما للفلسفة داخل الفكر أو اللغة أو المعنى، بل هو "الحقيقة البراغماتية" للفلسفة: ما الذي مارسته الفلسفة؟ وما الذي نمارسه حاليًا باسم الفلسفة؟ ما الذي نستفيده منها كخطاب وأفق للحوار وكفكر ونقد للتجربة والممارسات الاجتماعية والسياسية والمؤسسية؟ إن ما يركز عليه هذا الشكل الثاني هو الأثر الفعلي للفلسفة ووظيفتها النقدية لا أصولها المنسية أو الخفية. وغالبًا ما يخضع هذا الشكل من الإجابة إلى معطيات العلوم الإنسانية ويوظف تصوراتها حول المعرفة والتفكير وعلاقاتهما بالممارسة الإنسانية.
غير أن الاختلاف بين هذين الشكلين في الإجابة عن السؤال: "ماهي الفلسفة؟" في الفكر الحديث لا ينفي ترابطهما حسب الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا J. Derrida (1930- 2004 فالموقف الثاني البراغماتي رغم رفضه فكرة الماهية (الأصل)، ينطلق من تصور خاص أو معنى ما للتفلسف على أساسه يتساءل عن وظيفة الفلسفة. فإذا كان من غير الممكن التفلسف دون تكوين سابق (في مجال تاريخ الفلسفة)، ودون تعليم ومؤسسات فلسفية، ودون اللغة والمعرفة اللتين تصرفهما تلك المؤسسات، فلا يمكن أيضًا التفكير في الفلسفة خارج "المؤسسة الفلسفية" وفي استقلال عن "الجسد المدرس"1.
إن الفلسفة، رغم صعوبة تعريفها، أو لنقل سيولة هذا التعريف وصيرورته، هي ذلك الحقل المعرفي الذي يهتم بالسؤال عن المشكلات الكبرى للوجود والمعرفة والسلوك والإرادة والقيمة أو الاتجاه إلى التفسير الشامل للعالم. وقد ذهب لوك فيري إلى أنه "ليس بإمكاننا فهم العالم الذي نعيش فيه بدون الفلسفة. لماذا؟ ببساطة لأن كل أفكارنا ومسلماتنا، وكذلك قيمنا تقريبًا تندرج من دون أن ندرك ذلك ضمن رؤى للعالم تشكلت وتماسكت عبر تاريخ الأفكار. لذلك توجب أن نفهم تلك الرؤى لإدراك منطقها ومداها ورهاناتها، ما يسمح بإعطاء الذات الوسائل لتكون ليس فقط ذكية، وإنما أكثر حرية"2. ليست الفلسفة اجترارًا لمقولات الفلاسفة ونظرياتهم عبر التاريخ، وليست بحثًا مجردًا عن الحقيقة المطلقة، ولا تقتصر فقط على فهم المعرفة البشرية وطبيعتها كما هي، ولا هي بمعزل عن الحقول المعرفية الأخرى، ولا عن متطلبات الواقع المعيش، الفلسفة هي الوعي الفعال والحرية المتجسدة في أسمى معانيها.
والمراقب لتاريخ تطور المجتمعات يجد علاقة طردية بين الفلسفة وقيم التقدم الإنساني، وكما أننا نستطيع أن نتعرف على مجتمع من المجتمعات عبر مراقبة طبيعة الفنون السائدة فيه، فإننا أيضًا نستطيع التعرف على عقلية هذا المجتمع وكينونته من خلال معرفة التيار الفكري السائد فيه أو المفاهيم الفلسفية التي تحكمه.
ثمة منظوران يعكسان وجهة نظر سلبية تجاه الفلسفة في العالم العربي عمومًا: الأول؛ يمكن تسميته بـ"المنظور التقنوبيروقراطي"؛ وهذا المنظور ينتقد أصحابه الفلسفة بكونها عملاً عقليًا مجردًا بعيد عن الممارسة الإجرائية، ومن ثم فهي عديمة الجدوى في مجال تحقيق أي إسهام مباشر في تنشيط الاقتصاد والاستجابة لحاجات السوق على سبيل المثال3. والثاني؛ يعبر عن وجهة النظر القديمة لشعار الفلسفة التي ترى أن الفلسفة تصطدم مع ثوابت الدين4. وتلك إشكاليتان رئيستان لابد أن يوضعا في الاعتبار أثناء دراسة حال تدريس الفلسفة في الوطن العربي. إذ أن معالجتهما سيفضي في النهاية إلى معالجة معظم المشكلات الجزئية التي تتفرع بالضرورة عنهما.
الفلسفة والقيمة العملية
لا يمكن النظر إلى التقدم الحضاري بوصفه تقدمًا تقنيًا فقط، ولا توجد حضارة متقدمة تقنيًّا وفي الوقت ذاته تكون متخلفة على المستوى الثقافي. إذ لا ينفصل التقدم التقني عن التقدم الثقافي، فكلاهما مكملان لبعضهما. وعلى مر العصور المختلفة نستطيع أن نشهد علاقة طردية بين التقدم الحضاري والنمو الفكري والفلسفي للمجتمعات والعكس أيضًا صحيح. وتاريخنا الإسلامي ليس منا ببعيد، فقد ازدهرت علوم الحكمة في وقت ازدهار الحضارة الإسلامية وتوقفت عندما بدأ بريق حضارتنا في الزوال.
لا تعمل الفلسفة بمعزل عن نموذج معرفي سائد يحكم نظرة الإنسان للعالم من حوله، وتتحول الفلسفة مع الوقت إلى مكون رئيسي من مكونات هذا النموذج الذي تظهر تجلياته وتتجسد في المظاهر الثقافية للمجتمعات. وبمعنى آخر يتجلى أحد أوجه القيمة العملية للفلسفة كونها جزء من نموذج معرفي يحكم نظرة الإنسان لمحيطه ويشكل تصرفاته ويوجه سلوكه داخل بيئته.
وجه آخر من أوجه القيمة العملية للفلسفة يتمثل فهم ثقافة الآخر. إذ كيف نتعامل مع الآخر حضاريًا وثقافيًا وندخل معه في معاهدات واتفاقيات دون أن نفهم ثقافته ونستوعب نموذجه المعرفي؟ لقد خصص الغرب منذ أسس جامعاته أقسامًا علمية للدراسات الإسلامية والعربية، وما زالت دراسات الاستشراق حتى الآن قائمة وإن اختلفت أدواتها. والناظر إلى كم النظريات الفلسفية التي أنتجها الغرب في مختلف التخصصات خلال القرن العشرين حتى الآن سيدرك تمامًا أن هناك ضرورة ملحة لدراستها والوقوف عليها. والسؤال هو كيف لنا أن ننفتح على الآخر ونفهمه دون أن نعترف به أكاديميًا؟.
بالإضافة إلى ما سبق يمكن القول أن الفلسفة بصورتها القديمة قد تحللت أو تفككت أو على أقل تقدير تجاوزت الإشكاليات الأثيرة لديها والجدل النظري المميز لها لتصبح بصورتها الراهنة أكثر ارتباطًا بالقيم العملية والممارسات الفعلية. ولتأكيد ذلك يمكننا إلقاء نظرة على التخصصات الأكثر تداولاً الآن في المؤسسات الأكاديمية. فإذا كان تاريخ الفلسفة، كتاريخ العلم، جزء أصيل من أي موقف فلسفي راهن، فإن الفلسفة الراهنة استثمرت هذا التاريخ لتصبح أكثر التصاقًا بالواقع العملي سواء كان ذلك من خلال تطوير مباحثها التقليدية أو استحداث مجالات معرفية بينية. فعلى مستوى المباحث التقليدية، على سبيل المثال، نجد الفلسفة في مبحثها الأثير عن نظرية المعرفة تتجاوز الجدل النظري القديم حول أداة المعرفة وطبيعتها لتناقش قضايا مثل الذكاء الاصطناعي والعلوم المعرفية Cognitive science. أما بالنسبة لاستحداث مجالات جديدة فنجد العديد من المجالات الفلسفية التي تخذ طابعًا بينيًا كالجماليات البيئية، جماليات التخطيط العمراني، والأخلاق المهنية والطبية والبيولوجية.....إلخ.

الفلسفة والدين
أما فيما يتعلق بالإشكالية الثانية وهي النظرة التقليدية التي ترى الفلسفة خطرًا على العقيدة، فقد بات الحديث فيها مكررًا بدرجة كبيرة. واعتقد أن هذه النظرة بدأت تتلاشى تدريجيًا في وقتنا الراهن. فمن المعلوم أنه لا يوجد علم محرم في ذاته، إنما في استخدامه وتوظيفه. ومن ثم فإذا كانت الفلسفة خطر على العقيدة فهذا الخطر ينسحب بالمثل على العلوم الأخرى، بما فيها العلوم الطبيعية، فقد أفضت على سبيل المثال نظريات الفلك بالبعض إلى الإلحاد وأفضى علم الأحياء بدارون إلى نظرية التطور التي اعتبرها البعض تجديفًا.
حتى إذا عدنا إلى تراثنا القديم سنجد أن الفلاسفة قديمًا ناقشوا قضايا فكرية شائكة وهم في سبيلهم إلى محاولة التوفيق بين الوافد اليوناني والموروث الحضاري الإسلامي. وقد كانت مناقشتهم لتلك القضايا في سياق ثقافي متسامح يقدر قيمة الفكر ويتناسب طرديًا مع التقدم الحضاري السائد آنذاك. هذا السياق كان قريبًا زمنيًا من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك استطاع أن يستوعب كافة الآراء، حتى المتطرف منها، لأنه كان قويًا متماسكًا، فالثقافة القوية لا تخشى الفكر، فقط الثقافة المهزومة هي التي تقاومه.
لماذا يتم اختزال الفلسفة بأكملها في بعض الآراء والأفكار التي ترددت في كتابات بعض الفلاسفة؟ ولماذا لا يتم التعامل مع العلوم الأخرى على نفس القاعدة ومن ذات المنطلق؟ وهل هذه الآراء التي يرى البعض أنها تمثل خطرًا على العقيدة ستختفي في حال إقصاء الفلسفة من المشهد الثقافي والأكاديمي؟
ليس شرطًا بالتأكيد أن تدرس الفلسفة بكافة تخصصاتها داخل المؤسسات الأكاديمية وأن يتم الأمر دفعة واحدة، لكن قد يأتي الأمر تدريجيًا على شكل مقررات تركز على الطابع البيني للعلوم وهو المنحى الذي تنحاه كافة العلوم حاليًا. وأذكر هنا المؤتمر المهم الذي تبناه مركز دراسات اللغة العربية التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود في أبريل 2015 تحت عنوان "اللغة العربية والدراسات البينية" والذي أكد من خلال المشاركات التي قدمت فيه على هذا المعنى. فهل تجد الفلسفة، كما السينما، طريقها إلى المؤسسات الأكاديمية ومنها إلى الساحة الثقافية؟
المراجع:
1 - راجع الدراسة القيمة التي قام بها عبدالحي منصف بعنوان "دلالة السؤال ما هي الفلسفة في الفكر الحديث والمعاصر" نشرت في مجلة مدارات فلسفية على الموقع الإلكتروني الخاص بها. وراجع أيضًا الفصل الخاص بجيل دولوز من كتابنا حالة ما بعد الحداثة: الفلسفة والفن (القاهرة: هيئة قصور الثقافة، 2013). وفيه عرض تفصيلي لتلك القضية.
2 - ريتا فرج، في الفلسفة والتفلسف، ضمن كتاب حال تدريس الفلسفة في العالم العربي (بيروت: منشورات المركز الدولي لعلوم الإنسان، 2015) 25.
3 - لا تنحصر هذه النظرة إلى الفلسفة في العالم العربي فقط، إذ يتحدث المفكر الفرنسي ريجيس دوبريه ( R. Debray ( -1940 على سبيل المثال عن تراجع الاهتمام بالدراسات الإنسانية الكلاسيكية والاختصاصات الأدبية في الغرب وعن تفوق الإعلام البصري الذي همش اختصاصات المعنى القديمة من الأدب والفلسفة والتاريخ والفن. وهذا التراجع متعلق بتغليب العلوم التطبيقية وارتباطها بالسوق. عن عفيف عثمان، حال التعليم العربي، ضمن كتاب حال تدريس الفلسفة في العالم العربي، ص 12.
4 - ريتا فرج، مرجع سابق، ص 28.
تغريد
اقرأ لهذا الكاتب أيضا
- تحولات الصورة من الواقعي إلى المجازي
- المرئي أم المكتوب .. قراءة في لوحة هذا ليس غليونًا لرينيه ماغريت
- جان بودريار.. عن الإرهاب والحرب العالمية الرابعة
- السينما وكهف أفلاطون
- معادلة شارل بودلير
- من شارل بودلير إلى مارسيل دوشامب
- هل يمكن تأسيس نقد فلسفي للأفلام؟
- النموذج المعرفي مدخلاً لفهم الفكر الغربي
- موت المؤلف.. هل ثمة ضرورة؟
- الثقافة البصرية حتمية معرفية وضرورة أكاديمية
- متى تجد علوم الحكمة طريقها إلى جامعات المملكة؟
- أطروحة موت الواقع بين الفضاء الفلسفي وعوالم السينما
- بلاغة الصمت السينمائي
- وصايا رايت العشر بين وظيفية لو كوربوزيه وتفكيكية يزنمان
- فان غوخ بين مرثيتين
- «فضيلة أن تكون لا أحد».. عن الحكي بين الزمن المفقود والمستعاد
- كيف يمكن للعمارة أن تحقق السعادة في حياتنا؟
- العنف، العبث، والعدمية بين نيتشه وتارنتينو
- السوريالية وعمارة المفارقات
- استجابة الفلسفة الإسلامية المعاصرة للواقع والتفكير خارج التاريخ
- امتدادات التيارات الغربية في العالم الإسلامي
- المشاريع الفكرية العربية بين التراث والتجديد.. مراجعة نقدية




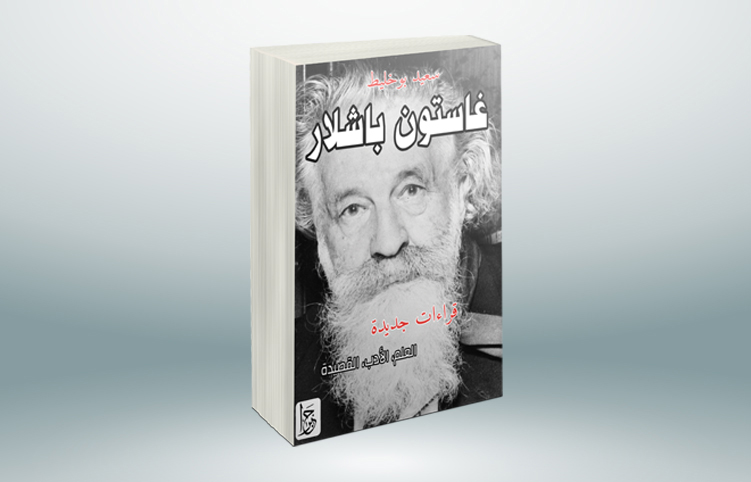

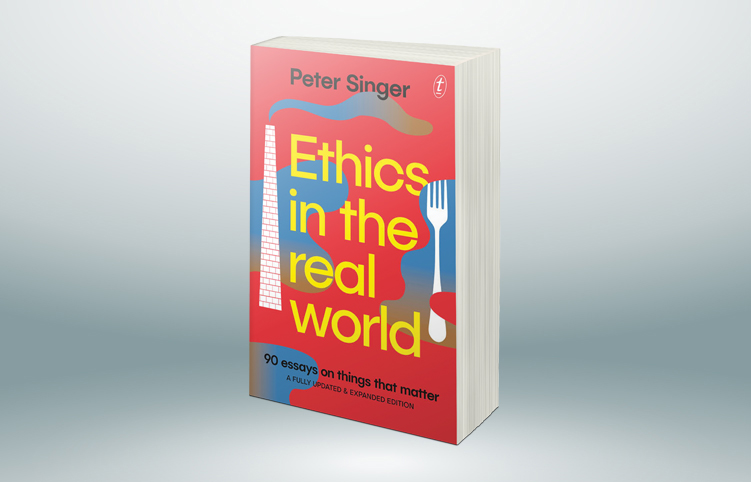










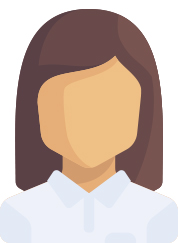
اكتب تعليقك