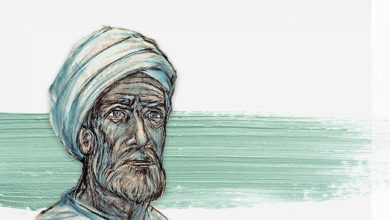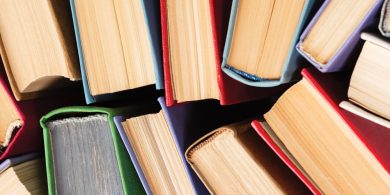تلقى الصحابة الكرام رضي الله عنهم الحديث من النبي ﷺ كما تتلقى الأرض الجديبة الغيث، وأودعوه قلوبهم وحوافظهم، وعني ﷺ بتثبيت حديثه في ذاكرتهم بما كان يراعيه من قصر الأحاديث غالبًا، ومن أساليب البيان المشوقة، وتكرار الحديث ليعقل عنه، وتنويع طرق الإلقاء، وغير ذلك مما ثبت عنه.
ثم قام الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، بتبليغ حديث النبي ﷺ على الوجه المطلوب، وراعوا غاية الحيطة لحديث رسول الله ﷺ، وكان الجو آنذاك فارغًا كل الفراغ من أي تأصيل أو أثر من قاعدة تتبع في أصول الرواية، أو قانون يراعى لضبطها، بل كان واقع الأمم مظلمًا، مما يدل على خطورة المهمة العظمى التي تحملها الصحابة رضي الله عنهم، ليؤدوا الحديث كما سمعوه، وكما قاله ﷺ.
لكن الدين الإسلامي متمثلاً في الكتاب والسنة جاء بأصول نظام الدين والدنيا، وقواعد نهضة العلم والحضارة، وكذا أصول الرواية والدراية.
وتتلخص هذه الأصول بإلزام الأمانة العلمية، من العدالة والضبط وما يتفرع منهما، واشتراط كل ذلك لقبول خبر الراوي، والتثبت من كل قضية بسلسلة إسناد كلهم ثقات، وخلو ذلك كله من الشذوذ والعلل القادحة.
معنى مناهج المحدثين:
هذه العبارة (مناهج المحدثين) مركب إضافي يتألف من كلمتي (مناهج) و(المحدثين)
والمناهج في اللغة: جمع منهج، والمنهج – كما يقول أهل اللغة – هو الطريق أو السبيل الواضحة البينة، والمناهج والنهج: كالمنهج(1).
قال تعالى: (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا)(2): أي سبيلاً وسُنَّة.
والمحدثُون: جمع محدث، اسم فاعل من حدث، والحديث من حدث، نقيض قدم، والحديث: الجديد(3).
وقد غلب استعمال المحَدِّث في العرف العام والخاص على المشتغل بالحديث النبوي.
والمعنى اللغوي لهذه العبارة: الطرق التي يسلكها المحدثون في أمورهم، وتشمل بإطلاقها العبادات، والمعاملات، ورواية الحديث بسنده، أو تخريجه، أو عزوه لمرجع يرويه بسنده.
وفي الاصطلاح: الطرق أو السبل التي سلكها المحدثُون في رواية الحديث وتصنيفه، بحسب شروط معينة، والتعليق عليها.
ويدخل في قولنا: (رواية الأحاديث) طرق التحمل والأداء وحكم كل منها، والرواية الشفوية والكتابية من صحيفة.
ويشمل قولنا (تصنيفه) في التعريف لأن الرواية قد لا تكون تصنيفًا، كرواية الصحابة والتابعين رضي الله عنهم قبل بدء التصنيف، ويشمل مناهج التصنيف العامة، أي أنواع المصنفات في الحديث النبوي كالجوامع والسنن والمسانيد والمعاجم.
وقولنا (بحسب شروط معينة) لتدخل الصفات التي يلتزمها كل مُحدَّثٍ في رواة الأحاديث التي يختارها لكتابه من الصحة أو الضَّعْف أو المِشْتَهِر على الألسنة، وفي الوجه الذي يروي به كل راو عن الآخر، كأن يورد المحدث سندًا واحدًا أو أسانيد متعددة، وكيف يجمعها في السياق ويحولها بـ(ح) التحويل، كما يفعل الإمام مسلم وغيره، أو يفرقها على الأبواب كما يفعل البخاري.
وقلنا و(التعليق عليها) لتدخل الفوائد الفقهية والإسنادية التي يبرزها أو يشير إليها كل واحد من المحدثين. (أي المنهج الخاص الذي يختص به كل محدث عن أمثاله).
وهذا الشمول في التعريف أليق بمناهج المحدثين، كما أنه أوفى بالغرض من الاقتصار على المناهج في التأليف، سواء المناهج العامة في ترتيب الأحاديث، أو الخاصة الفقهية والفنية، لأن الشمول الذي ذكرناه يسلط الضوء على مناهج الرواية، وقد غفل عنها كثيرون، مع أنها ركن في معرفة انتقال الحديث عبر حلقات الإسناد انتقالاً محكمًا بقواعد وضوابط دقيقة، تكفل سلامة النص في هذا الانتقال، وتحقق اتصال السند، كما تبين حال الراوي من مقابلة طريقته في الأداء للحديث بطريقة تلقيه لهذا الحديث، من حيث العدالة أو اختلالها، أو التدليس في الأداء بما يوهم طريقة عالية في تلقي الحديث سوى التي أخذ بها الحديث، وغير ذلك(4).
أقسام مناهج المحدثين:
تنقسم مناهج المحدثين إلى قسمين، مناهج عامة ومناهج خاصة:
أولاً: المناهج العامة: وهي الطرق التي يسير على كل منها جماعة من المحدثين، مثل كتب: المسانيد، والجوامع، والسنن، والمعاجم، وغيرها.
ثانيًا: المناهج الخاصة: وهي كل طريقة يختص بها المحدث عن أمثاله؛ مثل ما يختص به المسند للإمام أحمد، والمسند لبقي بن مخلد عن غيرهما.
ومثل ما يختص به كل من صحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي، عن غيرها من الكتب المرتبة على الموضوعات.
تعريف آخر لمناهج المحدثين:
هو العلم الذي يكشف لنا طريقة المصنف في كتابه، من حيث الترتيب والتبويب، واختيار الشيوخ والطرق، وصياغة الأسانيد، ويبين كذلك شروط المصنف ومصطلحاته الخاصة به، ومعرفة موضوعه، بما يعين على فهم ذلك الكتاب، والاستفادة منه على أكمل وجه.
وهذا تعريف جيد بالجملة، لكن يلاحظ عليه:
1 – أنه عرف المناهج الخاصة فقط، كما هو ظاهر، ولم يشر إلى المناهج العامة.
2 – أنه وسع التعريف وأطنب فيه، وذكر ما ليس من المناهج.
3 – أنه لم يعرض لمناهجهم في الرواية. والتعاريف يراعى فيها الإيجاز والشمول.
التأصيل الشرعي لمناهج المحدثين:
وقد نشأ هذا المنهج الجليل في عهد الصحابة الكرام ومع نشأة الرواية في الإسلام.
ولعل أول من فتش(5) عن الرجال(علم الرواية) من الصحابة: أبو بكر الصديق، وعمر، وعلي رضي الله عنهم، فقد جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله الميراث، فسأل الصحابة، فأجابه المغيرة بن شعبة بأنها ترث السدس – عن رسول الله ﷺ – فطلب منه أن يأتي بشاهد، فشهد معه محمد بن مسلمة رضي الله عنه.
وكذا فعل عمر رضي الله عنه حين طلب من أبي موسى الأشعري أن يأتيه بشاهد عن النبي ﷺ حينما ذكر له حديث الاستئذان(6).
وكان علي رضي الله عنه يستحلف من يحدثه بحديث عن رسول الله ﷺ وإن كان ثقة مأمونًا، ويقول في هذا: “كنت إذا سمعت من رسول الله ﷺ حديثًا نفعني الله عز وجل بما شاء أن ينفعني منه، وإذا حدثني غيره استحلفته، فحدثني أبو بكر، وصدق أبو بكر…”(7).
قال ابن الوزير رحمه الله: “وعلي رضي الله عنه لم يتهم الراوي بتعمد الكذب، لأنه لو اتهمه بذلك لاتهمه بالفجور باليمين ولم يصدقه إذا حلف، وإنما اتهمه بالتساهل في الرواية بالظن الغالب، فمع يمينه قوي ظنه بأنه متقن لما رواه حفظًا، وإن امتنع عن اليمين يعرف أنه غير متقن ولا مستيقن، فيكون هذا علة في قبول حديثه”(8).
وذكر الحاكم أن أبا بكر، وعمر، وعليا، وزيد بن ثابت، جرحوا وعدلوا وبحثوا عن صحة الروايات وسقيمها”(9).
وكان هذا في عهد كبار الصحابة فلما ذر قرن الفتن، وظهرت الخلافات خفت الأمانة فجرح صغار الصحابة عددًا من الرواة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: “إنا كنا نحدث عن رسول الله ﷺ إذ لم يكذب عليه فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه”.
وفي رواية أخرى عن ابن عباس: “لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف”(10).
وقد كذب عبد الله بن عباس نوفا البكالي، وقال: “كذب عدو الله” كما في صحيح البخاري(11).
ثم نما وتطور وقوي واشتد عوده في القرن الثاني، وامتد واتسع وبدأ يتكامل في القرن الثالث والرابع، وهكذا حتى اكتمل في القرن التاسع تقريبًا، حيث كثرت فيه الكتب وتنوعت فيه المؤلفات(12).
والأصل في ذلك: الكتاب، والسنة، وعمل الأئمة:
فمن الكتاب: قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)(13).
ووجه الدلالة من الآية: أمر الله عز وجل أن لا نأخذ بأخبار الفسقة وغير الثقات؛ ووجوب التثبت من حقيقة خبر الفاسق. وما جعل الجرح والتعديل إلا لأجل التثبت في نقل الأخبار.
وكما أن الله تعالى قد ذم المنافقين والكافرين والكاذبين في آيات كثيرة، فقد أثنى وعدل سبحانه وتعالى الصحابة في محكم قوله سبحانه: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) الآية.
وقوله تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا)
والوسط: هم العدول الخيار.
ومن السنة النبوية:
1/ ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً استأذن على النبي ﷺ فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة فلما جلس تطلق النبي ﷺ في وجهه وانبسط إليه فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه فقال رسول الله ﷺ: ياعائشة متى عهدتني فحاشًا إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره.(14)
وجه الدلالة من الحديث:
قال أبو حاتم بن حبان البستي رحمه الله: “وفي هذا الخبر أن إخبار الرجل بما في الرجل على جنس الديانة ليس بغيبة؛ إذ النبي ﷺ قال: “بئس أخو العشيرة، أو ابن العشيرة …”، ولو كان غيبة لم يطلقها رسول الله ﷺ،… وإنما الغيبة ما يريد القائل القدح في المقول فيه.
وأئمتنا – رحمة الله عليهم – فإنهم إنما بينوا هذه الأشياء، وأطلقوا الجرح في غير العدول لئلا يحتج بأخبارهم، لا أنهم أرادوا ثلبهم والوقيعة فيهم، والإخبار عن الشيء لا يكون غيبة إذا أراد القائل به غير الثلب”(15).
وقال الخطيب البغدادي: “وفي قول النبي ﷺ للرجل “بئس رجل العشيرة” دليل على أن إخبار المخبر بما يكون في الرجل من العيب على ما يوجب العلم والدين من النصيحة للسائل ليس بغيبة، إذ لو كان ذلك غيبة لما أطلقه النبي ﷺ، وإنما أراد عليه السلام بما ذكر فيه والله أعلم أن يبين للناس الحالة المذمومة منه، وهي الفحش فيجتنبوها، لا أنه أراد الطعن عليه والثلب له.
وكذلك أئمتنا في العلم بهذه الصناعة إنما أطلقوا الجرح فيمن ليس بعدل لئلا يتغطى أمره على من لا يخبره فيظنه من أهل العدالة فيحتج بخبره، والإخبار عن حقيقة الأمر إذا كان على الوجه الذي ذكرناه لا يكون غيبة”(16).
والنبي ﷺ تكلم في ذلك الرجل على وجه الذم لما كان في ذلك مصلحة شرعية، وهي التنبيه إلى سوء خلقه ليحذره السامع كما يفيده قوله ﷺ: “إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره”.
ولذلك تطلق في وجهه وانبسط إليه مداراة له لا مداهنة(17).
2/ عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله ﷺ “أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحي أسامة “فنكحته فجعل الله فيه خيرًا واغتبطت.
وفي رواية: فقال رسول الله ﷺ “أما معاوية فرجل ترب لا مال له وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة بن زيد”(18).
وجه الدلالة من الحديث:
قال الخطيب البغدادي: “في هذا الخبر دلالة على أن إجازة الجرح للضعفاء من جهة النصيحة لتجتنب الرواية عنهم وليعدل عن الاحتجاج بأخبارهم لأن رسول الله ﷺ لما ذكر في أبي جهم أنه لا يضع عصاه عن عاتقه وأخبر عن معاوية أنه صعلوك لا مال له، عند مشورة استشير فيها لا تتعدى المستشير، كان ذكر العيوب الكامنة في بعض نقلة السنن التي يؤدي السكوت عن إظهارها عنهم وكشفها عليهم إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام وإلى الفساد في شريعة الإسلام أولى بالجواز وأحق بالإظهار… فكذلك يجب على جميع من عنده علم من ناقل خبر أو حامل أثر ممن لا يبلغ محله في الدين محل عائشة أم المؤمنين ولا منزلته من رسول الله ﷺ منزلتها منه بخصلة تكون منه يضعف خبره عند إظهارها عليه وبجرحه تثبت فيه يسقط حديثه عند ذكرها عنه أن يبديها لمن لا علم له به، ليكون بتحذير الناس إياه من الناصرين لدين الله الذابين الكذب عن رسول الله ﷺ فيالها منزلة ما أعظمها أو مرتبة ما أشرفها وإن جهلها جاهل وأنكرها منكر”(19).
والنبي ﷺ ذكر معاوية وأبا جهم رضي الله عنهما بما فيهما لتتحقق المصلحة وهي المشورة على المستشير بالأصلح له، ولذلك قال لها عليه الصلاة والسلام: “انكحي أسامة بن زيد”.
ومما جاء عن العلماء في ذلك ما يلي:
1 – عن عفان بن مسلم، قال: كنا عند إسماعيل بن علية، فحدث رجل عن رجل، فقلت: إن هذا ليس بثبت. قال: فقال الرجل: اغتبته!
فقال إسماعيل: “ما اغتابه، ولكنه حكم أنه ليس بثبت”(20).
2 – قال عبد الله بن المبارك قلت لسفيان الثوري إن عباد بن كثير من تعرف حاله وإذا حدث جاء بأمر عظيم، فترى أن أقول للناس لا تأخذوا عنه؟ قال سفيان: بلى؛ قال عبد الله: فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في دينه وأقول: لا تأخذوا عنه(21).
3 – قال الحسن بن الربيع: قال ابن المبارك: “المعلى لا بأس به ما لم يجيء بالحديث فإنه يكذب، قال: فقال له بعض الصوفية: يا أبا عبدالرحمن: تغتاب؟ فقال: اسكت، إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل، ومن يبين؟”(22).
4 – وعن مسعر، قال: سمعت سعد بن إبراهيم يقول: “لا يحدث عن رسول الله ﷺ إلا الثقات”(23).
5 – وقال النووي رحمه الله:(جرح الرواة جائز بالإجماع، بل واجب للحاجة).
غاية علم مناهج المحدثين:
يظل تكوين العالم بأي علم ناقصًا ما لم يحط بمناهج علماء هذا العلم، وطرق بحثهم في مؤلفاتهم أو في دراساتهم وبحوثهم، فكيف بمناهج أئمة الحديث، الذين حفظوا لهذه الأمة الأصل الثاني من أصول دينها، ألا وهو الحديث النبوي، فكان للعلم بمناهج المحدثين أهمية عظيمة، ومنزلة عالية بين علوم الحديث، لما يحققه من أهداف وغايات، منها:
1/معرفة الدقة والمنهجية التي أحاطت بها هذه الأمة الحديث رواية ودراية، لتأمن عليه الخطأ والتحريف في أثناء تناقله بين الرواة.
2/ التمييز بين المناهج المقبولة في الرواية وغير المقبولة، وشروط القبول للمقبولة.
3/الإفادة في كيفية تخريج الحديث من هذه المصادر، والالتفات إلى دقائق في التخريج، لا يعرفها من لم يخبر مناهجهم.
4/الوصول إلى تمييز صحيح الحديث من غيره، ثم إلى معرفة شرحه من الشروح المصنفة على كل مصدر منها، وهي كثيرة.
5/دقة المنهجية العلمية التي اتبعها علماء الحديث، في الانتقاء والتصنيف.
6/تمييز كتب الحديث عن بعضها، ومدى إفادة روايتها للحديث عن منزلته من القبول أو الرد.
7/التعرف على أشهر المحدثين المصنفين، وما لهم من فضل في خدمة الحديث النبوي، وسيرتهم المباركة.
8/فهم مقاصد المحدثين التي يهدفون إليها، في كيفية ترتيبهم، وفي طرائقهم في صياغة عناوين الأبواب المعروفة بالتراجم.
وقد اشتهر بذلك الإمام البخاري، حتى قالوا: (فقه البخاري في تراجمه).
وننبه كذلك إلى أن فقه سائر المحدثين هو أيضًا في تراجمهم.
نشأة مناهج المحدثين:
منهج كل شيء يحكم على الشيء قوةً أو ضعفًا، ولأهمية المنهج في علم الحديث كانت نشأته مرافقة لنشأة روايته، ثم نمت وتدرجت مع نمو العلم وتدرجه حتى واكبت تمام نضجه.
وطبعي أن تكون أول المناهج ظهورًا مناهج الرواية في عهد الصحابة الذين استنبطوها من كتاب الله تعالى، وتعاليم نبيه ﷺ، فظهرت في أيامهم الرواية بالسماع والعرض والكتابة، وكثرت الكتابة بعد الصحابة، وظهرت مجموعات تنسخ ويتداولها أهل العلم، فظهرت الإجازة، كما يروى ذلك عن الإمام الزهري محمد بن مسلم بن شهاب (ت 125 هـ).
ثم انتقلت رواية الحديث إلى رواية الكتب فأصبحت تتناقل كما ينقل الحديث، يراعى اتصال النسخة بمؤلفها بالسند إليه، أو بكون النسخة مقابلة بها أو بما هو مقابل بها، مما دون في شروط الضبط بالكتاب والرواية منه، حتى يتصل السند بالمؤلف.
أما في مناهج التأليف والجمع والترتيب فقد كان أول مناهج التصنيف ظهورًا منهج التصنيف على الموضوعات في الكتب التي عرفت بالجوامع. مثل: جامع هشام بن حسان (ت 148هـ) وجامع سفيان الثوري (ت 161هـ) وجامع معمر بن راشد الجزري (ت 154هـ) وابن جريح (ت150هـ)، سميت بذلك لأنها جمعت الأحاديث بعضها إلى بعض. وكانت مرتبة على الأبواب.
ثم ظهرت الموطآت، وأشهرها الموطأ للإمام مالك (ت 179 هـ) وفيها الأحاديث واستنباط المصنف للكتاب، وتأييده بأقوال الصحابة والتابعين.
وتلت الموطآت المصنفات، وهي مؤلفات على الموضوعات تذكر الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، مثل مصنف وكيع بن الجراح (ت 197 هـ) ومصنف عبدالرزاق بن همام (ت 211 هـ) وأبي بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ) وفي رأس المائة الثانية رأت طائفة من الأئمة إفراد الحديث المرفوع بالجمع، فوجدت لذلك طريقة المسانيد، وانتشرت وكثرت، حتى قل إمام لم يصنف على المسند.
ثم جاء الإمام أمير المؤمنين في الحديث أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (ت 256 هـ) وكان قد أوتي حظًا عظيمًا في حفظ الحديث والعلم بعلله، وأوتي قدرًا عاليًا في الفقه والاستنباط، فصنف جامعه الصحيح والفقه فيه، وتبعه تلميذه مسلم بن الحجاج (ت 261 هـ)، لكنه نحى في كتابه منحى الاعتناء بفن الإسناد وصناعة الإسناد دون الفقه.
المصادر في مناهج المحدثين:
لأهمية العلم بمنهج المحدث في كتابه نجد البحث في مناهج المحدثين يواكب ظهور الكتب المعتبرة أمهات المصادر في الحديث الشريف. وكانت بداية ذلك نقول عن الإمام المصنف، ثم كتابات يكتبها المؤلفون أنفسهم، أفاد منها العلماء المحققون، وأضافوا أليها نتائج بحوثهم واستقرائهم للكتب.
1/ النقول عن الأئمة:
أقدمها ما نقل عن الإمام مالك بن أنس في إعداد موطئه، وما ذكره أصحابه عنه، كما أخرج ابن عبدالبر عن المفضل بن محمد قال: (أول من عمل كتابًا بالمدينة على معنى الموطأ من ذكر ما اجتمع عليه أهل المدينة عبدالعزيز الماجشون، وعمل ذلك كلامًا بغير حديث، فأتى به مالكًا فنظر فيه فقال: ما أحسن ما عمل، ولو كنت أنا الذي عملت ابتدأت بالآثار ثم شددت ذلك بالكلام. قال: ثم إن مالكًا عزم على تصنيف الموطأ فصنفه…)(24).
وقال مالك: (عرضت كتابي هذا على سبعين فقيهًا من فقهاء المدينة فكلهم واطأني عليه)(25).
وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: (لما وضع مالك الموطأ جعل أحاديث زيد بن أسلم في آخر الأبواب. فقلت له في ذلك؟
فقال: (إنها كالسراج تضيء لما قبلها)(26).
ثم ما نقل عن الإمام البخاري حول عمله في كتابه كقوله: (لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحًا، وما تركت من الصحيح أكثر).
وقوله: (كنت عند إسحاق بن راهويه فقال لنا بعض أصحابنا: لو جمعتم كتابًا مختصرًا لسنن النبي ﷺ. فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب)(27).
وقوله في بعض نسخ الجامع الصحيح في أثناء كتاب الحج في باب تعجيل الوقوف: «يزاد في هذا الباب حديث مالك عن ابن شهاب، ولكني لا أريد أن أدخل فيه معادًا»(28).
أي بالسند والمتن نفسه، بل يخرجه من طريق آخر، ولو اختلف براو واحد.
2/ ما كتبه المؤلفون أنفسهم:
وأقدمه مقدمة الإمام مسلم بن الحجاج لجامعه الصحيح، ورسالة أبي داود السجستاني لعلماء مكة، وكتاب العلل الصغير للإمام الترمذي الذي جعله ختام كتابه الجامع المعروف بسنن الترمذي.
ثم تتابع الجامعون للحديث على بيان مناهجهم ما بين مفصل مستقص، ومجمل مختصر، وكان من بين المفصلين ابن الأثير الجزري: المبارك بن محمد (ت 606 هـ) في المقدمة الوفية القيمة التي كتبها لكتابه القيم جامع الأصول، التي تعتبر كتابًا مفيدًا في تدوين الحديث وأنواع المصنفات ومقاصد أصحابها والتعريف بالكتب الستة التي جمعها، وبأصول عامة للمحدثين ومصطلحاتهم.
واعتبارًا من أواخر القرن الرابع الهجري ظهرت مؤلفات مفردة في مناهج المحدثين، تدرس قواعد كل منهم في اختيار الأحاديث لكتابه، والمستوى الذي يلحظ فيها، وتصرفه في كتابه وذلك فيما عرف بالشروط.
وكان أول ما ظهر منها كتاب أبي عبدالله محمد بن إسحاق بن منده (ت 395 هـ) وفيه بعض شروط عامة للأئمة الستة وبعض أئمة غيرهم، وكان بداية ونواة يسيرة.
ثم ظهر “شروط الأئمة الستة” للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي (ت 507 هـ).
ثم جاء بعده الإمام أبو بكر محمد بن موسى الحازمي (ت 584 هـ) فصنف كتابه (شروط الأئمة الخمسة) اقتبس فيه كثيرًا من كتاب المقدسي وأضاف إليه فوائد وعوائد كثيرة مهمة.
ثم في القرن السابع الهجري جاء الإمام شيخ الإسلام أبو عمرو عثمان بن صلاح الشهرزوري (ت 643 هـ) وصنف كتابه الجليل (علوم الحديث)، الذي كان فتحًا في هذا العلم، أودع فيه لمناسبة حديثه عن مصادر الصحيح ومصادر الحسن فوائد مهمة في مناهج أصحاب الكتب التي ذكرها ووسع ذلك الشراح بعده، كما في تدريب الراوي للسيوطي، وفتح المغيث للسخاوي.
وهكذا اتخذ البحث في مناهج المحدثين ثلاثة طرق لا يخرج عنها وهي:
1/حديث المؤلف في مقدمة كتابه، كما في صحيح مسلم، أو ختامه كما علل الترمذي الصغير، أو في بحث مفرد كما في رسالة أبي داود لأهل مكة.
2/مقدمات الشروح التي كتبت على كتب الحديث، مثل هدي الساري مقدمة فتح الباري، ومقدمة فتح الملهم شرح صحيح مسلم للعلامة الشيخ شبير أحمد، وهي مقدمات فياضة.
3/ بحوث في مصادر علوم الحديث، لمناسبة التعريف بكتاب من كتب الحديث المهمة الستة أو غيرها، حين يأتي ذكره في هذا المؤلف.
الهوامش
1 – ينظر: النهاية في غريب الحديث (4/185)، مختار الصحاح ص 681، والقاموس المحيط (النهج) ص 266.
2 – سورة المائدة، الآية 48.
3 – ينظر: المراجع السابقة.
4 – ينظر: مناهج المحدثين العامة د. نور الدين عتر ص 9-10، مناهج المحدثين العامة والخاصة، د. علي بقاعي ص 20.
5 – تذكرة الحفاظ (1/3).
6 – أخرج هذه القصة البخاري ومسلم ومالك وغيرهم، والحديث «إذا استأذن أحدكم ثلاثًا فلم يؤذن له فليرجع». فقال له عمر رضي الله عنه: والله لتقيمن عليه البينة، فجاء حلقة الصحابة وشهد معه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه.
7 – أخرجه أحمد في المسند، وينظر: الكفاية (ص68).
8 – الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم (1/52).
9 – معرفة علوم الحديث (ص52).
10 – مقدمة صحيح مسلم (7).
11 – كتاب العلم، الباب رقم 44 .
12 – ينظر تفاصيل مراحل هذا العلم نشأة وتدوينا في «علم رجال الحديث » للمظاهري ص99 .
13 – قال الإمام أحمد في المسند30/403 : حدثنا محمد بن سابق حدثنا عيسى بن دينار حدثنا أبي أنه سمع الحارث بن أبي ضرار الخزاعي قال: قدمت على رسول الله ﷺ فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به فدعاني إلى الزكاة فأقررت بها وقلت يا رسول الله أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة فمن استجاب لي جمعت زكاته فيرسل إلي رسول الله ﷺ رسولاً لإبان كذا وكذا ليأتيك ما جمعت من الزكاة فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله ﷺ أن يبعث إليه احتبس عليه الرسول فلم يأته فظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله عز وجل ورسوله فدعا بسروات قومه فقال لهم إن رسول الله ﷺ كان وقت لي وقتًا يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة وليس من رسول الله ﷺ الخلف ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة كانت فانطلقوا فنأتي رسول الله ﷺ وبعث رسول الله ﷺ الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق فرجع فأتى رسول الله ﷺ وقال يا رسول الله إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي فضرب رسول الله ﷺ البعث إلى الحارث فأقبل الحارث بأصحابه إذ استقبل البعث وفصل من المدينة لقيهم الحارث فقالوا هذا الحارث فلما غشيهم قال لهم إلى من بعثتم قالوا إليك قال ولم قالوا إن رسول الله ﷺ كان بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله قال لا والذي بعث محمدًا بالحق ما رأيته بتة ولا أتاني فلما دخل الحارث على رسول الله ﷺ قال منعت الزكاة وأردت قتل رسولي قال لا والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول رسول الله ﷺ خشيت أن تكون كانت سخطة من الله عز وجل ورسوله قال فنزلت الحجرات: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين}.
14 – أخرجه البخاري في صحيحه (10/452) (برقم 6032)، ومسلم (4/2002) (برقم 2591).
15 – مقدمة كتاب المجروحين (ص 18).
16 – ينظر: الكفاية (39).
17 – في فتح الباري10/454: والفرق بين المداراة والمداهنة أن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معًا، وهي مباحة، وربما استحبت، والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا، والنبي ﷺ إنما بذل له من دنياه حسن عشرته والرفق في مكالمته ومع ذلك فلم يمدحه بقول فلم يناقض قوله فيه فعله، فإن قوله فيه قول حق، وفعله معه حسن عشرة، فيزول مع هذا التقرير الإشكال بحمد الله تعالى.
وقفة: هل يدل الحديث على جواز الغيبة؟
قال ابن حجر في الفتح 471-472: ويستنبط منه أن المجاهر بالفسق والشر لا يكون ما يذكر عنه من ذلك من ورائه من الغيبة المذمومة، قال العلماء: تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعًا حيث يتعين طريقًا إلى الوصول إليه بها: كالتظلم، والاستعانة على تغيير المنكر، والاستفتاء، والمحاكمة، والتحذير من الشر، ويدخل فيه تجريح الرواة والشهود، وإعلام من له ولاية عامة بسيرة من هو تحت يده، وجواب الاستشارة في نكاح أو عقد من العقود، وكذا من رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق ويخاف عليه الاقتداء به. وممن تجوز غيبتهم من يتجاهر بالفسق أو الظلم أو البدعة. والله أعلم. وبسط النووي الكلام في هذا في الأذكار ص292.
18 – أخرجه مسلم في صحيحه (2/1114) (برقم 1480)، وأبو داود في سننه (2/712- 713) (برقم 2284).
19 – ينظر: الكفاية (ص 40 – 41). وفيه غير ذلك من الأدلة النقلية الكثيرة على جواز الجرح، وبيان عيوب الرواة.
20 – ينظر: مقدمة صحيح مسلم (ص 26)..
21 – ينظر: مقدمة صحيح مسلم (ص 17).
22 – ينظر: الكفاية (ص45)، وتهذيب التهذيب (10/242).
23 – ينظر: مقدمة صحيح مسلم (ص 15).
24 – تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك للسيوطي: 1/6.
25 – المرجع السابق: 1/5.
26 – المرجع نفسه: 1/6.
27 – شروط الأئمة الخمسة للحازمي: 64-65 وينظر هدي الساري: 1/4.
28 – هدي الساري: 1/10-11.
عدد التحميلات: 2