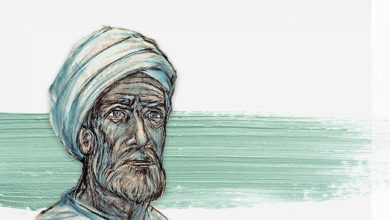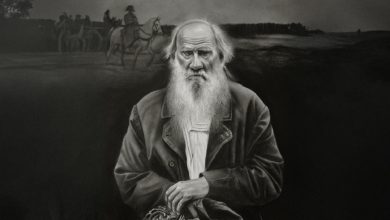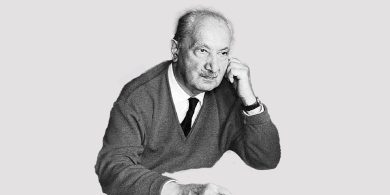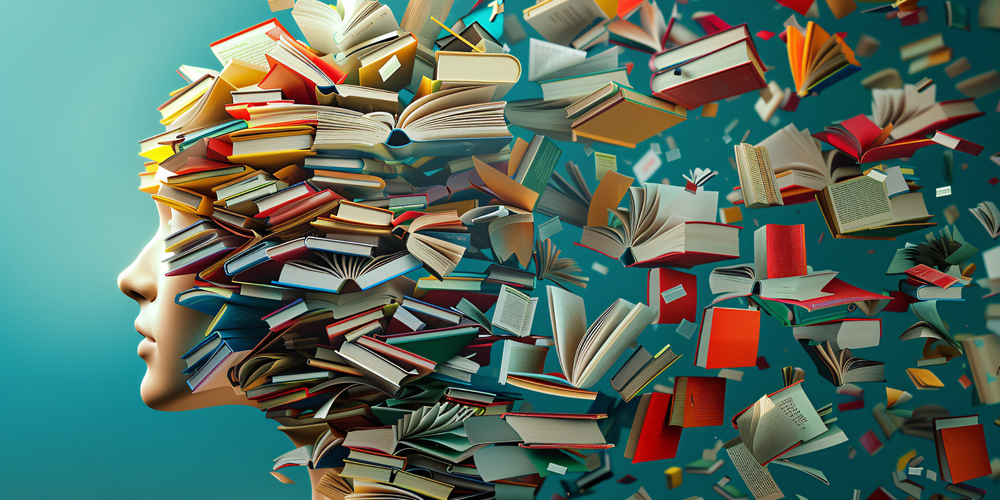
القطرس، هذا المسافر العظيم،
يرافق السفن في رحلاتها البطيئة،
يسخر منه البحّارة، حين يهبط على سطح السفينة،
ويصبح عاجزًا، وغريبًا، ومثيرًا للشفقة”
قصيدة القطرس Albatross
شارل بودلير
من ديوان أزهار الشر
غريبة هي الأفكار التي تعبث برأس صاحبها دون توقف، مناشدة استمرارية الغوص داخل عوالم خاصة بها، حيث يمر الآخرون إلى جوارها وقد كُفت أعينهم عن رؤية مقدار التوحش الذي لحق بها، ذلك الشعور الغريب بالعدمية كسرب من الدخان تبعثره أنامل الرياح العاتية، كأقوال عبثية متلحفة بخيوط واهية من المعرفة، دون قدرة حقيقية على قراءة النفس البشرية وفهم طباعها، كأنشودة حب في ميتم، أو كترنيمة جنائزية وسط احتفال، إنه الاغتراب….
إن الشعور بالغربة هو جزء من شعور الإنسان بهويته البشرية، الخروج من النمط السائد الذي تراه يحاول أن يمسك بخناق البشر جميعًا ويجعلهم نسخة كربونية من بعضهم، يسعى البشر باختلاف أنواعهم إلى التميز، والتفرد الذي قد يصل بهم في النهاية إلى التوحش.
تناولت الكثير من الأعمال الأدبية تلك التيمة التي تراها تمسخ هوية صاحبها وتحوله إلى شيء قد لا يعبر عن حقيقته، فمن عالِم يسعى للتميز فيخلق وحشًا، ومن موظف يشعر بالغربة في بيته فيُمسخ، ومن فتاة تشعر بالغربة داخل جسدها فتتجمد، ومن مجتمع يشعر بالوحدة فيتمرد، صور متفردة لشكل واحد من الانسلاخ.
تتناول تلك الرؤية النقدية مفهوم مقاومة التماثل التي تعتري مجموعة من الشخصيات الأدبية التي انفرجت عنها قريحة الفكر الغربي والشرقي باختلاف مركزيته الثقافية، وتشابه الأفكار الإنسانية فيه.
تعمقت العديد من الأعمال الأدبية في خبايا النفس البشرية، وفتشت في دهاليز المعرفة العاطفية والشعور العقلاني عن أحلك أسرارها، حتى يكاد كل عمل أدبي يحمل بين بصماته لمحة خفية من مستورات صاحبه الدفينة، وكأنه يحمل اعترافًا ضمنيًا بخطيئته الإنسانية التي يتساوى فيها البشر قاطبة، وقد يحدث عند تجزئة العمل الأدبي أن يجد الناقد نوعًا من الانسلاخ الأدبي في خلفية العمل، وعند النبش وراء آثاره يجد أن ذلك التفكك ما هو إلا انحراف كاتبه عن المسار المحدد من أجل الاضطلاع في الكشف عن خصوصياته بصورة مستترة تحت خيوط من الجمل الكاشفة والكلمات الشفافة، ويمكن التمثيل لذلك بمجموعة من الأعمال الأدبية، وهي:
- فرانكنشتاين لماري شيلي
- التحول لفرانز كافكا
- النباتية لهان كانغ
التمزق الوجودي بين الوحدة وعدم الانتماء:
تبدأ المأساة برهبة… مجموعة من الأدباء الشبان التحفوا في ليلة ثلجية بظلال نيران تهسهس بأهازيج شبحية، فقرر كل منهم أن يحكي قصة مرعبة، واقشعرت الأبدان من الهمسات الخافتة حيث صالت الأخيلة في حواري التوتر والترقب، وبعيون تنبض بالإثارة شاركتهم ماري شيلي الاستماع إلى الحكاوي، ولما لم يكن في جعبتها ما يجعلها تشاركهم لحظات البوح، فقد خلدت إلى وسادتها تستلهم من هدوء الليل طُعمًا لإلهامها، ثم شعرت به ينظر إليها وهي نائمة، يستعد لاستيقاظها ليسألها عن سر الوجود، فقامت فزعة وخلقت أسطورة فرانكنشتاين.
رواية فرانكنشتاين في قراءة أدبية نقدية ليست عن خلق الحياة من العدم، بل عن ولادة الغربة من رحم الطموح، وعن المسافة الشاسعة بين العقل الهارب نحو المجد، والجسد المنبوذ في هوامش الإبداع، إنها سردية الوعي حين يرتكب الخطيئة الأولى باسم العلم، ويجد نفسه وجهًا لوجه أمام انعكاس مشوه لروحه.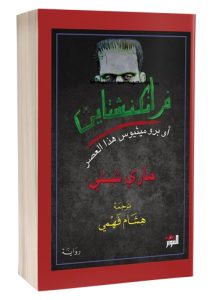
فيكتور لم يكن عالمًا تقليديًا، بل شابًا مهووسًا بسردية التفرد، يسعى لأن يكون نبيّا في عصره، مُبدعًا متفردًا في زمن تكراري. لم يكن يبحث عن المعرفة، بل عن الخلود، عن بصمة لا تُمحى، مهما كانت ملطخة باللحم الميت والأنسجة البالية، دفعه جنونه إلى اقتراف أعظم خطيئة يمكن للعلم ارتكابها ألا وهي صنع حياة، جسدٌ بلا نسب، نفسٌ بلا دعوة، كائنٌ يهذي بالسؤال لماذا وُجدت؟
ما إن قام الكائن حتى كان أول ما فعله هو أن تكلّم، لم يزأر كوحش، بل سأل كإنسان: أين أنا؟ من أنا؟ ولماذا؟ لكنه لم يجد الجواب، لا عند صانعه الذي هرب، ولا عند مجتمع لا يعترف بما لم يولد من رحمه؛ فغرق في غربة تكوينية، لا تتعلق بالمكان، بل بمعنى الكينونة ذاتها.
كان المخلوق صورة لعصر يخاف التشوّه، ويقمع كل من لا يشبهه، ولأنه لا يُشبه أحدًا، حُكم عليه بالوحشية، فبدأ تمرده الكبير بالقتل، لا كفعل انتقامي، بل بوصفه صرخة هوية، وكبحثٍ محموم عن “نصف مشوّه” يكمله، عن مرآة تؤكد أن وجوده ليس عبثًا.
وعندما تقابل الاثنان، لم يكن اللقاء بين صانع ومصنوع، بل بين ذاتين مكسورتين، كل واحدة منهما تحمل خراب الأخرى، فيكتور يرى في مخلوقه فشله، والمخلوق يرى في فيكتور ظلمه، لم تكن النهاية لحظة موت، بل تكثيفًا للمأساة الوجودية: لا أحد منهم نجا، لأن كليهما كان نتاج عزلة وألم وخطأ لا يُغتفر.
أعادت ماري شيلي إلى الوعي الجمعي كائنًا بلا اسم، فكانت اللعنة أن يُنسب الوحش إلى صانعه؛ إذ بات اسم فرانكنشتاين يلتصق بصورته المشوهة في المخيلة الشعبية، بينما ظل التمييز بين الصانع والمصنوع رفاهية لا يملكها سوى قلة من القرّاء المتأملين، لم يكن المخلوق شرًا خالصًا، بل علامةً فارقة على تمرّد الذات على المألوف، ورغبة جامحة في انتزاع لحظة ابتكار خارجة عن نطاق المسموح والتقليدي.
بمزاوجتها بين الرعب القوطي والعوالم الماورائية، رسّخت شيلي روايتها في ذاكرة الأدب بوصفها صرخة في وجه الوجود الهشّ، حيث يتحول السرد إلى مرآة لتمزق داخلي لا يجد خلاصه. حتى اليوم، تظل أسطورة فرانكنشتاين مادةً طيّعة للتأويل الفلسفي، خصوصًا حين نتتبع المأساة التي بدأها وحشٌ يبحث عن إجابة في عقل من أنجبه دون رغبة أو مسؤولية.
وفي تلك الليلة العاصفة، حين لم تستطع ماري شيلي أن تروي حكاية مرعبة، ولدت الغربة في شكل مخلوق لا يملك سوى السؤال، تمامًا كما كانت الكاتبة تطرح سؤالها الخاص: ماذا يعني أن نخلق معنىً في عالمٍ ينكره؟ وهل الوحش الذي نصنعه هو آخرٌ منفصل، أم هو المرآة الأكثر صدقًا لقلقنا الداخلي؟
العدمية والتمسخ:
حين تلامسك أنامل الكلمات التي ينسجها فرانز كافكا، لا تدخل عالمًا بل تُسحب إلى هاوية، إلى مدنٍ لا تُرى إلا بالحدس، مدن الفراغ والتيه، حيث اللغة نفسها تبدو ككائنٍ منفلت، تهرب منك الجمل كما يهرب المعنى من كاتبٍ يطارده الوهم. كل محاولة للإمساك بالفكرة تُقابل بصفعة من عبارة زائفة، كأن النص ذاته يرفض أن يُفهم، أن يُروى، أن يُروّض.
كافكا ليس مجرد كاتب، بل نصير العدمية، سيد القصر المظلم، ومهندس التمزق الداخلي، تقف أمام كلماته لا كقارئ، بل كمتهم في محكمة لا تملك فيها اسمًا ولا تهمة واضحة، سوى أنك موجود. في روايته القصيرة التحول، يستيقظ جريجور سامسا، الموظف العادي، ليجد نفسه قد تحول إلى حشرة ضخمة، لا تفسير، لا سبب، فقط تحوّل فجّ يعري هشاشة الوجود، أهله، الذين يفترض أن يكونوا ملاذه، لا يرونه إلا عبئًا، شيئًا غريبًا يثقل كاهلهم، حتى إذا مات، تنفسوا الصعداء، كأنهم تخلصوا من خطأ بيولوجيٍّ لا يخصهم.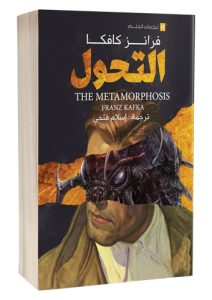
الرواية ليست عن حشرة، بل عن انسلاخ الفرد من ذاته حين يغرق في روتينٍ يبتلع روحه، عن ذلك القفص الحديدي الذي لا يُرى، لكنه يُحسّ، يُضغط على القلب دون توقف، القفص ليس من صنع الغرباء، بل من أقرب الناس، من أولئك الذين يُفترض أن يمنحوا الدفء، فإذا بهم يصنعون الأغلال. أين المفر؟ كيف يهرب الإنسان دون أن يفقد أجزاءً من نفسه؟ كيف ينجو دون أن يتحوّل إلى مسخٍ رمزيّ، جسدٍ يحمل روحًا مثقوبة، وظلًا لا يعرف صاحبه؟
كافكا لا يكتب عن التحول، بل عن التحلل البطيء للذات تحت وطأة التوقعات، العزلة، واللا جدوى، روايته ليست سردًا، بل مرآة مشروخة يرى فيها القارئ صورته حين تتآكل إنسانيته، ويصبح مجرد كائنٍ يؤدي وظيفة، يسكن غرفة، يُنتظر موته.
إن جريجور سامسا ليس سوى الوجه المعكوس لفرانكنشتاين كلاهما وليد مجتمعٍ مختل، لا يخلق الفرد إلا ليقمعه، لا يمنحه هوية إلا ليحاصرها، ذلك المجتمع يرسم للفرد حدودًا ضيقة، كأنها قفصٌ من توقعاتٍ وأعراف، وما إن يحاول أن يتجاوزها، أن يتنفس خارجها، حتى يُوسم بالخطيئة، ويُعاقب بالتمسخ.
سامسا لم يختر تحوّله، كما لم يختر مخلوق فرانكنشتاين شكله، كلاهما نتاج رفضٍ بنيويّ للذات الخارجة عن المألوف، وكأن المجتمع لا يحتمل اختلافًا دون أن يرد عليه بالتشويه، والتمسخ هنا ليس بيولوجيًا، بل رمزيّا إنه اللعنة التي يُنزلها النظام على من يجرؤ على أن يكون خارج النموذج.
إن سامسا هو الوجه المرتجف لكافكا، الروح القلقة التي تسكنه، ذلك الشعور المتجذر بالخوف من الغربة، من الانفصال عن نسيج المجتمع، من أن يُرى دون أن يُفهم، أو يُحكم عليه دون أن يُسمع، هو التمثيل الحيّ لعدم الانتماء، كائن يتخفّى خلف وجهٍ إنساني مشوّه، لا لأن ملامحه قبيحة، بل لأن روحه تنزف من فرط التوتر بين العقل والقلب، بين ما يُراد له أن يكون وما يشعر به.
سامسا ليس مجرد موظف تحوّل إلى حشرة، بل هو كائنٌ ليليّ خرج من كوابيس كافكا، كما خرج مخلوق شيلي من رحم الخيال في تلك الليلة العاصفة، كلاهما ظهر ليقضّ مضجع كاتبه، ليهلكه رمزيًا، لا بالقتل، بل بكشف ما هو كامن، ما هو مخبوء في الأعماق: الوحش الذي يسكن الداخل، الذي لا يُرى إلا حين تنهار الأقنعة.
الحمية المجتمعية والانعزال الأنطولوجي:
هذه المرة، نحن لا نقف أمام وحشٍ تقليدي، أو مخلوقٍ من روحٍ معذبة أنجبها خيالٌ قلق، ولا إنسانٍ خانته إنسانيته فتحوّل إلى حشرة أو مسخ، بل نحن بصدد توحّش أنطولوجي، ظاهرة تسكن الجسد وتتمرّد على قوانين الطبيعة البشرية، عن امرأة استيقظت من سباتها، لا لتصرخ، بل لتصمت، وتكره اللحم، وتنبذه، وتنفصل عن كل ما يمتّ للغريزة الحيوانية بصلة. قد يبدو الأمر بسيطًا: امرأة قررت أن تصبح نباتية، لكن الحقيقة، كما تنسجها هان كانغ، أكثر رعبًا من ذلك بكثير.
بطلة النباتية لا تتحوّل جسديًا، بل تتفكك داخليًا، تنقلب على ذاتها الإنسانية، وتغرق في شعورٍ غريب بأنها شجرة، كائنٌ نباتيّ لا ينتمي إلى عالم البشر، إنها لا ترفض الطعام فحسب، بل ترفض الهوية البيولوجية التي فُرضت عليها، وتبدأ رحلة الانفصال عن كل ما هو بشري، حتى عن اللغة، عن الرغبة، عن الجسد ذاته.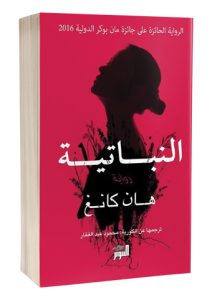
هان كانغ لا تكتب عن نباتية، بل عن توحّش الفكرة داخل الرأس، عن كيف يمكن لاختيار بسيط أن يتحوّل إلى صرخة وجودية، إلى عزلة لا تُحتمل، إلى انغلاقٍ تام داخل الذات، الجسد قد يبدو بشريًا، لكن الفكرة التي تسكنه وحشية، غريبة، مقلقة، بطلتها لا تبحث عن النجاة، بل عن التحرر من الإنسان نفسه، عن الانفصال عن النوع، عن الخروج من القطيع.
وإذا كان مخلوق شيلي سيئ الخلقة لكنه يحمل أفكارًا إنسانية، يبحث عن الحب والمعنى، وإذا كان سامسا قد فقد فجأة كل ما يربطه بعالم البشر، فإن بطلة هان كانغ تمثل الضلع الثالث في مثلث الوحوش، جسدها لم يتغير، لكن أفكارها توحّشت، وغرقت في عزلة لا صوت فيها سوى صوت الرأس.
قضية هان كانغ أكثر حداثة، لأنها لا تتحدث عن الوحش ككائن، بل عن الوحش كفكرة، كاختيار، كتمرد على نظام فكري يفرض على الإنسان أن يكون كما يريد الآخرون، إنها لا تسعى إلى التفرد، بل إلى تعذيب الذات بالفردية المطلقة، إلى الانفصال الكامل عن الجماعة، إلى أن تصبح الرأس هي محور العذاب، بينما الجسد مجرد وعاءٍ للنفي.
وعندما نربط بين الوحوش الثلاثة: مخلوق شيلي، حشرة كافكا، ونبتة هان كانغ، نكتشف أن ما يجمعهم ليس الشكل، بل التعرية الرمزية للذات، ذلك الكائن المختبئ خلف قناع الإنسانية، الذي لا يُكشف إلا حين تنهار اللغة، وتغيب الرغبة، ويبدأ التوحّش من الداخل.
في نهاية المطاف، لا يتعلق التوحّش هنا بالدماء أو الأنياب، بل بالفكرة حين تنقلب على ذاتها، حين يتحوّل الرأس إلى ساحة معركة بين ما يُراد للإنسان أن يكون، وما يختار أن ينفيه عن نفسه.
وهكذا، حين نضع بطلة النباتية إلى جانب مخلوق فرانكنشتاين وحشرة كافكا، لا نرى ثلاثة وحوش، بل ثلاثة مرايا مشروخة تعكس هشاشة الإنسان، وتفضح الزيف الذي يختبئ خلف قناع الإنسانية.
التوحّش، في جوهره، ليس نقيضًا للإنسانية، بل كشفٌ لها حين تنهار.
عدد التحميلات: 2