تراثنا السردي: من التناص إلى الأقلمةالباب: مقالات الكتاب
 | أ.د. نادية هناوي العراق - بغداد |

يبدو مفهوم اللامحاكاة للوهلة الأولى عائمًا وطارئًا بلا قاعدة تعطيه بعض الأهمية أو الصواب أو الجدية، أولاً لحداثة القول بها مفهومًا نقديًا وثانيًا لرسوخ ما يراد معارضته وهو المحاكاة حتى لا مجال للمقابلة بينهما. ومن ثم لا يتعدى القول باللامحاكاة، البحث عن المغايرة ومخالفة ما هو سائد، والتوق إلى التجدد والمناقضة. وهذا أمر طبيعي لو كان مفهوم اللامحاكاة طارئًا من دون مواضعات وأسس أو كان مقصودًا منه سد نقص أو مستجلبًا باندفاع إجرائي نحو تحليل نصوص الأدب. غير أن اللامحاكاة اشتغال أدبي مكانه في الموروث الطفولي للشعوب الأولى ومن ثم لا يكون القول به جزافيًا أو كيفما اتفق إنما هو مرصود عن سبق اصرار وتمحيص في الآداب الكلاسيكية بكل ما فيها من تحبيك وتخييل وفواعل غير طبيعية وبالاستناد إلى علوم السرد ما بعد الكلاسيكية. والغاية فهم علاقة العقل بإنتاج السرد.
ولا يفهم من القول باللامحاكاة أي قدح أو ذم بالمحاكاة الافلاطونية او الأرسطية ولا تعاليًا عليها أو رفضًا لها وإنما هي مقتضيات التنظير التي قد تكون مسايرة للتنظيرات المعهودة وأحيانًا لا تكون. وهذا شأن العلم في كل زمان ومكان فلا مقايسات ولا حدود، بل هي المغامرة التي لها أن تصل إلى أمر متوقع في البال أو غير متوقع أيا كان المتحصل يوطد المراد بلوغه في الأمر المبحوث فيه أو لا يوطده.
وما هو مؤكد أن اللامحاكاة أنبثت كفاعلية قولية في جذور أقدم المرويات التراثية التي وصلت إلينا منقوشة على رقم الطين العائدة إلى أقدم الشعوب على وجه الأرض، لكن فلسفة الفاعلية الأدبية بدأت من حيث كان الأدب قد ثبت قواعده وصارت له قوالبه وأجناسه أي في حدود ما بلغه الأدب الإغريقي من ازدهار فكانت المحاكاة هي النظرية التي بها فسر افلاطون وارسطو فنون الأدب ومقومات إبداعها. واستمرت نظرية المحاكاة من بعدهما نظرية ناجزة في تفسير الشعر والنثر، سارت إلى جنبها أو بعيدًا قليلاً عنها نظريات الأدب الأخرى مما عرفه تاريخ النقد الأدبي. وفي عصرنا الراهن أخذت ابحاث علوم السرد ما بعد الكلاسيكية وتحديدًا علم السرد غير الطبيعي تستغور في متروكات الفكر الإنساني معتمدة تعدد التخصصات ومازجة نظرية المعرفة بالنظرية الأدبية فاهتدت إلى كثير من الطروحات الجديدة ومنها أطروحة (اللامحاكاة) التي لم تطلق مفهومًا إلا بعد سلسلة أبحاث أجراها المنظرون الانجلوأمريكيون بقصدية من يباهل ويباهي بما وجده في مهملات الفكر البنيوي وما بعده من اهمية ونفع كي يضيف هو الى الفكر النقدي العالمي جديدًا. وفي مقدمة أولئك المنظرين براين ريتشاردسون الذي بدأ بكتابة أبحاث حول السرد غير الطبيعي عام 2006 واجترح مفاهيم: السرد المضاد والسرد غير المقيد والسرد غير الأدبي والسرد غير الخيالي ثم شاركه منظرون آخرون في هذه الابحاث التي كانت حصيلتها (اللامحاكاة) كمفهوم يستمد تطبيقاته من رحم النصوص التراثية حينا ومن النصوص الكلاسيكية وما بعد الحداثية حينا آخر.
وتعد النصوص التراثية النماذج البدئية للامحاكاة التي فيها تخيل العقل واقعًا خالصًا ولم يحاك واقعًا فعليًا، فالإنسان لم يكن يعرف عن نفسه والعالم إلا أقل القليل، لذا صاغ أشكالًا خرافية وخلق أنماطًا غير مسبوقة كي يتعرف إلى هذا العالم الذي لا يجهله. ونمت هذه الأشكال والأنماط بالتكرار وصارت نماذج في شكل خرافات وأساطير وملاحم. وحين توضحت مساراتها وأنماط بنائها، صُنع منها ما يماثلها أي تم تقليدها على وفق مواضعات تخييلية في بناء الأحداث والشخصيات لها بداية ونهاية، وتتألف من بنيات قولية حكائية أو شعرية.
وما أن تم تقليد النموذج حتى صار للأدب نظام قولي في التقليد، وكلما كثر التقليد، دل ذلك على رسوخ النظام وأصلية النموذج نفسه أيضًا. ولأن قيمة النموذج هي في قدرة صانعه على محاكاة العالم، صار ينظر المتلقون الى هذا الصانع نظرة تبجيل وتقديس بوصفه هو العالم المعلم والحكيم المحنك. فليس العالم هو المطلوب التعبير عنه إنما هي الذات التي تصور هذا العالم في صورتها. أي صورة الصانع المعلم الذي يصير العالم كيف تشاء، فالعالم رهن الصانع الذي نموذجه في ذاته، لأن العالم بالنسبة إليه غير موجود سلفًا، وكيف يكون موجودًا وهو الذي يصنعه؟!. بهذه الصورة أعطت اللامحاكاة الصانع/ المؤلف شاعرًا أو حكاء هيبة ومكانة فصار هو الأمين المؤتمن والمهيمن الذي يملك مجسات الإبداع كلها من جهة، ويتحكم من جهة أخرى بعقول الذوات من حوله، فهو مثل الساحر الذي يستجلب اليه أذهان المتلقين المستمعين استجلابًا وليس لهم إلا أن يصدقوا واثقين عن وعي وإدراك عقليين بحقيقة ما يقول ويفعل.
وتعني هذه العلاقة التوافقية الشفاهية ما بين صانع الكلام ومتلقيه، أن اللامحاكاة فاعلية عقلية صيغتها الأساس أنها سردية وأن منها تولدت المحاكاة وليس العكس. ومن ثم لا تكون المحاكاة خارجة أو شاذة أو بالضد من اللامحاكاة، لأن التخييل فعل ذهني ولا حدود له في أبعاده الحسية وغير الحسية. ولا يمكن لأحدنا أن ينكر أن للخرافات والاساطير تأثيرًا مستمرًا في الآداب القائمة على المحاكاة وما كان للمبنى الحكائي syuzhet أن يُعرف لولا انه تطوير للمتن الحكائي/الفابولا؟
ومعلوم أن ما قام به أرسطو من تحوير للمحاكاة الافلاطونية جعل مبدأ توليد الحبكة منقِحًا للواقع أي أنه لا يستنسخ الواقع إنما يعيد تصويره من جديد. مما يعني أن نطاق التخييل محكوم بقانون الاحتمال وسببية الحبكة وما ينبغي أن تكون عليه من وحدة عضوية وهو ما كان معتمدًا في كتابة المسرحيات الشعرية اليونانية وبكل ما فيها من نماذج بشرية أو حيوانية بيد أن أرسطو أباح للشاعر توظيف غير المحتمل إن هو اضطر إليه سواء على مستوى الزمان أو المكان أو الأفعال لكن بشرط أن يكون الانتهاك مبررًا بمنطقية. وبهذا تعود المحاكاة الى أصلها الذي هو اللامحاكاة حيث زمن النماذج ذات الطابع الروحي والطقسي مرتبط بالوجود حياة وموتًا ونشورًا، كدليل على قدرة العقل على الابتكار وكحتمية في أن السرد هو الفعل الابداعي الأول والأصيل الذي عرفه الإنسان.
ومع اتساع نطاق هذه النماذج ترسخت أعراف إنتاج الأدب ثم انتقلت من فضائها المحلي إلى فضاءات مجاورة، فازدادت بذلك أصالتها وارتفع سقف تقليدها أيضًا. بهذه الطريقة فرضت اللامحاكاة نماذجها على الأدب الواقعي. وعلى الرغم من تطور الحضارات وتنوع الثقافات، فان تلك النماذج ما زالت لها أصالتها وتفرض وجودها بوصفها تقليدًا من تقاليد الأدب، وأصلاً سابقًا لا يمكن تجاوزه. وإذا كان النموذج الأصل هو صنيعة اللامحاكاة، فان لا ضير أو ارتياب في أن يكون تقليده عن طريق المحاكاة تطويرًا وابتكارًا؛ فمصير كل نموذج أنه سيغدو تقليدًا، ولا تقليد من دون وسائط بها ينتقل النموذج من بيئته المحلية إلى بيئة ثقافية أخرى. وبهذا تصبح جدلية التأصيل/التقليد محركًا مهما من محركات تطور الأدب الإنساني كأمر عام وناجز خضعت له كل الآداب قديمها وحديثها شرقيها وغربيها.
وأغلب النماذج البدئية هي من انتاج الآداب الشرقية، فكان التأصيل مبينًا على اللامحاكاة والتقليد مبنيًا على المحاكاة بدءًا من جلجامش ولقمان ثم بيدبا وشهرزاد وليس انتهاء بأبي الفتح الاسكندري وحي بن يقظان. ومن هذه الآداب انتقلت هذه النماذج إلى الآداب الأوروبية فكانت القاعدة واحدة هي اللاواقعية وعليها تأسست تقاليد الأدب الواقعي بعامة. فالآداب في حالة تواصل مستمر، وما دامت جدلية التأصيل/التقليد حقيقة حاضرة، فان لا انقطاع في دورة النماذج من اللامحاكاة الى المحاكاة ومن اللاتحبيك إلى التحبيك ومن اللاواقع إلى الواقع.
وبتخصيص القول في المنظومة السردية العربية القديمة، يكون الحكاء في العصر الجاهلي هو مستجلب النماذج من أمم سابقة مجاورة أو بائدة. وكان لتقليده تلك النماذج أن جعله ينتج أخبارًا وحكايات وسيرًا شعبية وأمثالاً وأحاجي وأنسابًا. وبعض هذه التقاليد تحددت في قوالب قولية خاصة كانت صفوتها القصيدة العمودية بينما استمرت أشكال السرد بلا قوالب مخصوصة، وإنما هي تقاليد يتصرف فيها الحكاء ابتكارًا وتطويرًا بشكل شخصي وضمن حاضن شعبي/عمومي أحيانًا.
ومع رقي الحضارة العربية الإسلامية تحول الحكاء من استجلاب النماذج وتقليدها إلى تأصيل نماذجه الأدبية واختراعها بواقعية محاكاتية فيها التخييل يمتح من الواقع ولكنه في الآن نفسه استمر على شاكلة صانع النماذج اللامحاكاتية البدئية يتخذ من ذاته قطبًا ومحورًا للعالم مستوحيًا ذات الغايات الروحية التي كان يبحث عنها صناع النماذج الخرافية والأسطورية. فنما النظام السردي العربي في العصور الوسطى وصارت له نماذجه الواقعية المؤصلة أو الأصيلة. ثم تهيأت لهذه النماذج عوامل الرسوخ والتوسع بما كان للدولة العربية الاسلامية من مكانة حضارية وفكرية، فانتقلت النماذج عابرة الفضاء العربي والإسلامي إلى فضاءات مجاورة فارسية وتركية وأوروبية. وكانت بلاد الأندلس حلقة وصل مهمة في عبور النماذج الأدبية إلى الآداب الأوروبية، وضمن الجدلية الابداعية نفسها (تأصيل/تقليد) كدورة أدبية تبدأ باللامحاكاة وتنتهي بالمحاكاة. وبالمداومة على هذه الوتيرة تطورت هذه الآداب التي صار عصرها يُعرف بعصر النهضة.
إن بناء النموذج على قاعدة لا واقعية/لا محاكاتية كي يكون واقعيًا هو تأكيد لحقيقة أن السرد العربي عَرف الواقعية واللاواقعية فكانت لمنظومته الثقافية خصوصية تتمثل في أنه سرد مؤقلم فنماذجه انتاجًا وانتقالاً وتقليدًا تكشف عن مدى تعقد نظامه وقدم مواضعاته.
وانتقال النموذج من بيئته يعني أنه أقلم نفسه لبيئة أخرى وليس في الانتقال ما يشي بالاغتراب والبحث عن التجديد كما يرى عبد الفتاح كيليطو القائل: (يتجدد النص باغترابه.. فيتوق إلى الانتقال إلى لغة أخرى إلى تبديل ديباجته والظهور في هيئة طريفة باهرة لكن من سيلمح هذا التجديد أهم الغرباء الذين يحل بين ظهرانيهم؟ قطعًا لا، لأنهم لا يعرفون الوجه القديم وليس بوسعهم مقارنته بالوجه الحديث)1 ولو كان الأمر كذلك لما كان لنا أن نتحدث عن أصول ولما اكترثنا لسابقية نموذج على آخر ولما احتجنا إلى العودة إلى كلاسيكيات الأدب بالمرة.
وما نراه هو أن الانتقال مؤشر على ما للنموذج من أصالة، تجعله يهاجر، وهجرته تعني أن الغرباء استقبلوه وأثِّر فيهم. وطبيعي مع كل استقبال أن يكون التقليد أولاً، ومن بعده يأتي التطوير وربما التأصيل أيضًا.
وإذا كنا نخالف كيليطو في مسألة تجدد النص بالاغتراب، فإننا نوافقه الرأي في أن التراتبية الثقافية هي النزعة الغالبة على الثقافة العربية الكلاسيكية وبموجبها توضع (الذات في سلم ترتيبي، أن أتكلم عن نفسي معناه في هذه الحالة أن أعلن هل أنا أسمى، أرفع منزلة أعلى مقامًا من شخص آخر أم لا)2 فكان الفرد هو المجموع، كشاعر هو لسان حال القبيلة وكحكاء وراوية هو حكيم الأمة ومؤرخها، وكمؤلف يدوّن كتبًا تعبر عن المجتمع.
ولأن ثقافتنا العربية تكترث الاكتراث كله للذات بوصفها محور العالم، غدت النماذج الأدبية منسوبة الى مؤلف بعينه، فكان الحكاء يفصل صوته عن صوت الراوي، واضعا نفسه موضع المعلم الوقور والاخباري المحنك والناقد الكاتب والمفسر العالم بعكس الثقافتين الإغريقية والرومانية التي كانت نماذجها تتخذ من العالم محورًا فيغيب صوت الذات في صوت المجموع المتعدد. وكان المؤلف/الشاعر أو الحكاء يختفي من أجل أن تظهر شخصياته ومعها يكون العالم هو الحاضر وهو المركز. من هنا نشأ الشعر المسرحي وكان من تقاناته الكرنفالية والحوارية وليس في صالح الشاعر أن يقول (أنا) انما هي محاكاته العالم التي تعطيه المهابة وتحقق له النجاح، والقدح المعلى هو للشاعر والحكاء الذي تتشابك في قصصه الأصوات.
وتضمن اللامحاكاة للصوت الواحد أن يكون صانعًا لنماذج أدبية حيث التأصيل سابق على التقليد، لكن المحاكاة تضمن للأصوات المتعددة أن تصنع نماذجها فيضيع من ثم صوت الصانع/الأصل في أصوات نماذجه. من هنا كانت الثقافة الغربية صنيعة نماذج لا تأصيل لها وهو ما أوحى لباختين أن يضع نظريته الحوارية التي عليها أقامت كريسطيفا نظريتها في التناص وتلقفها النقد الغربي لأنها تتماشى مع ثقافته وأنساقها الهجينة التي ترى المتلقي متفاعلاً مع المبدع متوهما ــ وليس مصدقا وواثقا ــ أن الشخصيات هي التي تتكلم.
وهو ما ترفضه جدلية التأصيل/التقليد التي فيها اللامحاكاة سابقة على المحاكاة وفيها يكون المتلقي الذي يتفكر مصدقًا في ما يعرف انه كذب ولكنه يتقبله على أنه حقيقة، سابقًا المتلقي الذي يتوهم أن ما يسمعه أو يقرأه حصل أو هو حاصل أو سيحصل. وهذه هي اللاواقعية التي عليها أقام النظام السردي العربي قاعدته فكان المتلقي لا يتوهم وإنما هو يعلم أن الحكاء موثوق به ثقة مطلقة بوصفه معبرا عن المجموع وصوته الفرد صوتهم. من هنا تكون نظرية (التناص) نابذة للأصول ورافضة القول باللامحاكاة بينما نظرية (الأقلمة) قائلة بالأصول وبلا أدنى تعارض بين المحاكاة واللامحاكاة. وإذا كانت الآداب الهومرية بؤرة صالحة للتناص، فإن الآداب الشرقية ومنها الأدب العربي بؤرة صالحة للأقلمة.
وقد يعترض أحدهم على ما تقدم متسائلا عن وفرة ما في نصوص السرد القديم من الاقتباسات والاستشهادات، ونجيب: هذه الظاهرة حاصلة في كل الآداب ولها وظيفة تعليمية بلا شك لكنها لا تنفي أن الثقافة العربية ذات صوت واحد وأنها تفرز الأصيل عن المقلد وقديما قالوا: لولا إن الكلام يعاد لنفذ، وأن اختيار الكلام أصعب من تأليفه. وبسبب ذلك كانت قضية السرقات فنًا ولم تكن كل السرقات مذمومة، بل هناك المحمود والحسن والمستحب ولقد تشعب النقاد القدماء في تعليل السرقة والإحاطة بأبعادها وتصنيفها وتحدثوا عن الاقتباس والتضمين3. وعلى الرغم من ذلك كله، فإن الأصل يبقى مفصولاً عن المقلد، ويظل الحقيقي مفروزا عن المزيف من ناحية مركزية صوت الذات المؤلفة. ولو كانت المحاكاة هي أساس إنتاج النصوص لما تمكن هؤلاء من الفصل والفرز، إنما هي فاعلية التخييل التي فيها اللامحاكاة هي القاعدة.
ولقد ابتدع الحريري نماذجه ولم يضره أن الهمذاني ابتدع قبله مثلها، لأن الأصالة مضمونة لكل صوت منهما. وإذ اتهم ابن الخشاب (1099هــ ــ 1172 م) الحريري بالسرقة والتسلط على الجاحظ ورسالة أبي العلاء المعري وأخذ عليه مآخذ أسلوبية وصرفية ومعجمية، فإنه لم يستطع أن ينفي أصالة نماذج مقاماته ممثلة بالحارث بن همام وأبي زيد السروجي. وفي هذا دلالة على أن الناقد العربي القديم يهتم بالأصالة، وأن للتخييل أن يكون بلا مقاييس، ومن ثم لا خطأ في أن يسلك الحريري في موضوعاته سلوكا لا محاكاتيًا، فيضع السرد أحيانا على ألسن العجماوات والجمادات؛ فنماذج السرد العربي القديم ليست كلها مبنية على المحاكاة، لسبب بسيط هو أنها تتخذ قاعدتها من اللاواقعية التي قوامها اللامحاكاة.
من هنا تكون الثقافة العربية ثقافة نماذج أحادية الصوت، فيها الذات هي المركز. وتلك هي الخصوصية المهمة التي أتاحت لنماذج سردنا القديم أن تهاجر وأن تُقلَّد، فبنيت عليها سرديات كلاسيكية وحداثية وما بعد حداثية، وبما يؤكد أن السرد العربي القديم يملك خصوصية، نابعة من عالمية نماذجه وما يملكه من أقلمة.
وما بين انتقال النماذج واستقبالها، وكون الذات هي المركز، يصبح نظام السرد العربي واضحًا في قوته ورسوخ تقاليده وتكون أصالة الذات لا في نقاء عرقها أو لغتها وإنما هي في نماذج ثقافتها. من هنا تقع الدراسات ـــ التي تقارن بين قوة نماذج نظام السرد العربي ونماذج سرد آخر أقام نظامه على تقليد نماذج النظام الأول ـــ في التجزئة فتتميع فاعلية الأصل وتضيع نموذجيته.
وما جرى من مقايسات ومقارنات بين السرديات العربية الكلاسيكية وأشباهها في السرد الأوروبي، إنما يقع خارج إطار الجدلية التي أشرنا إليها آنفا وهي التأصيل/التقليد ومن ثم تكون أدوارها في البحث عن العناصر المشتركة كمن يساوي القديم بالحديث، والمغمور بالمشهور، والأصيل بالمقلد، والسابق باللاحق، والنتيجة المستخلصة في النهاية لا تتعدى سوء الفهم وخطأ التقدير. وإذا كان السرد العربي أصيلاً في نظامه وصالحًا للأقلمة فلأنه الواهب الذي أخذ وأعطى. وتلك خصوصية الآداب التي تجمع بين قدم النمذجة ودوامية النظام، وهو ما تدلل عليه تقاليده القائمة على قاعدة لا واقعية من اللامحاكاة وعليها بُنيت مختلف صور السرد الواقعي الذي قوامه المحاكاة.
الهوامش:
1 - الأدب والارتياب، عبد الفتاح كيليطو (المغرب: دار توبقال للنشر، ط2، 2013) ص ـ11 ـ12.
2 - الحكاية والتأويل دراسات في السرد العربي، عبد الفتاح كيليطو (المغرب: دار توبقال للنشر، ط1، 1988) ص73
3 - درس النقاد المحدثون قضية السرقات واغلبهم ساير البلاغيين العرب القدماء في طرحها باستثناء الدكتور طه حسين الذي عد السرقة هي الانتحال متبعا منهج الشك الذي لا ينجو منه أصل ولا تقليد ولا مركز ولا تابع.
تغريد
اقرأ لهذا الكاتب أيضا
- الجسد الأنثوي بين الانسلاخ وأدًا والبزوغ سردًا .. قراءة في قصة قصيرة لعلوية صبح
- الشك بين تصارع الأضداد والغوص في التساؤل .. قراءة في رواية «جمرات من ثلج»
- التداخل الأجناسي والتغاير الأسلوبي في القصة القصيرة جدًّا
- السرد الروائي بين التاريخي والتخييلي في رواية «قواعد العشق الأربعون»
- القصة القصيرة وبروتوكولات السرد ما بعد الحداثوي معاينة في مجموعة سايكو بغداد لرغد السهيل
- التخصيب السردي في رواية (مقتل بائع الكتب) لسعد محمد رحيم
- التوحد السردي موضوعًا وتقانة في رواية ( الطيف) لهيثم بهنام بردى
- الكينونة المؤنثة بين أمل العودة وخيبة الضياع قراءة في قصيدة الأم والطفلة الضائعة
- رواية التاريخ .. معاينة في التمثيل الثقافي
- مسارب المبادرة في التصعيد الدرامي في قصص (حافات الحلم)
- الأخلاق بين أفلاطون والفارابي
- سطوة الحكاية وسرديات الاستعادة في رواية (في بلاد النون)
- رواية التاريخ: المعطيات المعرفية
- رواية التاريخ: المعطيات المعرفية
- الحرج النقديّ في (السرديّة الحرجة) للدكتور عبدالله الغذاميّ
- الجنون بوصفه مهيمنة فكرية في قصص لطفية الدليمي
- طه حسين والبحث الحفري
- البعد الثالث للشخصية في قصص سعدي المالح
- جيرار جينيت والسرد ما بعد الكلاسيكي
- أحمد فارس الشدياق: ريادة سرديّة.. تُنقد بإتباعيّة
- تراثنا السردي: من التناص إلى الأقلمة




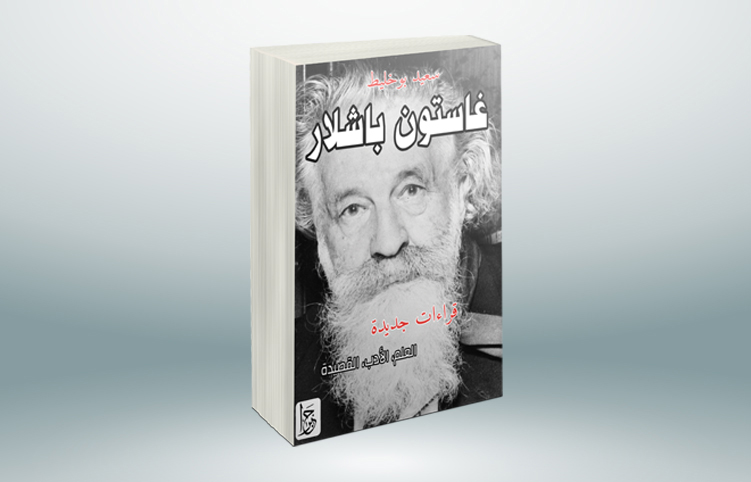

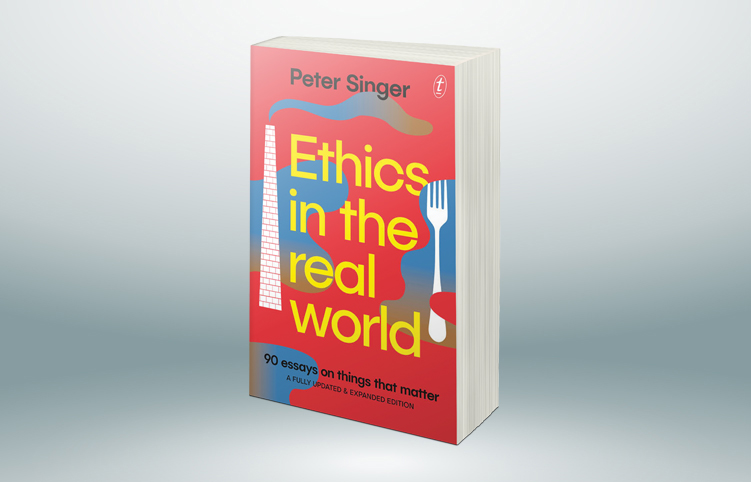










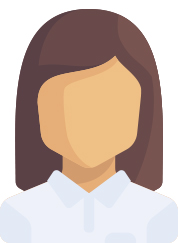
اكتب تعليقك