البيداغوجيا ليست علمًاالباب: مقالات الكتاب
 | محمد الحبيب بنشيخ المغرب |

حوار: رومينا رينالدي و هيلواز ليريتي
Romina Rinaldi. و Héloïse Lhérèté
ترجمة: محمد الحبيب بنشيخ
يعبّر فيليب ميريو، عميد البيداغوجيا، في كتابه الأخير عن عدوانيته بشكل واضح. «اللابيداغوجيون»؟ ماضويّون ونخبويّون! «المفرطون في البيداغوجيا»؟ ليسوا أكفاء وضيّقو التفكير! هُواة علوم الأعصاب؟ عِلمَويّون! ولكن على مَن نعتمد إذن في تربية أطفالنا؟
فيليب ميريو هو بكلّ تأكيد الأكثر شهرة والأكثر تميُّزًا من بين البيداغوجيين الفرنسيين. مناضل مسؤول، «رجل يسار»، إيكولوجي، يناضل منذ أربعين سنة لنشر مبادئ التربية الجديدة داخل المجتمع الفرنسي. إن المدرسة، في نظره، تخرج عن الإطار المدرسي. إنها تؤسس للسياسة؛ المكان الذي يجري فيه الإعداد لمشاريع مجتمع الغد. يُدرِج فيليب ميريو، سليل حركات التربية الشعبية، في غالب الأحيان خطابه خارج الممارسة البيداغوجية الصارمة، ليُقيم صورة جِهازية لمدرسة تنتمي إلى المجتمع، مثلما هو الأمر في كتاب معالِم لعالَم بلا معالِم Repères pour un monde sans repères 2002، المؤلَّف الذي يتساءل فيه عن مدى تلاؤم الممارسات التربوية مع التحولات المجتمعية (الإدمان على المخدرات، الإفراط في الجنس، وسائل الاتصال الجماهيرية …).
كتابه الأخير، يحمل عنوان التصدي. نهاية الخديعة Riposte.en finir avec le miroir aux alouettes.2018. «هجوم مضاد» على إصلاح جون – ميشال بلانكي – الذي يراه تطبيقًا للقيم الليبرالية (التقنوية، الإنجاز، التجريبية …)، ولكن يهاجم أيضا وفي آن واحد الاتجاه الحالي نحو «الإفراط في البيداغوجيا» . وباسم الاحترام الكامل للطفل، ننتهي إلى اعتبار هذا الأخير «كائنًا مسكينًا معزولاً في مدرسة تقليدية تسيء إليه». باختصار، إننا ندمِّر التربية الوطنية علَنًا. مؤسسة مضمونة يصفها بـ"البيزنيس" تناصر التربية الإيجابية، في صورة مناهج لا بدّ أن تسمح للآباء والمربين كذلك بأن يتلافوا كلّ أشكال الصراع مع الطفل. غير أنه في نظر ميريو، إذا كانت مُسلّمة التربية – الإيمان بقدرة كلّ طفل – هي الشرط الضروري لممارسة البيداغوجيا، فإن الرفض الخالص والبسيط للقيود هو فخّ يفتح الثغرة على انحرافات فردانية على المدرسة أن تحمي نفسها منها.
المدارس البديلة، العلوم العصبية، مناهج قديمة ولا زالت …، وهكذا يمرّ ميريو إلى الانتقاد الشديد لكل الطرق التربوية التي اختيرت حاليًا وبسهولة دون أن ينسى أبدًا وضعها في تاريخيتها. إنه مقتنع بأن التربية مسألة معقّدة جدًّا ولا تقبل أجوبة تبسيطية. وبقراءة ما بين السطور، فالسؤالان اللذان يوجّهان مجموع مؤلفاته هما: لماذا نربّي؟ ولبناء أيّ مجتمع؟
تدعون في كتابكم الأخير التصدي، إلى إعادة قراءة البيداغوجيين القدامى الكبار، بدلاً من «طوطمة التجديد». فهل تعتقدون أن مناهج الأمس لا زالت صالحة إلى اليوم؟
لا. لا أعتقد ذلك. إن التاريخ لا يعيد نفسه: فالظروف تتغيّر والأطفال كذلك يتغيرون، الشيء الذي يضطرنا إلى إعادة النظر في ممارساتنا التربوية باستمرار. ولكن البيداغوجيين الكبار واجهتهم إشكاليات نصادفها دائمًا في الوقت الحالي. والطريقة التي صاغوا بها تساؤلاتهم يمكن إذن أن تلهمنا. ففي الاتحاد السوفياتي مثلاً في العشرينيات من القرن الماضي، تساءل أونتون ماكرينكو عن كيفية تلافي سيطرة الأطفال الأكثر دينامية على الآخرين بطريقة مُمنْهَجَة داخل الجماعة؟ طبعًا لقد تغيّر السياق، غير أن هذا السؤال لا زال قائمًا. فلا معنى لتقليد مكارنكو تقليدًا أعمى، ولكن يمكن أن نبحث عند هذا البيداغوجي عن الاقتراحات التي قدّمها – مثل دورة المهامّ والوظائف داخل جماعات الأطفال – لنعيد النظر في منهجنا البيداغوجي الخاص بِنَا.
تجد المدرسة الفرنسية صعوبة في تطوير مناهجها وممارساتها، في حين أننا نشاهد نموّ البيداغوجيات المسمّاة بديلة. فكيف تفسّرون هذا؟
إن المدرِّسين الفرنسيين تنقصهم الثقافة البيداغوجية، وهذا مرتبط بفقدانهم هوّيتهم المهنية. فمهنتهم لا يمكن أن تُختزل في مجموعة من القدرات التقنية ولكنها تندرج ضمن تاريخ طويل. لا توجد أية مهنة بلا هوية، أي بلا تسلسل بالمعنى الأنثروبولوجي للكلمة. ولدعم هذه الاستمرارية، فنحن في حاجة إلى إعادة النظر في الشخصيات الكبيرة، ولكن أيضًا في الصراعات، الأسئلة، النقاشات البيداغوجية التي نشّطت القرنين التاسع عشر والعشرين. إن قضية المدارس البديلة تُطرَح اليوم بشكل كبير، ولكنها قضية قديمة طرحت منذ نهاية القرن التاسع عشر. ومن المفيد تحليلها لكي نفهم كيف ولماذا طرحت في الماضي. لنستلهم منها ما تقترحه، ولكن وبالأخص حتى لا نكرّر الأخطاء نفسها.
غالبًا ما تكون نقاشات علوم التربية معقّدة ومتناقضة، غير أن الاتجاه الحالي يميل بالأحرى إلى « صندوق وسائل تربوية»، أعلينا أن نخشى هذا البُعد؟ وهل سيجعل التفكير التربوي المنهجي في خطر؟
نعم ولا. لا يمكن للبيداغوجيا أن تستغني عن الوسائل. فكلّ مُربٍّ يبحث عن وصفات في وقت من الأوقات. وما العمل تجاه طفل في وضعية صعبة، مضطرب، وشارد …؟ لا بدّ من أخذ هذه المطالب مأخذ الجدّ، لأنها دليل على صعوبات حقيقية. ولكن الوصفات لا بدّ أن تُردّ إلى مشروعها. أحاول أن أبيّن أن لا وجود في التربية – وهذا صحيح أيضًا في علوم أخرى – لطريقة أو «تطبيق جيّد» محايد بالأساس. لا وجود للفعالية في حدّ ذاتها؛ إنها تُوجَّه دائمًا نحو شيء ما، نحو هدف محدّد. بهذا المعنى، فإديولوجية الفعالية تخدع لأنها تركّز ودون أن تصرّح بذلك، على نمط من الفعالية الخاصة، كالقدرة على ملء روائز بيزا Pisa. علينا أن نسائل دائمًا الوسائل البيداغوجية على ضوء المقاصد والأولويات التي نحدّدها لأنفسنا. لا وجود أبدا لوسائل أو تقنيات يمكن أن نتحكّم فيها وتكون مستقلة عن مشروع حول الطفل، الإنسان والمجتمع.
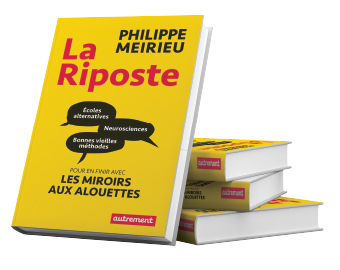
يبدو أننا في نهاية الأمر نتفق حول بعض الأهداف. ليكن كل طفل أنهى المدرسة الابتدائية عارفا بالقراءة، الكتابة والحساب، مثلاً …
أكيد، ولكن الطفل يمكن أن يتعلم القراءة لغايات مختلفة جدًّا. إن معرفة القراءة، مثلاً، ليست اكتساب طريقة فحسب. لقد كان هذا التعلم أولاً منضويًا بالأساس تحت مشروع ديموقراطي. لا يمكن أن نتصوّر وصفات معدَّة في المختبرات، وصحَّتها العلمية الوحيدة هي تمثيل شرط الاستعمال. إن الأمر ليس كذلك. فمسألة القيم لا يمكن تلافيها. والحالة هذه، تبدو لي أن النقاشات الحالية تقيم في غالب الأحيان، خطّة تفكير ديمقراطي تطمح إليه المدرسة.
يملك المدرسون اليوم وسائل عديدة للتدريس، ضبط الفصل، أو الإشراف على مشروع … فكيف ندمج هذه الوسائل في وِضْعة بيداغوجية واضحة ومنسجمة توافق عصرنا؟
إن العلاقة بين الطريقة والبيداغوجيا تقوم على ما يمكن تسميته «تكوين الحُكْم» . تفترض البيداغوجيا أن تكون هي نفسها مكَوَّنَة ومُطَّلِعَة بما يكفي، وأن تكون لها شبكات للقراءة تسمح بفهم ما نعيشه في العلاقة التربوية. ولكي نفهم فصلاً دراسيًا ما، فمن الضروري أن نملك مفاتيح في علم الاجتماع، وعلم النفس، وعلم النفس المعرفي – لنتمكّن من فهم الحَصْر عند الطفل مثلاً. وعلى هذا الأساس، فعلى التكوين أن يمنح المدرس مجموعة من الإضاءات. ولكن لا إضاءة من هذه الإضاءات وحدها يمكن أن تقدم عناصر القرار. إن الممارس في حاجة دائمًا إلى التصوُّر، التكوين، واتخاذ القرار وبسرعة في بعض الأحيان. وربما عليه أن يضع نظامًا للجماعة أو الدّعم، ويغيّر طريقة التعليم. ولا بدّ له لكي يدرِّس أن يستثير رغبة وإرادة الأفراد … كل هذه القرارات البيداغوجية تصدُر عن تأمُّل شخصي. وهذا لا يمكن أن يُختَزل في تطبيق إجراءات مقَنَّنة، يقرّرها عِلْمِيًّ خبراء ويطبقها آليّاً منفِّذون.
يحمل أحد فصول كتابكم عنوان «لماذا لا تعطي العلوم العصبية فصلاً دراسيًا» . فهل يتعلق الأمر باتخاذ موقف من العلوم العصبية في حد ذاتها، أو من هيمنتها الحالية على السياسات التربوية؟
إنه موقف من التربية. التربية ليست علمًا، هي «فنّ العمل»، بالمعنى الذي يفهمه ميشيل دي سيرطو M. de Certeau. فنّ هشّ وإنساني بالأساس. إن اللقاء البيداغوجي أمر شخصي يستدعي تقييم الشخص، وقدرته على أخذ الآخر بعين الاعتبار. ويتعذر اختزال هذه الخاصية. إنها تتضمن دائمًا جزءًا سياقيًا وقيميًّا، أي حمولة من القيم، تدعم هذا المشروع المجتمعي أو ذاك. ولا يمكن أن نعلِّم من غير أن نطرح مسألة الغاية: ما نوع الإنسان الذي نريد تكوينه، لأي مجتمع؟ ونسيان وجود قِيَم كامنة في كل نوع من أنواع المشروع، هو في الحقيقة إساءة فهم لطبيعة العمل البشري.
بعيدًا عن البيداغوجيا العصبية، أليست فكرة «علم» التربية هي التي ترفضونها إذن؟
نعم، إذا كان مثل هذا العلم يعني إملاء إجراءات سواء أكانت تربوية أم سياسية. يمكنني إذن أن أنتقد وبنفس الطريقة علم الاجتماع التربوي، اللسانيات التربوية، علم النفس التربوي الإكلينيكي أو التجريبي … سنكون دائمًا أمام الانحراف نفسه: انحراف خلط البحث العلمي – الذي لا بدّ أن يحافظ على صرامته – وأدوات الفاعلين الذين يهدفون إلى مشروع يبقى هدفه قيميًّا. كان هذا الهدف في القديم دينيًا، ثم فلسفيًا، أما اليوم فهو سياسي أكثر، بالمعنى النبيل للكلمة.
لقد تطورت العلوم المعرفية كثيرًا في السنوات الأخيرة. نفهم جيّدا إواليات الذاكرة، التفكير أو الانتباه، التي هي في قلب التعلم المدرسي. ألا يوجد نوع من الظلامية تريد القضاء على هذه المعرفة باسم التقليد البيداغوجي؟
تسمح العلوم العصبية بفهم كيفية عمل المُحرِّك، إنها ترفع الغطاء، وهي تسمح بمعرفة أفضل، مثلاً، لِما يمكن الانتباه إليه لتشجيع التركيز، وكم من المعلومات يمكن لدماغ طفل أن يعالج في آن واحد، وما الشيء الذي يمكن أن يكبح التفكير، إلخ. وبالنسبة للمدرس، فهذا نوع من لوحة القيادة، إنه مفيد ومثير للاهتمام في بعض الأحيان. ولكن لوحة القيادة هذه لا تعفينا من التفكير في الاتجاه الذي ستأخذه السيارة. وحينما تخبرنا العلوم العصبية عن كيفية عمل الذاكرة، فإنها تقوم بوظيفتها وتساعدنا على التعليم بصورة أحسن. ولكنها لا تقول لنا إن كان على الطفل أن يحفظ بالأحرى المعجم الإنجليزي، قصيدة لرامبو، أو سورًا من القرآن الكريم. كما أنها لا تفسّر ما يجب إيصاله، ولا لأي هدف … ولا تقول لنا أيضًا كيف نعلِّم طفلاً لا يرغب في التعلم. وببساطة، إنها لا تقول لنا إلى أين تتجه السيارة.
أتخشون تدخُّل العلوم العصبية في الميدان التربوي؟
لا، لأن علوما أخرى، مثل علم الاجتماع، يمكن أن تكون شكلاً من أشكال التدخل. ما هو خطير هو التعليمات. إننا لا نعلم أبدا الشيء الكثير عما يجري في رؤوس تلامذتنا. وعلماء الأعصاب أنفسهم، بعيدون عن استيفاء الموضوع، زِد على ذلك، فهم في غالبيتهم يعترفون بذلك عن طيب خاطر: فنتائجهم إلى حدّ اليوم، لا تقدم وصفة سحرية. وفضلاً عن ذلك، اكتشفتُ أن العلوم العصبية بفرنسا كانت ميدانا تسوده نقاشات حادّة. كما كانت لبعض المعسكرات رؤى متعارضة تمامًا عن دورها في التربية الوطنية. إن فعل التعلم لم تقرأ خطوطه الغامضة بعد: فهل نختزله في وضع بروتوكولات كونية مرتبطة بتطوّر البنيات الدماغية؛ أم هل هو في الحقيقة مرتبط بتواريخ خاصة، باستراتيجيات شخصية في التعلّم؟ هذا هو النقاش – من بين نقاشات أخرى – الذي على علماء الأعصاب أن يثيروه، ومن المستبعد الحسم فيه.
تؤكدون أن المدرسة تحمل دائمًا مشروعًا سياسيًا يتجاوزها. فكيف تفسّرون الإصلاحات الحالية في النظام المدرسي الفرنسي؟
يوجد في نظامنا ومنذ سنوات مسألة ضمنية لم تناقش أبدًا: الرأي الذي يرى أن الجودة تنشأ عن التنافس. «لنترك الأفراد يتنافسون في مجال الإنجاز؛ وسنحصل على أفضل ما عند كل واحد منهم، وعلى أفضل مجتمع ممكن» وهذا المُضمَر، الذي حمله في الغالب التيار الليبرالي الجديد، هو الذي يفسر كثرة التقويمات. ونجاح تقويمات بيزا Pisa العالمي يفسر هذا المُضمَر. فنحن أمام نوع من طوطمة للقدرات التقنية. وإذا أضفنا إلى هذا اختيار العلوم العصبية كـ« أساس» للممارسات التربوية الجيدة، فإننا نرى تكوُّن نواة إيديولوجية منسجمة: نواة مجتمع حيث «النجاح» يساوي النتيجة، وحيث نرى الإنسان كـ«إنسان – آلة»، ونختزل الحياة في أرقام والعالم في نظام واسع للصراع بين المصالح المتضاربة التي نسمح لها بالتطوّر، على أمل أن التقدم هو الحلّ. إن المدرسة لم تهدف أبدا إلى المنافسة والإنجاز. لقد تساءلتْ في الغالب، حتى وإن لم تجد الحلول دائمًا، عن كيفية تدعيم التفكير النقدي، وكيف نكوِّن مجتمعًا تضامنيًا، وكيف نسمح للأشخاص بالظهور والتحرُّر. وبالنظر إلى الإشكاليات التي تقلب مجتمعنا اليوم، مثل صعود الفردانية، صعوبة إقامة تفكير رصين، غزارة الكاريكاتورات والأخبار الزائفة، إلخ، يبدولي من المفيد أخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار.
فيليب ميريو
مرتبط منذ شبابه بحركات التربية الشعبية، درس في البداية الفلسفة والآداب، قبل أن ينال شهادة الأهلية البيداغوجية كمعلم ثم مدرس بالسلك الأول. تحمّل بعد ذلك مسؤولية إدارة إعدادية تجريبية، تعتمد البيداغوجيا الفارقة، وحصل بالموازاة مع ذلك على دكتوراه عن التفاعلات المعرفية لدى الأقران. تحمّل عدة مسؤوليات مؤسساتية، وهو يتابع أبحاثه. أدار على الخصوص المعهد الجامعي لتكوين المعلمين بمدينة ليون. ألّف العديد من الكتب نذكر منها:
رسالة إلى أستاذ شاب
Lettre à un jeune professeur (2016)
الهجوم المضاد. نهاية الخدعة
La Riposte.En finir avec le miroir aux alouettes (2018) .
تغريد


















اكتب تعليقك